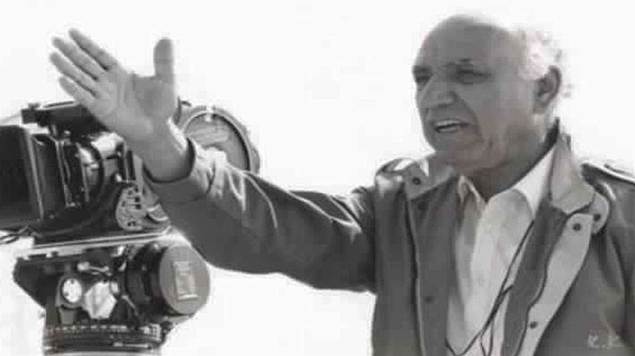الحضور الشيطاني والأشباح والقوى الخفية في أفلام الرعب (3 من 3)

منذ أن تمرّد الشيطان على المشيئة الإلهية، وأعلن عصيانه، واتخذ من الإنسان هدفاً أساسياً يسعى إلى إفساده وتلويثه وتدميره روحياً، صار الشيطان مصدر الرعب الأعظم للإنسان، الذي يشعر بحضوره ماثلاً في كل لحظة وفي كل مكان، فهو الذي يجعله – حسب ادعاءاته – يرتكب الآثام ويتفوّه بما لا يليق ويزيّن له المعاصي. صار الذريعة التي يلجأ إليها الفرد كلما أخطأ أو أذنب محمّلاً إياه المسؤولية.
الحضور الشيطاني تجسّد على الشاشة في بدايات السينما. فيلم “طالب من براغ” (1913) يحكي قصة طالب يحتل الشيطان صورته المنعكسة في المرآة وروحه أيضاً. هذه القصة قُدمت على الشاشة عدة مرات. كذلك أسطورة فاوست التي صُوّرت سينمائياً ثمان مرات في مرحلة السينما الصامتة، كان أشهرها فيلم الألماني مورناو في العام 1926، كما صُوّرت مرات عديدة منذ أن نطقت السينما. وفاوست، حسب الحكاية المرعبة التي ظهرت في القرن السادس عشر، هو المنجّم الذي باع روحه إلى الشيطان لقاء امتلاك قوى سحرية.
سينمائياً بدأ اهتمام الشيطان بالتحكم في العالم من خلال ولادة ابن له من أم بشرية، وذلك في فيلم رومان بولانسكي “طفل روزماري” (1968). الفيلم لم يلجأ إلى التصريح بالحضور الشيطاني أو إلى العنف، بل أن قوته تكمن في واقعيته وطبيعيته والطاقة الإيحائية حيث أننا لا نرى طفل الشيطان إنما نشعر بوجوده.
في العام 1972 قدّم وليام فريدكن “طارد الأرواح الشريرة” Exorcist الذي لقي إقبالاً هائلاً، وكان بدايةً لموجة من أفلام الاستحواذ الشيطاني، حيث يسكن الشيطان جسد ضحيته ويجعلها تمارس أفعالاً شنيعة. كان فيلما مرعباً وعنيفاً وصادماً، يتلاعب بأكثر المخاوف بدائية عند الجمهور: الاعتقاد بهشاشة الهوية الذاتية، وإمكانية فقدانها بسهولة، والإحساس بوجود الشيطان أو القوى اللاعقلانية داخل الذات البشرية.
التوجه الديني، في هذه الأفلام، صريح ومباشر، فتخليص النفس والجسد لا يتم إلا من خلال الإيمان. العلم يعلن عن عجزه أمام ظاهرة غير طبيعية، خفية، خارقة، ويشجّع اللجوء إلى الطقوس الدينية من أجل إنقاذ النفس. بهذا تتم إعادة تثبيت وضع الكنيسة والدولة والعائلة كقوى ثابتة، مطلقة، أزلية، تمثّل الخير.

من فيلم “النذير” أو The Omen
في الأفلام التالية لم يعد الشيطاني يسكن الجسد البشري فحسب، بل الأشياء أيضاً.. مثل السيارة والبيت والمصعد وغيرها. وإذا كانت هذه الأفلام تُظهر انتصار قوى الخير بعد تجربة قاسية ومعاناة مريرة في جحيم الاستحواذ الشيطاني، وإنقاذ النفس البشرية بفضل الإيمان والقوى الروحية، فإن أفلاماً أخرى مثل “النذير” The Omen (1976)، مع أجزائه اللاحقة، تؤكد على انتصار الشر وحتمية المواجهة بين المسيح والمسيح الدجال الذي ينشأ في كنف أعلى سلطة سياسية في أميركا، ويكبر ليصبح على وشك الاستيلاء على العالم بحكم عمله في السلك الدبلوماسي. إن تدمير العائلة هنا يكون تمهيداً لتدمير أمّة أو عالم سيكون مأهولاً بالشياطين فقط.
الأشباح والقوى الخفية
بيت قديم، موحش، معزول، في موقع ناءٍ ومعتم. إنه منظر يثير الرعشة ويوحي بوجود شيء شرير. يضاعف هذا الإحساس صرير الأبواب الحاد، الدهاليز المظلمة، الظلال الغريبة، الضوء الملتمع فجأة بفعل البرق والذي يخترق النافذة، إضافة إلى عواء الريح. وعندما نسمع وقع أقدام وضحكات غريبة وهمسات مبهمة، عندما تحدث أشياء خارقة للطبيعة، نعرف أن ثمة قوى خفيةً، غامضة، شريرة، تسعى إلى إرعاب وإيذاء القاطنين، ونعرف أن البيت مسكون بالشياطين أو الأشباح أو الأرواح.. وأنه سيتحول إلى جحيم.
هذه الظاهرة مصوّرة في أفلام عديدة مثل: البيت المظلم القديم (1932)، بلا دعوة (1944)، موت الليل (1945)، بيت على التل المسكون (1959).
إذا كانت الألغاز تحل في النهاية، وتجد الظواهر الغريبة تفسيراتها المنطقية في أغلب تلك الأفلام، فإن في أفلام لاحقة يتضاعف الغموض، وتدوم الألغاز المحيّرة والمقلقة، ولا يتم تقديم أي تفسير لما حدث.. كما في فيلم “المبنى المحترق” (1977) حيث لا نجد البيت المسكون بالأشباح أو القوى الروحية، إنما البيت الذي يمتص حياة قاطنيه ليجدّد نفسه. في “سفينة الموت” تتحول المدرّعة النازية إلى قوة مدمرة غير مرئية. في “رعب أميتيفيل” تسيطر القوى الشريرة على عقول ساكني البيت وتدفعهم إلى ارتكاب جرائم بشعة. في “اللمعان”The Shining لستانلي كوبريك، يستحوذ الفندق المهجور على روح وعقل حارسه ويدفعه إلى محاولة قتل زوجته وابنه.

من فيلم “اللمعان” The Shinning
ظاهرة القوى الخفية تعكس الإحساس بهيمنة قوى خارجة عن الذات، لا يمكن إدراكها والسيطرة عليها، بالتالي تعكس الخوف من المجهول ومن الأشياء المستعصية على الفهم.
الأشباح لم تؤخذ بجدية في بدايات السينما، ولم تكن تثير الفزع، بل أنها أحياناً كانت ترتاد على نحو ودّي ومضحك بعض الأفلام الكوميدية مع لوريل وهاردي، بوب هوب، أبوت وكوستيللو. في ما بعد، صارت الأشباح تأخذ مظهراً جاداً ومخيفاً، فبداية الستينات شهدت أحد أكثر أفلام الأشباح إثارة للرهبة هو “المسكون” The Haunted (1963) للمخرج روبرت وايز، عن فريق من الباحثين في القوى الروحية أو الخارقة يتحرون حقيقة منزل غريب يسبّب بقواه الخفية الموت لساكنيه. إن مصدر الرعب هنا لم يكن مجسداً بصرياً، ولم يكن هناك حضور جلي لقوى الشر، بل اعتمد الفيلم على الإيحاء بذلك الحضور والقوة اللامرئية في خلق الخوف والإثارة عند الجمهور. هذه القوى تمتلك سلطة مطلقة نظراً لكونها غير مرئية بالدرجة الأولى، بالتالي فهي عصيّة على الإدراك والتخيّل. هذه الخاصية هي التي تعمل على تصعيد الخوف والرهبة عند المتفرج العاجز عن الرؤية ومعاينة مكامن التهديد والخطر.
إن قصص الأشباح في السينما ذات حبكات ومعالجات متعددة، ففي فيلم “الضباب” (1980) تتعرض مدينة ساحلية لغزو ملاحي سفينة موتى في هيئة ضباب كثيف ومميت. في “قصة شبح” تعود فتاة ميتة بعد سنوات طويلة لتنتقم من أولئك الذين تسببوا في موتها. وفي الأجزاء الأربعة من “الأشباح الضاجة”Poltergeist تختبر العائلة الحضور الشبحي وتحاول إنقاذ الابنة الصغيرة من القوى التي أخذتها إلى عالم الأرواح.
أحياناً يعبّر الحضور الشبحي عن تحذير ما أو دعوة للأحياء للكشف عن سر جريمة غامضة. في فيلم “استبدال”Changeling تستحوذ روح صبي معوق على موسيقار للكشف عن حقيقة موته على يد والديه واستبداله بطفل آخر هو الآن يمتلك سلطة ونفوذاً في الوسط السياسي.
إقليم الجنون
لقد لاحظنا كيف استثمرت أفلام الرعب غريزة الخوف من المجهول في إثارة مشاهديها وإرعابهم، ورأينا مظاهر وأشكالاً متعددة للمجهول الذي يتمثّل في الآخر، الحيواني، الفضائي، الوحشي، الشبحي. كما أنه يتمثّل أيضاً في الدماغ البشري وذلك عندما يضطرب ويتشوش ويختل ويختبل.. أي يغادر إقليم العقل ليسكن إقليم الجنون، عندئذ يتحول المجنون إلى آخر، مختلف، يفتقر إلى التفكير المنطقي ولا يمكن التنبؤ بما سيفعله.
إنه يصبح مجهولاً لأن أحداً لا يستطيع أن يفهمه، ولأن الإنسان يخاف غريزياً من الشيء أو الكائن الذي لا يفهمه، فإن المجنون يصبح كائناً مخيفاً ينبغي احتجازه أو نفيه خلف أسوار عالية وحصينة لا يمكن النفاذ منها.
خوفنا من المجنون هو انعكاس لخوفنا من – أو على – عقولنا المهدّدة بالاختلال في أية لحظة ولأي سبب خارجي أو ذاتي. إنه الإحساس المرعب بأن العقل معرّض للعطب أو الاضطراب، وأن الجنون شيء ضار ومدمر. لكن ماذا يحدث عندما ندرك، نحن العقلاء والأسوياء، أن الشخص المجنون طليق، يتجول في طرقاتنا وأمام بيوتنا، وأنه لا يستطيع أن يميّز بين الخير والشر، بين ما هو مسموح وما هو محظور، بين البراءة والإثم؟ ماذا يحدث عندما نكتشف بأن هذا المجنون ممسوس بفعل القتل، يرتكبه تحت ضغط نفسي وعقلي لا طاقة له على احتماله، كما لو أن الفعل يمليه باعث داخلي لا يقوى على عصيانه، أو كما لو أنه يمارس القتل بوصفه لعبة طفولية؟إنه الغريب المجهول الذي يتحرك بيننا لينشّط مخاوفنا.
الشخصية السايكوباتية (المضطربة عقلياً) ارتادت عوالم السينما منذ البدايات، ليس في أفلام الرعب فقط بل في الأنواع الأخرى كالأفلام البوليسية والحربية والويسترن. إنها الشخصية التي تتصرف على نحو غير سويّ وغير منطقي، وتمارس عنفها الجنوني بلا رادع ولا ضمير.. بالأحرى، بلا عقلانية. أعماقها غامضة وشديدة الاضطراب، تصرفاتها غير مبرّرة، دوافعها مبهمة. لكن هذه الشخصية لم تحقق حضورها المطلق والمهيمن والأكثر رعباً وعنفاً إلا في فيلم هتشكوك “سايكو” Psycho (1960)الذي يعرض شخصية نورمان بيتس، المختل عقلياً والمصاب بالشيزوفرينيا، الذي يقتل ضحاياه مرتدياً ثياب أمه المحنطة.
هذا الفيلم أصبح مادة للمحاكاة – موضوعاً وأسلوباً – في العشرات من أفلام الرعب اللاحقة، وكان بداية لموجة من الأفلام التي تتخذ من الشخصية السايكوباتية محوراً رئيسياً.
استخدمت هذه الشخصية في الأفلام عبر تنويعات وحبكات مختلفة:
سلسلة من جرائم القتل تحدث ولا أحد يعرف مرتكبها. المعلومة الوحيدة المتاحة هي أن القاتل شخص مريض عقلياً. الشبهات تحوم حول مختلف شخصيات الفيلم إلى أن تتضح هوية القاتل في النهاية مع تقديم تفسير سيكولوجي للدوافع الجنونية، بدرجات متفاوتة من الإقناع. مثل هذه الأفلام تتلاعب بفكرة الجنون والعقل، والتخوم التي تفصل بينهما، بحيث تجعل المتفرج يختبر حالة من التشوش وعدم الفهم فيرتاب في المظاهر وفي حقيقة ما يراه، ولا يعود يميّز بين البرئ والمذنب، فذلك الذي حسَبَه بريئاً يتضح في النهاية أنه القاتل.
في أفلام أخرى تكون هوية القاتل، المختل عقلياً، محددة منذ البداية، والمتفرج يتابع، في قلق بالغ، عنفه وعدوانيته وأفعاله المجنونة. مثل هذا السلوك لا يأتي بشكل فجائي ومباشر بل على نحو تصاعدي وتدرجي، حيث نرى تلميحات أو إشارات إلى جنونه الكامن إلى أن يصبح هذا الجنون كاملاً ومطلقاً في النهاية. وبما أن القاتل المجنون مكشوف ومرئي فإن الفيلم عادةً لا يركّز على التدمير الذي يلحقه بالآخرين فحسب، إنما أيضاً على التدمير الذاتي، كما في فيلم “نفور” Repulsion للمخرج رومان بولانسكي، وفيلم “لابد أن يحل الليل” Night must fall ، وغالباً ما تثير هذه الشخصيات تعاطف المتفرج معها (حتى وإن كان مؤقتاً) ذلك لأنها معروضة كضحية للوضع الاجتماعي والعائلي والنفسي المحيط بها. القاتل في فيلمTwisted nerve يبدو أشبه بطفل في تفكيره وسلوكه. أما في “بيت الرعب المسكون” فيركض القاتل في الليل صارخاً وباكياً، مرعوباً من الظلام المحيط به.

من فيلم “نفور” Repulsion
ثمة أفلام تعتمد في بنائها وحبكتها على الاشتباه والمخاوف العامة من الجنون. البطلة، على سبيل المثال، تتعرّض لمحاولات لحوحة، مصحوبة بدلائل تبدو مقنعة، لإيهامها بأنها مجنونة فعلاً وأنها قاتلة، وذلك بغية التخلص منها. هي تجد نفسها وحيدة، بلا دفاع ولا حماية، في مواجهة شكوك وأوهام تدفعها نحو حافة الجنون. الشرير أو القاتل مجهول هنا، ومن يبدو بريئاً يتضح في النهاية أنه آثم.
إن أفلام الرعب المنتجة في الخمسينيات والستينيات كانت تركّز على الخطر الخارجي: غزوات مصاصي الدماء والمستذئبين وكائنات الفضاء الخارجي وغيرهم. العدو “الآخر” كان يوجد خارج ذوات الأفراد، وكان هؤلاء يخشون غزو الآخر أو تلويثه لأجوائهم وبيئتهم.
في سنوات الثمانينيات أصبح العدو في “الداخل” ولم يعد خارجياً فقط. أصبح وجهاً مألوفاً في ظاهره وغريباً في جوهره. إنه كائن حقيقي وليس متخيلاً. من داخل البيوت والأحياء والضواحي، من وسط الظلام الدامس والمخابئ المجهولة، يخرج القاتل وحيداً وصامتاً، مقنّعاً، مسلحاً، يقتفي الضحايا الغافلين، المغمورين بوهْم الأمان والطمأنينة، ليصطادهم الواحد بعد الآخر – بلا شفقة ولا ندم ولا تأنيب ضمير – من أجل اشباع رغبته في الانتقام أو التلذذ بالسفك وإرضاء ميوله السادية. القاتل هنا يفقد اتزانه العقلي، ويكبح كل مشاعره وعواطفه الإنسانية، ويبلغ الدرجة القصوى من الجنون والسادية.
فيلم “عشية عيد القديسين” Halloween (1978) للمخرج جون كاربنتر يعتبر بداية لموجة مختلفة من أفلام الشخصيات السايكوباتية، حيث يتم الاستغناء عن التحليل السيكولوجي، وتفسير الحالة العقلية للقاتل، لتتخلل البناء الإثاري والتشويقي مشاهد عنف بالغ، وصار الهجوم يتركز، بمساعدة المكياج والمؤثرات البصرية والسمعية، على الجهاز العصبي للمتفرج بتوجيه صدمات متوالية عبر كميات هائلة من الدماء وجرائم القتل البشعة بمختلف الأدوات والوسائل، فالقاتل المختل لم يعد يحتاج إلى دوافع لأفعاله الإجرامية، بل صار يكتفي باصطياد ضحاياه، الغافلين أو اللامبالين أو المختبئين في أماكن يسهل كشفها، أو الذين يتصرفون بحماقة وغباء، ليمزّق أجسادهم بآلية وسادية بالغة.
فيلم “هالووين” أسّس بنية نموذجية، أو بالأحرى أسّس كليشيهات، التزمت بها الأفلام اللاحقة على نحو صارم.
منذ هذا الفيلم برز نسل جديد من القاتل المختل عقلياً: إنه خارق، يتحرك خارج قوانين الطبيعة والوجود الإنساني، ذو حضور شيطاني، قادر على الظهور في عدة أماكن في وقت واحد، خالد وسرمدي حسب الأجزاء المتوالية إذ ما إن تنتهي حياته بالرصاص أو بالأدوات الحادة المميتة حتى يُبعث ثانية في الجزء التالي من لدون أن يتأثر بالإصابات، ليرتكب جرائم أخرى بالطرق نفسها، وليلقى المصير ذاته عبر أحداث يمكن بسهولة التنبؤ بمجرياتها.
ثم يأتي فيلم “الجمعة 13” (1980)، وما يليه من أجزاء متتابعة، ليركّز على العنف الصارخ ويحوّل الشاشة إلى مسلخ مغمور بالدماء الغزيرة المنبثقة من ضحايا يصعب التعاطف معهم. القاتل المجنون ذاته، الخارق، الذي ينتحل إسماً وهيئة مختلفة، يقتحم المعسكرات الصيفية الغاصة بالمراهقين ليستعرض مهاراته في القتل.
وفي سلسلة أفلام “كابوس في شارع إلم” Nightmare on Elm Street (1985) يرتاد المسخ القاتل كوابيس الشباب من الجنسين ويقتلهم بطريقة عنيفة جداً انتقاماً من أهاليهم الذين أحرقوه حياً.

من فيلم “كابوس في ايلم ستريت”
وفي سلسلة أفلام “أعرف ماذا فعلتم في الصيف الماضي”I Know What You Did Last Summer(1997) شخص مجهول الهوية يسفك دماء الشباب انتقاماً منهم لدهسهم بالسيارة ابناً له في حادث غير متعمد.
وفي سلسلة أفلام “الصرخة” Scream(1996) نرى أيضاً قاتلاً مقنّعاً يسفك دماء الطلبة من الجنسين بلا مبرر.
الإيرادات العالية التي حققتها هذه السلسلة من الأفلام أدت إلى إنتاج العشرات من الأفلام التي تتمحور حول الشخصية السايكوباتية، وتحاكي البناء والحبكة نفسها، متجاهلة الأبعاد الدرامية والسيكولوجية، معتمدة على المؤثرات والمكياج وحركات الكاميرا الاستعراضية، مستعينة بممثلين عاديين ومخرجين يفتقرون إلى الخيال وحس الابتكار، مع إقحام لقطات جنسية لضمان الرواج التجاري.
السرد في هذه الأفلام مجرد ذريعة لربط سلسلة من الجرائم البشعة. الحبكة المألوفة، المستهلكة، تظهر مجموعة من المراهقين في موقع ناء ومعزول أو مهجور، مع قاتل مختل ومشوّه أو هارب من مصح عقلي، وحالات متكررة من القتل.
ثمة توجّه آخر ومختلف، أكثر جديّة وطموحاً، لتناول الشخصية السايكوباتية في السينما، نجده في فيلميْ: “زوج الأم” Stepfather (1986)، و”صمت الحملان” The Silence of the Lambs(1991).
هنا يتم استبعاد عناصر الرعب التقليدية والصدمات المجانية، والتركيز على الدوافع السيكولوجية وانحرافات النفس البشرية في أوضاع مدروسة بوعي وعمق. كما يتسم الفيلمان بخاصيات فنية تعبّر عن الحالات الدرامية، بأدوات متطورة ومبتكرة، تحت إدارة مخرج متمكن ومتحكم في مادته وعناصره السينمائية، بممثلين قادرين على نقل أعماق الشخصيات بقوة وصدق وإقناع.
العائلة كمصدر للرعب
حرصت أفلام الرعب، لسنوات طويلة، على توكيد – أو إعادة توكيد – القيم العائلية التقليدية، والانحياز إلى العائلة الطيبة في مواجهتها مع الشر، بتصوير انتصارها المحتوم على الآخر الذي يمثّل المنتهك والغازي، والذي ينوي أن يدمّر قيمها ويحطم وحدتها ويفترس أفرادها.هكذا رأينا وحدة العائلة المتسمة بالتناغم والانسجام تتعرض لاختراق عنيف وانتهاك خطير يهدّد بتفكيك هذه المنظومة لكن العائلة تدحر الغزو وتنتصر في النهاية لتعود كما كانت موحدة وسليمة وقوية.
الرغبة في المحافظة على العائلة ككيان اجتماعي يوفّر الحماية والأمان والاستقرار للفرد، جعلت هذه الأفلام تنأى عن استجواب وحدة العائلة والكشف عن مظاهر القمع والانحراف المتوارية تحت السطح الهادئ والآمن ظاهرياً، وأخذت تروّج للفكرة القائلة بأن مصدر الرعب خارجي وأجنبي، وأن الخطر يأتي دائماً من الخارج: من المواقع النائية، أو من الفضاء المسكون بقوى الشر، محاولةً بذلك المحافظة على الصورة البريئة والنقية للعائلة.
جاء فيلم هتشكوك “سايكو” ليحطم هذا الوهم ويكسر الصورة الزائفة، مصوراً العائلة – ربما للمرة الأولى – كمصدر للرعب.. هذا الكيان الذي كان عرضة لهجمات شرسة ومتلاحقة من الوحوش صار منتجاً للوحوش والمسوخ. الشخصيات الشيزوفرينية، والسايكوباتية (المضطربة عقلياً)، والأطفال المتوحشون، بل وحتى المسيح الدجّال، هي شخصيات معروضة كنتاج للعائلة.
في هذا المحيط يتم اختبار المخاوف الأولى للطفولة، الكوابح الدينية والجنسية، مشاعر الإثم والإحساس بالذنب، التعرّف على أشكال السلطة في صورتها الأوليّة.
الفضاء الداخلي للبيت يصبح مشحوناً بالأسرار والتوترات والمخاوف والمشاعر المنفلتة التي لا يمكن التحكم فيها والسيطرة عليها. وعندما يُنظر إلى العائلة بوصفها عالماً مصغراً أو نموذجاً للأمة فإن هذه المظاهر تكتسب أبعاداً اجتماعية وسيكولوجية أشمل، ويصبح التهديد أعم.
صارت الأفلام تهتم بتصوير الجانب المظلم من الحياة العائلية، وتبرز بجرأة أشكال الانحرافات المخيفة وانفلات الغرائز البدائية وانبعاث المسوخ من حضن العائلة. وغالباً ما تنتهي الأفلام بانهيار العائلة كنظام مؤسس، وبهزيمة تعاليمها وقيمها المتوارثة.
في فيلم “ليلة الأموات الأحياء” (1968) تقتل البنت الصغيرة أبويها وتفترسهما. في فيلم “موت الليل” Dead of Night (1972) يعود الابن الشاب من فيتنام في هيئة زومبي ليثأر من العائلة ورموز السلطة. في “إنه حي” It’s Alive (1974) يكون الطفل المسخ نتاج العائلة.
في زوج الأمStepfather نرى رجلاً ممسوساً بصورة العائلة المثالية وما إن تتعرّض هذه الصورة لنوع من الخلخلة والاهتزاز حتى يظهر كقاتل وحشي فيتخلص من العائلة التي خيّبت أمله ويبحث عن عائلة أخرى تتوافق مع الصورة.
في أفلام أخرى تصبح الكانيبالية (أكل لحوم البشر) وسيلة العائلة للبقاء وتغذية نفسها: فيFrightmare لا تستطيع الأم الطيبة أن تستمر في البقاء إلا بأكل اللحم البشري. في “مجزرة تكساس المنشارية” (1973) و”للتلال أعين” (1977) تتغذّى العائلة من اللحم البشري. فيلمParents يصور معاناة صبي يكتشف أن والديه من أكلة لحوم البشر. أما فيلمNear dark فيُظهر عائلة شاذة وبدائية تتجول ليلاً لتصطاد ضحاياها وتمتص دماءهم.
الطفولة ليست بريئة دائماً
في عدد من أفلام الرعب، مثل: الدائرة (The Ring) الضغينة (The Grudge) مياه قاتمة (Dark Water) يتعرض الأطفال، بعد تصدّع وانهيار العائلة النووية، للهجر والتعذيب والقتل على أيدي ذويهم المضطربين نفسياً وعقلياً. هؤلاء الأطفال، العالقون في عالم آخر غامض ومخيف، يبحثون عن أم بديلة وعن ملاذ بعد أن فقد البيت وظيفته كملجأ آمن.

من فيلم The Grudge
في سينما الرعب يفقد عالم الأطفال براءته وطهارته المعهودة، ويتحوّل إلى عالم مخيف مأهول بالرغبات المدمرة، المجنونة، اللاعقلانية. الأطفال هنا يشعرون بخيانة الكبار لهم، وبأن هؤلاء الكبار يسعون إلى تلويث براءتهم وتقييد حرياتهم، لذا يجابهونهم بالتدمير والعنف الدموي.. حتى الأب والأم والأقارب لا يسلمون من العنف.
أحياناً يمارس الأطفال القتل كنوع من اللعب، وذلك عندما يحدث الالتباس بين الوهم والحقيقة. ربما لا تكون الدوافع مبرّرة، لكن الضغوط تصبح – من وجهة نظرهم – صعبة الاحتمال، وينظرون إلى أفعالهم كضرب من الدفاع عن النفس.
الرضيع المسخ الذي يفتك بمن يصادفه، في فيلم “إنه حي”، هو نتاج العائلة. إنه الضحية والوحش معاً. الأب ينكره فيعود من أجل إحراز الاعتراف به.. وبدلاً من تدمير الوحش، تحاول العائلة حمايته.
في فيلم “أطفال القمح” Children of the corn يرتكب الأطفال، بدوافع شيطانية، أبشع أنواع القتل والعنف ضد سكان البلدة.
الشيطان يجد مأواه المثالي في أجساد الأطفال، إنهم يصبحون مسكونين به، ومن خلالهم يتجسّد مهدّداً العائلة ومن ثم العالم.. كما في “طارد الأرواح الشريرة”. وفي فيلمThe omen يكتشف الأب – السفير الأميركي – بأن الطفل الذي يربيه ليس ابنه بل هو ابن الشيطان.
انقلاب التكنولوجيا
حتى عندما يكون الإنسان معزولاً داخل بيته، أو محتمياً في مكان ما رغبةً منه في تفادي أي تدخل أو تطفل أو انتهاك، معتمداً فقط على الوسائط والوسائل الإليكترونية، فإن التكنولوجيا المصنوعة أو المخترعة لخدمته تنقلب ضده لتشكل خطراً فتاكاً ضده: الانترنت كوسيلة إغواء وفتك بالمشاركين في برامجه الخطرة، الفيديو كمعْبر للهلاك (أفلامThe Ring))، الهاتف النقال كمؤشر لحوادث قتل بشعة في فيلمOne Missed Call
كل هذه الوسائل التقنية تتحول إلى أدوات رعب وإلى قوى شريرة هدّامة. التكنولوجيا صارت تشكّل خطراً مميتاً يحْدق بالمراهقين والبالغين معاً في بيوتهم أو مكاتبهم.
الفيروس والعدوى
الأمراض من أكثر المحن فتكاً بالإنسان، وهي مسبّب رئيسي للألم والعذاب والموت. بالتالي هي مصدر خوف وفزع وقلق وتوجس لدى البشر من مختلف الأجناس والأعمار. الإنسان يبذل كل ما بوسعه، كل وسيلة وكل ما يملك من مال، لتجنب التعرض للمرض.. أياً كانت طبيعته وأعراضه. والخوف من المرض يستلزم بالضرورة الخوف من العدوى، من انتقال المرض من الشخص العليل إلى الشخص السليم. السليم يتحاشى العليل، بل ويصدّه ويبعده ويعمل على اقصائه أو احتجازه في مكان خاص، محكم الإغلاق، ويمنع انتقال العدوى وانتشاره.
السينما استغلت هذه المخاوف، وراحت ترصد أشكال العدوى لإثارة الذعر عند جمهورها. وكانت البداية، تقريباً، مع فيلم مورناو الصامت “نوسفراتو، سيمفونية الرعب” (1922) حيث تنقل الجرذان وباء الطاعون إلى شوارع ألمانيا في القرن التاسع عشر.
وتتعدّد الفيروسات التي تفني البشر أو تحوّلهم إلى كائنات عنيفة ومميتة تدمر كل ما يصادفها.. حتى ذواتها. هكذا تحوّل الفيروسات سكان بلدة أميركية هادئة إلى أموات أحياء (زومبي) كما في فيلم جورج روميرو “ليلة الأموات الأحياء” وكذلك في سلسلة أفلام Resident Evil(2002). وفي فيلم كروننبرغ الكندي Rabid(1976) ينقل الفيروس العدوى من شخص إلى آخر، محولاً الأفراد إلى كائنات عنيفة ومتوحشة.. وهذا ما يحدث أيضاً في فيلم The Crazies(1973).
وفي فيلم Cabin Fever(2002) يهاجم فيروس معدٍ وغريب أجسام مجموعة من المراهقين ليدمر أجهزة المناعة لديهم.
في فيلم “العمى” Blindness(2008) المعد عن رواية خوسيه ساراماغو ينتشر وباء غريب، مفاجئ ومجهول المصدر، يسبب العمى للناس فيقلب حياتهم رأساً على عقب.
الرعب مادة للإضحاك
في الثمانينيات، ومن أجل ترويج الأفلام وجعلها مقبولة لدى الجمهور الشاب، حاولت سينما الرعب أن تدمج عنصرين متنافرين: الرعب والفكاهة. أي إضفاء لمسات هزلية ولحظات دعابة على الأجواء المخيفة والشخصيات المرعبة. لكن أغلب هذه المحاولات لم تستطع أن تحقق التوازن بين العنصرين نظراً لعدم تماسك الأسلوب واتساقه، كما أخفقت في إثارة استجابة محدّدة من المتفرج الذي احتار في كيفية التعامل مع الفيلم.
هذه الظاهرة (دمج الرعب والفكاهة) ليست جديدة، بل تعود إلى سنوات الأربعينيات حيث ظهرت الشخصيات المخيفة (دراكيولا، مخلوق فرانكنشتاين، المستذئب، الأشباح) في مواقف ضاحكة مع نجوم الكوميديا. لكن تلك الأفلام كانت كوميدية خالصة، تطوّع الجانب المرعب لصالح الهزلي.
في فترات متقطعة شاهدنا أفلاماً تتخذ من أجواء وشخصيات الرعب مادةً للإضحاك، أو تقدم محاكاة ساخرة لتلك الأجواء والشخصيات والحبكات.
********
ما تريد أفلام الرعب تأكيده هو أن الآخر، المتمثّل في أشكال بشعة ومخيفة، هو دائماً مجاور للفرد، قريب جداً منه، وربما يوجد بداخله. إنه يسكن الأحلام والكوابيس والدواخل الأكثر عمقاً وظلمةً. إنه يمثّل الصورة الأخرى من الذات، تلك التي تعكس المخاوف.