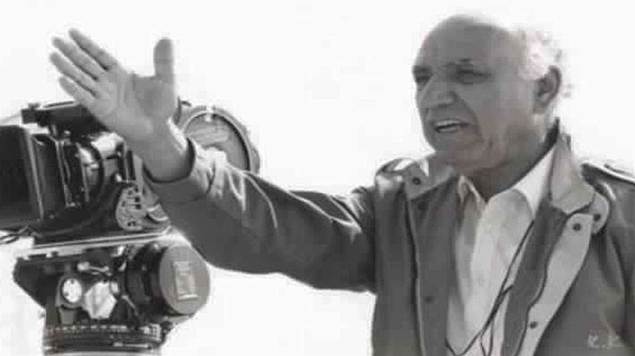مفهوم الصورة السينمائية واللغة والتواصل مع الفيلم

يحاول دائما النقاد السينمائيون ومخرجو الأفلام النهوض بالمستوى الفني للسينما منذ بداياتها في أواخر القرن التاسع عشر، فصدرت الآلاف من الكتب والمقالات التي تطرح مسائل نظرية للنقاش أو تعلق على الأفلام أو حتى تعرض نظريات في استخدام الألوان والكاميرا مثلا، وكل ما يتعلق بصناعة الفيلم.
لكن كانت هناك دوما مسألة شائكة جدا عن طرحها للنقاش سواء بتأكيدها أو بنفيها، ولم يقترب منها السواد الأعظم من نقاد السينما ومنظريها وتلك المسألة كانت “لغة السينما”، سواء أكان المصطلح حقيقيا أي أن هناك فعلا لغة للسينما أو خاطئ ومغال ولا يقال سوى تشبيها.
ظلت هذه المسألة محل جدال مستمر ولم ينشر فيها شيء مطلق خصوصا وأن ذلك المبحث لا يتضمن حقل السينما وحده بل يضم أيضا علم اللغة والسيمائيات، فكان لابد لأي معارض أو مؤيد لفرضية لغة السينما الاطلاع بشكل جيد على أهم النظريات في علم اللغة أو السيمائيات بالإضافة إلى إدراكه الجيد للسينما شكلا ومضمونا، وكان عليه طرح وجهات نظر الحقول الثلاثة، والمقارنة فيما بينها للوصول إلى رأي لا يناقض تلك الحقول التي تدرس وتشرح مسألة وجود لغة السينما من عدمه سواء من خلال علم اللغة الذي يشرح اللغة ومن أين هي وماهيتها، أو السيمائيات التي تختص بدراسة العلامات باعتبار أن الصورة علامة وتتكون من علامات وأيضا إمكانية وجود شيفرة لقراءة الصورة من عدمه، كي تكون نظاما تصبح عنده السينما مثلا تمتلك لغة.
صعوبة تحقيق ذلك الرأي الذي يدحض الآراء الأخرى المؤيدة أو المعارضة لوجود لغة السينما، ترجع إلى تعدد النظريات في تعريف اللغة، أو تعدد المدارس التي تشرح السيمائيات، ثم تباين الآراء السينمائية أصلا في تلك المسألة، فأصبحت الفرضيات القديمة كفرضية الشكلانيين الروس بأن الفيلم مكون من عدد من الجمل التي هي مشاهد وكلمات هي لقطات، غير صالحة، ولم تصمد طويلاً أمام التطور النظري في الحقل السيميائي أو السينمائي، التي تنفي التشابه بين الكلام والصورة، وما هو بصري وسمعي، وتوجب على النقاد مراجعة تلك الآراء، والإلمام بما صدر حديثا في الحقول الثلاثة كي تطرح المسألة مرة أخرى للنقاش على خلفية التطور النظري الحاصل.
إلا أن بعض تلك النظريات تلك التي افترضت وجود لغة للسينما، كان تمتلك قدرة على المقاومة في تأكيد وجود لغة للسينما في وجه من عارض من السينمائيين والسيميائيين أو علماء اللغة وفلاسفة الصورة الذي تعرضوا لتلك المسألة ولو على استحياء مثل دانييل أريخون مثلا في كتابه “قواعد اللغة السينمائية” الذي كان يفترض أساسا أنها لغة ولم يتطرق لتأكيد أو نفي الفرضية التي بنى عليها كتابه كاملا.
وسوف نعرض في موضوعنا هذا أهم الآراء والنظريات التي أكدت أو نفت وجود لغة للسينما ومقارنة تلك الآراء ببعضها للوصول إلى تصورنا الخاص عن لغة السينما بداية من تعريف اللغة وأولية التعبير البصري وإمكانية وجود لغة بصرية، إلى آخر جزء في البحث والذي سوف نصل فيه إلى أبعد مدى توقف عنده كريستيان ميتز أحد أهم منظري السينما ومؤكدي أحقيتها في امتلاك لغة، وذلك هو شيفرة الفيلم، سواء إن كانت موجود أو لا.
ماهي اللغة؟
منذ أن وطأ الإنسان الأرض باحثا عما حوله، نشأت في عقله فكرة التواصل، بدأها بالتواصل مع أقرب الأشياء إليه في الطبيعة كالحيوانات وحاول ترويضها، ثم حاول استخدام ما تعلمه من تلك الحيوانات من أصوات استخدمتها كي تتواصل فيما بينها كما ذكر لويس كالفي في “حرب اللغات”، وحاول تنشئة نظام بدائي من الأصوات للتواصل مع ذويه جغرافيا ثم حاول تطوير قدراته واستخدم النحت لكي يتواصل مع ذويه زمانيا، ليعرف من مر بالمكان أن هناك من طرق الحائط كي يدل على وجوده، والتي حينها يحاول الآخر فهم الخطاب الذي كان في البدايات، على جدران الكهوف عبارة عن رسومات لحيوانات أو أشياء أكثر تعقيدا كلما ابتعدنا عن بدايات الإنسان، وتلك الأشياء كانت نتاجا للطبيعة والتي أيضا تصبح مقبولة للقراءة عند التعرف على شيفرتها من خلال الإرجاع التاريخي، المقارنة بين ما تحويه الذاكرة البصرية والشعبية وما تراه الذاكرة الآنية، فيتم توليد الخطاب أثناء ذلك الاشتباك، وهو ما طور اللغة وجعلها ممكنة وجعل تعليمها سهلا أيضا، كما تثبت البحوث التي أجراها العالمان جولشايدر ومولر بأن تعليم اللغة للأطفال بالصور، هو أسهل طرق التعليم.
لكن للأسف لا يوجد تاريخ دقيق أو معلومة مؤكدة لنشأة اللغات، وكل ما يملكه العلماء هو فرضيات نتمنى صحتها، ونظريات وضعت فمنها ما تم نسيانه ومنها ما ثبت قدمه في التاريخ النظري لعلم اللغة.

فرديناند دي سوسير
عالم اللغة السويسري فرديناند دي سوسير، هو من أهم علماء اللغة الذين كتبوا عنها، وأهميته ليست في علم اللغة وحسب وإنما أيضا في حقل السيميولوجي الذي كان بذرة للسيموطيقا التي نترجمها للعربية السيمائية أو السيمياء، وكان علم خاص بدراسة العلامات وكل ما يحتمل أن يكون علامة تنقل معنى، والذي قام العديد من علماء اللغة بعده بتطويره وتطبيقه على مسائل النقد الأدبي، ودراسات العلامات كعلامات الطرق والمرور والطرز المعمارية وحتى السينما.
يضع دي سوسير العديد من التعريفات للغة كلها تتفق بأن اللغة ، نظام للتواصل، ونتاج جماعي لملكة اللسان، ومجموعة من التقاليد الضرورية التي تبناها مجتمع ما ليساعد أفراده على ممارسة هذه الملكة، واللسان ملك للفرد والمجتمع، وهي سلوك عام وظاهرة اجتماعية تتكون بعلم الناس، وهي شيء محدد تماما ضمن الكتلة الغير متجانسة لعناصر اللسان ويمكن تحديد موقعها في الجزء المحدد لدائرة الكلام في المكان الذي ترتبط فيه الصورة السمعية بالفكرية، فهي الجانب الاجتماعي للسان وتقع خارج الفرد الذي لا يستطيع أبدا أن يخلقها أو يحورها بمفرده، فلا وجود للغة إلا بنوع من الاتفاق الذي يتوصل إليه أعضاء مجتمع معين، وعلى الفرد أن يقضي فترة يتعلم فيها وظيفة اللغة، وهي نظام من الإشارات جوهره الوحيد الربط بين المعاني والصور الصوتية وكلا طرفي الإشارة سيكولوجي.
ويتفق كثير من العلماء مع سوسير في مسألة التواصل والتي جزء منها التوجيه والإخضاع كما يذكر ذلك رولان بارت، وأنها وسيلة للتعبير عن الإنسان وغايتها الإشارة لأشياء والتعبير عن حالة المتكلم وتغيير حالة السامع عند برتراند راسل.
لكن المتغيرات التي تؤثر في اللغة وعملية التواصل التي تتم بين الأفراد بشكل مباشر أو ثانوي كانت كثيرة ولم يذكرها سوسير في نظريته عن اللغة، وكان لابد أنها تتضمن التعريفات التي رصدها العديد من العلماء لوصف اللغة كما يذكر ذلك بارت في كتابه “هسهسة اللغة”.
إذ انه صحيح بأن اللغة هي ملكة اللسان، لكن العين لها نصيب من عملية التواصل تلك، وذكر بارت العديد من الملحوظات الأخرى يتساءل فيها عن سبب غيابها عن نظرية سوسير، فإذا كان هناك زمن خاص بالخطاب مماثل للزمن اللساني عند نطق الكلام، كما في الهندية وبعض الأوروبية التي تظهر تلك الأزمنة في علاقة حوادث الماضي بكلمات الحاضر، و أيضا الشخص نفسه ومسألة الإيماءة التي ذكرها بازوليني في بحثه عن السينما الشعرية، وتعليقات أخرى لا يسعنا المجال هنا لذكرها، ولكن وجب التنويه على أن العديد من النظريات التي عرّفت اللغة قد تجاهلت المنحى البصري المرتبط بعملية التواصل، والذي هو جزء هام من تلك العملية، باعتبار ان اللغة ومسألة التواصل، مسألة سمعية وبصرية.
وكان ذلك أحد الانتقادات التي وجهت إلى السينما بعدم حدوث مسألة التواصل فيها لأن طرفي معادلة التواصل (مرسل-خطاب- مستقبل) لا يحدث بينهما تزامن، لأنه من أهم مقومات اللغة، هو عملية التواصل الآني الحاصلة بين المرسل والمستقبل، والسينما تمتلك نوعا آخر من التواصل، ليس بتواصل آني كما تتميز بتلك اللغات السمعية، وليس تواصلا فرديا، وذلك لطبيعتها المختلفة.
وفي اللغات السمعية أنواع أخرى من التواصل، إذ أن مسألة الآني، لا يتم اعتمادها جغرافيا، وإذا استسلمت لفرض التواصل الآني، لما تعلمنا اللغات ولا قرأنا ولا عرفنا ولا تقدمنا، فمشاهد الفيلم كما ذكرنا لا يجيب على الفيلم بفيلم آخر، وإنما التواصل هنا هو الأثر الذي يحدثه الفيلم، فالتوحد مع أبطال الفيلم هو تواصل، ونقاد السينما هم أيضا جزء من عملية التواصل بترجماتهم للفيلم ورموزه، والمشاهد المتمرس كذلك، هو مدرك للغة السينمائية ومحقق للتواصل التام.
فالمعادلة تختلف لطبيعة السينما الخاصة، فالمتكلم موجود والخطاب موجود والمستقبل موجود، لكن معادلة التواصل لا ترتد بنفس الشكل، وإنما ترتد سواء بآراء المشاهد أو الآثار الشعورية، كما ترتد اللغات السمعية في أحيان عدة بأشكال أخرى كالعنف إثر السباب أو الأفعال الجسدية المختلف كالعناق أو التصافح مثلا.
ويعلق تشاندلر على مسألة التواصل الآني في اللغة (وكما يركز التراث السوسوري على التزامني وليس الزمني، إذ يدرس التحليل الزمني الظاهرة كما لو أنها قد تجمدت في لحظة من الزمن بينما يركز التحليل الزمني على التغير مع الوقت).
ومعادلة التواصل تلك كانت أحد انتقادات نظرية لغة السينما كما علق عليها كريستيان ميتز (ان السينما ليست وسيلة للتواصل وإنما للتعبير)، لكن المشكلة الحقيقية هنا هي تعريف التواصل والتعبير، اذ ان التعبير نوع من التواصل، لكنه لا يمتلك ثنائية المرسل والمستقبل، وهي ذي طبيعة السينما ولغتها الخاصة، والتي نؤكدها كما شرح ذلك راسل بأن اللغة ذاتها وسيلة للتعبير تخدم أغراضا ثلاثة وهي الإشارة للحقائق والتعبير عن حالة المتكلم وتغيير حالة السامع وهذا كلام حاضر في السينما بحضور الثلاثة مجتمعين بالرغم من ندرة حضورهم في اللغات السمعية كما يؤكد راسل.
لقد كنا نتواصل فيما بيننا قبل ظهور التليفونات بالرسائل، وكان بالطبع لابد من استخدام شكل مباشر جدا للخطاب كي يحدث جزء من التواصل والذي كان في أغلب الأحوال لا يحدث اثناءه أية تماس شعوري لفقدان الجزء البصري، كما أنه لا يمكن التعبير عن العديد من المشاعر الإنسانية بسبب فقدان التزامن، لكن البعض تغلب على ذلك باختراع السباب أو كلمات كانت في زمانها تنطق عند الغضب فيتم استخدامها في سياق الغضب للتعبير عنه أو في العواطف الكثيفة أي أن الرسائل الورقية قد راعت الظروف الخاصة لمسألة التواصل كما يراعي الوافد الجديد على أي بلد ظروف لغتها الخاصة، وكذلك السينما في مسألة التواصل تلك، فمن كان من المشاهدين يرغب بالتواصل مع الأفلام بأفلام لفعل ذلك، لكنه كان يحاول الاحتفاظ بالدفقة الشعورية وقدسية تلك اللحظة، أو لعدم توافر الإمكانيات المادية أو الفكرية كي يصنع فيلما، وذلك لا ينفي مسألة التواصل مطلقا، لأن لها طرفان، كالمشاهد والفيلم، والكاميرا هي المُشاهد في بعض الأحيان، أي أن المُشاهد يشاهد الفيلم الذي كان هو أحد أبطاله أو كان حاضراً مع شخصيات الفيلم وكان يتواصل معهم شعوريا، وكأن الفيلم هو أصلا تجربة حلمية خاصة بكل المشاهدين، صنعها لهم واحد يمتلك القدرة على ذلك اكثر منهم.

سيجموند فرويد
لقد تم تجاهل الجانب الشعوري للعلامة في السيميائيات أيضا، والذي يؤثر بشكل مباشر في الدالة السيمائية (دال-علامة-مدلول)، لكل أشكالها وذكر دانيال تشاندلر في نهاية كتابه عن أسس السيمائية معلقا بأنه قد لا يكون من المفاجئ أن يهمل التحليل السيميائي المجال العاطفي، كانت الدلالات الضمنية من أهم المواضيع التي تناولها بارت، لكنه لم يتناول في بحوثه تنوع الدلالات الضمنية، علما أن دراسة هذه الأخير يجب أن تتضمن سبر لطائف المعنى المتغيرة بدرجة عالية والذاتية والانفعالية بدرجة دقيقة.
ويقدم السيميائيون أحيانا تحليلاتهم وتفسيراتهم كما لو كانت موضوعية علمية خالصة، وليست تحليلات ذاتية، ويذكر ذلك تشاندلر أيضا في تعليقه على الرأي المطلق الذي يعتز به السيميائين ومن اقتبسوا منهم، وتشاندلر قد وضع قاموس مصطلحات السيميائية وأحد أهم أعمدتها أيضا، والذي بدورنا هنا نذكر إنتقاداته التي سوف تدعمنا في طرحنا عن لغة السينما بالتنويه عن عدم الصحة النهائية لآراء اللغوين والسيميائيين في السينما بالذات، إذ أنها سمعية بصرية وتعتبر المشاعر الإنسانية أساسا للتواصل.
واستنتاجا لآراء اللغويين الأكثر صحة، فإن اللغة نظام من العلامات، ولها نظام لقراءتها ويسمّى شيفرة، ومن خلال ذلك الاتفاق على مسألة الشيفرة والعلامة، فإن الرسوم المصرية القديمة كانت لغة أيضا، إذ أنها تحتوي نظاما تقرأ من خلاله وبه الازدواجية التي عرفها سوسير باختلاف الصورة السمعية عن مدلولها (الصوت- الكلمة) مثل كلمة أرنب مثلا لا تدل صوتيا على أرنب وتختلف بين اللغات جغرافيا وزمانيا كما يظهر في تعدد أسماء الأسد مثلا في اللغة العربية، وذلك الافتراض تمهيدا للقول بإمكانية وجود لغة بصرية قوامها الطبيعة وتمتلك شفرة تستخدم الصور، لكنها صور متحركة هذه المرة.
حتى يمكننا استيعاب إمكانية وجود لغة بنيانها مؤسس على الصور، ينبغي أن نعرف بأن عملية التذكر التي يفعلها الإنسان للماضي تتم من خلال متتاليات من الصور البصرية، يثير تذكر صور بعينها مرتبطة بحدث في القريب العاجل مشاعر ترتبط بصور أخرى بدورها ترتبط بمعاني تكمّل فعل الاستذكار والتي يترجمها الإنسان في البداية إلى أسهل لغة يعرفها وإن كانت الكلمات ثم عندما يتعرف بشكل جيد على الصور وما ترمز إليه لا يترجمها ويدركها كما هي حتى وإن تجدد شكلها وأعيد تخليقه في ذهنه.
وأحيانا تتم عملية الاستغراق في التفكير وحل المشاكل أيضا من خلال متتاليات الصور، كأنني أتذكر أنني مررت من ذلك الشارع وسقطت نقودي فـأبحث عنها أو أنني تعاركت مع أحد قطاع الطرق أو أن اللون الأصفر مثلا يثير حزني لما واجهته في الماضي من حدث مرير كنت أرتدي أثناء حدوثه قميص أصفر.
كما يمكننا القول بأن ذاكرة الإنسان هي عبارة عن مخزون بصري سينمائي لكل التجارب التي مر بها تحتوي المونتاج واللقطات القريبة والبعيدة وحتى البانورامية وبالطبع بشكل غير إحترافي.
كما أن الأحلام هي الأخرى ردة فعل في شكل تتابع للصور/الخيالات التي تنشأ كنتاج كبح لجماح رغبات الإنسان أو كانت أماني لم تتحقق أو كانت رؤية للمستقبل المظلم أو المنير و توقع للأحداث نتيجة حدث مضارع مقلق أو كانت حتى أحلام اليقظة أو الخيالات التي تحدث نتيجة لتناول أحد العقاقير الكيميائية ، ما يهمنا أن هذه الخيالات هي نماذج بدائية من السينما تم التعامل معها بمنتهى الجدية لفهمها و لفهم أثرها على الإنسان و لماذا تحدث و كل تلك الأسئلة المتعلقة بماهيتها، و وضعت لها التفاسير التي تحللها و تشرحها و تقدم حلولا لها إذا كانت أحلام شديدة القتامة، وتم التعامل مع الأحلام كـلغة لها نظامها الخاص والتي أثبتت صحتها بنسبة كبيرة جدا جعلت فرويد في مكانة عالية جدا بسبب كتاباته عنها واستنتاجاته الحقيقية في فهم الإنسان ومحاولاته الحثيثة على تنشئة نظام سيميائي لفهم الأحلام استفاد فيه من كتابات أسلافه وفلاسفة آخرون حاولوا وضع قواميس لأشهر الأحلام وتفاسيرها أو دلائل كل الرموز في الأحلام من خلال التجريب والقياس على تجارب السابقين في الحلم، بل توصّل بعض الأطبّاء إلى تشخيص الأمراض من خلال الأحلام كما ذكر العالم تيسه بأن الاضطرابات التي تحدث للجهاز الهضمي و التنفسي تعبر عن نفسها بأنواع معينة من الأحلام.
والأحلام هي أجزاء من شريط سينمائي بها بعض وسائل الفيلم كالمونتاج أو اللقطات القريبة و البعيدة أيضا والألوان التي تم تعديلها وقد تكون مفهومة أو غامضة جدا لكنها في الغالب بدائية الشكل، و تلك الأمثلة تزيد من حقيقة أن السينما هي فن عملية التذكر و فن الحلم ولغة أيضا سهلة يفهمها الجميع لأنها تشبه الخبرات البصرية التي مر بها الإنسان سابقا سواء في واقعه أو أحلامه و وسيطها المشاعر الإنسانية و التي كانت تبايناتها ضئيلة جدا سوى في حالات شاذة ، كما أن تصوّر وجع الظلم مؤلم لكل البشر مثلا و كل الناس تتأثر بمشاهد ظلم أحد أبطال الأفلام أو تتذكر ظلم ما أو تحلم بظلم ما أو حتى تشاهد أمامها أو تقرأ ، و إن لم يمر المرء بتجربة الظلم ، لابد من أنه قرأ أو سمع أو رأى الظلم و بالتالي من الصعب جدا عدم التأثر بمشهد الكنيسة في فيلم الصيد عندما كان مادس ميكلسون جالسا ملتفتا إلى الوراء بعينين مدمعتين ناظرا لأعز أصدقائه و الذي صدق حكايات ابنته الكاذبة عنه ولم يثق في العشرة الطيبة التي قضاها معه.
ولعل أكثر لحظات التأثر والتوحد مع زمن ومكان الفيلم هي اللحظة الأكثر شهرة في بدايات السينما، لحظة هرب المتفرجين من قاعة السينما عند مشاهدة أحد أول الأفلام في السينما خوفا من اصطدام القطار بهم في فيلم “وصول القطار 1896” بسبب توحدهم مع زمن و مكان الفيلم بسبب اللقطة الواحدة التي تم تصوير المشهد بها و بسبب توجه القطار مباشرة إلى ناحية الجمهور للأمام و لم تكن السينما حينها بنفس التطور الحاصل حاليا ولم تكن أيضا معروفة نهائيا بل كانت اختراع جديد، لكنه حقق أثره كما ذكرنا سابقا، بأن الأفلام هي امتداد للذاكرة البصرية للإنسان و احتكاك مع الموروث البصري الذي اكتسبه من عينه، كأن السينما هي ملكة العين، و التي نمت نفسها و تذوقها بالأحلام ، و التي هي من طبائع الإنسان و إحدى أقدم حالات الإبداع المرتبطة بالإنسان منذ وجوده.
إن أقرب الأمثلة لإمكانية وجود لغة وأبجدية كاملة من الصور لهي اللغات المصرية القديمة، والتي تكونت من صور استقاها الإنسان من الطبيعة، حيث أخذ يفتش عن فكرة ومعنى في كل شيء إلى أن استقر على اختيار بعض الأشياء ورسمها ثم تطورت الفكرة كاملة إلى أن تأسست أولى أبجديات العالم والتي كانت عبارة عن صور كانت ترمز إلى صورة صوتية بدورها توازي معنى بعينه إلى أن تطور ذلك وتجمعت الصور وتكونت الكلمات المركبة وإلى أن تتطور كل ذلك أيضا من أول نظام لتلك اللغة وهي الهيروغليفية والتي كانت تحتاج التبسيط أكثر وتفكيك الكلمات ذات المعاني المركبة أكثر و نشأت أبجدية أخرى و هي الهيراطيقية ثم تبعها تطور آخر في الديموطيقية والتي أضيفت بعض الكلمات إليها حتى يتسنى لشريحة أكبر من الناس استخدامها ومرة أخرى تتم توسعة استخدامات اللغة إلى أن أصبحت اللغة القبطية والتي تم كتابتها بالأحرف اليونانية مع إضافة بعض الرموز المصرية التي لم يكن في اليونانية مثلها وهي آخر تطور حدث للغة المصرية القديمة و التي جاءت بعدها كل أبجديات العالم ونشأ نظام الحروف والذي كان في الأصل عبارة عن صور وقد وصل إخلاص بعض علماء اللغة لأصلها المصري بأن قاربوا بين الكلمات وصورتها في الواقع كـكلمة عين باللغة العربية والإنجليزية و العبرية والتي هي رسم لوجه الإنسان محددا منه العين بالذات من أحد حوافها كلّ وصورته اللغوية و جغرافية مكانه.
أيضا ما ذكره هنري برجسون في مقاله عن الأحلام و التي تفيد أولية التعبير البصري ووجود الصورة فوق الكتابة و إمكانية وجود اللغات أصلا من الصور في تجربة العالمان جولشايدر و مولر، حيث كان هذا المجربان يكتبان عبارات شائعة الاستخدام مثل الطبعة الأولى أو ممنوع الدخول و يحرصان على ارتكاب أخطاء تبديل الأحرف أو حذفها تماما ويضعان الشخص الذي يجريان عليه التجربة في الظلام ويكون جاهلا بالمكتوب مقدما، ثم يضيئان الكتابة لفترة قصيرة جدا بحيث لا يستطيع الشخص مشاهدة الأحرف كلها وكانا بالتجربة مسبقا عرفا الزمن الذي تستغرقه العين لمشاهدة الأحرف كلها فكان سهلا بالنسبة لهم معرفة الزمن الذي تستغرقه عين الإنسان لمشاهدة أحد تلك الأحرف الثلاثين أو الأربعين التي تتكون منها الجملة ، فـكان الشخص في معظم الأحيان يستطيع مع ذلك قراءة الجملة كلها في غير عناء ، و ليس ذلك المهم في التجربة ، بل أننا إذا سألنا الشخص عن الحروف التي يثق بأنه أدركها، وجدناه يذكر حروفا أبدلت مع غيرها أو حذفت أصلا ، فقد كان المعني من التجربة ، هي أن يرى حروفا غير موجودة ، و هكذا يكمل برجسون بأن الاحرف المدركة بالفعل، قد أفادت في استحضار ذكرى ألقتها الذاكرة اللاشعورية للكلمة التي تتشابه صورتها مع صور تلك الكلمات ، و هذه الذكرى هي ما رآه للمكتوب و أكثر، ويتابع برجسون بأن القراءة هي فعل من التخمين ، ليس تخمين مجرد، وإنما هو إبراز ذكريات صور ، تنشطها أجزاء أو حواف أو تخيّل لتلك الأحرف أصلا.
السينما لغة
يمكننا القول إن السينما مجازا هي إحدى اللغات المصرية القديمة أو حتى الصينية التي نشأت في القرن التاسع عشر والتي تتكون من نظام معقد من الإشارات التي نشأت أيضا من الطبيعة والمحيط الداخلي والخارجي للإنسان والتي بدورها تتواصل من خلال مشاعره والتي يستحيل ضمها إلى قاموس لغوي لا لعدم قبولها كـلغة، بل لأن صفحات ذلك القاموس ستكون لانهائية لأنها تتكون من الصور، بل أن اللغات التي تعتمد الحروف أو اللغات الحديثة أيضا كما يقول لورنس وينر المفاهيمي الأمريكي (حين تتعاطى مع اللغة، فلا حد لما يمكن أن ينتج من تداعي الصور وتشظيها. إنك تتعامل مع كيان مطلق، فاللغة بوصفها أكثر ما طورناه وعكفنا على توسيعه من أنساق في عالمنا هي الأكثر استعصاء على التجسد والتشيؤ، إنها لا تكف عن التوسع والتوليد أبداً).
ولكن كل تلك الصور الفيلمية وتتابعها ومنطقها الخاص و التكوين اللغوي المغاير أصبح من الممكن فهم سياقه و الذي أتم تلك العملية “المونتاج” بنوعيه الداخلي والخارجي و الذي جاء كخطوة أولى لرفع مكانة السينما إلى اللغة و أيضا كخطوة نهائية لتكوين المعاني التي يريدها المخرج بعينها و تأكيد قاموسية الفيلم أي أن الفيلم له قاموس معانيه الخاصة ، وكما ذكرنا اعتباطية فكرة وجود قاموس للسينما ، فإن ذلك لا يأتي من قصور السينما في الوصول إلى أبجدية كاملة ، حيث أن بعض اللغات أيضا من الصعب وضعها في قاموس و مثالا على ذلك اللغة الصينية و التي تضم حوالي 45 ألف علامة مصورة على الأقل أو اللغة المصرية القديمة و التي تضم حوالي 2500 صورة كما يقدرها المتضلعون في دراستها حتى الآن وحتى قواميس اللغات الذي يحتوي أحدها على ملايين الكلمات والتي لاتستخدم كلها بالطبع.
ولكن من الممكن تكوين قاموس الفيلم وليس قاموس السينما، ويكون هذا قريبا للفهم جدا من خلال فهم نظرية أندرو ساريس التي سماها نظرية “المخرج المبدع” الذي يمتلك أسلوبا في حلول الفيلم البصرية والذي يؤسس لسيميائيته الخاصة عبر أفلامه والتي تتطور كما كل شيء من خلال أفلامه الواحد تلو الآخر، كما كانت المرأة علامة على القصور في الاستيعاب الكامل للأشياء ونموذجا للتضحية عند تاركوفسكي أو الحوائط المغبّشة دائما عند تاركوفسكي تدل على قلق الشخصيات الداخلي وشعورهم بالاغتراب أو الأيدي عند روبير بريسون والتي تدل على الحيوية والتواصل بالرغم من أن أجسادها تحمل الموت الداخلي وكثير من العلامات وكل ذلك كان يحدث عند تجريد الأنثى من باقي مشاعرها أو فصل الأيدي عن الجسد فـتحول الإنسان في الفيلم إلى علامة، وذلك ما نثير الانتباه حوله، فـللسينما طبيعتها الخاصة جدا والتي قوّضت الواقع لصالح الدراما لتنشئة قاموس خاص بكل فيلم على حدة، وكسرت وحدة الزمان والمكان من أجل الفيلم، و كل ذلك الجدال في التناقضات بين سيميائية الواقع والسينما لهو جدال منتهي و لن يفضي إلى شيء سوى توسيع الهوّة بين الفيلم و الجمهور و تقييد الخط الوهمي الذي هو أساس عملية المشاهدة.
وكان أحد الإنتقادات الموجهة لنظرية لغة السينما أيضا من السيميائيين، هي مسألة وحدة الزمان والمكان السينمائي، أي تشظي المكان إلى كادرات والزمان كذلك، ولكن تلك الفرضية بوجوب وحدة الزمان والمكان، كانت أصلا غير موجودة في بدايات السينما أو حتى في نظرية السينما الواقعية التي تفترض المونتاج داخل اللقطة والذي عنده توجد وحدة الزمان والمكان، لكن عند التطرف في ذلك الأمر، سوف يعيدنا ذلك إلى المسرح، وتنتهي السينما إلى مسرحيات مصورة، لا تستفيد من كسر وحدة الزمان والمكان، كما أنه رأي ووجهة نظر تتمنى السينما كذلك، وهو خاطئ يحجم إمكانيات السينما في استغلال الزمان والمكان، وإنتاج المعنى المتواصل وتعدد مستوياته.

من فيلم “برسونا” أو “القناع” لبرجمان
لقد أسست السينما سيميائيتها الخاصة التي تتجاوز سيميائية الشعر أو المسرح ، بل استخدمتهم فيها وأعادت بشكل كامل تركيب العلامات القديمة بإضافتها أفق أرحب لاستخدام العلامات ،و جعلت الإنسان في بعض الأحيان علامة ، جرّدت الإنسان من محيطه و أدغمته في محيط خاص جدا من خيال المؤلف ، شحنته بالمعاني و الأفكار التي تتسق في موضوع عام لدى مخرج الفيلم و في أفلامهم الأخرى ، لقد خلقت سيميائية خالصة ، فعل ذلك بيرجمان في فيلم “بيرسونا” وليف أولمان مجردة تماما من الانفعال أو التفاعل ، كانت جماد ، علامة اعتبارية تحظر الكلام في محيطها و إلا سببت الجنون ، وفعلا سببت جنون بيبي أندرسون و أكدت وجود العلامة ، عندما خُيّل لأندرسون أن أولمان تتفاعل بشكل كامل معها و أتى ذلك في أحلامها إلى أن صدمت ، لم تكن العلامة أو الإشارة في الفيلم بشكلها المباشر كما في الحياة العادية ، بل كانت إنسانا ، لكن قبل التجريد من الرغبة في التحدث ، التواصل الذي هو أساس الإنسانية ، التفاعل مع الآخر و الذي هو جزء لا يستهان به من الإنسانية.
عندما خلقت السينما علاماتها الخاصة، نطقت أبجديتها الخاصة و التي هي في تعقيدها، تشبه تعقيد نشأة أول أبجدية خالصة بعد المحاولة الأولى و تصوير المعاني ثم ترميز الصور ثم تجزئة الرموز إلى علامات ثم العلامات إلى أصوات و أخيرا إلى علامات أخرى سميت أحرفا تكوّنت منها الأبجديات الحديثة، حتى أن إحدى أهم وسائل تعليم اللغة للصغار و الكبار، هي اقتران كل حرف بصورة لشيء يبدأ به، وكل ذلك من صميم التعبير البصري و الذي هو قوام السينما ، لقد تجاوزت السينما اللغة المكتوبة ، فأمكنها نقل أعقد الأحاسيس الإنسانية بشكل من المستحيل مضاهاته في وضوحه أو وصفه بالكامل، و تمكّنت من تصوير أشد الأفكار تعقيدا على وجه الإنسان، و أمكنها إعادة هيكلة العالم، بل و خلق عوالم أخرى كانت مستحيلة، واستخدام كلمة أبجدية هنا ليس سوى استخدام مجازي، لأننا لا نعتقد بأن المشهد كلمة.
لعل أهم الانتقادات التي وجهت لنظرية لغة السينما كانت ضرورة “اعتباطية العلاقة بين الدال والمدلول”، فالكلمة لا تشبه صورة مدلولها وهذا كما يعلق رولان بارت ما أثرى كتابات سوسير عن اللغة، ولكن الخطأ في ضرورة تطبيق ذلك الكلام على السينما، هو محاولة ترحيله من بين وسيطين مختلفين تماما حقل اللسانيات إلى الحقل السينمائي، فذلك منافي للطبيعة المختلفة بينهما، وغير ملائم.
لأننا إذ حاولنا وصف السينما باللسانيات مع عدم مراعاة الفروق المختلفة بين الوسيطين، لأوقعنا في فخ (التمفصل المزدوج) أيضا، وبذلك يتحقق انتصار للخلط والتناقض كما حدث حينما حاول ذلك بازوليني إثبات وجود التمفصل المزدوج في السينما، وأيضا لافترض وجود التمفصل المزدوج، تقسيم الفيلم إلى فونيمات ومونيمات، وذلك خاطئ جدا، لأنه يصعب تقطيع الصورة إلى وحدات صغرى في المبنى وأخرى في المعنى كما يؤكد ذلك نصر الدين العياضي.
ذلك يعيدنا إلى الوراء، إلى كثيراً، وأولى نظريات السينما عند بيلا بالاش القائل بأن السينما ستكون فن سابع عندما تفرض أشكال اللغة قواعديا، فاللقطة هي الكلمة، والمشهد هو الجملة، والذي وافقه الكثير من المخرجين الروس وحتى كريستيان ميتز في بعض آرائه، كما أن ذلك الافتراض بوجود مسألة التمفصل المزدوج عند بازوليني أو من حاول إثبات ذلك، هو عدم مراعاة مبدأ التخفيف والتكثيف الذي دفعه جيل دولوز لنظريته عن السينما والذي كان صحيح جدا حينما قسم أنواع الكادرات إلى هذين النوعين، كما أن المشهد السينمائي يعادل بالطبع العديد من الجمل حتى لو استخدمنا ذلك مجازا، وسوف يشكل قطعة معقدة جدا من الخطابات نظرا لتعددية مدوناته أيضا، ما أبعد بازوليني والسينما الشعرية عن الصواب الكامل لتجاوزه الطبيعة المختلفة بين السمعي والبصري، وكذلك بيلا بالاش أو كل من حاول إثبات وجود التمفصل المزدوج في السينما، أو من حاول إثبات وجوده كمبدأ للغة لا تقوم سوى به.
والخلط الحاصل بسبب استخدام مصطلحات اللسانيات التي تم تعريفها بناء على وظيفتها في علوم اللسانيات، كان أهم العقبات التي لم يواجهها المنظرين ولم يحاولوا تأسيس مصطلحات تؤسس لنظرية السينما وتكن تلك المصطلحات وليدة غرض سينمائي، فسبب ذلك خلط للمفاهيم وحرب نقدية لا طائل منها تماما.

بازوليني
وفي سياق الخلط المفاهيمي، يرى بازوليني بأن التمفصل المزدوج ذلك موجود في السينما، وحاول بازوليني تأكيد فرضيته تلك بتأكيد وجود الخطاب الحر الغير مباشر، باعتماده على لغوية الشعر أولا، ثم اعتماده على وجود الخطاب الحر الغير مباشر في السينما والشعر، ومعللا لذلك بتشابه عملية تكوين الصورة الذهنية في كليهما، أو التخيل للصورة الشعرية مشابه للتخيل للصورة السينمائية (في هيولي)، متجاوزا تعقيد المسألة في الصورة السينمائية والشعرية، ، وحاول وصف السينما بالشعر، بل وتجاوز ووصف الشعر أساسا بأنه لغة، بالرغم من أن الشعر أصلا هو استخدام للغة، واللغة موجودة قبل الشعر، عكس السينما، التي توجد اللغة السينمائية من الطبيعة التي هي مادتها والطبيعة لا لغة فيها ومثالا على ذلك:
وفي يدي العنكبوت= أنا عاطل.
رمزية الصورة
أرى أمامي رجلا في الشارع وآخر يحمل مطرقة وامرأة تشعل بعض الأوراق على الرصيف، كل ذلك لا يحمل أي معنى، وغير مفهوم وغير منتظم، يفتقد للهارمونية، حتى إذا عرفنا معلومات عن السائر ورجل المطرقة وسيدة النار، يبقى وجودهم في الشارع في ذلك التوقيت بالذات عندما سرت أنا اعتباطيا، لا يحمل مجازا حتى، وبالتالي لا يوجد أي احتمال للغة بصرية للطبيعة، ولكن عند تحويل تلك الأحداث إلى مشهد في فيلم أو حتى فيلم قصير جدا، سوف تكتسب الأشياء تلك معانيها وتتحول إلى عناصر لغة سينمائية، اعتمادا على رمزية الصورة ومجازها، إذ أن المطرقة تخرب الطريق الذي سوف يمشي عليه الرجل الذي يشاهد الأوراق أثناء احتراقها عندما تبتسم في وجهه السيدة بسخرية، فهذا الرجل إما قد خانه/ ضله/ فقد طريقه واحترق نتاجا لذلك، وهذا بالطبع تفسيري مجازي وبسيط جدا، إذ باستخدام المونتاج مثلا من الممكن إعادة ترتيب الدلالات التي تخلق معاني أخرى، واستخدام الصوت والضوء والألوان وباقي عناصر الفيلم وكل ذلك سوف ينتج خطاب كامل وعنده تحدث عملية تواصل تامة.
ما يهم أن ذلك أهم مآخذنا على بازوليني عند تشبيهه للسينما بالشعر، حتى في العملية الذهنية، كما أن اللغة السينمائية هي سمعية ومرئية، تحتوي أصواتا وصوراً، وتحيل أصواتها لأصوات أخرى وصورها كذلك، وذلك يختلف عن الشعر عند التعرف على شيفرة القراءة.
لكن تلك الاعتباطية (اعتباطية العلاقة بين الدال والمدلول) هي أمر من الصعب تحييده وتحديده، إذ تمتلك الصورة علاقة اعتباطية مع نظيرتها، لكن الاعتماد على انتاج المعنى من خلال الصورة، هو ماينفي تلك الاعتباطية والذي حاول إيكو تمريرها في بحثه عن تمفصلات الشفرة السينمائية، وان كان ذلك تعرض مباشر لنظرية سوسير وهدم لآرائه، ورأيه كان محاولة منه لاحتواء بحث ميتز في لغة السينما وآراء مواطنه بازوليني عن سينما الشعر، وحاول إيكو تمييز السينما بأن لها تمفصل ثلاثي والذي بالطبع لم يكن موفقا في رأيه والذي علق عليه بيل نيكولز قائلا بأنه رأي ذو نزعة إزدواجية متطرفة.
كانت المعضلة الأهم في نظرية (لغة السينما) هي الشفرة، كيف تتم قراءة الفيلم، من خلال ماذا يمكننا الإمساك بتلابيب المعنى الموجودة في الفيلم حتى نقرأه كاملا، وهي المعضلة التي انتهى إليها ميتز، أقرب المنظرين صحة في عموم من كتبوا عن لغة السينما، قائلا بأن السينما لغة بلا شفرة، بالرغم بحثه عنها إلا انه لم يدركها في فرضه بأن الفيلم لايتبع نظام يجعل المشاهد قارئا للفيلم بأكمله، وهو الافتراض الذي سيورط ميتز والكثيرين اذا التزموا به، اذ انه يجرد الفيلم من صيرورة المعنى، ومنظومة التعبير السينمائي، وتصبح السينما عنده مجرد فيديوهات جامدة او حتى متحركة لا تحمل أية معنى في داخلها أو خارجها، وذلك الافتراض هو الذي دفع بترو الين للتعليق عليه بحدة قائلا بأن ميتز يورط نفسه في عدد كبير من المعضلات التي لايستطيع التغلب عليها على نحو مرضي.
وهي التي سوف نشرحها في الجزء الثاني من موضوعنا عن اللغة السينمائية.