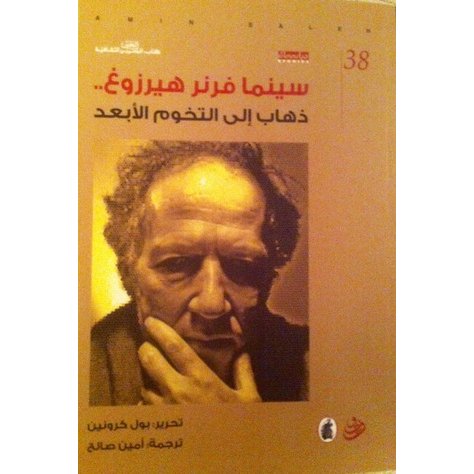أمين صالح والوقوع في “فتنة السينما”

عشقت السينما منذ الصغر، منذ أن وجدت أمامي نافذة مستطيلة، هائلة الحجم، تطل على مدى رحب وأفق شاسع، حيث العوالم المختلفة والمتنوعة، الغنية بالشخوص والأحداث، المحكومة بالصور الآسرة، بالحركة والتتابع.. عوالم سحرية كنا ندخلها – نحن الصغار – بغبطة من يدخل حلماً جميلاً لا يتمنى أن يغادره.
السينما حياة أخرى أعيشها لساعات معدودة لكنها حافلة بما هو آسر وفاتن.. ساعات أخرج فيها من رتابة الحياة اليومية لأدخل عوالم تتجدّد باستمرار، تأخذك كما الأحلام في رحلات لا نهائية.
علاقتي بالسينما لا تندرج ضمن الاهتمامات الثقافية فحسب، إنما هي بالدرجة الأولى علاقة حياة.. تجربة حياتية بدأت منذ الصغر في صيغة عشق لم يخفت مع مرور السنين بل ظل متوهجاً حتى هذه اللحظة.
ولا أبالغ إذا قلت بأن ارتباطي بالعوالم السينمائية هو أقوى وأغنى وأعمق من ارتباطي بالواقع اليومي الذي أعيشه. ربما لهذا السبب، في نصوصي الأدبية لا أجسّد، ولا أعبّر عن، الواقع المعاش بل الواقع المتخيّل الذي قد يتجذّر في هذا الواقع اليومي، وبالضرورة يستمد عناصره منه.. أما كعلاقات وشخوص وطبيعة ومناخات وحالات، فإن ذلك ينتسب إلى المتخيّل، إلى الحلم، إلى العوالم الكائنة وراء الأفق والتي ارتادها كلما أغمضت عينيّ.
السينما عشقي الأول.. عرفتها وأحببتها قبل أن أعرف وأحب الكتابة، واعتقد أنني من النوع الذي يخلص لمن يحب ولا يخون.
ولا أبالغ إذا قلت أنني تعلمت من السينما (عن الحياة، عن العيش، عن المشاعر) أكثر من أي مجال آخر.
السينما عالم لا أتفرج عليه، لكن أعيشه.. كيف ولماذا؟ كأنك تسأل عاشقا لماذا عشقت هذه المرأة بالذات وليس غيرها.
2
كما أشرت، بدأت علاقتي بالأفلام، وأنا صغير السن، عن طريق المشاهدة كنوع من التسلية لذاك الطفل الذي أخذ يهيم بسحر حركة الناس وبطولاتهم وقصصهم الدرامية، المنبعثة من تلك الشاشة المستطيلة، في طقس مغلّف بعتمة الصالة. لكن مع مرور السنوات غدا الطفل شاباً، وأخذ يطرح أمام نفسه الأسئلة الصعبة حول وظيفة ودور وأهمية هذا النوع من التسلية، القادر أن يصبح فعلاً إبداعياً متعدّد الأشكال.
بدافع الفضول أولاً، ثم بدافع الرغبة في المعرفة، بدأت أتساءل عن مصادر ومنابع هذه الحكايات التي نشاهدها بانبهار، وما هي الطاقات والقوى التي تديرها وتحركها بهذا القدر من الدقة والإحكام والتناسق والتآزر بين العناصر الفنية التي تساهم معاً في تشكيل العمل الفني.

شعرت بأن هذه العوالم، التي يفيض بها سحر الشاشة البيضاء، لا يأتي بالصدفة أو السهولة التي يجري فيها عرض الفيلم عقب إضاءة الصالة، وإنما يقف خلفها مبدعون بذلوا المال والجهد الشاق، الفردي والجماعي، في العمل والدراسة من أجل تقديم إنجازاتهم السينمائية لتصل أفلامهم إلى هذه الصالة التي اعتدت على ارتيادها برفقة الأهل والأصدقاء.
من هنا انتابتني رغبة شديدة في متابعة هؤلاء السينمائيين البارزين، سواء أكانوا مخرجين أو نجوماً أو كتّاباً، وأخذت علاقتي تتدرّج في فهم السينما من حالة ترفيهية إلى وسيلة تعبيرية تمتلك مفرداتها الجمالية والفكرية.
أستطيع القول أن انتمائي إلى السينما كان أيضاً بفعل علاقتي بطروحات لعناصر مثل المخيلة والأحلام والإبداع، وهو ما جذبني إلى التعرّف على السينما من دون الاكتفاء بالفرجة أو التلقي السهل عبر الشاشة، وإنما إلى التوجّه نحو رؤى وأفكار وتوجهات صانعيها من أصحاب المدارس والتيارات العريضة التي تكشفت عن تنوّع إبداعي ثري.
إذن لم أكتف بالمتعة والترفيه والتسلية التي كانت توفرها لنا الصالات بسخاء، كما فعل أقراني آنذاك، بل أردت أن أعرف أكثر عن صانعي تلك الأفلام، تلك العوالم الجميلة، كيف يصنعون هذه الأحلام الأخاذة، كيف يكتبونها ويخرجونها ويصورونها ويمثلونها.. أسئلة كثيرة معلقة بلا إجابات. الفضول وحب المعرفة دفعاني إلى البحث والقراءة.
المكتبة العربية، في ما يتعلق بالكتب السينمائية، كانت شحيحة جداً. دور النشر (ولا تزال) تنظر إلى الثقافة السينمائية بوصفها هامشية، غير ضرورية، ولا قراء لها. المثقفون أنفسهم كانوا (ولا يزال قسم كبير منهم) يرون السينما كشكل ترفيهي أقل قيمة وأهمية من الأشكال الفنية الأخرى، ولا يرونها – كما هي في حقيقتها وجوهرها – كنتاج ثقافي، فكري ورؤيوي وجمالي، يضاهي الأشكال الأخرى.
تميزت البحرين عن سائر بلدان الخليج بريادتها في إنشاء عدد من صالات العرض السينمائي منذ وقت مبكر، وهذه الصالات كانت تعرض الكثير من الأفلام العربية (المصرية) والأجنبية (الأمريكية)، و(الهندية) طبعا.. وهي أفلام ذات نوعية محددة تعتمد في أغلبها على الإثارة والتشويق والمغامرات والكوميديا.
في فترة السبعينيات، استطعنا تكوين نادٍ للسينما يعرض الأفلام النوعية المختلفة، بشكل أسبوعي، مصحوبة بنشرة متخصصة تتعلق بالفيلم وصانعيه، مع تعريف بأبرز تيارات ومدارس السينما العالمية.
بحكم عوامل العرض والتوزيع السائدة، ظل تواصلي بقامات السينما العالمية، والأفلام العالمية المتميّزة، محدوداً وشاقاً.. وبجهود ذاتية رحت، بدافع الشغف والحرص على المتابعة، أبحث عن وسائل للحصول على تلك الإبداعات السينمائية. ويجب أن نشكر التكنولوجيا التي نجحت في توصيل الأفلام عبر أشرطة الفيديو والسي دي والـ DVD.
غالباً، أحرص على مشاهدة الأفلام التي تنمّي وعيي وتوسّع مداركي وتنعش روحي وتعمّق حساسيتي.
3
اهتمامي بالسينما يتعدى المشاهدة، إلى الكتابة عنها. لكن أود أن أوضح أولاً أنني لست ناقداً (بالمعنى الحقيقي). عندما أكتب عن الأفلام فإنني أختار الأفلام التي أحبها.
النقد، في رأيي، فعل حب. من العبث، ومن غير المجدي، الكتابة عن نص أو فيلم تكرهه. هذا لن يفيد أحداً. من الأفضل أن تتجاهل العمل وتتجنب التوتر الذي تحدثه الكتابة عن شيء لا تطيقه.
أميل إلى قراءة النقد الذي هو، في جوهره، رسالة حب إلى الفيلم أو صانعه.. حتى لو اتسمت بالقسوة أو اشتملت على توبيخ ما. لكن لا براعة لدي في سبر الأفلام وتحليلها نقدياً، واستكشاف ما يوجد خارج أو خلف الصورة. إنها طاقة يمتلكها ناقد موهوب ومتخصص، يكرّس وقته وطاقته لهذا الفن الذي يعشقه. ولا أشعر بأني موهوب في النقد. أغلب كتاباتي في السينما هي محاولة لتحريض المتفرج على مشاهدة الفيلم.. إنها عملية إغواء أكثر مما هي نقد.
4
دفعتني حماسة الشباب إلى ضرورة التوجه نحو دراسة السينما والالتحاق بقافلة صناعها، بيد أن الظروف المادية الصعبة وقفت عائقا أمام استكمال هذه الرغبة التي ظلت في دائرة المشاهدة والمتابعة النقدية.
5
في بداية الثمانينيات بدأ ميلي إلى كتابة الدراما التلفزيونية، في شكل سهرات وبرامج منوعة ومسلسلات.
كنت وقتها أبحث عن بديل يعوّض غياب السينما كممارسة في واقعنا المحلي. وعندما سنحت لي الفرصة للكتابة للسينما، في شكل سيناريوهات طويلة وقصيرة، لم أتوقف عن كتابة الدراما التلفزيونية. لقد اكتشفت أن لكل وسيط فني مزاياه وجاذبيته ومتعته، وشروطه أيضاً. بالتالي، فإنني عندما أكتب للتلفزيون لا أشعر بأن هذا الوسيط لا يستوعب ما أريد أن أتناوله وأطرحه، بل أحاول أن أتكيّف مع أجوائه وإمكانياته وطرائقه وتقنياته، ومن خلال ذلك أسعى إلى تقديم قصصي.
6
في بداية التسعينيات، أتيحت لي الفرصة لخوض التجربة السينمائية بكتابة سيناريو فيلم “الحاجز” بتكليف من المخرج بسام الذوادي، المتخرج حديثاً من معهد السينما بالقاهرة، والذي كان وقتذاك يرغب في إنجاز أول فيلم درامي طويل في البحرين.

لقطة من فيلم “الحاجز” للمخرج بسام الزوادي
فيلم “الحاجز” كان أشبه بالحلم، أو بالأحرى ثمرة حلم جماعي أردنا لها أن تتحقق بجهود فردية وبإمكانيات متواضعة وميزانية فقيرة.
لكن الحماس والنوايا الطيبة لا تخلق سينما. إنها تحتاج إلى دعم مادي. من دون توفر المنتج والممول والموزع لا يمكن لأي فيلم أن يتحقق.
السينما ترف، حاجة غير ضرورية.. هكذا ينظر إليها الجميع هنا.
7
لاشك أن السينما مارست تأثيرا كبيرا على تجربتي الأدبية من ناحية المنظور البصري والعناصر التقنية في السرد. كان لها دور مؤثر وفعال في تشكيل وتكوين الصورة الأدبية في نصوصي.. سواء عبر الإطار التشكيلي أو التقطيع (المونتاج) أو حركة المنظور في المشهد. العين تأخذ غالبا دور الكاميرا. أحياناً أنظر إلى الصورة الأدبية التي تتشكل من زاوية مصوّر سينمائي، وأحياناً من زاوية رسام.
عندما أكتب روايةً أو نصاً أدبياً لا أحاول استعارة عدسة سينمائي أو تشكيلي أو مسرحي، إذ أن شيئاً كهذا سوف يؤذي عملك ويعطّل طاقتك وإمكانياتك.. وذلك لسبب بسيط، أن لكل مجال لغته الخاصة، المختلفة والمتباينة، وأنت لا تقدر أن تستعير لغة السينما القائمة على الصورة البصرية، لتكتب بها نصاً أدبياً يعتمد على الصورة اللفظية.
لكن، من جهة أخرى، يمكن أن تستفيد من عناصر معينة في السينما، كالمونتاج، مثلاً، أو تنسيق المشهد بصرياً. وأن تستفيد من التشكيل والمسرح وكل ما تعتقد أنه سيعزّز ويثري كتابتك.
8
أود أن أوضح هنا إنني منذ البداية لم أرغب في أن أكون مترجماً، فهي ليست غاية بالنسبة لي، بل لا أميل إلى ممارستها كثيراً. ولا أعتقد أنني أصلح لأن أكون مترجماً محترفاً.. في الواقع، لا أحب تصنيفي ضمن المترجمين.
الترجمة، بالنسبة لي، مجرد وسيلة لإيصال أفكار ورؤى وعوالم فنانين لم يسمع عنهم إلا القلة، ومن الضروري في رأيي أن نتعرّف عليهم أكثر. واختياري للحقل السينمائي نابع من حبي للسينما وإيماني بأن عددا كبيرا من السينمائيين هم أصحاب رؤى وفكر وفلسفة تضاهي ما يتمتع به أقرانهم في الحقول الفنية والأدبية الأخرى، ومن الضروري أن نتعرّف عليها ونحاورها ونتفاعل معها.
من خلال المشاهدة والقراءة اكتشفت عوالم خصبة، ثرية، مكتظة بالرؤى والأفكار والمفاهيم والدلالات، الجديرة بالتعميم، وتقديمها إلى الآخرين لكي يتقاسموا معك هذه المكتشفات.

اندريه تاركوفسكي
المشكلة أن السينما لم تدخل ضمن النسيج الثقافي في المناخ العربي، فالعديد من المثقفين العرب لا يزالون ينظرون إلى السينما بوصفها مجالا ترفيهيا بحتاً، ولا يأخذونها بجدية. المكتبة العربية، في ما يخص السينما، فقيرة أو متواضعة جداً. لذلك وجدت نفسي مضطراً لتقديم تاركوفسكي وأنجيلوبولوس وغيرهما إلى القارئ العربي لعله يكتشف عوالم جديدة وغنية ومغرية، أما إذا لم يكن بحاجة إلى ذلك، فهذا شأنه. عليّ أن أؤدي واجبي، حتى لو كان ثقيلا ومرهقا.
عندما شاهدت أفلام تاركوفسكي وقعت في أسر جمالياته وموضوعاته، سحرتني أعماله، فقررت أن أعرف عنه كل شيء، وكان كتابه الرائع والهام “النحت في الزمن” الذي نقلته إلى العربية لكي يتقاسم معي الآخرون هذا الولع بأفلامه. قبله كان أنتونيوني، بيرجمان، فلليني، جودار، بريسون، أوزو.. وآخرون.
دافعي هو تحريض الآخرين على التعرّف على المخرجين الذين أحبهم، والذين يلهمونني ويحفّزون وعيي ومخيلتي وذاكرتي، ويجلبون لنا المتعة واللذة والنشوة. من خلال هذه الكتب أحاول أن أرافق القارئ في رحلة – أتمنى أن تكون ممتعة وغير مرهقة – داخل عالم المخرج الذي يحكي، عادةً، عن تجربته الحياتية والفنية، ويطرح آراءه وفلسفته وهمومه.
في الفن، في الثقافة عموماَ، لا ينبغي أن تكون أنانياً، أن تستحوذ وحدك على معرفة شيء ما، بل من الضروري نقل المعرفة إلى الآخرين، سواء أكانوا بحاجة إليها أم لا. من هذا المنطلق، وبسبب عدم توفر الكتب السينمائية والمجلات الجادة، لجأت إلى ترجمة المقالات والحوارات التي وجدتها هامة ومفيدة، قد تساعد القراء على “استيعاب” عوالم صانعي الأفلام.. رؤاهم ودوافعهم وتأويلاتهم.
الترجمة، إذن، كانت اختياراً اضطرارياً، بإملاء من الحاجة المعرفية والرغبة في توصيل الأفكار إلى الآخرين، وليس إغواءاً يفرضه الشكل الإبداعي.. كما الحال مع القصة والرواية والنص الأدبي.. وهي الأشكال التي أمارسها – بشغف وتلذّذ – منذ بداية السبعينيات وحتى يومنا.

ميكلانجلو أنتونيوني
في معظم ما ترجمت، كنت أحاول أن أعرّف القارئ بسينمائيين كبار قلما قرأ عنهم أو شاهد أعمالهم أو أتيحت له الفرصة للدخول في عوالمهم. هؤلاء السينمائيون، ساهموا في إضافة الكثير إلى لغة السينما، وقدموا في أفلامهم رؤى عميقة على الصعيدين الفكري والفني. أعمالهم هي تأملات عميقة في جوهر الأشياء والعلاقات، في مسألة الهوية الذاتية ومعضلات الوجود والقضايا الأساسية التي تمس الفرد والمجتمع، إلى جانب كونها – هذه الأعمال – استنطاقاً مستمراً لعناصر السينما وجمالياتها وتقنياتها وعلاقاتها بالمضامين والأشكال.
9
السينما حياة أخرى نعيشها حتى الثمالة.