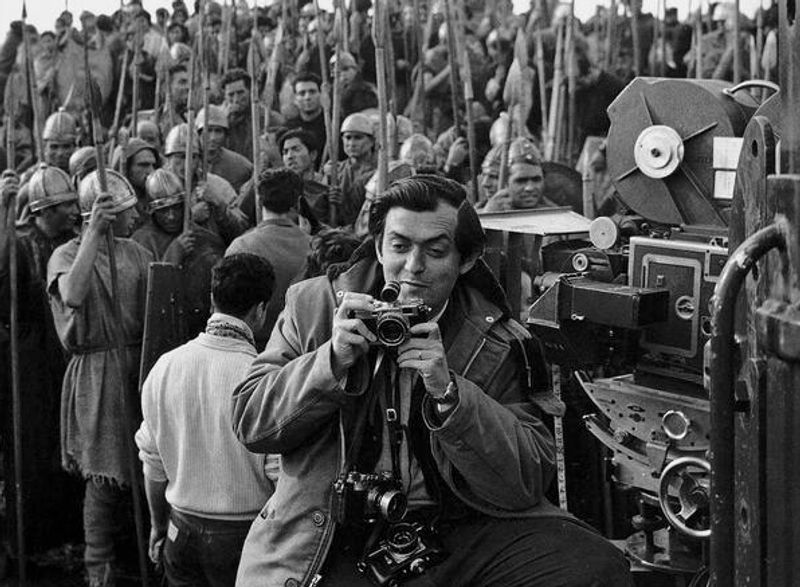“الرقص مع بشير” عقدة الذنب والعلاج باستدعاء الذكريات الكئيبة

أمير العمري
هذان المقالان نشرا في جريدة “البديل” المصرية التي كانت تصدر في القاهرة (في نوفمبر وديسمبر 2008) أعيد نشرهما هنا معا لأهميتهما في فهم سيكولوجية صانعي الأفلام في إسرائيل وهم ينتقدون سياسات بلدهم.
المقال الأول
حملة دعائية كبيرة سبقت إطلاق الفيلم الإسرائيلي “الرقص مع بشير” في بداية صيف العام الجاري ثم انتقاله إلي عدد كبير من المهرجانات السينمائية في العالم، صورته باعتباره دليلا آخر علي “يقظة” الضمير الإسرائيلي، والقدرة علي انتقاد المؤسسة الحاكمة وفي مقدمتها بالطبع الجيش الإسرائيلي، وإدانة ما وقع في صبرا وشاتيلا، ومحاسبة النفس علي ما جري من مذابح في حق الفلسطينيين من النساء والأطفال.
وقد جاء هذا الفيلم أخيرا للعرض في مهرجان لندن السينمائي وأحيط باهتمام كبير وعرض في احتفالية خاصة في منتصف المهرجان بمناسبة الاحتفال بمرور 60 سنة علي قيام إسرائيل.
إلا أن تأمل الفيلم بشكل دقيق، بعيدا عن المبالغات الإعلامية التي وصلت إلي حد قول صحفي عربي إن ما يصوره “لا يجرؤ مخرج عربي علي تقديمه”، يكشف طبيعته الحقيقية ونواياه وأغراضه وحدوده السينمائية أيضا.
مخرج الفيلم «أري فولمان» كان جنديا شابا في الجيش وقت الغزو الإسرائيلي للأراضي اللبنانية واقتحام بيروت عام 1982 فيما أصبح يعرف حتي الآن باسم “حرب لبنان”، وقد فقد أي أثر لأي ذكريات عن تلك الحرب التي انتهت كما هو معروف بمذابح صبرا وشاتيلا التي قتل خلالها مئات الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال.

يبدأ الفيلم بزميل سابق في الجيش للمخرج يطرق عليه باب منزله في وقت متأخر من الليل لكي يقول له إنه يعاني من مطاردة كابوس ليلي له يطارده خلاله 26 كلبا متوحشا، وإن هذا الكابوس يعود إلي فترة اشتراكهما معا في “حرب لبنان” أي غزو عام 1982. ويروي الجندي كيف أنه كلف وقتها بمهمة قتل عدد من الكلاب بلغ 26 كلبا في قرية لبنانية كانت تهاجم الجنود الإسرائيليين عند محاولتهم اقتحام القرية لاصطياد المسلحين. ويحاول زميل فولمان تذكيره بما حدث في صبرا وشاتيلا من مذابح رهيبة كان الجيش الإسرائيلي شاهدا عليها، لكن المشكلة أن فولمان لا يتذكر أي شيء من تلك الفترة وإن كان يشعر بقلق غامض كلما فكر فيها. ولذا يقرر العودة للبحث فيما حدث.
ولأنه لم يشأ تصوير فيلم تسجيلي بدون توفر وثائق على تجربته الشخصية مع زملائه في تلك الحملة، فقد اختار صنع فيلم من أفلام الرسوم يستعيد خلاله أحداث الفترة من خلال شهادة 9 من زملائه.
يتردد في الفيلم حوار واضح تماما بين فولمان وزميله “بوز” الذي يعاني من “كابوس الكلاب”. يسأله فولمان: لماذا أتيت إلي وأنا مجرد مخرج سينمائي ولست طبيبا نفسيا؟ فيرد قائلا: يمكنك أن تصنع فيلما عن ذلك، أليست الأفلام أيضا وسيلة للعلاج النفسي؟!
هذه العبارة تلخص فلسفة الفيلم كله، فنحن أمام جندي سابق في الجيش أصبح مخرجا سينمائيا، يريد أن يستدعي ذكريات أغلق عليها ذهنه تماما رغبة في الهرب من بشاعتها، بغرض تصفية حسابه مع الماضي، واستعادة ثقته بنفسه والخلاص مما يؤرقه في الداخل. ومن هذه النقطة بالفعل تبدأ رحلة صنع الفيلم الذي لقي تمويلا من فرنسا وألمانيا.

ويركز الفيلم بشكل أساسي على عدة عناصر تتبدي في معظم لقطاته ومشاهده:
أولا: صغر سن الجنود، بل إنه يصورهم في لقطة تتكرر أكثر من 4 مرات عبر الفيلم، كما لو كانوا أطفالا يافعين، وهم يخرجون من البحر علي شاطئ بيروت، عراة تماما، ثم يبدأون في ارتداء ملابسهم في لقطة مصبوغة باللون الذهبي القاتم، كما لو كانوا يخرجون من بحيرة زيت تنعكس عليها أشعة شمس ما قبل الغروب فتضفي عليها جوا شديد الكآبة والرعب. واللقطة المتكررة مصورة بالحركة البطيئة، بحيث تجعل الفتيان يبدون كما لو كانوا يسيرون نياما.
هذه اللقطة تعكس براءة الفتيان وتمهد لما سيشهدون عليه من مذابح رهيبة. وتصور ما حدث باعتباره انتهاكا لبراءة الشباب اليافع، وهي فكرة متكررة في الأفلام الإسرائيلية المناهضة للحرب، أي أن ما يشغلها ليس القتل في حد ذاته بل تأثر ممارسة القتل على نفسية شباب الجيش الإسرائيلي.
ثانيا: يصور الفيلم العنف الشديد من جانب الجنود الشباب في “جيش الدفاع” الإسرائيلي واستمرارهم في إطلاق الرصاص بشكل متواصل من الدبابات على طول الشاطئ كما نري في مشهد متكرر، كرد فعل لشعور قوي بالخوف في داخلهم.. الخوف من الموت، هكذا بشكل “وجودي” دون الإشارة إلي أنهم يشاركون في غزو دولة، ويقتحمون أرضا غريبة عليهم لتحقيق هدف سياسي محدد ومعروف مسبقا، وليس حسب المعني الذي يتردد في الفيلم: لم أكن أعرف ماذا نفعل ولا أين نحن. كنت فقط أنفذ الأوامر!
ويعقب هذا المشهد الواضح الدلالة مشهداً آخر حين يصل الجندي إلي قاعدة جوية ويري عددا من جثث الجنود الإسرائيليين والمروحيات تستعد لنقلها، ويزداد شعوره بالخوف من الموت، أو عندما يروي أحدهم كيف أصيبت دبابته وهرب منها مع زملائه الذين قتلوا جميعا فيما عداه، وكيف تمكن من السباحة حتي عاد إلي وحدته.

ثالثا: يؤكد الفيلم من خلال كل شهادات الجنود والضباط، كيف أن القوات الإسرائيلية التي كانت مكلفة بالتمركز قرب مخيمات صابرا وشاتيلا لم تكن تعرف ماذا سيحدث بعد اغتيال الرئيس اللبناني بشير الجميل وقبل تنصيبه. ولم تكن على اطلاع على ما تخطط له قوات الكتائب، فكل الشهود في الفيلم يؤكدون أنهم “سمعوا عنها ولم يشاهدوا بأنفسهم إلا بعد أن انتهت”، ويقول كثيرون منهم إن تصرفات مقاتلي الكتائب بعد اغتيال بشير الجميل أثارت الشك في نفوسهم وأنهم أبلغوا قيادتهم بذلك دون أن يتخيلوا أن الأمر مرتبط بمذبحة وشيكة.
ويروي أحد الضباط في الفيلم كيف أنه اتصل بشارون لكي يخبره بما يجري في المخيمات من مذابح، وأن شارون شكره على لفت انتباهه للأمر، دون أن يتعهد بتحري الأمر كما هي العادة. ويتخذ المدافعون عن الفيلم هذا المشهد كدليل لا يقبل الشك، على إدانة الفيلم للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، في حين أن شارون تحمل بالفعل مسئولية عدم التدخل لوقف المذابح بموجب ما توصلت إليه لجنة تحقيق خاص في الكنيست. ويصور الفيلم ضابطا إسرائيليا يقود سيارته ويتوقف بها داخل المخيمات أمام عدد من مسلحي الكتائب يسوقون عددا كبيرا من النساء والشيوخ والأطفال قبل إطلاق النار عليهم، ويأمرهم بوقف الرصاص والتفرق، مرددا عليهم أن “هذا أمر”. وعلي الفور يترك مسلحو الكتائب الفلسطينيين يعودون إلى المخيمات ويتفرقون. وهو ما يقول لنا إن الإسرائيليين هم الذين أوقفوا المذبحة!
ولا جديد في اللقطات التي تستعيد مظاهر الموت والخراب والدمار وتراكم الجثث بين أنقاض صابرا وشاتيلا، ولا جديد في تصوير يد ورأس لطفلة فلسطينية مدفونة تحت الأنقاض يعلق عليها ضابط إسرائيلي بقوله: إنها تشبه ابنتي!
فيالها من إنسانية كاذبة تلك التي تسعي إلي تطهير نفسها على شاشة السينما، فتسيء استخدام السينما وتجعل منها أكثر وسيلة للتضليل في التاريخ الإنساني، بدلا من أن تصبح وسيلة للتنوير والوعي.
المقال الثاني
كتبت من قبل عن الفيلم الإسرائيلي “الرقص مع بشير” واختلفت تماما مع من يقولون بأنه فيلم ينتقد المؤسسة الإسرائيلية، ويدينها ويكشفها، وقلت إنني لم أر فيه أي إدانة من أي نوع للمؤسسة الإسرائيلية العسكرية، بل على العكس يؤكد الفيلم أكثر من عشر مرات، أن الجنود والضباط الإسرائيليين (الذين يستجوبهم المخرج في الفيلم ولو بالصوت فقط ويستخدم رسوما عوضا عن اللقطات السينمائية المباشرة) أنهم لم يعلموا بما سيحدث في صبرا وشاتيلا إلا بعد وقوعه، وإنهم لم يروا شيئا بأنفسهم بل سمعوا بما حدث بعد حدوثه.
ثانيا هذا فيلم، أساسه وجوهره، حول “الفاعل” وليس المفعول به، أي عن المأزق “الإنساني” الذي يزج بالجنود الإسرائيليين فيه، ويؤكد في كل أجزائه أنهم “مغلوبون على أمرهم” “سيقوا إلى حرب لا يعلمون شيئا عنها” “كانوا شبابا صغار السن يافعين”، وأنهم “كانوا نائمين وقتما صدرت لهم الأوامر بركوب سيارات والتوجه إلى الجبهة، ووصلوا وهم لايزالون نائمين”. هذا ما يتردد في الفيلم بشكل حرفي.
بمعنى آخر، هذا فيلم عن المٌعتدي وليس المعتدى عليه، وهو إن كان يظهر بعض الصور في النهاية للمعتدى عليهم فبقصد غسل ضمير المعتدي، وتخليصه من “عقدة الإحساس بالذنب” المفتعلة فنيا ، ي أنها عقدة “غير حقيقية” صنعت بنظرة ليبرالية مفتعلة موجهة للغرب تحديدا، بقصد تصوير “العذاب” الروحي الذي يعانيه المعتدي لعجزه عن حماية “المعتدى عليه” من اعتداء لم يأت من طرف هذا “المعتدي” الذي هو الإسرائيلي، الغازي، الذي اقتحم أرض الغير، وشن حرب تصفية شملت آلافا من المدنيين الأبرياء، ودمر إحدى أهم العواصم العربية، بل من “معتد” آخر هو حزب الكتائب اللبناني. صحيح أن هذا المعتدي الآخر كان عميلا وذيلا للمعتدي الصهيوني، إلا أن الفيلم يريد أن يقول لنا إنه تجاوزه في وحشيته إزاء الفلسطينيين، وإزاء رغبته في الانتقام بأبشع الطرق لاغتيال زعيمه بشير الجميل.
هكذا يتطهر الإسرائيلي ويغتسل من عقدة الذنب، وينجو من الإدانة المباشرة: كإنسان، وكجندي، وكمواطن إسرائيلي عادي اضطر لأداء “الخدمة” العسكرية في 1982 في لبنان، ثم تحول إلى “مخرج سينمائي” لديه أيضا حساسيته الخاصة.
هنا يُلقي ذلك “الجندي السابق- السينمائي الحالي” اللوم بأسره على قيادته المتمثلة في شارون (اليميني، العسكري المحترف الخشن، العنيف، رمز الجيل المؤسس المتطرف صهيوينا، ًالمدان لفرط توحشه في الأوساط الغربية) كما لو كان شارون مثلا أكثر وحشية من ليفني أو أولمرت أو باراك. فهل هناك بعد ذلك لامعقولية أكثر من هذا!
والغريب أن الناقد السينمائي سمير فريد (وهو متمرس على مشاهدة الأفلام) يكرر في أكثر من مقال له أن الفيلم يصور غزو الإسرائيليين للبنان على صورة كلاب متوحشة سوداء تفتك بالفلسطينيين. وهذا غير صحيح على الإطلاق.

والصحيح أن الفيلم يبدأ بكابوس (نعرف فيما بعد أنه يتكرر في حياة بطل الفيلم منذ عودته من الحرب اللبنانية عام 1982). في هذا الكابوس المتكرر يرى البطل- المنكسر- الذي يعاني من أزمة نفسية، 26 كلبا أسود، يطاردونه باستمرار ويحاصرون منزله في تل أبيب، ومن هذا الكابوس المعذب يبدأ الفيلم، فهذا الجندي السابق (بواز) يلتقي بالمخرج آري فولمان ويطلب نصيحته بشأن هذا الكابوس، ويروي له أنه كان قد كلف أثناء غزو لبنان عام 1982 مع زملائه باقتحام قرية لبنانية في جنوب لبنان للقضاء على أفراد المقاومة فيها، وكانت المهمة التي أوكلت إليه تحديدا قتل عدد من الكلاب المتوحشة التي كانت تحرس تلك القرية (لأن رؤساءه كانوا يعرفون أنه لا يستطيع قتل البشر!) وأنه اضطر لقتلها واحدا واحدا، وكان عددها 26 كلبا.
غير أن سمير فريد يتخذ من هذا المشهد- الكابوس دليلا على أن الفيلم يدين الجيش الإسرائيلي ويشبه جنوده بالكلاب، فهو يقول بالنص:
“ لم يحدث أبداً، فى حدود معلوماتى، أن تم إنتاج فيلم يصور مخرجه ضباط وجنود جيش البلد الذى ينتمي إليه على شكل كلاب مسعورة عيونها حمراء تنقض على مدينة فى ظلام الليل كما فعل آرى فولمان، وهو يصور غزو بيروت عام ١٩٨٢” (المصري اليوم- 29 يناير 2009).
قبل ذلك، وبعد أن شاهد سمير فريد الفيلم نفسه في مهرجان كان كتب يقول بالحرف الواحد أيضا:
“ويدين الفيلم الغزو حتى أنه يبدأ مع العناوين بكلاب متوحشة تقوم بالغزو، وينتهي بمشاهد تسجيلية للمذبحة وإحدي الفلسطينيات تصرخ في المخيم: تعالوا صوروا القتل.. أين العرب.. وأين العالم مما يحدث لنا” (المصري اليوم- 17 مايو 2008).
يقول سمير فريد أيضا في مقاله الذي يعلق فيه على ترشيح الفيلم لأوسكار أحسن فيلم “أجنبي” تحت عنوان “أول فيلم تحريك يرشح لأوسكار أحسن فيلم أجنبي” (المصري اليوم- 29 يناير): ” وقد يتصور البعض ممن لم يشاهدوا الفيلم أن وصوله إلى ترشيحات أوسكار أحسن فيلم أجنبى، ودخوله التاريخ كأول فيلم تحريك يتنافس على هذه الجائزة يرجع إلى «تعاطف» أغلب أعضاء الأكاديمية «نحو ٦ آلاف عضو» التى تنظم الأوسكار، تعاطفهم مع إسرائيل، حيث يتم الترشيح والفوز بعد ذلك من خلال التصويت الفردى المباشر، ولكن من واقع مشاهدة الفيلم، ومن دون إنكار التعاطف السائد فى الغرب عموماً مع إسرائيل بالحق أو الباطل، فإن السبب فى رأيى ليس التعاطف مع إسرائيل بقدر ما هو تأييد السلام، وتقدير الفيلم من الناحية الفنية حيث يعتبر نقلة نوعية فى أفلام التحريك”.

وسمير فريد بالطبع حر بالطبع في إعجابه بالفيلم وبمستواه الفني رغم ما فيه من قتامة في الألوان وتواضع شديد في نوعية ومستوى رسومه التي تبدو مثل رسوم الأطفال، وموسيقاه الزاعقة التي تثير من الضجيج أكثر مما تدفع إلى التأمل، غير أنني أود التوقف هنا أمام فكرة أن أعضاء الأكاديمية من المؤيدين للسلام.
أي سلام ذلك الذي يتعاطف معه أعضاء الأكاديمية: فهل رسالة هذا الفيلم تتلخص في الدعوة إلى السلام؟ النقاد في الغرب بل وداخل إسرائيل نفسها، يتفقون على أن الهدف الأساسي من الفيلم هو هدف “علاجي” therapeutic ويروي كثير من الجنود الإسرائيليين الذين حاربوا في لبنان 1982 مثل فولمان لصحيفة “هاآرتز” الإسرائيلية (5 فبراير) كيف أن مشاهدة الفيلم جعلتهم يشعرون بالراحة النفسية بعد أن أعاد إدخالهم إلى التجربة وتنتقية الذاكرة حولها، والأهم، توضيح عدم مسؤولية الجنود كأفراد عما وقع في صبرا وشاتيلا.
إنه العلاج النفسي (بقصد تطهير الروح) عن طريق استعادة الماضي، واستدعاء الأحداث بقسوتها وعنفها على طريقة التحليل النفسي، وهو المدخل الذي يستخدمه فولمان في فيلمه بوضوح لا ريب فيه.
يقول بيتر برادشو ناقد صحيفة “الجارديان” البريطانية (21 نوفمبر 2008) إن من الممكن الاعتراض على الفيلم باعتبار أنه “يجعل الأولوية لآلام المتفوق على حساب المضطَهد”.

ويقول ج. هوبرمان في “هوستون برس” الأمريكية (13 يناير 2009) “إن الفيلم “يهتم أساسا باستدعاء التجربة القاسية. هناك جانب علاجي في هذا الموضوع، وليس غريبا أن فولمان أحد صناع عرض تليفزيوني إسرائيلي شهير كان مقتبسا من الدراما النفسية التي أنتجها تليفزيون إتش أه بي “في العلاج”.
ولا شك أن “فتح الجرح” أو استدعاء التجربة، عامل أساسي في العلاج وفي تحقيق الشفاء، ولكن كم من العلاجات والصدمات والمواجهات مع النفس سيحتاج الجنود الإسرائيليون في المستقبل بعد كل هذه المذابح المستمرة!
إن ترشيح الفيلم من جانب القائمين على الأوسكار الذين لم يمنحوا جائزة واحدة في تاريخهم لفيلم يتعاطف مع الفلسطينيين ولو بأي مقياس (ولا حتى لفيلم “ميونيخ” من إخراج طفلهم المدلل سبيلبرج)، ليس حبا في السلام، بل من أجل التأكيد على “التفوق” الإسرائيلي: في شن الحروب، وفي البحث عن الشفاء من عقدة الحروب، في مواجهة الأعداء، وفي مواجهة النفس وقتما يقتضي الأمر بغرض تحقيق الاسترخاء اللازم للعودة إلى مواصلة القتل، في استخدام أدوات الدمار للتخلص من “المواد البشرية الفائضة”، ثم في استخدام أدوات السينما بغرض تطهير أرواح الأبناء من عقد الإحساس بالذنب.