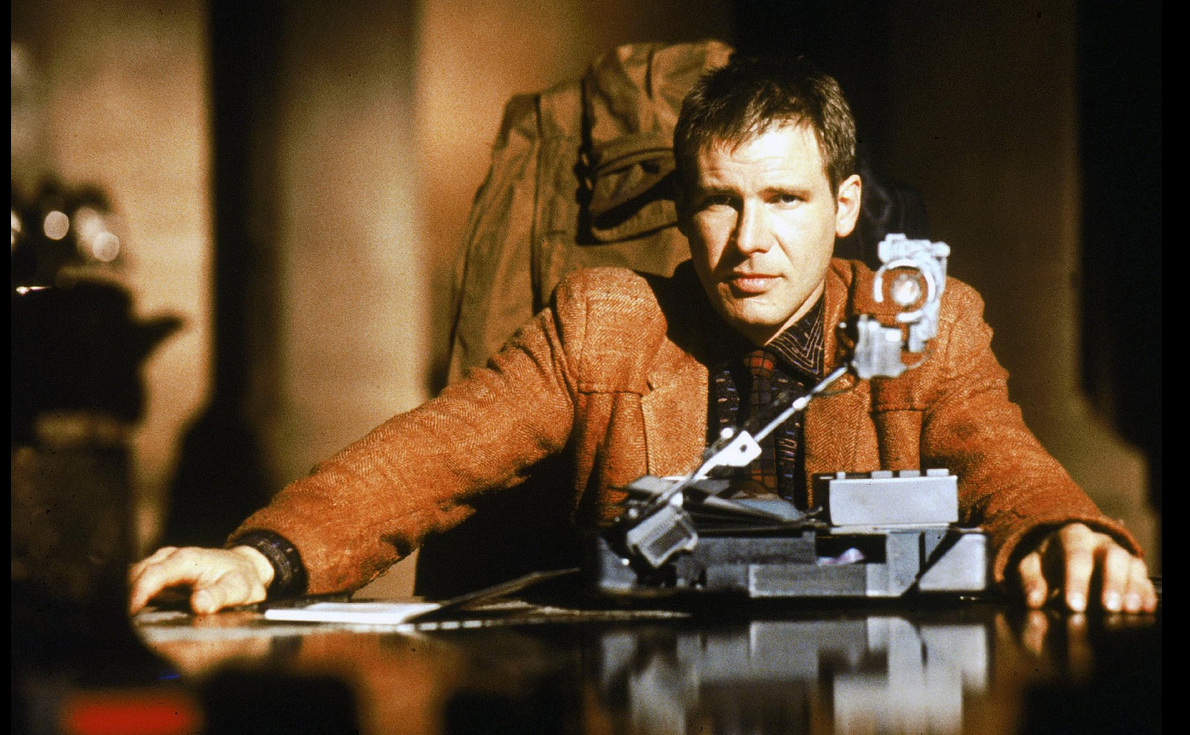اللغة السينمائية في أفلام صلاح أبو سيف

د. ماهر عبد المحسن
يعتبر المخرج صلاح أبو سيف، أحد رواد الواقعية في السينما العربية، فهو يشكل حالة فريدة من نوعها تستحق الدراسة والتأمل الطويل. ورغم أنه قدم 42 فيلما، أخلص فيها لتيار الواقعية الذي تبناه، كاتجاه إخراجي أثير لديه على مدار مسيرته السينمائية الطويلة، إلا إنه لم يغرق في الواقعية بحيث ينزلق إلى التسجيلية كما حدث مع الكثيرين من مخرجي الواقعية بعده، ولم يغال في التجريبية بحيث يقع في شراك التغريب كما حدث مع البعض مثل يوسف شاهين.
فقد كان حريصا على أن يوازن بين الشكل والمضمون، أي بين جماليات الفيلم وقضيته، وفي هذا المعنى ينصح طلابه في أحد اللقاءات المنشورة بموقع “المدرسة العربية للسينما والتلفزيون” قائلا:
” أرجو منكم مراعاة القيم الجمالية وأن تعلموا أن ذلك ليس معناه تزييف الواقع، فقد سئمنا من القبح بكل أشكاله والذي يتم ممارسته تحت دعوى الواقعية، وهذا خلط كبير، فعلى الرغم من أن الواقع يحتوي على اللونين الأبيض والأسود إلا أنه يوجد بين اللونين العديد من درجات اللون الرمادي، والتي تتيح للفنان الاختيار فيما بينها لكي يعطي لعمله الواقعية، ولكن بعد إضفاء اللمسة الجمالية التي تجذب المتفرج بادئ ذي بدء لكي يشاهد العمل”.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، نجح أبو سيف في أن يحظي بالتقدير من قبل النقاد والجمهور على حد سواء، فبالإضافة إلى الجوائز العديدة التي حصل عليها والمهرجانات الدولية التي مثل مصر فيها، يعشق المشاهد العربي أفلامه، بل ويحفظ منها مشاهد كاملة كما يحفظ بيتا من الشعر أو مقطعا من أغنية محببة إليه، ليس أدل على ذلك من أن المشاهد العادي يمكنه أن يقرأ أفلام أبي سيف جماليا من خلال فهمة للغة السينمائية التي يقدم فيها وجهة النظر التي يرغب في التعبير عنها.
وفي هذا السياق، لا يمكننا أن ننسى المشهد الأيقوني الذي قدمه في فيلم “القاهرة 30” ويصور حمدي أحمد جالسا على الكرسي مرتديا طربوشا وفي الخلفية على الحائط قرني تيس، يظهران في الكادر وكأنهما خارجان من رأس محجوب عبد الدايم (الشخصية التي يؤديها حمدي أحمد) في إشارة إلى موقفه غير الأخلاقي الذي يجعله أشبه بالتيس الذي لا يغار على شرفه.

والحقيقة أن السر الذي يقف وراء شعبية أبي سيف لا يكمن في اللغة السينمائية الراقية التي تهم النقاد، ولا في الواقعية المفرطة التي تجتذب الجماهير، وإنما في مقدار الصدق الذي يحمله العمل، وفي قدرة المخرج على التعبير عن وجهة نظرة بلغة يفهمها الجميع دون أن يخل بجماليات العمل باعتباره، في التحليل الأخير، ينتمي إلى دائرة الفن لا الواقع.
ومن هذا المنطلق يتبنى أبو سيف مفهوما للواقعية يسمح له بالتحرك بحرية بحيث يقدم فيلما مثل “الزوجة الثانية” أو “شباب امرأة” وفي الوقت نفسه يقدم فيلما تجريبيا مثل “بين السماء والأرض” أو فيلما خياليا مثل “البداية”، ويعبّر أبو سيف عن هذا المعنى قائلا:
“الواقعية هي الواقعية في كل الأفلام التي تتسم بالواقعية، وفي رأيي الشخصي أن الواقعية هي أن تكون صادقا في تقديم فنك للمتفرجين، وإلى جانب الصدق تأتى مراعاة القيم الجمالية والإجادة في العمل، وفوق كل ذلك لابد أن يكون للفنان رأي صائب من الناحية الأخلاقية والسياسية، وأن يراعي في اختياره للمواضيع التي يتناولها، أن تكون ذات صلة بمشكلات تهم جميع فئات المجتمع الذي يعيش فيه والتي قد تمتد لتهم الانسانية.“
ومن رأي أبي سيف يمكننا أن نضع أيدينا على مسألة غاية في الأهمية، وهي علاقة الفن بالأخلاق، أو الفن بالواقع، فأبو سيف يضع القيم الأخلاقية والسياسية فوق القيم الجمالية، أي تغليب المضمون على الشكل، وتأتي هذه الرؤية من رغبته في تقديم ما يهم الناس، بل والإنسانية جمعاء. وأذكر أنه في أحد اللقاءات التليفزيونية عبّر عن رغبته في إخراج فيلم يدور حول قضية التفرقة العنصرية، وهي بالطبع قضية إنسانية بالدرجة الأولى.

ونقطة الانطلاق في هذا الاتجاه السينمائي الملتزم يمكن أن نعثر عليها في البدايات الأولى لصلاح أبي سيف، عندما أخرج أول أفلامه “دايما في قلبي”، وعن هذا الفيلم يحكي واقعة ذات دلالة. فقد كان الفيلم رومانسياً غنائياً، يحتوي على مشهد غرامي يحدث في حديقة الأسماك، وقام أبوسيف بالإعداد للمشهد بحيث يجلس الشاب وتنام الفتاة إلى جواره فوق الخضرة. وكمخرج مبتدئ أعجب بهذا التكوين composition جدا من الناحية الشكلية، ولم يلتفت إلى مضمون المشهد أو المعنى الذي يمكن أن يصل إلى المتفرج من خلال هذا التكوين، فما كان من أحد أولاد البلد، ولم يكن متعلما، إلا أن قال له بشكل عفوي تلقائي “مش عيب يا أستاذ البنت تنام للولد بالشكل ده من أول مقابلة”.
ويعلق أبو سيف على هذه الواقعة بنحو يكشف عن تواضع المخرج حين يتعلم من المشاهد، حتى لو لم يكن متعلما، فيقول:
” عندما أعدت التفكير فيما قاله هذا الشخص وجدت أنه بعفوية ابن البلد قام بلفت انتباهي إلى أن اهتمامي بالتكوين وإعجابي الشديد بالشكل جعلاني لا ألتفت للمعنى الذي قد يصل إلى المتفرج من خلال هذا التكوين، أي أنني أعطيت كل الأولوية للشكل فجاء ذلك على حساب المضمون، وقد استوعبت هذا الدرس جيدا ولم أقع في مثل هذا الخطأ مرة أخرى، وأصبحت أولي نفس القدر من الاهتمام لكل من الشكل والمضمون، بل وأعطي الأولوية للمضمون أولا ثم أهتم بالشكل بعد ذلك”.
والحقيقة أن أبي سيف لم يتخل عن الشكل تماما لصالح المضمون، لكنه جعل منه خادما للمضمون، وهي الرؤية التي يتحفظ عليها دعاة الفن للفن. وبهذا الاعتبار يقترب أبو سيف من المنظّرين السيميوطيقيين، الذين يتعاملون مع مفردات الفيلم باعتبارها فضاء لغوياً يشبه اللغة الطبيعية التي يتحدثها الناس في حياتهم مثل العربية والإنجليزية، وما تتضمنه من بلاغة ونحو وصرف.
وأبجدية اللغة السينمائية التي اعتمد عليها أبو سيف في أفلامه تتألف من ثمانية حروف: خمسة منها تخص الصورة، والثلاثة الباقيات تخص الصوت، فلابد للسينمائي أن يتقن هذه الحروف ويتقن التعبير عن رؤيته الفنية من خلال استعمالها، الحروف الخمسة الخاصة بالصورة هي: الديكور، الممثل، الإكسسوار الثابت، الإكسسوار المتحرك، الإضاءة. والحروف الثلاثة الخاصة بالصوت هي: الحوار، الموسيقى، المؤثرات الصوتية.
وبالرغم من أن أبي سيف كان متأثرا بالواقعية الإيطالية التي تعتمد كثيرا على اللقطات الطويلة، إلا أن خبرته الطويلة في العمل كمونتير في استوديو مصر، جعلته يعتمد أكثر على الجماليات السينمائية المستمدة من المونتاج. وفي هذا السياق يميز أبو سيف بين نوعين من المونتاج اعتمد عليهما في أفلامه: المونتاج المتوازي، والمونتاج الفكري.
ومن أمثلة المونتاج المتوازي المشهد الذي صوره في فيلم “الفتوة”، ويحوي مقارنه بين عمل بطل الفيلم الفنان فريد شوقي في جر عربة الخضار، وحمار يقوم بالعمل نفسه. وهنا نجد القطعات نفسها على لقطات متشابهة، لحركة رجلي بطل الفيلم وحركة أرجل الحمار، والإجهاد البادي على كل منهما في ايحاء بأن بطل الفيلم يعمل كالحمار.

ويمكن أن نعثر على مشهد مشابه في فيلم “شباب امرأة”، حيث نجد مقارنة بين إمام “شكري سرحان” صاحب الجسد المقتول وهو ينقذ أحد العمال الذين سقطوا تحت الطاحونة، قبل أن يقع في الغواية، وبين الحمار الذي يدير الطاحونة وهو معصوب العينين في إشارة إلى قوة إمام البدنية من ناحية، والشرك الذي ستنصبه له شفاعات (تحية كاريوكا)، وسيمضي إليه كالحمار المعصوب العينين حتى يقع فيه من ناحية أخرى.
كما لا يمكننا أن ننسى مشهد استدراج الضحية وقتلها في فيلم “ريا وسكينة”، ثم القطع الذي نقلنا من مكان الجريمة إلى “السلخانة” حيث تواصل قوات البوليس التحقيق في جرائم القتل المستمرة، ويتم القطع على لقطة لأحد الجزارين وهو يقوم بذبح نعجة في إشارة إلى أن الضحية تم ذبحها كما تُذبح النعجة.
وأما عن أمثلة المونتاج الفكري فهي كثيرة، وأهم ما يميزها أنها تعكس قناعات أبي سيف الأخلاقية في صناعة السينما. ومن هذا المنطلق يمكن الاعتماد عليها حين التنظير لأي اتجاه سينمائي يهدف إلى تغليب الأخلاق العملية على الجماليات الفنية مثلما حدث ذات يوم وأطلق البعض مصطلح “السينما النظيفة” دون غطاء نظري مقنع عدا حسن النية والدعوة إلى الأخلاق الحميدة!
وفي هذا الصدد، نعثر لدى أبي سيف على مشاهد عديدة استطاع من خلالها أن يعبّر عن أكثر اللحظات الإنسانية سخونة دون أن يقع في شرك الابتذال والمباشرة، لعل أبرزها مشهد من فيلم “الأسطى حسن” يصور الفنانة زوزو ماضي، وكانت تقوم بدور سيدة أرستقراطية تعجب بالأسطى حسن (فريد شوقي) وتحاول إغراءه واستدراجه إلى غرفة نومها، ولأن أبي سيف لم يشأ أن يصور العلاقة الجنسية، فاستعاض عنها بتمثال في أحد الأركان يصدر عنه صوت صفير فيسألها فريد شوقي عن هذا التمثال في لقطة سابقة فترد قائلة إن هذا التمثال يصدر عنه صوت الصفير في حالة انبساطها.
ومن خلال هذه التفصيلة يقوم أبو سيف بالقطع عليهما في لقطة وهما يهمان بالدخول إلى غرفة النوم، ثم لقطة تالية للتمثال وهو يصدر صوت الصفير، ثم لقطة للتمثال وهو يبدأ في إصدار صوت الصفير مرة أخرى للإيحاء غير المباشر عن انبساطها بسبب علاقتهما الجسدية.

ويوجد مثال مشابه لمشهد من فيلم “شباب امرأة” تم فيه استخدام المونتاج الفكري بالقطع على انطلاق مدفع في مولد للتعبير عن ممارسة العلاقة الجسدية بين البطل الفنان شكري سرحان، والبطلة الفنانة تحية كاريوكا.
وفي كل الأحوال، لا يمكن اختزال عبقرية مخرجنا الكبير في قدرته على توظيف اللغة السينمائية من أجل خدمة الأغراض الأخلاقية، ولكن في قدرته على تقديم مشاهد سينمائية مبتكرة، ولفته الأنظار إلى أن الواقعية في السينما ليست هي التسجيلية الخالية من التعبير الفني، وأن الإفراط في استخدام اللغة السينمائية بنحو مجاني من شأنه أن يفقد السينما واحدا من أهم عناصرها وهو الجمهور، كما يضيّع على الفن واحدة من أخطر وظائفه وهي توصيل رسالة إنسانية.