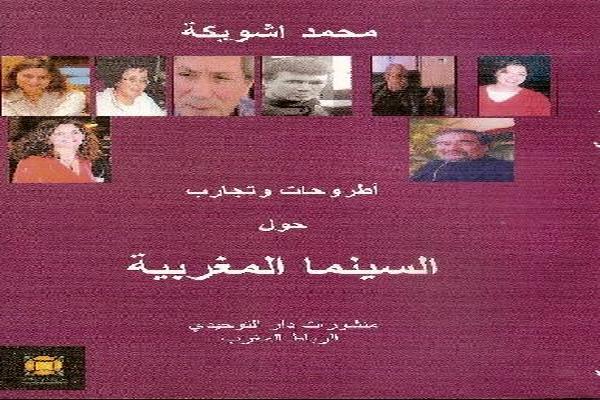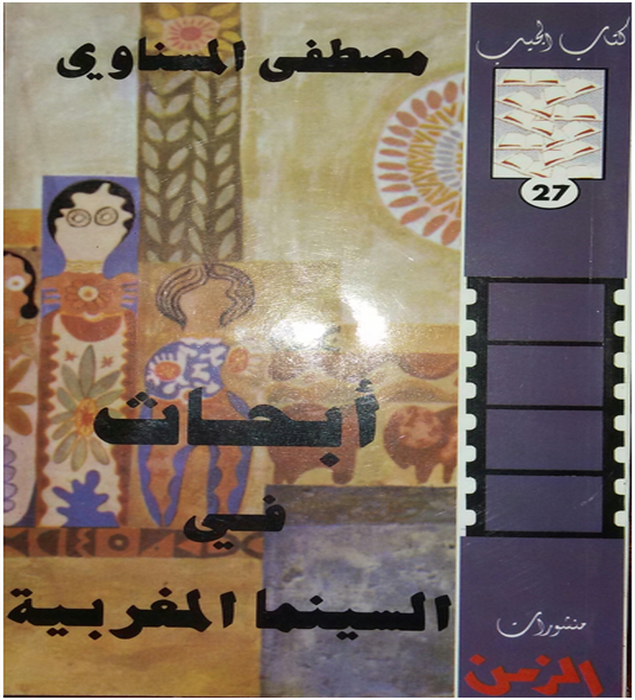فيكتور إريثه: ليس جمال الصورة، بل جمال الحقيقة

هذا نص اللقاء الذي تم مع المخرج الأسباني فيكتور إيريثه Victor Erice في لندن، في صيف 2003 بمسرح الفيلم الوطني نقلاً عن مجلة Sight and Sound البريطانية، عدد شهر سبتمبر 2003.
وقد عرض في الملتقى فيلمه الأول “روح خلية النحل” وفيلمه القصير “خط الحياة” Lifeline(2002) وهو جزء مدته 10 دقائق من فيلم طويل بعنوانTen Minutes Older.. بعده جرى حوار مع إيريثه أداره الناقد جوف أندرو، ثم فتح باب النقاش مع الحضور حول الفيلم، وسينما إيريثه عموماً، والمفاهيم التي يتبناها.)
يستهل إيريثه الكلام بالترحيب بالجمهور، قائلاً:
* قبل كل شيء، أود أن أشكركم جميعاً على حضوركم، ووجودكم هنا اليوم. كما أريد أن أعتذر عن عدم تمكنني من الحديث باللغة الإنجليزية. هذا الفيلم (خط الحياة) جاء نتيجة عرض قدّمه لي منتجو فيلم Ten Minutes Olderمع شرط واحد: أن لا تتجاوز مدة الفيلم عشر دقائق، وأن الثيمة الرئيسية للفيلم ينبغي أن يكون “الزمن والتعبير عن الزمن”. هذا هو ما ألهمني لتحقيق هذا الفيلم.
– هل يمكنك التحدث عن هذه الثيمة (الزمن) بالذات، لأن ذلك شيء تعاملت معه في كل أفلامك حتى الآن؟
* هذا شيء طبيعي، نظراً لكوني مخرجاً سينمائياً، ولأن الفيلم بطبيعته حافل بالزمن، خصوصاً إذا قارنت الأفلام مع أشكال فنية أخرى. من الجليّ أن الفيلم مجهّز بشكل جيد للتعبير عن مفهوم الزمن والأمد. بالطبع كل أشكال الفن تعبّر عن الزمن بطريقة أو بأخرى، لكن هذه الأشكال لم تنجح في احتواء الزمن، مثلما يحتوي الكأس الماء، كما نجح الفيلم في فعل ذلك.
– الشيء الآخر الذي يبدو ثيمةً في فيلمك هذا، من الواضح أنه يتّصل إلى حد بعيد بحياتك الخاصة، حيث أنه يدور في المنطقة التي ولدت فيها، واعتقد أنه يحدث في يونيه 1940.. تاريخ مولدك. إلى أي حد يتصل فيلمك بالسيرة الذاتية؟
* أحاول ألا أنغمس كثيراً في المظاهر السيرية، ذلك لأنني أخشى أن يُنظر إلى الفيلم من هذه الزاوية فقط، وفي هذه الحالة، سوف أعتبر عملي فاشلاً. طموحي أن أكون قادراً على الوصول إلى مواضع عالمية أكثر من مجرد سرد قصتي الخاصة، ذلك لأنني أعتبر نفسي مواطناً عادياً. مع ذلك، هناك حتماً بعض المظاهر السيرية لأن ثيمة الزمن، والطريقة التي عرضها عليّ منتجو الفيلم، هي شيء فلسفي وتجريدي جداً. نحن لا نعرف، وأنا شخصياً لا أعرف، ماذا يعني الزمن حقاً. لذلك حاولت أن أجعله ملموساً، أو أملأ الفراغ، بشيء أكثر صلابة. حاولت أن أعطي الصور نوعاً من الحس الوثائقي. على سبيل المثال، في الفيلم لا يوجد ممثلون محترفون. الذين ظهروا في الفيلم إخترتهم من القرية التي صوّرت فيها الفيلم. ومن الطبيعي أن يتغذّى الفيلم، بطريقة ما، من الذكريات التي جاءت إليّ، عن طريق والديّ، عن مولدي.
– لماذا صورت الفيلم بالأسود والأبيض؟ كل أفلامك الأخرى كانت بالألوان..
* هذا سؤال جيد. بالنسبة لي، كانت تلك مشكلة أساسية. في الواقع أنا صوّرت الفيلم بالألوان. الألوان كانت جميلة جداً. لكن صورة الدم في السينما المعاصرة – ربما الهيموغلوبين (خضاب الدم) أكثر من الدم نفسه – وعبر المؤثرات الخاصة، هناك ذلك النوع من الصورة التامة، أو الشمولية، للدم في السينما المعاصرة، إلى حد أن الدم صار مبتذلاً تماماً، وفقدَ ما كنت أحاول أن أقوله باستخدامه. المصور لم يكفّ عن القول بأن الصور جميلة جداً، لكنني أبداً لم أسع إلى إحراز جمال الصورة. حاولت أن أحرز جمال الحقيقة. كنت دوماً أتبنى، كشعارٍ لي، ما قاله روبير بريسون: “لا يتعيّن عليك أن تصنع صوراً جميلة، ينبغي أن تصنع الصور التي هي ضرورية”. وبريسون هو السينمائي الذي كان، قبل كل شيء، رساماً.
– هذا يقودنا إلى سؤال آخر. أنت كنت ناقداً سينمائياً، ومدمناً على مشاهدة الأفلام.. ما الذي جذبك إلى السينما في المقام الأول؟ متى صرت مولعاً بالأفلام؟
* أجد صعوبة في الإجابة. إنها أشبه بالتجربة. لا أشعر إني اخترت السينما أو صنع الأفلام. أشعر بأنها هي التي اختارتني. لا أريد أن أبدو مدّعياً. في طفولتي، الأفلام كانت مهمة جداً. في بلاد، وتحديداً في الأربعينيات من القرن الماضي، كانت معزولة تماماً عن بقية العالم، وموسومة بالحرب الأهلية، الأفلام منحتني إمكانية رائعة واستثنائية لأن أكون مواطناً ينتسب إلى العالم.
– هل كنت دائماً ترغب في تحقيق الأفلام؟ ربما ليس في فترة طفولتك، لكنك أصبحت ناقداً وأنت في ريعان الشباب..
* أعتقد أنها مسألة تتصل بالنشوء والتطور. وقد أصبحت واعياً لذلك عندما بلغت التاسعة عشرة من عمري. لكنك لا تختار الإخراج السينمائي وأنت صغير، ستكون وحشاً صغيراً. بالمثل، لا أحد يختار من يحب.
– كتبتَ بحساسية شديدة وحب بالغ عن أفلام نيكولاس راي وجوزيف فون شتيرنبرغ وكارل دراير وآخرين. ربما باستثناء كارل دراير، لست متأكداً من أن أفلامك الخاصة تنتمي إلى العالم نفسه الذي تنتمي إليه أفلام من أعجبت بهم. هل تشعر بأن هناك إحساساً بالإتصال بين الأفلام التي أحببتها ودافعت عنها والأفلام التي حققتها بنفسك؟
* كلما أسمع شخصاً يتحدث هكذا، بمثل هذه العبارات، أفقد القدرة على التعرّف على نفسي، ذلك لأنني أجد صعوبة في وضع نفسي داخل تاريخ السينما. في الواقع، أعتبر نفسي أفضل كمتفرج مني كمخرج. لكنني أدرك أن لديّ وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر المتفرج، والتي عادةً يأخذها المنتجون بعين الإعتبار. في رأيي، كل متفرج هو صانع أفلام محتمَل. وبالطبع، من دون وجود المتفرجين، الأفلام تفقد معناها ومبرّر وجودها. لذلك أستمر في الذهاب إلى السينما كلما أمكنني ذلك. على أية حال، أستطيع أن أقول أن السينما ساعدتني على العيش.
– والآن ننتقل إلى فيلمك “روح خلية النحل” The Spirit of the Beehive، الذي شاهدناه في هذه الأمسية. فيلمك هذا تضمّن مشاهد من الفيلم الأميركي “فرانكنشتاين” (1931)، الذي أخرجه جيمس ويل، لكنك وظفته لغايات مجازية. يبدو أن لديك ميْل للمجاز في أفلامك..
* في طفولتي شاهدت الكثير من أفلام هوليوود. تلك كانت السينما المتاحة لنا. كنت كمتفرج أستمتع بتلك المرحلة الإستثنائية الرائعة في الأفلام الأميركية. كنت أدرك، كطفل، أنني أشاهد أفلاماً اعتبرتها تحفاً فنية، ومازلت أعتبرها كذلك اليوم، كرجل بالغ. على نحو محتوم، معظم الأفلام التي كان بمقدورنا مشاهدتها، والإستمتاع بها، كانت أفلاماً أميركية. حتى قبل أن أعرف أن فرانكنشتاين هو نتاج مخيلة ماري شيلي، حتى قبل أن أقرأ الكتاب، شاهدت الفيلم. لذلك، بالنسبة لي، بوريس كارلوف (الممثل) هو فرانكنشتاين، وبمعنى آخر، الأساطير التي تشرّبناها في طفولتنا تبقى معنا إلى الأبد.
لكننا حتماً نكبر، وذات يوم، في مرحلة المراهقة، ذهبت إلى السينما لمشاهدة فيلم. الفيلم أنتج قبل خمس سنوات، لكن لم يُعرض في أسبانيا إلا في فترة متأخرة. كان فيلم “سارقو الدراجة” الذي أخرجه فيتوريو دي سيكا في العام 1948. لقد حرّك مشاعري وأثّر فيّ بعمق. وعندئذ أدركت أن هناك جانباً آخر من السينما ظل مجهولاً ولم تكن لديّ أية فكرة عنه، لأنه مختلف عن كل ما نعرفه. للمرّة الأولى أشاهد الواقعية في السينما، أشاهد الوجوه التي تشبه وجوه من أراهم في الشارع، أشاهد الأوضاع التي يمكنني أن أميّزها وأدركها. على الأرجح، من ذلك الموضع، أستطيع أن أقول بأنني تركت البراءة خلفي وانتقلت إلى مرحلة أكثر وعياً.
أصبحت مدمناً، بشكل مفرط، على مشاهدة الأفلام، وزرت كل الأندية السينمائية. لذلك أنا أستمر في التطور، مع ذلك أظل دائماً أميناً لمشاعري الأصلية، أيام طفولتي، بشأن السينما. بهذه الطريقة، فهمت أن الأفلام ليست مجرد حفلة أنس وسمر، بل يمكن أيضاً أن تكون فعل مقاومة.
إلتحقت بجامعة مدريد، وبوسعي القول إنني هناك عشت تجربة هامة جداً مع فيلم إيطالي آخر: شخص ما نجح في احتجاز نسخة من الفيلم في مطار باراجاس لبضع ساعات. الفيلم (روما مدينة مفتوحة – 1945 – للمخرج روبرتو روسيلليني) كان ممنوعاً تماماً من العرض في زمن فرانكو، لكنهم نجحوا في الحصول عليه لمدة ثلاث ساعات وعرضه في مكان سرّي يسع عشرين شخصاً. كانت تجربة راديكالية بالنسبة لي، ليس فقط بسبب الفيلم نفسه وأهمية معناه، لكن أيضاً لأننا كنا نعيش فترة حكم فرانكو. هذا يعيد توكيد شعوري بأن الفيلم يمكن أن يكون فعل مقاومة، وأنا مدين بعمق إلى تلك التجربة. بطريقتي الخاصة، أحاول أن أستمر في المقاومة وأن أستخدم الفيلم بهذه الطريقة.
– ما الذي دفعك إلى عرض هذه التجربة المؤلمة جداً، عن عائلة تتعرض للأذى نتيجة الحرب الأهلية، من خلال عينيّ طفلة، في فيلمك “روح خلية النحل”؟
* كيف يتوصل المرء إلى القصة؟ عبر تدخلات الصدفة. في الواقع، أنت لا تعرف أي طريق سوف تسلك. أنا أؤمن بعمق بالصدفة. لقد تلقيت عرضاً بتحقيق فيلم عن فرانكنشتاين ضمن تلك النوعية التقليدية، وكان من المفترض أن يكون مشروعاً تجارياً تماماً. ولأنني كنت شديد الحاجة إلى تحقيق فيلمي الأول، وكنت مطيعاً جداً، فقد بدأت كتابة فيلم تقليدي عن فرانكنشتاين. لكن حين شرعت في وضع الميزانية، تدخلت الصدفة السعيدة لصالحي، ذلك لأن هذا النوع من الأفلام يحتاج إلى الكثير من المواقع، وممثلين معروفين، والمنتج اضطر إلى الإعتراف بأنه لا يملك ما يكفي من الموارد المالية. لذلك اقترحت نسخة إسبانية من فرانكنشتاين.. ليست باهظة التكاليف، وبلا ديكورات ضخمة، ونحتاج أربعة أسابيع فقط للتصوير. المنتج أعجب بالفكرة. لكنني عندئذ وجدت نفسي أمام معضلة عويصة جداً: لم أكن واثقاً مما ينبغي عليّ فعله بالضبط. على طاولتي، كانت هناك صورة، لقطة من فيلم جيمس ويل “فرانكنشتاين” تُظهر المخلوق مع الطفل. الصورة علّقتها في حجرتي، وكنت أراها كل يوم. آنذاك أدركت أن تلك الصورة تحتوي كل شيء. لذا استدعيت تجاربي الذاتية كي تسعفني، وشعرت بأن التماثل مع الطفل والفيلم سيكون أكبر إن استبدلت الطفل بطفلة. هكذا بدأت القصة تتكشّف تدريجياً.
– الشيء الآخر، الجليّ مباشرةً، بشأن فيلمك هذا هو أسلوبك البصري، الذي هو جميل للغاية، قريب الشبه من اللوحات. وكأننا أمام لوحات فيرمير أو فيلاسكويز ورسامين عظام آخرين. كيف تتعامل مع صور أفلامك؟ هل تلجأ إلى رسم المشاهد، هل تصمّمها سلفاً؟
* أنا أؤمن كثيراً بالتجربة الفعلية. لا أعتبر نفسي مفكراً. القليل مما فعلته كان نابعاً من التجربة. أنا أؤمن بالتجارب اللاواعية والمشاعر التي تنبني تدريجياً في أذهاننا من دون أن نكون واعين لها، ذلك لأن المشكلة في الفن ليس فقط أن تكون لديك أفكار، إنما كيف تعبّر عنها وتعطيها هيكلاً وحياةً. الصعوبة تكمن هنا. من الجليّ، في هذا الفيلم (روح خلية النحل)، بروز عشقي للرسم.
لقد ذهبت إلى مدريد لدراسة أشياء لا تستطيع دراستها إلا في مدريد، ولكي أجد شيئاً يروق لوالديّ ويتيح لي أن أنتقل إلى مدريد، لأن في العام 1957 كان هناك أكثر من 200 صالة سينما، إضافة إلى متحف برادو. وللأمانة، قضيت أوقاتاً في الصالات السينمائية وفي المتحف أكثر مما قضيتها في الفصول الدراسية.
– أود أن أنتقل إلى فيلمك التالي، “الجنوب” (1983) والذي سيعرض هنا لاحقاً. وربما يتذكره البعض عندما عُرض في 1983. إنه فيلم رائع جداً، وأظن أنه ملتحم ومتماسك تماماً رغم أنه غير مكتمل، إذ لم يُسمح لك بأن تصوّر كل ما أردت تصويره.. هل كانت تجربة موجعة جداً بالنسبة لك؟
* نعم، كانت مؤلمة جداً لدراما الفيلم، لكن بالنسبة لنا، نحن المخرجين، مثل هذا الشيء يعد حدثاً اعتيادياً. الفيلم لم يكتمل لأسباب مادية. كان من المفروض أن تكون مدة الفيلم أطول بساعة واحدة. من جانب آخر، في ما يتصل بالإنتاج، كانت الأمور طيبة، وأمضينا أوقاتاً سعيدة أثناء تنفيذ العمل. حتى في تلك الحالة، الفيلم حقق نجاحاً تجارياً في إسبانيا، كما أثنى عليه النقاد. العديد من النقاد والجمهور امتدحوا حقيقة أن الجنوب، الذي قد يكون جنوب البلاد، لم يظهر أبداً في الفيلم. رغم أني كنت أميل إلى إظهاره، خصوصاً وانني عشت سنوات طويلة من عمري في الجنوب رغم إنني مولود في الشمال. لقد شعرت بأنها فرصة رائعة لجعل الشمال والجنوب يلتقيان معاً في الفيلم. في الواقع، هذا كان مجازاً للإنقسامات التي أصبحت جلية في الحرب الأهلية، وبالمثل، الإنقسامات في الفرد الذي لا يستطيع أن يستوعب أو يضمّ الجزئين من كينونته.
الأب في “الجنوب” هو الرجل المنقسم بين حبّيْن: عاطفته الرومانسية وحياته الدنيوية مع زوجته. إنه عن الرجل الذي يريد دائماً أن يذهب إلى الجنوب لكنه لا ينجح أبداً في الذهاب. القطار دوماً يمرّ عبر المحطة لكنه لا يستقلّ القطار قط. يعود إلى البيت، مثل شخص خفيّ، ويموت. بمعنى ما، هو يترك تفويضاً، لأنه عندما يوشك على الموت، يضع تحت وسادة ابنته رمزاً يدلّ على الصلة الحميمية والمشاركة، الشيء الذي يربطهما معاً. هذا هو الشيء الأخير الذي يفعله في حياته، لذا هو هناك، يعمل كحافز ليحثّ ابنته على القيام بالرحلة التي عجز عن القيام بها.. وهي تفعل الشيء الذي لم يستطع أن يفعله قط.

من فيلم “الجنوب” (1983)
في الجزء المكتوب والذي لم نستطع أن نصوره، هذه الفتاة تصل إلى الجنوب في الأندلس، حيث وُلد أبوها، وفيها عاش طفولته. بالتالي هذا الجزء يكمل قصة موت الأب. بهذه الطريقة، هي كانت قادرة على جعل نفسها تقبل صورة أبيها. هذه كانت الفكرة الأصلية للفيلم. الفيلم، كما هو الآن، لا يزال تحت وطأة الألم، وبالطبع فإن زيارة الجنوب كانت انعتاقاً، وصار بإمكانها أن تكبر وتبلغ سن الرشد. لا أستطيع القول بأن الفيلم كان يمكن أن يكون سعيداً، لكن كان يمكن أن يحتوي طاقة وحيوية جديدة لأن، في كل قصة، يكون فهم تاريخ أحد الوالدين مهماً للغاية بالنسبة لكل كائن بشري.
– أردت أن أسألك عن الميلودراما القصيرة “الزهرة في الظل”، في فيلم “الجنوب”، والذي يماثل استخدامك مشاهد فيلم فرانكنشتاين في “روح خلية النحل”. كان ذلك ممتعاً. تبدو لي أشبه بميلودراما مكسيكية. لكنك نفّذتها بنفسك. أتساءل هل هي محاولة منك لصنع عمل على غرار أفلام فون شتيرنبرغ Von Sternberg؟
* هو مقطع صغير. صورته بنفسي، واستمتعت كثيراً وأنا أنفّذه. ثمة تأثيرات معيّنة لشتيرنبرغ،في الإضاءة. كنت من أشد المعجبين بشتيرنبرغ، خصوصاً أفلامه الصامتة التي حققها في العشرينيات من القرن الماضي. أعتقد أنه من أبرع من استخدم الزخرفة في تاريخ السينما.
– لابد وأنك استمتعت أيضاً وانت تحقّق “شمس شجرة السفرجل”، والذي يحتوي على لحظات مضحكة جداً، لكنه مختلف أيضاً. نقول لمن لم تتسنّ له مشاهدة الفيلم، والذي سيعرض هنا قريباً، إنه عمل وثائقي عن الفنان التشكيلي الأسباني أنتونيو لوبيز، الذي قضى زمناً طويلاً وهو يرسم لوحة جميلة جداً لشجرة السفرجل في حديقته. هو استغرق وقتاً طويلاً جداً في الرسم، ولأنه باحث عن الكمال، لم يتمكن من إنهاء لوحته، فالزمن كان يتدخّل، بطريقته الخاصة، في ما يطرأ على الشجرة من تغيّرات وتحولات. الفيلم إذن بقدر ما هو عبارة عن بورتريه للفنان لوبيز، ربما هو أيضاً بورتريه للسينمائي إيريثه، المعروف عنه عنايته الشديدة بالتفاصيل.
* لقد اكتسبت هذه السمعة، ولا أريد أن أخيّب ظنك. لكنني أقل بحثاً عن الكمال من الرسام لوبيز. حققت هذا الفيلم في ثمانية أسابيع. ربما ثمة مظهر من السيرة الذاتية يكمن في واقع أن كلينا اختبر الحياة بطريقة مماثلة وهواجس مماثلة. لو فكرت في الأمر لوجدت أنها الثيمات الأعظم للفن الباروكي الأسباني: مرور الزمن، الأحلام، الإنحطاط، وأيضاً ثيمة الطفولة. هذه ثيمات تنتسب إلى هناك. كذلك نحن الاثنان لدينا جذور في الريف.
– هو فيلم خاص جداً لأنه وثائقي. لكن الرسام كان واعياً تماماً لحقيقة أنك موجود هناك طوال الوقت، فيما نحن نراقبه. إنه ليس مثل الأعمال الوثائقية الأخرى التي تنفّذ بكثير من الإرتجال. أتخيّل أنك أحياناً كنت تسأله عما يمكن فعله اليوم، ومن أي زاوية يريد أن تصوره..
* في الواقع لم نكن نتبادل الحديث كثيراً. لابد وأنك تعلم أن الرسام عادةً يعمل في عزلة، بعكس صانع الفيلم. استغلال الزمن، بالنسبة للرسام، هو أيضاً مختلف تماماً عن استغلال صانع الفيلم. في الرسم، هو يستغل الزمن بشكل فردي، لذلك هو يمتلك حصانة ويقدر أن يفلت من أية عاقبة، بينما في حالة صانع الفيلم، العملية هي صناعية. هو محاط بالآخرين، لذلك لا يمتلك امتياز الزمن الفردي. زمن صانع الفيلم جماعي، ويقدّر بالمال. كنت مدركاً أن حضورنا – الكاميرات وأجهزة الصوت وغيرها – سوف يعدّل إلى حدٍ ما الطريقة التي بها يعمل الرسام، وكذلك علاقته الخاصة بالشجرة التي يرسمها. مع إنني حاولت قدر الإمكان أن أحترم هذه العلاقة بين الرسام والشجرة – التي هي غامضة جداً، وقد حاولت أن أعبّر عنها في نهاية الفيلم – إلا إنني شعرت بأن الطاقم الفني، المؤلّف من ستة أشخاص، لابد وأن يتدخلوا بطريقة ما. لهذا السبب عرضت الكاميرا السينمائية في النهاية، لكي أظهر أداة العمل التي أستخدمها. بل إنني لمّحت إلى أن إضاءتنا الإصطناعية هي التي أفسدت الثمرة المتدلية من الشجرة.

من فيلم “روح خلية النحل” (1973)
أشعر أن لغة الرسم تنتسب إلى فجر زمننا وحضارتنا، وبطريقة مماثلة، السينما تنتسب إلى الغروب. إجمالاً، السينما لها صورة فتيّة. لكن، في الحقيقة، أظن أنه العكس تماماً. ذات مرة تحدثت مع الرسام أنتونيو لوبيز، وسألته “ألا ترى كيف أن السينما سرعان ما أصبحت هرمة، وفي سرعة فائقة؟ مثل الطفل الذي صار شيخاً قبل الأوان.. مع إن عمر السينما مائة عام فقط، خلالها غطّت مساحة شاسعة لم تستطع الفنون الأخرى أن تحرزها إلا بعد قرون طويلة”. عندئذ ردّ عليّ أنتونيو، وسوف لن أنسى أبداً ردّه، إذ قال: “آه، لكن كما ترى، لحظة ولادة السينما، كان الإنسان شيخاً طاعناً في السن”.
أسئلة الجمهور:
– أعتقد حان الوقت لنعطي الحضور مجالاً لطرح أسئلتهم..
سؤال: ما هو وضع فيلمك “روح خلية النحل” اليوم في الذاكرة الجمعية لأسبانيا؟
* ربما يتعيّن على النقاد والمؤرخين الإجابة على هذا السؤال. غالباً ما يُشار إلى هذا الفيلم بوصفه فيلماً يعبّر عن مشاعر جيل ما بعد الحرب الأهلية، بطريقة انطباعية أكثر مما هي واقعية.
سؤال: هنا نحن لا نشاهد الكثير من الأفلام الأسبانية الجديدة. في رأيك، هل السينما في أسبانيا هي في حالة صحية؟
* السينما في أسبانيا لم تنجح قط في أن تكون صناعة مناسبة. كانت دائماً تحمل مظهراً حرفياً، وبالطبع لا يمكن اعتبار هذا نقيصة أو عيباً. من جانب آخر، ليس هذا وقتاً طيباً لنوعية معينة من الأفلام في أي قطر في العالم، حتى في أوروبا. إننا نعلم أن السينما الأوروبية تواجه خطر الإنطفاء. الخطر يكمن في أن أوروبا ككل لا تدرك أن السينما المحلية أو الوطنية لها أهميتها، وهذا ينطبق على دول العالم أجمع. السوق الحرّة، بشهيتها الشرهة، تستطيع على الأرجح أن تجعل النتاج يصبح مجرد سلعة واحدة، بدلاً من أن يحمل أوجهاً عديدة. 90 في المئة من الأفلام تُرى بوصفها سلعة وليست فناً.
– أردت أن أسألك عن هذا إنطلاقاً من واقع إختلاف فيلمك “شمس شجرة السفرجل”، إلى حد ما، عن أفلامك الأخرى، فأنت هنا منتج فيلمك وعملت بحرية مع طاقم فنيّ محدود العدد. هذا يذكّرني بعباس كيارستمي الذي اكتشف متعة العمل بكاميرات رقمية (ديجيتال)، والتخلص من شعوره بالقلق بشأن الطاقم الفني، فضلاً عن إمكانية تحقيق الأفلام بميزانية بسيطة. هل فكرت في استخدام الكاميرا الرقمية؟
* التكنولوجيا الجديدة تبشّر بديمقراطية جديدة، أو بمعنى ما، جعل الطريقة التي بها تُصنع الأفلام ديمقراطية. ثمة إمكانية متاحة لنا لصنع أفلام بميزانية ضئيلة. بالطبع تظل المشكلة الرئيسية في التوزيع. بإمكانك أن تحقق فيلماً، لكن إن لم يشاهده أحد، فعندئذ لا وجود للفيلم. ومن يسيطر على التوزيع ويتحكم فيه هو الولايات المتحدة، إلى حد أن في إمكانها أن تمنع عرض الأفلام الأسبانية في أسبانيا. هناك نسبة من الأفلام المصنوعة التي لا تحصل على توزيع. لذلك من الأساسي تنظيم الأشياء بحيث تحصل الأفلام على توزيع متماثل وليس هامشياً.
لا أزال أؤمن بأن هناك جمهوراً لهذا النوع من الأفلام.. والمثال هو فيلمي “شمس شجرة السفرجل” الذي، على الرغم من نوعه، حاز على الكثير من النجاح وشوهد في العديد من أقطار العالم. يتعيّن على الحكومات والمنظمات أن تحترم الأقليات، وتسمح لها بالبقاء على قيد الحياة.
إذا أردت أن تخلق نوعاً من التقليد أو من الخاصيات الوطنية في البلاد، فيتعيّن عليك أن تحقق هذه الأفلام. في إيران هم نجحوا في فعل ذلك. لقد استطاعوا أن يخلقوا تقليداً سينمائياً خاصاً بهم. والذي سيكون ذا قيمة عظيمة لجميع أجيال المستقبل.
سؤال: في فيلمك “روح خلية النحل”، الرسومات التي نراها في افتتاحية الفيلم، مع نزول أسماء العاملين، هي من أعمال فتيات صغيرات.. هل قمت بتوجيههن لرسم ما تريد، أم أنها كانت مرسومة سلفاً وأنت قمت باختيارها؟
* لقد طلبت منهن رسم ذلك. اقترحت عليهن الموضوع وهن نفّذن ما أريد بتشجيع مني.
سؤال: ما الذي كنت تفعله في الفترات الفاصلة بين فيلم وآخر، والتي تمتد إلى عشر سنوات؟ هل كنت تكتب سيناريوهات، أم تمارس أشياء أخرى مثل البحث عن مموّلين؟
* قد أكون بطيئاً لكن ليس بتلك الدرجة من البطء. كنت أعمل على مشاريع مختلفة عديدة. عندما أتمكن أخيراً من تحقيق فيلم فإن ذلك يكون عادةً نتيجة لكل تلك المشاريع السينمائية التي لم أتمكن من تحقيقها، والتي ربما تخلق خاصية استحواذية تقريباً مع الفيلم الذي تمكنت من تحقيقه. لقد حاولت أن أحافظ على اتصال طبيعي أكثر مع عملية صنع الفيلم لأن، مع هذه العملية، كل فيلم يصبح حدثاً استثنائياً. كنت دائماً أميل إلى فكرة أن أكون حرفياً يذهب كل يوم إلى ورشته ويقوم بعمل ما، لهذا السبب أشعر بالغيرة من الرسامين الذين لديهم هذا الوقت لفعل ذلك.
على سبيل المثال، إنهمكت في مشروع لثلاث سنوات متواصلة بتكليف من أحد المنتجين. كان يتعيّن عليّ أن أعمل وفقاً لتكليف ما. لا أستطيع القول بأنني أعمل حسب ما أشاء وأحب. عندما طلبوا مني أن أحوّل رواية إلى الشاشة، وافقت. ورحت أعمل لثلاث سنوات، لكن للأسف لم يتحقق المشروع. غير إني سعيد لتمكنني من نشر السيناريو الفعلي. بمعنى آخر، كنت على نحو متواصل أحاول أن أشتغل على شيء ما والذي لا يتحقق.
سؤال: ما اسم هذا المشروع وماذا كان مصيره؟
* هو سيناريو كتبته بعنوان “وعد شنغهاي” Promise of Shanghai، وطبعته في كتاب، لكنني لم أشاهد الفيلم الذي حققه المخرج فرناندو تروبا في العام 2002.
سؤال: كيف تعمل مع مؤلف الموسيقى؟
* في “روح خلية النحل” عملت مع لويس دي بابلو الذي هو موسيقار عظيم، وواحد من أعظم الموسيقيين في أوروبا. وفي الجنوب” لم أتمكن من العمل مؤلف موسيقيّ بسبب ضيق الوقت، لذلك اخترت مقاطع من موسيقى رافيل وآخرين. في “شمس شجرة السفرجل” عملت مع موسيقار آخر، وفي فيلمي القصير “خط الحياة”استخدمت تهويدة مشهورة.
أنا دائماً أشعر أن الموسيقى هي جزء من التسجيل الصوتي. مع إنها مهمة جداً، إلا أنني أحاول أن أدمجها في عالم الصوت كله المسجل على الفيلم من دون أن أعطي الموسيقى أهمية أكبر من أي صوت آخر. إني أحاول أن أركّبها أو أنقّيها، أن أستخدمها فقط عندما تكون ضرورية حقاً، ولا أستخدمها لمجرد توكيد شيء موجود سلفاً. الموسيقى التي أحبها فعلاً هي تلك الأصوات المنتَجة عن طريق مونتاج كل الصور.
إن إيقاع الصور له موسيقاه الخاصة، وهذا بحد ذاته أصعب بكثير من مجرد وضع الموسيقى على الفيلم. وبالطبع فإن عملية المونتاج لها علاقة وثيقة بذلك الإيقاع. إجمالاً، أشعر أن الأفلام المعاصرة تسئ توظيف الموسيقى، إذ غالباً ما تكون الصور ميّتة فعلياً ويحاولون إعادة الحياة إلى الجثة باستخدام الموسيقى.
سؤال: ما هو شعورك وأنت تعود إلى الأفلام القصيرة في هذه المرحلة من مسيرتك الفنية، مع أن المخرجين لا يفعلون ذلك إلا نادراً؟
* في الواقع، متطلبات وشروط الفيلم القصير هي نفسها كما مع الفيلم الطويل. في أسبانيا يتم إنتاج مئة فيلم قصير سنوياً، وهي مدعومة مالياً بحيث يتسنى للشباب إنتهاز هذه الفرصة لإظهار قدراتهم. لكن للأسف، غالباً ما يكشف الكثيرون عن افتقارهم إلى معرفة السينما. لذلك ربما من الأفضل لهم أن يلتحقوا بالمعهد.
بالطبع، المشكلة مع الأفلام القصيرة تكمن في التوزيع. لكن في ما يتصل بصنع الفيلم، سواء أكان طويلاً أم قصيراً، فإن المتطلبات والشروط هي نفسها. كما في الأدب، لكل من القصة القصيرة والرواية شروطها الخاصة.. بورخيس في حياته لم يكتب غير القصة القصيرة، مع ذلك هو كاتب عظيم.
سؤال: هل مارست يوماً تدريس السينما وكيفية صنع الفيلم، وكيف كانت التجربة؟
* نعم، مارست التدريس، لكن لمدة ستة شهور فقط. بإمكانك أن تعلّم الآخرين الأمور التقنية وأشياء من هذا القبيل بسهولة، خصوصاً في الوقت الحاضر حيث اعتاد الشباب على التكنولوجيا. لكن الأمر الصعب هو أن تتعلم كيف ترى. أعتقد أن من المستحيل تقريباً تعليم الآخر كيف يرى.
سؤال: أشعر أن “الشعرية” جزء رئيسي من أفلامك. هل يمكنك أن تقول شيئاً عن ما تعنيه “السينما الشعرية” بالنسبة لك؟
* الشعر والسينما كانا دوماً متلازمين في الأفلام الطليعية. ما يثير الإهتمام حقاً أن الشعراء، وليس الروائيين، هم أول من أبدوا اعجابهم وتقديرهم للفيلم. بالإمكان إيجاد العديد من القصائد التي أشارت إلى سينمائيين، مثل بستر كيتون وشارلي شابلن، وتحديداً عند السورياليين. في مرحلة الأفلام الصامتة خصوصاً كان هناك اتصال وثيق بين الشعر والفيلم، ذلك لأن الفيلم الصامت يتضمن شكلاً من الشعر أنقى مما نجده الآن في عملية تحقيق الفيلم. في العام 1960 قدّم بيير باولو بازوليني بحثاً شيقاً عن هذا الموضوع، وتحدث بوضوح عن “الفيلم النثري” و”الفيلم الشعري”.
في نظري، “الشعري” في السينما يتصل بصيغة المتكلم. في الشعر نحن نعي وجود المؤلف. في النثر، الراوي يكون في الخلفية، غير مرئي. ولأسباب تجارية، النثر السردي مماثل للسردي في الفيلم.. يسهل قراءته ويسهل فهمه. ربما في صناعة السينما لدينا الكثير من السرد لكن لا ريب أن الشباب، الذين يحققون الأفلام اليوم، يرغبون في التعامل مع الشعري. هذا ما يصبون إليه، وعليكم أن تتحلوا بالإيمان.
مدير اللقاء: عند هذا الموضع نختتم لقاءنا. وأود أن أعلمكم أن هناك كتاباً يضم مقالات عن أفلام فيكتور، نشرته دار سكيركرو Scarecrow Pressبعنوان “نافذة مفتوحة: سينما فيكتور إيريثه”، حرّرته ليندا إهرليش (2000). إنه كتاب جيد، جدير بالقراءة. ويمكنكم مشاهدة أفلامه هنا خلال هذا الشهر.
في هذه الأمسية تطرقنا إلى الموسيقى، الشعر، السرد. وقد تحدث فيكتور عن شيء مهم جداً في أفلامه هو الإيقاع. سوف نختتم اللقاء بمشاهدة جزء من فيلمه “شمس شجرة السفرجل”، لكن قبل ذلك، رجاء وجهوا الشكر إلى فيكتور إيريثه.