المرأة في سينما رأفت الميهي

شهاب بديوي*
تعدُّ أفلام رأفت الميهي واحدة من أبرز علامات السينما المصرية التي تناولت قضايا المرأة في سياقات اجتماعية وثقافية بالغة الأهمية. في أعماله، تظهر المرأة بشكل غير تقليدي، بعيدًا عن الصور النمطية السائدة في السينما المصرية في فترات مختلفة. لا يُمكن فهم الرؤية المتميزة للمخرج رأفت الميهي للمرأة إلا من خلال تفكيك الشخصيات النسائية في أفلامه، التي غالبًا ما تكون تجسيدًا للمجتمع المصري في مرحلة معينة من التحولات الاجتماعية والثقافية.
إذا كان هناك شيء مميز في أفلام رأفت الميهي، فهو أن شخصية المرأة لا تكون مجرد إضافة لخطوط الدراما الأساسية، بل هي في قلب الأحداث التي تفتح المجال للتساؤلات حول الوضع الاجتماعي والديني والسياسي في المجتمع المصري. يمكننا أن نرى في أعماله كيف يتعامل مع قضايا المرأة بشكل نقدي وفكري، ويبحث عن الأصوات المهمشة والمغيبة في الخطاب السائد. ما يميز شخصية المرأة في أفلامه هو أنها لا تقدم كـ “ضحية” أو كـ”تضحية”، بل كـ “شخصية قادرة على التأثير والتغيير”، حتى وإن كان ذلك ضمن سياقات معقدة وصعبة.
خلل عميق في بنية المجتمع، حيث تُعامل المرأة كفرد ناقص الحقوق، وتُحصر في أدوار محددة مسبقًا، بينما يُمنح الرجل امتيازات بمجرد انتمائه لجنسه، لا لمؤهلاته أو جهوده.
من بين أفلامه التي تناول فيها قضايا المرأة بجرأة فنية وفكرية فيلمه الشهير “السادة الرجال” (1987)، وهو عمل سبق عصره، وجاء في توقيت بالغ الحساسية، حيث كان الفكر المحافظ والتقاليد الاجتماعية المتزمتة تفرض سطوتها على المجتمع المصري، بالتزامن مع صعود التيارات الإسلامية، وتأثير موجات الهجرة إلى الخليج. جاءت تلك التغيرات لتعيد تشكيل العلاقة بين الرجل والمرأة على أسس أكثر صلابة، وتكاد تكون رجعية في بعض الأحيان، حتى كادت أن تطمس صوت المرأة وتكبل حريتها.
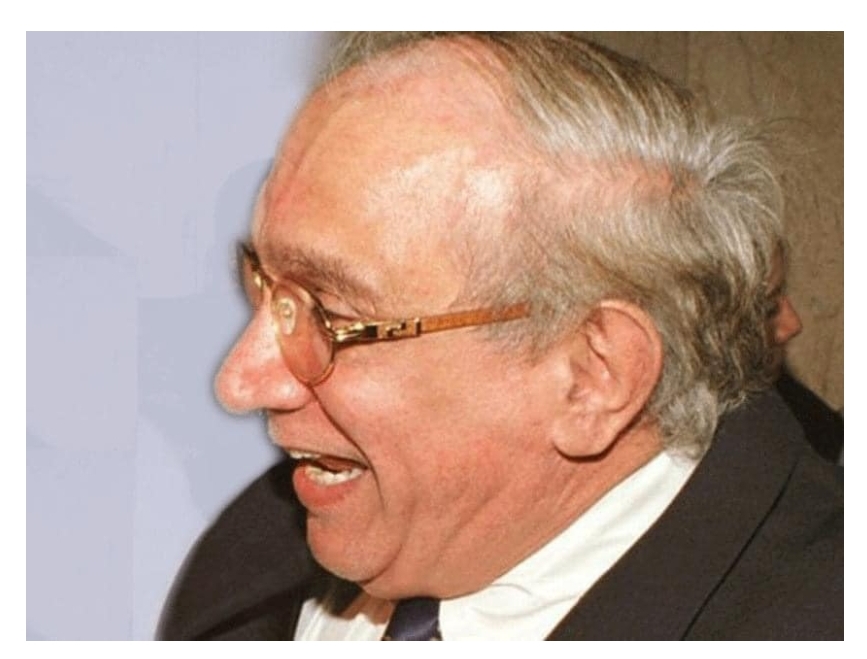
في هذا المناخ، اختار رأفت الميهي أن يصوغ فيلمًا فنتازيًا، ساخرًا، وجريئًا في طرحه: “السادة الرجال”، حيث تتلخص حبكته في قرار بطلة الفيلم، فوزية (معالي زايد)، الموظفة المتفانية في عملها، والمظلومة في بيتها، والمقموعة في مجتمعها، أن تتحول إلى رجل! ليس كتحول نفسي أو رمزي، بل تحول بيولوجي كامل، يخضع لعملية جراحية تغير جنسها.
يبدأ الفيلم برصد الضغوط اليومية التي تتعرض لها فوزية. فهي زوجة وأم وموظفة، تؤدي كل ما عليها من أدوار، لكنها لا تحصد شيئًا من التقدير. زوجها ينظر إلى عملها بازدراء، ولا يشاركها أعباء المنزل. في عملها بالبنك تُقصى عن الترقية لصالح زميل أقل كفاءة فقط لأنه رجل. تتعرض للمضايقات، والتحرش، ويُنظر إليها على أنها عبء إداري بسبب إجازات الوضع والرضاعة. حتى أمها ترى أن زوجها “راجل ومش غلطان”.
عند هذه النقطة، يقرر الميهي أن يأخذنا إلى عوالم الفانتازيا والعبث. تذهب فوزية إلى طبيب وتطلب منه أن يجري لها عملية تحول جنسي. المثير في معالجة الميهي أنه لا يكتفي بطرح الفكرة كفنتازيا ساخرة، بل يُظهر المجتمع وقد تعامل مع الفكرة ببراغماتية مدهشة: رئيس القسم في المستشفى يرفض أولًا، ثم يوافق بعد أن يُمنّى بالشهرة. حتى الأم، حين تعلم بتحول ابنتها إلى رجل، تفرح، لأن “الولد سند!”.
ويحصل “فوزي” بعد العملية على كل ما حُرمت منه فوزية: الترقية، الاحترام، المساواة، والسلطة. يعود زوجها من السفر فيجد أن زوجته أصبحت رجلًا، وتبدأ مفارقات عبثية ممتعة، لكنها في جوهرها تكشف عن أزمة بنيوية في العلاقة بين الرجل والمرأة، وفي تعريف المجتمع لكل منهما.
يضع الميهي نصب عينيه تفكيك التصورات التقليدية عن الذكورة والأنوثة. هل الرجولة صفة بيولوجية؟ أم اجتماعية؟ هل هي مسؤولية؟ أم سلطة؟ فوزية التي أصبحت فوزي لم تتغير داخليًا: تغار، وتحزن، وتحب، وتشتاق لطفلها، وتحمل في قلبها مشاعر الأمومة ذاتها. لكن المجتمع يغيّر معاملته لها فقط لأنها أصبحت تحمل ملامح رجولية! هنا تبرز عبقرية الطرح: المشكلة ليست في المرأة، بل في نظرة المجتمع إلى النوع.
وفي لحظة فارقة، يقع “فوزي” في حب صديقته السابقة “سميرة” (هالة فؤاد). تتطور العلاقة إلى زواج، وتبدأ فوزية في معايشة تناقضات داخلية شديدة، بين أنوثتها المدفونة، ودورها الاجتماعي الجديد كرجل. ويصبح المشهد الذي يجمعها بـ”سميرة” داخل السيارة، لحظة مكثفة من التوتر النفسي والرمزي، حيث تشتبك مشاعر الحب، مع الهوية الجنسية، ومع الإدراك بأن التحول لم يلغِ شيئًا من الحقيقة.

ذروة المأساة تظهر حين يمرض الطفل الصغير. الطبيب يخبرهم بأنه لا يحتاج إلى دواء، بل إلى أم. هذه الجملة التي يُسدل بها الميهي ستار الفيلم تحمل في طياتها نقدًا بالغ العمق: في معركة الصراع بين الرجل والمرأة، وفي محاولات كل طرف أن يستغني عن الآخر، يضيع الطفل. تضيع الأسرة. يختفي الحنان.
هنا، يحوّل الميهي الفيلم من مناقشة لقضية النوع، إلى تحليل للمأساة الإنسانية الكبرى: تفكك الأسرة، ونسيان الطفل في خضم الصراع على الهوية والحقوق. ويصل الذكاء الدرامي ذروته حين يذهب الزوج إلى المستشفى، طالبًا أن يتحول إلى أم! إنها لحظة عبثية عظيمة، تذكرنا بمسرحيات بيكيت ويوجين يونسكو، حيث تغدو الحياة غير قابلة للفهم إلا بالسخرية السوداء.
في “السادة الرجال”، لا يسخر الميهي من المرأة، ولا من الرجل، بل من التصورات الزائفة عنهما، من الصور النمطية التي صنعها المجتمع، ومن المحاولات اليائسة لتجاوزها بطرق سطحية. فالحل ليس في أن تتحول المرأة إلى رجل، ولا أن يتحول الرجل إلى أم، بل في أن نعيد بناء العلاقة على أسس إنسانية، متساوية، وعادلة.
يشكل حضور المرأة في أفلام رأفت الميهي أحد أبرز محاور مشروعه السينمائي. لم يتعامل الميهي مع قضايا المرأة باعتبارها ملفات حقوقية معزولة، بل دمجها داخل نسيج المجتمع المختل، في بنية تتشابك فيها الأدوار وتتنازعها الهويات، حيث لا يمكن فهم وضع المرأة دون فهم المنظومة الأكبر التي تسحق الطرفين: الرجل والمرأة على السواء. وبهذا المنظور، تصبح المرأة عند الميهي ليست فقط ضحية بل أحيانًا شريكة في صياغة واقعها، أو صدى لانهيار ذكوريّ أكبر.

يتجلى هذا الطرح بوضوح في فيلمه “سيداتى آنساتى”، وهو امتداد مباشر لخط كان قد بدأه بفيلم “السادة الرجال”، حيث قدّم قصة امرأة تتحول إلى رجل كي تنال حقوقها داخل مجتمع ذكوري، ليأخذنا في الفيلم الجديد إلى قلب اللعبة بالعكس: رجل يجد نفسه في قبضة أربع نساء قررن الزواج به طوعًا، ليس من باب العشق، بل بدافع اقتصادي واضح. وبينما كانت المرأة في الفيلم السابق تبحث عن العدالة، يصبح الرجل في هذا الفيلم مجرد أداة بحث نسوية عن الخلاص في ظل مجتمع مأزوم اقتصاديًا.
الدكتور محمود عبد البديع، بطل الفيلم، ليس تجسيدًا للهيمنة الذكورية المعتادة، بل هو صورة ساخرة لرجل فقد مكانته الاجتماعية، واضطر إلى قبول عرض غير تقليدي من أربع نساء ليتزوجهن مجتمعات. ومع أن الفكرة تبدو عبثية، فإن الميهي يصوغها بحنكة تجعلها ممكنة في سياق عالمه السينمائي الذي يمتزج فيه الكوميدي بالواقعي. تعيش النسوة مع محمود في بيت واحد، يتبادلن أدوار الزوجية، فيمنحنه المأوى، والطعام، والحياة الجنسية، وحتى الترقية في العمل، وكأننا بصدد إعادة إنتاج نموذج “هارون الرشيد” مقلوبًا.
لكن، وكما هو معتاد عند الميهي، لا تلبث الأمور أن تنقلب. يفقد محمود وظيفته، وتقرر الزوجات الأربع– وفقا لمنطق العدالة الاقتصادية– أن يتفرغ للعمل المنزلي بوصفه الأقل دخلًا. هنا تتبدى مهارة الميهي في كشف هشاشة الأدوار الاجتماعية، إذ لا يتردد في أن يجعل من البطل الذكوري حاملًا.. في مفارقة تجمع العبث بالسخرية، يكتشف محمود أنه يعاني من حمل نفسي سببه تحمله أعباء النساء اليومية، وفقدان سلطته الاجتماعية، والمادية، وحتى الجسدية.

هذه المفارقة ليست مجرد نكتة درامية، بل تعبير حاد عن انكسار التصورات السائدة للرجولة. لم يعد الرجل عند الميهي ذلك الكائن المتحكم، بل ضحية جديدة في سلسلة القهر، تمامًا كالنساء، ليطرح بذلك سؤالًا جوهريًا: هل الصراع بين الجنسين هو صراع بين طرف قوي وآخر ضعيف، أم هو صراع بين من يحاول التكيّف مع واقع فاسد وبين هذا الواقع نفسه؟
اختيار الميهي للبطلات لم يكن عشوائيًا، فكل منهن تمثل شريحة مهنية معينة: المحامية، والطبيبة، والمهندسة، والمحاسبة، وكل واحدة تحمل ملامح الاستقلال والنجاح النسوي، ولكن هذا النجاح يصطدم بجدار الواقع الاقتصادي الذي يمنعهن من الزواج إلا عبر حلول غير تقليدية، كأن يتقاسمن رجلًا واحدًا. وهنا ينقلب سلاح التعدد، الذي طالما كان وسيلة الرجل للهيمنة، إلى وسيلة نسوية للسيطرة الجماعية.
ورغم أن النساء لم يخترن محمود منذ البداية، إلا أن مجرد علمهن بكونه “دكتور” –ولو كان يعمل ساعيًا– دفعهن لاختياره. تلك المفارقة التي أجاد الميهي رسمها تفضح هوس المجتمع بالمكانة لا بالكفاءة، وبالألقاب لا بالمعنى. المفارقة الأعظم أن محمود لا يريد الاعتراف بأنه دكتور، لأنه يخشى أن يخسر امتيازاته المالية، في حين أن مجرد اللقب هو ما منحه الاعتراف في أعين الآخرين، لا علمه ولا شخصه.
تتفاقم السخرية حين نعلم أن ترقيته في العمل جاءت بسبب زواجه من أربع نساء، وكأن النجاح الجنسي أصبح معيارًا للكفاءة المهنية! وهو نقد لاذع يوجهه الميهي نحو مؤسسة العمل، والزواج، والمجتمع بأسره، الذي تحكمه المصالح لا القيم، والظواهر لا الجواهر.
لكن الفيلم لا يكتفي بالعبث، بل يرسّخ فكرة جوهرية حول فشل العلاقات القائمة على المصلحة. لا ينجح زواج محمود لأنه لم يكن مبنيًا على الحب، بل على المنفعة المتبادلة، وبالتالي تهاوى سريعًا. أما علاقته بالمرأة العجوز، “ماما تريزا”، التي تنشأ بعيدًا عن التوقعات الاجتماعية، فتثمر عن “مولود”، في إشارة رمزية إلى أن العلاقات التي يُكتب لها الازدهار هي تلك التي تنبع من الحنان والمشاركة، لا من الصفقات.
يكرر الميهي في هذا الفيلم ما فعله في “السادة الرجال”، حين تساءل افتراضيًا: ماذا لو عاش الرجل في عالم المرأة؟ وهو سؤال لا يهدف فقط إلى قلب الأدوار، بل إلى اختبار جدية خطاب المساواة نفسه. عبر هذه التقنية، يفضح هشاشة المسلّمات الاجتماعية، ويعرض الواقع من زاوية مقلوبة تسخر من كل شيء: الزواج، الذكورة، الإنجاب، السلطة.
وكما هو معتاد في أفلام الميهي، لا نهاية وردية تنتظرنا. فالخاتمة تنبئ بانهيار الجميع: الرجل الذي فقد ذاته بالكامل، والنساء اللواتي خسرن المعنى في خضم التنازلات. ومع أن الفيلم لا يقدم حلاً مباشرًا، إلا أن جوهره يحمل الإجابة: لا يمكن لأي علاقة أن تنجح على حساب طرف دون الآخر. لا الرجل إذا تنازل تمامًا، ولا المرأة إذا خضعت كليًا. وحده الحب، والمشاركة، والاعتراف المتبادل، ما يصنع أسرة حقيقية.
* كاتب من مصر










