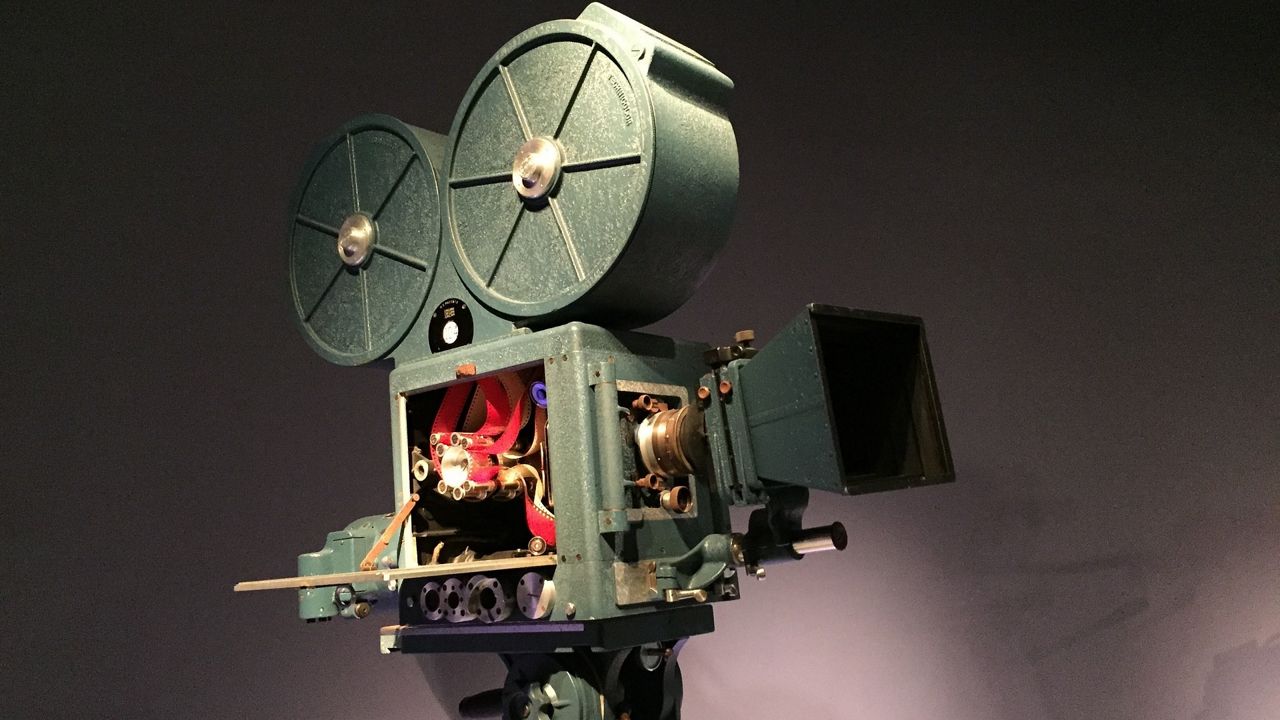عن الأفلام المرشحة لـ”أوسكار” أفضل فيلم 2021

مقاديرٌ مُكثّفة مِن الأداءِ العالي وخيباتِ الأمل
امرأةٌ تجوبُ الوطنَ بسيّارةِ “فان” وحزنٍ طافح، عازفُ درمز يفقدُ سمعَه، أبٌ كوريّ يرفضُ الاستمرارَ في فحصِ الأعضاء التناسليّة للصيصان فيُسافر بعائلته إلى المجهول، رحلةٌ نحو هوليوود الأربعينيات لاكتشافِ خلفيةِ الفيلمِ الأعظمِ، زيارةٌ لعقلِ رجلٍ عنيدٍ وخَرِف، امرأةٌ تصطاد من أرادَ الصيْدَ، خيانةُ الجلدِ لنفسِه، وأخيرًا قصّة السبعة الذين أُريدَ لهم أن يُشنقوا مع التحية والاعتذار للروائيّ الروسيّ ليونيد أندرييف.
هكذا جاءت الأفلامُ الثمانيةُ التي وصلتْ إلى قائمةِ الترشيحاتِ النهائيّة لجوائزِ الـ”الأوسكار” عن فئةِ أفضل فيلم لعام 2021.
إنّه موسم ممتلئ بالأفلامِ التي يسيلُ منها الإحباطُ، وخيبة الأمل، وحشدٍ من الممثلين البريطانيين!
لقد تمَ تأجيلَ الحفلِ بسببِ تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19)، وهذه هي المرّة الخامسة التي يُصادف فيها حفل الـ”أوسكار” شهر رمضان في الشرق الأوسط، كانت المرّة الأولى في الدورة الثلاثين من المهرجان عام 1958، وآخرها كان في الدورة الـ64 من عام 1992 التي وافقت ليلة الـ27 من رمضان، مما يجعل الفوزَ آنذاك وكأنّه عطيةً من “ليلةِ القدر” فعلًا!
مرّت أفلام هذا العام بهدوءٍ ملحوظٍ في الصحافةِ العربيّةِ ووسائلِ التواصلِ الاجتماعيّ، فلم يواجه أي فيلمٍ حملةَ مديحٍ أو هوجةَ تقريعٍ مثلما حدث مع أفلام العام الماضي: “الجوكر”، و”الإيرلندي”، و”باراسايت”، وحتى “نساء صغيرات”.
في القائمة ثمانية أفلام، مقابل تسعة في العام الماضي، وباستثناء الأمريكييْن ديفيد فِنشِر وأرُن سوركِن، فإنّ كل المُخرجين تحت الخمسين عامًا، ومنهم اثنتين تحت الأربعين وهما كلوِي جاو وإِمِيرَلد فِنِل، بالإضافة إلى وجودِ ثلاثة مُخرجين من أصل آسيويّ/ أفريقيّ وهم شاكا كِنغ، وكلوي جاو، ولِي إساك تشُنغ.
يُعد “شابّة واعدة” و”مانك” و”يهوذا والمسيحُ الأسود” أفضل ثلاثة أفلام في القائمة، يليهم فيلم “صوت الميتال”، بينما يقع فيلم “ميناري” في آخرها، يسبقه بدرجة فيلم “مُحاكمة 7 من شيكاغو”. وتوزّعت باقي الأفلام من الجيّد للأكثرِ جودة، وبجانبِ أنّها مجموعة أخرى من الأفلام التي دخلت التاريخ بوصولها إلى النهائياتِ، فهي حصيلةُ العامِ السينمائيّ الأكثر خسارة، وفوضويّة، وغرابة: عامُ الجائحةِ.
“نومادلاند”

هنا ساعة وخمسون دقيقةً من الانقباضِ، يحكي الفيلمُ قصة المواطنة فِرن وهي أرملةٌ تتنقّل في أرجاءِ البلادِ بسيارتها الـ (فان) وقد حولتها إلى مسكنٍ شديد البدائيّة، فيه تأكل، وتشرب، وتقضي حاجتها، وتتذكّر حياتها السابقة، مات زوجُ فِرن قُبيل خسرانِها لوظيفتِها في مصنعٍ الجبسِ في إمباير، نيفادا، حيث كان يعملُ زوجُها أيضًا، وقد اُغلق المصنع، وهجر السكانُ المنطقة، حدّ توقف استخدام الرمز البريدي الخاص بها، وخلال رحلتها تكتشف فِرن الكثير من معاني الحياة، والبهجة المُتخمة التي تحملها تجربة الوقوف بين المئات من طيور السنونو المُحلّقة وقشور البيضِ الصغيرة تتهادى فوق صفحة الماء!
يندرجُ هذا الفيلم، المأخوذ من كتاب للصحافيّة الأمريكيّة جِسِكا برودر، ضمن ما يُسمّى بـ”أفلام الطريق” حيث يبتعدُ الإنسانُ عن مكانِه ليرى نفسه عن قُرب أكثر.
قامت بدورِ البطولةِ المُمثلة الأمريكيّة فرانسِس مِكدورمَند وهي واحدة من الممثلات الـ14 اللاتي فزن بـ”الأوسكار” مرّتين و/ أو أكثر مثل إنغرد بيرغمَن، وجاين فوندا.
وقد حصلت مِكدورمَند على آخر “أوسكار” عن دورِها في الفيلمِ البديعِ “ثلاث لوحات دعائيّة خارج إِبِنغ، ميزوري” للمُخرج مارتِن مِكدونا.
“نومادلاند” من إخراجِ الصينيّة الأمريكيّة كلوِي جاو، وقد التهم الفيلمُ العديد من الجوائز الرفيعة منها “الأسد الذهبي” من مهرجانِ البندقيّة، وأربع جوائز من الـ”بافتا” وهي أفضل إخراج، وأفضل فيلم، وأفضل مُمثلة، وأفضل تصوير سينمائي.
جدير بالذكر أنّ جاو قد استعانت ببدوٍ حقيقيين في الفيلم، وقد شكرتهم، بعد ذلك، على استقبالهم واحتفائهم.
أجمل ما في “نومادلاند”، بجانب أداء مِكدورمند والموسيقى الساحرة للإيطاليّ لودوفيكو إيناودي، المشهد الذي جمع بينها والرحّالة بُب ويلز الذي قال بأنّه لم يودّع في حياته شخصًا وداعًا نهائيًا لأنّه متأكد أنه سيُقابله مرة أخرى وإن بعد سنوات، وقد تم اقتباسَ سطرٍ من ذلك الحوار على شكلِ إهداء في آخر الفيلم، فكان الختامُ مسكًا رغم عاديّة ما سبقه.
إنّ “نومادلاند” فيلم جميلٌ بلا شك، وقد راقت نكهته الآسيويّة/الشرقيّة للأمريكيين كثيرًا، اللقطات الصامتة الطويلة نقلت لنا أحاسيس فِرن كاملة، واهتياج المشاعر قد فاض من الشاشة، لكنّ هناك تقدير مبالغ فيه للفيلم، كعادة الكثير من الأفلام التي تصل إلى الـ”أوسكار” من قبل زمن “الصوابيّة السياسيّة” بما لا يُقاس، ولو أنّ الاعتقادَ بفوزِه كبيرٌ جدًا.
“يهوذا والمسيحُ الأسود”

إنّه واحد من أفضلِ ثلاثةِ أفلام في قائمة الـ”أوسكار” لهذا العام، قِصّة أمريكيّة سوداء مشتعلة بالهجاء، واللعنات، والـ”أدرينالين”.
يحكي الفيلم عنِ اغتيالِ الناشط الاشتراكيّ الثوريّ فرِد هامبتُن رئيس حزب “الفهود السود” فرع إلينوي، إذ قامت المخابرات الفيدراليّة بتجنيد المراهق وليام (بِل) أونيل ليندسّ بين الأعضاء، وقد وافق أونيل على ذلك بعد أن ضُبط في حادثة سرقة سيارة، وكان العفو عنه مشترطًا بالموافقة على العمل كجاسوس للبيض.
يُعبّر المُخرج شاكا كِنغ عن وجهة نظره بوضوحٍ حول خيانة أونيل بدءًا من صياغةِ الاسم، إذ يستحضرُ كِنغ إحدى أشهر خيانات التاريخ البشريّ، فيهوذا الإسخريوطي، حسب المرويات المسيحيّة، قد وشى بيسوع لدى اليهود فتمكنّوا من قتلِه، وأخبرهم بأنّ رجلهم المطلوب هو من سيقوم بتقبيله دونًا عن الآخرين، وقد ألهمت هذه “القبلة” الكثير من الرسامين لتخليدها، أبرزها لوحة الإيطاليّ جوتّو دي بوندوني.
يلعبُ الدوريْن الأساسيْن هنا البريطانيّ دانيال كالُويا والأمريكيّ لَكيت ستانفيلد، الأوّل قُدمت له الشهرة على طبقٍ من الماس عندما لعب دور البطولةِ في فيلم المُخرج جوردَن بيل “غِت آوت” حين امتلأت الشاشةُ بتعبيراتِه وعينيه الواسعتيْن تملؤهما المخاوف.
والثاني لعب دورًا ثانويًا في “غِت آوت” أيضًا لكن موهبته العاليّة قد ظهرت في هذا الفيلم بوضوحٍ، واستطاع وجهُه أن ينطق بكل ما يدور في عقلِه المُنهك وضميره الممتلئ بالثقوب.
كعادة الأفلام التي تتحدث عن قِصص الخيانة، فإنّ اللقطات المُقرّبة متوزعة على الفيلم بأكمله، وقد أمتعنا أبطالُ الفيلم، من السودِ والبيضِ، بأدائهم الممتاز، وكعادةِ الأفلام التي تحكي قصصًا حقيقيةً أيضًا يُطالعنا في النهايةِ يهوذا الحقيقي في المقابلة الوحيدة التي أجراها مع التلفزيون، ونعرف أيضًا ما آلت إليه حياته القصيرة.
في الفيلم أكثر من مشهدٍ يُسبّب القشعريرة، أبرزها خطبة فرِد هامبتُن بحضور موظف الإف بي آي الذي قام بدورِه جيسي بليمنز، يليه اللقاء الموتّر بين الرجليْن الأسوديْن في الحانة ثم في الشارع، حيث تهبط نفسية بِل إلى أقصى القاع.
“يهوذا والمسيح الأسود” فيلم مؤثّر، ومُلهم، وعاطفيّ، وإن فاز بالـ”أوسكار” فهو فوز مستحق للغاية.
3. “ميناري”

يطلُّ هنا شرق آسيا مرة أخرى، عائلة كوريّة تنتقل من كاليفورنيا إلى أركانسس نزولًا عند رغبةِ الأب جاكوب (ستيفِن يُن) الذي يُريد أنْ يؤسّس مشروعَه الخاص، هذا الانتقال يُسبب توتّرًا بينه وزوجته التي تفتقدُ أيّامها السابقة ولا تجدُ ضيرًا في أن يكملا حياتهما في كشف مؤخراتِ الكتاكيت، ويقدحُ ذلك التوتّر عيبٌ خُلُقي في قلبِ الابن الأصغر ديفيد (ألان إس. كِم)، ولا أكثر ضيقًا من أسرة يعاني أحد أطفالها مرضًا في القلب.
ضجرُ الزوجةِ ينتقلُ إلى المشاهدين، ولكنّ رابطًا ما يدفعك لإكمال المشاهدة، أو، في أسوأ الأحوال، فضولًا لمعرفة معنى كلمة ميناري، وبعد وصول الجدّة (والدة الأم مونيكا) نعرف أنّ ميناري نبات كوريّ ذو خصائص متعددة، منها، حسب الجدّة، قدرته على النمو في أي ظرفٍ، وأنّه في متناول الجميع، وقد يصلحُ كإضافةٍ مع الحساء، أو دواءً عند المرض، إنّه نباتٌ قويّ، ومفيد، ولذيذ في نفس الوقت.
قامت بدور الجدّة الممثلة الكوريّة القديرة يون يوه-جونغ، التي خففت بروحها الفريدة عنِ الأسرة المتعثّرة، وفي نهايةِ الفيلمِ ينتظرُ الجميعُ مفاجأةً ثقيلةً وغير سارّة، لكن الأسرة تستطيع أن تنهض كأي “ميناري” يعرف طريقه في الحياة، وهنا تشعُ فكرة الفيلم الذي يحتفي بالروح الكوريّة التي لا تُقهر، ويُمكن القولُ أيضًا أنّه يشتبكُ مع “الحلم الأمريكيّ” حول ارتيادِ المجهول، واجتراح المعجزات.
“ميناري” مثل أي فيلم كوريّ، إذا أخفقَ في كُلّ شيء فسوف ينقذه الأداء التمثيليّ، وقد شاهدنا هنا تشخيصًا عاليًا مِن كُل الممثلين، وعلى رأسهم الكوريّة هان يي-ري التي لعبت دور الزوجة مونيكا، والأمريكيّ وِل باتون، بجانبِ يون يوه-جونغ بالطبع.
هذه السنةُ الثانيةُ على التوالي التي يصلُ فيها فيلم كوريّ إلى القائمةِ النهائية لجوائز الـ”أوسكار” عن فئةِ أفضل فيلم بعد “باراسايت”، لكن بمقارنة بسيطة بين الفيلمين من ناحية الفكرة، أو الإخراج، أو الحبكة، فإن “باراسايت” يتفوّق دون جهد.
إنّه فيلم التبس عليه الأمرُ فيما يخصّ الشعرة التي بين الرصانةِ والإملال.
“ميناري” كتابة وإخراج لي إساك تشُنغ.
“مانك”

إنّه واحد من أهم أفلام عام الوباء، ديفيد فِنشر يتبنّى صراحةً وجهة النظر التي تنصّ على أنّ هيرمَن جِاي. مانكويتس (مانك) هو الكاتب الفعليّ لفيلم “المواطن كاين” الذي يعتبره كثيرٌ من النّقاد حول العالم بأنّه الفيلم الأعظم في تاريخ السينما.
مانك الذي كان مدمنًا ومقامرًا كبيرًا فوّت على نفسه التحصّلَ على حقوقِه الأدبيّة لعدد كبير من الأفلام، فقد كان من طينةِ الكُتّاب الذين تُلهم حياتهم مُخرجي الأفلام الوثائقية حسب وصف الكاتبة الأمريكيّة إليزابيث غِلبرت في أحد مقالاتها التي ترجمتها شوق البرجس.
يُطلعنا الفيلمُ الذي ظهر بالأبيض والأسود، مثل “المواطن كاين” نفسه، على كواليس كتابة مانك لسيناريو الفيلم، إذ يُجهَّز له، وقد تعرّض حينها لحادثِ سيرٍ، بيتًا مُنعزلًا، ومساعدتيْن، وصندوقًا من الكحولِ الخفيفةِ، حتى ينتهي من كتابة السيناريو في تسعين يومًا تقلّصت إلى ستين يومًا فقط.
لا يقف فِنشر على لحظات كتابة سيناريو “المواطن كاين” فقط، وليس بوسعه أن يقوم بذلك أصلًا، إذ أنّ كل لقاءٍ في حياةِ مانك، وكل جدلٍ، وكل أمسيةٍ، وكل قرارٍ سياسيّ، وكل لحظةِ تأمّل، أو إخفاق، أو اشتهاء، قد شحنت مانك بأفكاره التي سكبها على الورق لتصير “المواطن كاين”: الفيلمَ الخالدَ.
إنّ “الحقيقة” التي ينتصر لها فِنشر ويوصلنا بها، تشبهُ كثيرًا اكتشاف المشاهدين ماهيّة “روزبَد” التي نطق بها كاين قبيل وفاته، وكانت اللغز الذي حرّك الفيلم.
يمنحنا فِنشر، بسخاءٍ شديدٍ، عدسة مُكبّرة لتفحّص المزاج السياسيّ والاقتصاديّ في أمريكا آنذاك، وعلاقات مانك برجال الصحافة، والسياسة، والسينما منذ الثلاثينيات، وكل الحروب الخفيّة التي تُدار في استديوهات هوليوود، إنّه فيلم عن الزمن الجميل بكلَّ قباحاته وسذاجاته، حيث كان البعض يعتقدُ أنّ هتلر رجلٌ طائشٌ لا يجب أخذه بجديّة، ولم يكن العالم يعرفُ بعد معنى أن يبدأَ النّازيون بناءَ مُعسكراتِ الاعتقال!
إنّ أفلام الحنين إلى هوليوود “زمان” من النقاط التي تُحسب لصالح الفيلم في تصفيات الـ”أوسكار”، وقد وصل العام الماضي المُخرج كوِنتِن تارَنتينو بفيلمه “حدث ذات مرّة في هوليوود” إلى النهائيات فعلًا لكنّه لم يحصل على الجائزة، وإن قارنّا بين الفيلميْن فسيفوز “مانك” بعشرةِ أهدافٍ نظيفةٍ.
“مانك” فيلم مُبهر، ومُحفّز، ومُمتع، وقد قدّم البريطانيّ غاري أولدمَن أداءً لا يُجارى مُمسكًا بروحِ الشخصيّةِ فلم يفلتْ منه نَفَسًا، ويُذكر هنا أنّه حين نال أوسكاره الأوّل قال مُخاطبًا والدته بأنْ تضع إبريق الشاي على النار فهو قادم لها بالجائزةِ، فهل يطلب ديفيد فِنشر من والدته شيئًا مماثلًا هذا العام؟ هذا إذا افترضنا أنّ السيدة كلير ما زالت على قيدِ الحياة!
“صوت الميتال”

في هذا الفيلم بطلٌ آخرٌ كان يعيشُ في سيّارة “فان” لكنّها تختلف عن “فان” فِرن في “نومادلاند”.
يبدأُ الفيلمُ بضجةٍ عنيفةٍ من إحدى حفلات الـ”هيفي ميتال” والبطلُ في مكانِه الذي يُحبّه بكل ما يملك وعشيقته أمامه تُغني في انسجامٍ غير محدود، ثم ينتهي ونفس البطل يقفُ في صمتٍ رهيب وكأنّ حفرةً ما ابتلعت كُلّ الأصوات في العالم.
“صوت الميتال” عن عازف الدرمز روبِن (البريطاني من أصل باكستاني ريز أحمد) الذي يفقدُ سمعه بالتدريج جرّاء تعرضه لضوضاء عالية لفتراتٍ طويلةٍ، ونشاهده، لحظة إثر أخرى، يفقدُ شغفَه، وحبيبتَه، ووظيفتَه دفعةً واحدةً، ومن هنا نتتبّع مسيرتَه في استعادةِ ما مضى، واستماتته في إرجاعِ حياتِه التي لا يعرف غيرها، حتى يصلَ في النهاية إلى المآل المنطقي الذي ينتهي إليه أيّ إنسانٍ في ظروفِه.
“صوت الميتال” كتابة وإخراج ديريوس مادر، فيلمٌ يتشارك مع غيره من الأفلام بحصّته الخاصّة من الكآبة والخذلانِ، وقد أتاح لنا مادر أن “نرى” العالم “بآذان” روبِن الصمّاء، وأن نعيش محاولاته العديدة للهرب من هذا الفقدانِ الذي لا يُعوّض.
من أجمل عطايا الفيلم اكتشاف بول رايسي الذي قام بدور جو مُرشد مركز الصُمّ، وقد ظل مغمورًا حتى بلغ الثانية والسبعين، وها هو اليوم يترشّح لجائزة الـ”الأوسكار” لأفضل مُمثّل مُساعد.
قال ديريوس مادر بأنّه تواصل مع عدّة نجومٍ للعب دور جو، ولكنّه اختار المغمورَ بول رايسي لاعتقادِه بأنّه الأجدر للعب هذا الدور كونه ابنًا لوالدين أصمّين.
ونصائح جو/ بول رايسي هي التي صدقت، إذ يقول لروبِن في أحدِ المشاهد أنّ لحظات السكونِ التي طلبَ منه سابقًا أن يتدرّب عليها، هي المكان الذي لن يهجرَه أبدًا، وبالفعل، ينتهي الأمرُ بروبِن في حديقة عامّة، يُراقب أثر طائرة بعيدةٍ جدًا، هذه الطائرةُ تصدرُ صوتًا يخترقُ الطبلاتِ، ورغم ذلك لا يسمع منها الناسُ سوى عزيفًا مُتلاشيًا، وأحيانًا لا يُسمع شيءٌ، وهكذا كان روبِن تمامًا.
“صوت الميتال” فيلمٌ يهبطُ على المشاهدين بقوة، ويقسو على أبطالِه دون تردّد، فهو لا يُقدّم فكرتَه على طريقةِ “التنمية البشريّة” التي تصرّ بأنّ بداخل كل إنسان مارد يحقق المستحيلاتِ، ولا يروّجُ للآمالِ الفارغة التي تسيلُ من هكذا قصص، وإن كان لا بدّ من استخلاص درسٍ من روبِن وفجيعتِه، فيُمكن القول بأنّ الاستسلامَ مهمٌ لاستمرارِ الحياةِ كما الأمل بالضبط.
6. “مُحاكمة 7 من شيكاغو”

إنّ العالمَ يُحبُّ أن يشاهدَ الولايات المتحدة وهي توبّخ نفسها، خاصةً إن تم ذلك في محكمةٍ رسميّة، وفي هذا الفيلم يضربُ الكاتب أرُن سوركِن عصفورين بحجرٍ: دراما المحاكم المحجوز جمهورها على الدوام، واستعادة الأحداث السياسيّة سيئة السمعة.
لقد كتب أرُن سوركِن هذا الفيلم بنية أن يُخرجه ستيفن سبلبرغ لكن أسبابًا مهنية واقتصاديّة حالت دون ذلك فأخرج سوركِن الفيلمَ بنفسه.
يحكي الفيلم عن محاكمةِ سبعة شباب، وثامنهم بوبي سيل عضو حزب “الفهود السود”، بتهمة التآمر والتحريض على إثارة الشغب، حين خرجوا في مُظاهراتٍ ضدّ حرب فيتنام أثناءَ انعقادِ المؤتمرِ الوطنيّ للحزب الديمقراطيّ في شيكاغو عام 1968.
وتضم القائمة السُباعية كُلًا من: توم هايدِن ورايني ديفز، وديفيد دِلِنجر، وآبي هوفمَن وجيري روبِن بالإضافة إلى لي وينِر، وجون فروِنز.
إنّها، إذن، فترة الستينيات بكل ما فيها من تغييراتٍ جارفة في السينما، والسياسة، والحريّات.
لا يأتي الفيلم في لحظة فارقة من تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية فحسب، بل صادف عرضه قرب حلول الذكرى العاشرة لقيام الثورات الشبابية في العالم العربيّ ضد الأنظمة الحاكمة في تونس، ومصر، واليمن، وسوريا، وليبيا.
لقد أعادت مشاهدُ توحّش الشرطة ضد المحتجّين العزّل من السلاح، حقائق اختبرها المشاركون في هذه الثورات، إنّها محاكمة باطلة إذن، وقصة ظُلمٌ خالصٌ، ومشاهدٌ كل ما فيها يدعو لعدم الارتياح، أبرزها مشهد بوبي سيل (يحيى عبد المتين الثاني) في المحكمة.
أكثر أداء لافت للنظر يفوز به الممثل ساشا بارُن كوهِن في دورِ آبي هوفمَن، مما قد يُسبّب دهشة للبعض نظرًا لنوعيةِ مُعظم أدواره السابقةِ.
لعب دورَ مُحامي الدفاعِ عن الشبابِ السبعةِ الممثلُ البريطانيّ مارك رِيلانس الذي شارك في فيلم سبلبرغ “جسر الجواسيس” بعبارتِه الشهيرة: ” وهل يُجدي ذلك؟”.
إنّ الأفلام “الجادّة” التي تستعرض قضايا واقعيّةً جسيمةً، وتُعرّي السياسيّ مقابل الفنان قد يخشى البعض أن ينتقدها، إذ يخلط الكثيرون بين قيمةِ الفيلمِ الفنيّة وبين القضيّة التي يحملها خاصةً إن تم تقديمها في وقتٍ مواتٍ مثلما حدث مع هذا الفيلم، لكن في الحقيقةِ إنّ “محاكمة 7 من شيكاغو” يحمل عددًا من العيوب رغم وجود نجميْن أوسكارييْن على الأقل، وأهمّ هذه العيوب أنّه يعطي إحساسًا بأنّه لا يتحرّك، إنّ الوقت يمرُّ على الشريطِ السينمائيّ لكنّ التصاعد الدراميّ لا يتزحزح شبرًا، إنّه ثاني أفلام أرُن سوركِن الروائيّة الطويلة كمُخرج، ورُبما يُفسّر ذلك القصور الذي شابه، رغم أفلامه الناجحة الكثيرة التي قدّمها سابقًا ككاتب نصوص سينمائيّة.
إنّ فيلمَ “مُحاكمة 7 من شيكاغو” فيلم جاد، جاد فقط، ولا شيء غير ذلك.
“الأب”

أشهر أدوار أنثُني هوبنكنز على الإطلاق كان هانيبال ليكتِر في فيلم “صمت الحملان” وهو أحد الأفلام الثلاثة التي حصلت على الخمسة الجوائز الأوسكاريّة الرئيسية، وفيه تحاول المتحريّة كلارِس ستارلنغ (جودي فوستر) الغوصَ في عقلِ القاتلِ الأكثر وحشيةً كي تحصل على إجابة لغز الجريمة التي تعملُ عليها، وبعد قرابة ثلاثين عامًا، هنا عقل آخر جدير بالتفحّص يلعب دوره الممثل أنثُني هوبكنز مرة أخرى.
فيلم “الأب” من كتابة وإخراج الفرنسيّ فلوريَن زِلِر مقتبسًا من مسرحية كتبها زِلِر نفسه، ولذلك يبدأ الفيلم بدخول الابنة آن للبيت وهي تفتحُ بابَ الشّقةِ اللندنيّةِ الفارهةِ، وكأنّه ستارة مسرحٍ تُرفع عن الجمهورِ المتشوّق.
“الأب” فيلمٌ مشحون، يسيرُ بارتباكٍ مُنضبط، ويضغطُ العاطفةَ في أكثر المواضعِ حساسيةً، مع أداءٍ بديع لجميع الممثلين وعلى رأسِهم أنثُني هوبكنز وأوليفيا كولمَن في دور الأبِ وابنته.
يدورُ الفيلمُ في مكانٍ واحدٍ تقريبًا باستثناء المشهد الأخير، ونعيش فيه توترًا بالغًا في محاولة فهمِ ما يحدث للعجوز أنثُني المُصاب بالخرف في أيّامه التي أصبح عيشها من الصباح للمساء تحديًا بالغ الصعوبة، فمن نقاش مُحتقن مع ابنته التي تريد المغادرة إلى فرنسا، إلى حديثٍ ساخن مع زوج الابنة، ومن تساؤل عن مكانِ اللوحة المفقودة، إلى ضرب مُهينٍ ينزلُ به الرجل الغامض على الأبِ الذي لا حيلة له سوى إصراره بأنّه بخير، ومن مشهدٍ لآخر تنسكبُ دموعَ المشاهدين دون حساب حتى بعد انتهاءِ الفيلم.
يتشابه فيلمُ “الأب” مع فيلمِ “أفكر في إنهاء الأمور” لتشارلي كوفمَن حيث أننا نقبع داخل عقلٍ رجلِ متقدّمٍ في العمرِ أيضًا، مع الفارق الكبير في التكنيك، ومستويات السرد، والهدف من القِصّة.
في “الأب” ننتبهُ أنّ أنثُني هوبكنز قد وصل إلى العمرِ الذي لا يحتاج فيه إلى ماكياج ليبدو رجلًا خرِفًا، وقد ظهر في الفيلمِ باسمه وعمره الحقيقيْن، حيث يقول للطبيبة بأنّه مولود في يوم الجمعة 31 ديسمبر/كانون أوّل 1937، وهو تاريخ ولادة أنثُني هوبكنز الحقيقيّ، لكن أنثوني الأب ليس هو النّجم البريطانيّ الذي ما زال قادرًا على التمثيل، وعلى المُنافسة على “أوسكار” أفضل ممثل.
في الفيلم مشاهد قليلة للممثلة البريطانيّة الموهوبة إِمِجِن بووتس، التي ظهرت بنفس قصّة شعرها التي رأيناها بها قبل 12 عامًا في فيلم “تشققات” للمُخرجة البريطانيّة جوردَن إسكَت؛ أحد أجمل الأفلام على الإطلاق.
في فيلم “الأب” كل العيوب حجبها الأداء العالي، والموسيقى الفاخرة للإيطاليّ لودوفيكو إيناودي، والقصّة النبيلة، والحُب الكبير لهوبكنز في قلوبِ مُعجبيه حول العالم.
“شابّة واعدة”
كاسندرا في الأساطيرِ الإغريقيّة هي ابنة الملك برايم والملكة هِكِبا، وقد أحبّها الإله أبولو ومنحها قدرات على التنبؤ، ثم حلّت عليها لعنته عندما غضب فسحب منها المنحة ولم يعُد يُصدّقها أحد.
في فيلم “شابّة واعدة” للمُخرجة إِمِيرَلد فِنِل يوجدُ كاسندرا من نوعٍ آخر، وتكذيب يوميّ ينمو في الظلام.
البريطانيّة كيري موليغَن تلعب شخصية كاسندرا (كاسي) توماس، وهي امرأة شقراء تعيش حياتيْن مُتنافرتين، في الصباح موظفة في مقهى وفي الليل “صيّادة” من نوعٍ مُختلف، إذ تخرجُ إلى المراقص كل ليلة لتتظاهر بأنّها ثملة، ولا تخيب خطّتها على الإطلاق، ففي كل مرة يوجد رجلٌ ما يستدرجها ليمارس معها علاقة جنسيّة، وقُبيل الاندماج الكُلّي تفاجئه بأصعب سؤال قد يواجهه رجلٌ في هذا الظرف المشين: ما الذي تفعله؟

لقد كانت كاسي ذات يوم امرأة “طبيعيّة” وواعدة فعلًا، حتى تم اغتصاب صديقتها نينا فِشِر من زميلٍ لها وهي ثملة في إحدى الحفلاتِ، فقرّرت كاسي الانتقام، إذ لم يُصدّقهما أحد، وقد كانت عواقب عدم التصديق وخيمة جدًا.
من السهلِ تخمين أنّ فكرةَ “شابّة واعدة” قد نبتت بعد حركةِ “أنا أيضًا”، بخصوص التحرّش الجنسيّ الذي يطال النساء، لكنّ فِنِل استطاعت باحترافيّةٍ ملحوظةٍ تلافي كُلّ الأخطاء التي وقعت فيها الأفلامِ الأمريكيّة والأوروبيّة التي حاولت أنْ تركبَ الموجة: صدقًا أو رياءً!
ولأنّ “شابّة واعدة” نتيجةً مباشرة أو غير مباشرة لذلك، فسوف يُظلم في تقديره للغايةِ، وسيعدّه كثيرٌ من النقّاد “الجادّين” بأنّه مجرد فرقعة أخرى، ومداهنةٌ مكشوفةٌ للجنةِ التحكيم.
الرجالُ في “شابّة واعدة” ليسوا فقراء، ولا جهلة، ولا مدمنين، بل من أسرٍ عريقةٍ، وعلى قدرٍ من الوسامة، وحظٍ وافرٍ من التعليم، وقد كانوا جميعًا طلبة في كلية الطب.
“شابّة واعدة” أفضل فيلم في قائمة الـ”أوسكار” لهذا العام، ليس فقط لتماسك السيناريو، والرتم المشوّق، وجدّة الفكرة وطزاجتها، بل لأنّ مُخرجته استطاعت أن توازن بين العناصر الفنيّة والجوهر الخاص بقضية صعبة، ومحدّدة، ومُهملة وهي المواقعة الجنسيّة لأنثى تحت تأثير المخدرات أو الكحول، لقد نجت إِمِيرَلد فِنِل بفيلمِها من التكرارِ، والوعظِ، والتلقينِ، واستدرجت المشاهد للفخ، كما الرجال اللطفاء في الفيلمِ، كي يُفكّر بنفسِه لنفسِه عن هذه القضية، ويصدر حكمه الخاص المتوقّع من عقلِ كل ذي عقل.
“شابّة واعدة” فيلمٌ ذكي، وخبيث، ومُمتع، ومُتلاعب.
وأستعيرُ هنا من فيلم “مانك” ما قاله لوِس بي. مِير بأنّ الفيلمَ النّاجح هو ما يحرّك المشاعرَ التي تكمن هنا، وهنا، وهنا، وأشار إلى عقلِه، وقلبِه، وإلى مكانٍ ثالثٍ يُمكن تخمينه بسهولةٍ، وقد استطاع “شابّة واعدة” تحقيق ذلك بحصافةٍ، واحترافيّة، وخفّة ظلّ.