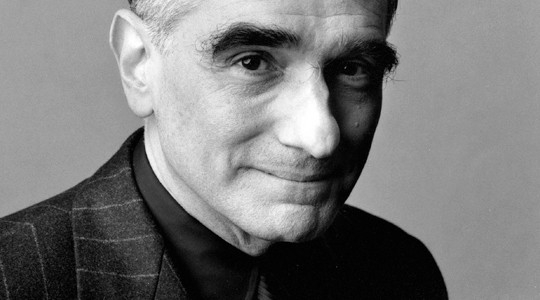الشعرية والتفاعلية والتشكيلية في ثلاثية سميح قبلان أوغلو
 من فيلم "لين"
من فيلم "لين"
يعد المخرج التركي سميح قبلان أوغلو أحد الأسماء البارزة في سينما الألفية الجديدة، فهو واحد من صناع أفلام قلائل برزوا خلال القرن الحادي والعشرين من القادرين على مفاجئة محبي فن الشاشة الفضية بسينما تحمل طابعا فريدا. سينما قد تتفق أو تختلف معها، لكن لا يمكنك إلا أن تشهد لها بالجدّة والجدية، فهي سينما “جديدة” لم تستهلكها الصناعة وهي سينما “جادة” تحترم متلقيها وتطالبه مقابل ذلك أن يحترمها وألا يتعامل معها باعتبارها فن يهدف فقط للإمتاع.
ويبرز هذا الطابع المميز لسينما قبلان أوغلو في ثلاثيته التي قدمها خلال الأعوام الخمسة الأخيرة “بيض” و”لبن” و”عسل”. الأفلام الثلاثة تحمل أسماء عناصر شكلت حياة بطل السلسلة يوسف، وأكاد أجزم بمساهمتها في تشكيل حياة المؤلف والمخرج نفسه، فهي عناصر الطفولة الأولية لأي طفل ريفي ولد في بلدة منعزلة في الجبال التركية، يتعامل مع وجودها باعتبارها من تفاصيل الحياة اليومية العادية، حتى يكبر فيكتشف إنها تمثل أكثر من ذلك.
شعرية السرد وصعوبته
سينما قبلان أوغلو سينما شعرية خالصة تعتمد على اللقطات الواسعة والطويلة التي تدفع المشاهد دفعا للتأمل، تعتمد على بداية الفيلم بمشهد ممتد يعرض حادثا غير مفهوم ندرك أبعاده لاحقا في سياق الفيلم، ولكن ذلك المشهد ـ على غموضه ـ يتمكن من اللحظة الأولى من إحكام قبضته على انتباه المشاهد المناسب الذي سيبذل قدر الجهد الكافي للتعاطي مع ما سيلي من دراما. الفكرة هنا هي أن الفيلم يفرز مُشاهده تلقائيا منذ اللقطات الأولى، ربما ليقين المخرج بإنه يقدم نوعا من الفن يصعب افتراض تفاعل جميع طوائف الجمهور معه.
الصعوبة تبدأ من اختيار سرد الأجزاء بشكل معكوس، فالجزء الأول “بيض” يعرض قصة يوسف البالغ الشاعر وبائع الكتب القديمة الذي يعيش في المدينة وتجبره وفاة أمه على العودة لجذوره الريفية، بينما يتناول الجزء الثاني “لبن” يوسف الشاب الذي تتنازع أحلامه الأدبية مع ارتباطه بأمه، أما الجزء الثالث “لبن” فيعود ليوسف الطفل المتعلق بوالده، وهو بالمناسبة الجزء الذي نال جائزة الدب الذهبي كأحسن فيلم في مهرجان برلين السينمائي. اختيار السرد المعكوس هو أول رهان غير مأمون بالنسبة لأي مشاهد اعتاد السرد التجاري التقليدي، خاصة وإن كل فيلم من الثلاثة وإن كان عملا مكتمل البناء بحد ذاته، فهو يحتوي أيضا على تفصيلات وصراعات داخلية لا تتضح بشكل كامل إلا مع مشاهدة الجزء التالي.
الخيار السابق قد يبدو غريبا على مسامع محبي السرد الهوليوودي المشبع ظاهريا، والذي يقدم للمشاهد كل ما يجب معرفته عن الشخصيات انطلاقا من ضرورة عرض تلك المعلومات لفهم الصراع، ولكنه الخيار الأمثل لعمل يقوم الصراع فيه بالأساس على البحث عن ذلك المجهول، ليس بحثا في الإطار التشويقي ولكن في الإطار الاستكشافي للطبيعة البشرية التي لا تتغير باختلاف البلدان ولا الوجوه. هذا تحديدا هو لب السينما الشعرية.. البحث عن لحظة التنوير الإنسانية التي يكتمل فيها هضمك للقصيدة المرئية.
عن الرموز الثلاثة
تتعامل الأفلام الثلاثة مع مستوى راق من الرمزية.. انس هنا ما تعرفه عمن يقومون بإلباس الشخصيات رداء الأيديولوجيات أو يجعلون الأم القوية تمثل الوطن، فأنت هنا أمام رموز ثلاثة هي الحياة ذاتها، رموز لن يكتمل فهمك لها إلا بنهاية الفيلم الثالث، فلا تملك وقتها إلا احترام صانعها شديد الاختلاف والتفرد.

فالعسل منتج فني بديع ولكنه خطير، منتج يحتاج لذائقة فنية عالية وإدراك فائق للاختلافات الدقيقة بين أنواع الأزهار، يحتاج لحكمة وحنكة ملكها الأب الذي كان مَثَل الطفل يوسف الأعلى. الأب هنا فنان حقيقي يستمتع بعمله كمُربي للنحل وصانع للعسل، يشكل له “خلق” هذا المنتج قضية حياته الأهم التي يريد نقلها لابنه الصغير. تلك القضية التي تظهر خطورتها على الرجل وأسرته الصغيرة عندما يلقي حتفه وحيدا وسط الغابات عندما أراد صعود أحد الأشجار بحثا عن العسل ليتغير مسار حياة الأسرة بالكامل مقابل محاولة لنيل نشوة الإبداع والخلق.
اللبن على النقيض تماما من العسل، فهو منتج مضمون وآمن، تصحو الأم من نومها يوميا وهي على يقين بأنها ستجد ضروع أبقارها ممتلئة باللبن لتبيعه أو تصنع منه الجبن لتضمن بذلك القروش الضئيلة التي تعيش بها مع ابنها الوحيد. اللبن هو حرفة محدودي الطموح وغير المبدعين والخائفين من المستقبل. اللبن هو ما كان يوسف يكرهه في طفولته ويتصنع الطرق للتهرب من شربه وكأنه يخشى أن يصير كوالدته؛ لذلك فقد كان قرار شرب اللبن هو أول قرار اتخذه يوسف الطفل عندما علم بوفاة والده، ولهذا أيضا كانت وصية الأم الوحيدة لابنها الممزق بينها وبين والده بعد وفاتها أن يقوم بذبح أحد الماشية المنتجة لنفس المنتج الأبيض.
العنصر الثالث هو البيض، وهو منتج يختلف في خصائصه عن سابقيه، فهو لا يحتاج للكثير من الإبداع ولا الموهبة كالعسل، لكنه ليس مضمون الوجود كاللبن. فدجاجات يوسف لا تبيض بشكل يومي، ولا يمكن المراهنة على بيع بيضها لسد رمق الأسرة، لكن يظل وجوده كل حين وآخر مصدرا للسعادة. مثلها مثل القصائد التي يكتبها يوسف، تأتي لإسعاده ومنحه القناعة بأنه قادر على الخلق، وهي نفس السعادة التي تمنحها لوالدته المستسلمة التي تفخر بلصق خبر فوز ابنها بجائزة شعرية متواضعة على باب ثلاجتها. ولكن مقابل هذه السعادة المحدودة فهي تمزق من ينتظرها طويلا، فذهاب الطفل الصغير يوميا لأعشاش الدجاج باحثا عن بيض لا يجده لا يختلف كثيرا عن بحث يوسف طوال عمره عن تحقق لم يتحقق إلا عندما قرر في النهاية العودة لجذوره ليجد الطفل البيض أخيرا في العش الدافئ.
تفاعلية النص الدرامي
التفسير السابق لرموز الفيلم هو تفسيري الشخصي الذي قد يتفق كليا أو يختلف كليا مع تفسيرات الآخرين له. فسميح قبلان أوغلو يقدم لنا نصا دراميا يستحيل الجزم بوجود تفسير أو تناول واحد له. وكأن ثلاثية المخرج الذي بزغ نجمه في الألفية الجديدة تحمل في طياتها السمة الأبرز للفن والإعلام في الحقبة ألا وهي التفاعلية. فثلاثية يوسف لا تروي حكايته فقط، بل تروي حكاية كل مشاهد بذل الجهد المناسب للانخراط في الحكاية ومحاولة فهم مآزق أبطالها، وهذا ما قصدته عندما ذكرت إن رحلة الفيلم هي رحلة البحث عن المجهول لحين الوصول للحظة تنوير إنسانية، للحظة تدرك فيها إن الثلاثية تتحدث عنك لا غيرك، وإن يوسف الذي كنت في أول مشاهدة له تراه مجرد شخصية خيالية تعيش في بلاد بعيدة تحكمها عادات وقيم ولغة مختلفة، ما هو إلا صورة مغايرة منك يعاني من نفس هواجسك ونفس أزماتك.

هذا البحث عن نقاط اللقاء بينك وبين يوسف يستمر من بداية الأحداث لنهايتها، تزيكه لحظات الصمت المطولة التي تمنحك فرصة حقيقية للتفكير والمقارنة والهضم، ويمهد الطريق له اختيار وتوجيه مدهشان لجميع ممثلي الثلاثية على مختلف أعمارهم، ويدعمه نضج المخرج الذي اختار أن يبتعد عن مراهقة الصراعات المرتفعة والغرائبية لحساب الدراما الإنسانية التي تخاطب الإنسان أيا كان مكانه في هذا العالم.
سينما بكاميرا تشكيلية
كل ما سبق كان من الممكن أن ينتج عملا متوسط المستوى إذا لم يتم تقديمه بواسطة مخرج يدرك بدقة سمات السينما كفن بصري بالأساس. فما قلته عن اختزال الدراما لصورتها الأدنى باعتباره انجازا سرديا كان من الممكن أن يقال على عمل آخر كعيب في البناء الدرامي. ولا تناقض هنا بين الحكمين لأن المعيار في كل حالة هو اختيار المخرج الذي يمكن الحكم عليه من خلاله.
فإذا كانت غالبية المخرجين يعتقدون في كون الصورة هي مجرد وسيلة لنقل نص مكتوب يعتمد عليه نجاح الفيلم أو فشله فنيا وجماهيريا، فإن هؤلاء يخضعون أنفسهم طواعية لقوانين البناء الدرامي ويجبرون النقاد على تناول أعمالهم باعتبارها حكايات تميزها ميزات الحكي وتضعفها عيوبه. أما القلة المبدعة والتي ينتمي قبلان أوغلو لها بالتأكيد فتأتي بالجديد البصري لتجبر من يتناول العملعلى أن يضع الصورة على رأس قائمة عوامل التقييم، وهو بالمناسبة الهدف الأسمى الذي يجب أن يسعى كل صانع أفلام حقيقي لبلوغه.
وإذا كنا نعيش في منطقة جغرافية لا يزال بعض صناع الصورة فيها يتباهون بأن صورتهم السينمائية ليست مسطحة بل تحتوي على عمق، وتدرس معاهدها أوليات المنظور اللوني فقط لتعلم الناس إن الصورة يجب أن تنقسم إلى مقدمة وخلفية، فأنت أمام مخرج يعلم جيدا إمكانيات الكادر السينمائي الحقيقية، ويتمكن عبر الاستخدام السلس للتكوين ولألاعيب المنظورين الخطي واللوني أن يقسم صورته إلى أربعة ـ وأحيانا خمسة ـ مستويات من العمق.
الأمر لم يقتضي تقنيات مخترعة خصيصا من أجل الفيلم ولا لإمكانيات ضخمة ولا حتى لتوظيف مفرط للإضاءة. كل ما في الأمر هو إن المخرج التركي يعلم جيدا تأثير أشياء كمكان الكاميرا وتوزيع الألوان والخطوط وتقسيم مواضع الحركة والثبات، واستخدم هذه المعرفة مع الكثير من المجهود في رسم مشاهده بعناية، لتكون النتيجة لوحة تشكيلية متحركة تبهرك كل لقطة منها مرة لثراءها ومرات لبساطة عناصرها.
وفي النهاية
المحصلة هي إن سميح قبلان أوغلو تمكن من اجتياز خطوة ضخمة بالسينما التركية التي أفرزت صناعتها الضخمة خلال العقدين الأخيرين عددا من صناع السينما المتميزين بعد عقود طويلة من سيادة الفن التجاري عليها. ولعل التتويج بجائزة الدب الذهبي يعطي مؤشرا على هذا التقدم الذي تشهده بلاد الأناضول سينمائيا تزامنا مع نهضتها الاقتصادية والعلمية، في الوقت الذي تستمر السينما المصرية التي كانت في يوم أكثر نضجا من نظيرتها التركية في التراجع. وحتى عندما تريد وسائل إعلامنا استيراد الفن التركي فإنها تختار التجاري والضعيف من المسلسلات والأفلام بينما تظل الأسماء الأهم والتي تقدم سينما حقيقية مجهولة في المنطقة العربية