إشكاليات وتعقيدات السينما المستقلة في مصر

شهاب بديوي
في مقالٍ سابق، طرحنا عددًا من الأسئلة المتعلقة بصناعة السينما، وأجبنا على بعضها، وها نحن نواصل هذه الرحلة التحليلية في عالم الفن السابع، إذ لا تزال في جعبتنا تساؤلات عديدة، تتطلب الوقوف أمامها بتأنٍّ وتأمل. من أبرز هذه التساؤلات: هل السينما المستقلةـ أو ما يُعرف بـ”أفلام الآرت هاوس”ـ هي فعلًا أكثر تحررًا من السينما التجارية؟ وهل نالت هذا الوصف عن جدارة، أم أنها لم تفرّ إلا من قيود السوق والنجومية والجمهور، لتقع في أسرٍ آخر لا يقل ضيقًا: أجندات المهرجانات ومتطلبات الورش الإنتاجية؟
كما يبرز سؤال آخر لا يقل إلحاحًا: هل عزوف المتفرج عن هذه الأفلام، المسماة “بالمستقلة”، هو تقصير من صانع الفيلم، أم نتيجة لفجوة حقيقية في الذوق والخطاب؟
في السياق التقليدي لإنتاج الأفلام، يُنظر إلى المنتج بوصفه الطرف الساعي إلى الربح أولًا وأخيرًا، دون اكتراث حقيقي بمستوى العمل الفني أو رؤيته الجمالية. هذا المنتج “الاستهلاكي”، إن صح التعبير، يقف على النقيض من “المنتج الفنان” الذي يرى في السينما وسيلة للتعبير الجمالي والفكري، لا مجرد سلعة تسويقية.
وبسبب غياب هذا الأخير، يضطر كثير من صناع الأفلام الجادين إلى الانسحاب من السوق التجاري، والاتجاه نحو السينما المستقلة، هربًا من قيود لا تنتهي تبدأ من المنتج، ولا تنتهي بالرقابة أو شروط النجم ومتطلبات القاعة.
وقد وصف المخرج محمد خان السينما التجارية بـ”السينما المعلبة”، في إشارة إلى نمطها الاستهلاكي الجاهز، الذي يخنق الإبداع ويستنسخ التكرار. لذا، لم يكن غريبًا أن يبحث المخرج الجاد عن ملاذ بديل يُمكّنه من تقديم رؤاه دون مساومة على جوهر أفكاره، ولو كان ذلك عبر مسارات ضيقة ومحدودة الإمكانات مثل الورش والمهرجانات.
١
تجارب تاريخية
إن تأمل تاريخ السينما المصرية يكشف أن هذا الصراع بين “التحرر الفني” و”القيود الإنتاجية” ليس جديدًا. ففي ستينيات القرن الماضي، ظهرت “جماعة السينما الجديدة” كمحاولة واعية لتقديم سينما مغايرة، تؤمن بالتجريب والتعبير عن الذات، بعيدًا عن السوق ومنطقه. هذه الجماعة، التي ضمّت مخرجين ومثقفين درسوا السينما وتفاعلوا مع تياراتها العالمية، قدّمت أعمالًا مثل “أغنية على الممر“ لعلي عبد الخالق و”ظلال على الجانب الآخر” لغالب شعث، في محاولة لصياغة سينما تعبّر عن آمالهم وهواجسهم.

ورغم أن التجربة لم تُكتب لها الاستمرارية، إلا أنها دلت على نزوع صادق نحو خلق مساحة حرة للتعبير الفني. تكررت المحاولة مرة أخرى في الثمانينيات، مع تأسيس “شركة أفلام الصحبة”، التي ضمّت أسماء لامعة مثل بشير الديك، نادية شكري، وعاطف الطيب. ورغم أن نتاجها اقتصر على فيلم واحد هو “الحريف” لمحمد خان، إلا أن قيمتها لا تكمن في الكم، بل في دلالة الإصرار على تقديم فنّ حرّ، حتى وإن غابت الموازنات التجارية.
والمفارقة أن كثيرًا من هذه الأسماء – التي فشلت تجاريًا في البداية – استمرت لاحقًا في تقديم أفلام تعبّر عنها بصدق دون تنازل، مما يدل على أن الإخلاص للمشروع الفني، ولو عبر طرق ملتوية وصعبة، لا يُعدم أثره.
٢
نعود إلى سؤالنا الجوهري: هل السينما المستقلة اليوم حرة بالفعل؟
الواقع أن الحرية الكاملة في الفن وهمٌ مثالي. إذ لا تخلو أي منظومة، مهما بدت منفتحة، من محددات وأطر. والمهرجانات ليست استثناءً؛ فلكل منها ذوقه الخاص، وأجندته الثقافية أو السياسية أو الجمالية، التي تؤثر في اختيار الأعمال. وكثير من الأفلام تُصمَّم خصيصًا لتُرضي هذه التوجهات، لا لتعبّر عن أصحابها بالضرورة.
ورغم ذلك، فإن السينما التي تنتج في هذا الإطار – برغم قيودها – تظل أكثر صدقًا وتحررًا من أفلام السوق التجاري. على الأقل، لا يُفرض على المخرج فيها نجم معين، أو نهاية سعيدة، أو مشهد راقص. لا يُحاكم فيها على نسبة الكوميديا، أو كمية الأكشن، بل يُمنح مساحة نسبية للتعبير، وهذا مكسب كبير في مناخ يضيق بالحرية.
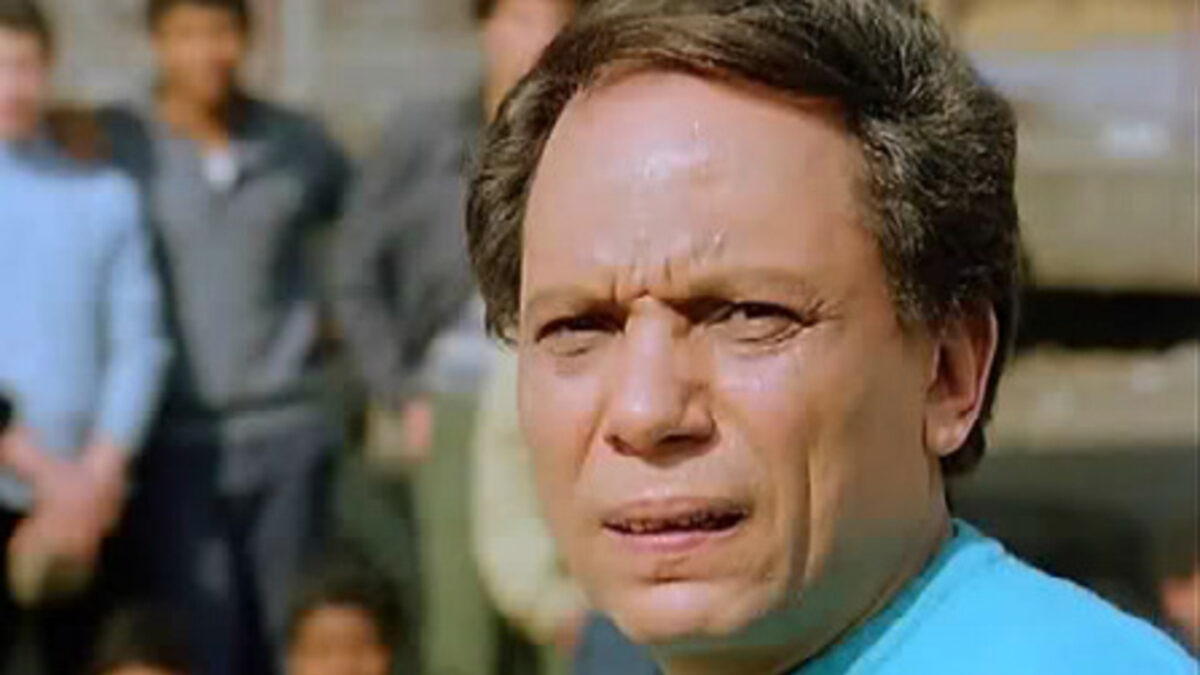
تظل المهرجانات اليوم هي المنفذ الأوسع والأكثر واقعية للمخرجين المستقلين، في ظل غياب المنتج الفنان أو المخرج القادر على تمويل نفسه كما فعل يسري نصر الله في بداياته. فالفيلم المستقل في مصر لا يملك دعمًا مؤسسيًا حقيقيًا، ولا سوقًا فاعلة، ولا حتى جمهورًا واعيًا يحتضنه. وهو ما يعزز أهمية المهرجانات لا كخيار مثالي، بل كأهون الشرّين.
ولذا، فإن الحل الحقيقي يظل في إعادة بعث نموذج المنتج الفنان، القادر على التوفيق بين الرؤية الجمالية والحسابات الإنتاجية، وعلى خلق توازن بين الصدق الفني والنجاح الجماهيري. هذا النموذج، الذي كان نادرًا في الماضي، أصبح اليوم ضرورة مُلحّة، إن أردنا لسينمانا أن تنهض مجددًا وتستعيد ثقتها بنفسها وبجمهورها.
٣
في المشهد السينمائي المصري، كثيرًا ما تُوصف الأفلام المستقلة وأفلام المهرجانات بأنها “نخبوية”، “معقدة”، وربما “مملة”، وهو وصف شائع ومتداول بين جمهور عريض، حتى صار جزءًا من صورة ذهنية نمطية لدى قطاع واسع من المشاهدين. وفي المقابل، نرى أن السينما الغربية – وعلى رأسها الأمريكية – تنجح في تقديم أفلام عالية المستوى الفني والفكري دون أن تتنازل عن جاذبيتها الجماهيرية، بل وتحقق بها أرباحًا ضخمة، كما هو الحال مع فيلم “أوبنهايمر” Oppenheimer لكريستوفر نولان. فما المعضلة إذًا؟ ولماذا يتجدد الصراع في مصر بين “السينما الجادة” و”السينما الجماهيرية”؟ وهل المشكلة في الجمهور، أم في الخطاب السينمائي ذاته؟
أولًا: غياب الصناعة
السينما الأمريكية، بما فيها من أفلام مستقلة أو تجريبية، تنتمي إلى منظومة صناعية راسخة. هناك استوديوهات كبرى، أنظمة توزيع متقدمة، أدوات تسويق فاعلة، وتحليل دائم لاتجاهات الجمهور. حتى الأفلام الفنية تُقدم ضمن خطط إنتاجية محكمة تُراعي الذوق العام دون الإخلال بالبعد الإبداعي. في المقابل، تعتمد السينما المستقلة في مصر غالبًا على مجهودات فردية، بتمويل محدود، وتوزيع شبه معدوم، وتسويق لا يتجاوز صفحات التواصل الاجتماعي. هنا لا توجد “صناعة” بالمعنى الحقيقي، بل هناك “محاولات” تتفاوت في الوعي والاحتراف.
ثانيًا: جماهيرية المخرج
أحد أهم عناصر الجذب الجماهيري في السينما هو النجم، لكن حين يصبح المخرج نفسه نجمًا، تنقلب المعادلة لصالح الفيلم. هذا ما فعله مخرجون كبار في الغرب، مثل نولان أو تارنتينو، حيث بات اسم المخرج يكفي ليجذب الجمهور بصرف النظر عن طاقم التمثيل.
ولعل السينما المصرية شهدت تجارب مشابهة وإن كانت محدودة؛ فالمخرج يوسف شاهين استطاع أن يصنع لنفسه جماهيرية خاصة، وأصبحت أفلامه تُتابع من جمهور مخلص له هو شخصيًا، لا للممثلين الذين يشاركون في أفلامه. وتكرر الأمر بدرجة أقل مع مخرجين مثل داوود عبد السيد، وعمرو سلامة، حيث نجح كل منهم في تكوين نواة جماهيرية تتبع أسلوبه وتنتظر جديده.
وهنا تبرز أهمية أن يصنع المخرج نفسه كعلامة تجارية – لا أن يكون مجرد صانع ظل خلف نجم شباك. الجمهور اليوم، في ظل هيمنة الميديا الرقمية، لا يبحث فقط عن القصة أو الأداء، بل عن توقيع المخرج، عن عالمه المتفرد، عن رؤيته، وحتى عن شخصه.
يعلق الناقد الفني طارق الشناوي قائلا: التعريف الدارج للسينما المستقلة هو تعبير ظهر تاريخيًّا في أمريكا، على أساس كونها مستقلة عن هوليوود.
بالنسبة لمصر، هي سينما مستقلة عن شركات الإنتاج المعروفة. ومن سماتها أنها لا تعتمد على النجوم، وهي كذلك أيضًا في هوليوود؛ فهي ليست سينما النجم، ولكن سينما المخرج.
والسوق المصري الذي نعرفه جميعًا لا يرحّب بفيلم ويمنحه شاشات عرض مفتوحة إلا إذا كان هناك اسم نجم أو نجمة تثق جهة الإنتاج في قدرته على تحقيق الإيرادات. فهي إذًا ـ السينما المستقلة ـ تتعارض مع طبيعة السينما المصرية.
ثالثا: التوزيع
في الواقع، إن رغبة الفرد في مشاهدة فيلم فني مستقل في مصر تكاد تتحول إلى مهمة مستحيلة. فليس أمامه من سبيل لتحقيق تلك الرغبة سوى “سينما زاوية” التي تُعد بموقعها في وسط القاهرة، المنصة الوحيدة التي تعرض الأفلام المستقلة بتذاكر بأسعار معقولة، دون السعي لتحقيق أرباح تجارية كبيرة. كما تقدم عروضًا لأفلام حائزة على جوائز دولية من مهرجانات مثل كان وبرلين وتورنتو وصاندانس، وتُتيح أحيانًا لقاءات مع صُنّاع الأفلام، وأصبحت الملاذ الوحيد لصنّاع الأفلام الجادين وعشاق السينما الباحثين عن تجارب بصرية وروحية ذات قيمة. تخيّل أن فيلماً مثل “شرق ١٢”، وهو عمل حديث ومهم، لا يُعرض إلا في قاعة واحدة على مستوى مصر. هذا ليس استثناءً، بل هو القاعدة السائدة.

في المقابل، تحاصرك الأفلام التجارية من كل صوب، بإعلاناتها المنتشرة كالأوبئة على جدران الشوارع، وشاشات المولات، ومنصات التواصل الاجتماعي، حتى يكاد المُشاهد العادي لا يجد فرصة لالتفاتة خارج هذا السيل الجارف من الأعمال الاستهلاكية. وهكذا، تتكرس هيمنة نمط معين من السينما لا لأنه الأفضل، بل لأنه الأوسع انتشارًا والأكثر دعمًا من شبكات التوزيع والرعاية.
وقد تحدثت إلى الناقد طارق الشناوي أثناء كتابة المقال للاسترشاد برأيه، وأجاب برأي حصيف هو: المتعة درجات وأنماط مختلفة؛ فهناك متعة بصرية وسمعية، وهناك متعة مباشرة (الإفيه المباشر)، وهناك متعة وجدانية تستغرق وقتًا، إذ يستقر العمل الفني داخل وجدان المتلقي ويستمتع به.
فالمتعة التي هي ضد الملل هي المقصودة من أي عمل فني، فلا يوجد عمل فني ممل إلا إذا كانت لديه مشكلة. بالنسبة لنا، يمكن القول إن جزءًا كبيرًا من رصيد الأفلام التي دأبنا على وصفها بالمستقلة، بعض مخرجيها ـ وليس كلهم ـ يقدّمونها بلغة سينمائية معقّدة بعض الشيء، في حين أن الفن في البساطة.
لكن يظل العائق الكبير أمام ما دأبنا على وصفه بالسينما المستقلة هو التعود؛ فأي شيء في الحياة يحمل نسبة من التعود، حتى لو كانت أكلة جديدة ـ على سبيل المثال ـ فقد لا يعجبك مذاقها في المرة الأولى، ولكن عند تكرار التجربة تكسر حاجز الغربة أو الألفة بينك وبينها، فتألفها.
إذًا، جزء من مشكلة السينما المستقلة في السوق المصري هو أنها لا تُعرض إلا بشكل قليل ونادر، والمتعارف عليه أن تكون سينما زاوية حاضنة لهذه الأفلام، وهي سينما عدد مقاعدها محدود.
لكنني أراهن على القادم، وهو أن يألفها الناس. (وبالفعل وجود منصات العرض أتاحت فرصة أكبر لهذه النوعية من الأفلام، وهذا ما يمكن ملاحظته مع فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” للمخرج خالد منصور، وفيلم “٦ أيام”، وهو الفيلم الأول، للمخرج كريم شعبان، وأفلام أخرى..).
وهنا تتبدّى المأساة الحقيقية: أن تصبح السينما الفنية – رغم غناها الإنساني والجمالي – هامشًا على خارطة العرض، محرومة من الدعم، محرومة من قاعات العرض، محرومة من التغطية النقدية والإعلامية، بل محرومة حتى من جمهورها الذي يُجبر قسرًا على تذوق ما يُفرض عليه، لا ما يختاره.
٤
حين نتأمل الأزمة التي تعاني منها الأفلام المستقلة أو الفنية في مصر والعالم العربي، لا يجوز أن نحصر النظر في دائرة ضيقة تكتفي بإلقاء اللوم على الجمهور أو صنّاع تلك الأفلام، بل يجب أن نتبنى نظرة بانورامية شاملة، تُحلق فوق المشهد الثقافي والاجتماعي برمته، لتستكشف الجذور العميقة للمشكلة.
إن ما نعانيه في جوهره هو غياب البنية التحتية القادرة على إنماء وتشكيل ثقافة التلقي الفني. فالفرد لا يُولد بذائقة جمالية، بل تُربى فيه هذه الحاسة عبر تراكم تربوي وثقافي منذ الطفولة. من المفترض أن يُنشّأ الطفل على تذوق الفنون الرفيعة، من خلال بيئة تعليمية ومجتمعية تشجع على التأمل، وتقدير الجمال، والتفكير النقدي. أما حين يُحرم هذا الطفل من هذا التكوين، فمن الطبيعي أن ينشأ وقد فقد قدرته على الانفعال بالفن الجاد، أو التواصل مع الخطاب السينمائي العميق الذي تتبناه غالبية الأفلام المستقلة.
ويضاف إلى هذا الخلل التربوي، غياب الدعم الرسمي الجاد للثقافة من قِبل الدولة. فحين تُترك الساحة الثقافية نهبًا لمنطق السوق وحده، يصبح الربح التجاري هو المعيار الأوحد للحكم على جدوى أي عمل فني. وهكذا تسود أفلام التسلية والاستهلاك، بينما تتراجع تلك الأفلام التي تنطوي على مسائلات فكرية أو اجتماعية، لأنها بطبيعتها أكثر تطلبًا، وتحتاج إلى جمهور ناضج ومتفاعل.
ثم إننا -كمجتمعات عربية- نعاني من أزمة عميقة في علاقتنا بالنقد. فالفن، بطبيعته، يُقدِّم رؤى ناقدة، ويطرح الأسئلة أكثر مما يُسارع إلى تقديم الأجوبة. غير أن المجتمعات التي تعيش في ظل أنظمة سلطوية وقمعية غالبًا ما تزرع الخوف وتُميت الشغف. المواطن الذي نشأ في مناخ يحاصر فيه السؤال، وتُخوّن فيه الفكرة، لن يستطيع أن يتذوق فنًا يتأسس على الشك والطرح والتفكيك، وهو ما تُجيده السينما المستقلة في أبهى صورها.

ويأتي على رأس كل ذلك الهيمنة المطلقة للنجوم على الوسط الإعلامي، حيث تُسوَّق الأفلام على أساس أسماء الممثلين لا على أساس الأفكار التي تطرحها. هذه الهيمنة الشخصية تسحب البساط من الفن، وتُحيل الذوق العام إلى رهينة للنجومية. في ظل هذه السيطرة، يتراجع النقد الفني الجاد، لأنه لا يجد التربة المناسبة لنموه، ويصير الحديث عن السينما مشغولًا بالأشخاص لا بالقيم الجمالية والفكرية.
من هنا، فإن أزمة الأفلام الفنية في مصر والعالم العربي ليست أزمة ذوق فقط، بل هي انعكاس واضح لاختلالات أعمق في بنية الثقافة، والتعليم، والدعم المؤسسي، وعلاقة الفرد بالمجتمع والدولة. وما لم نبدأ بإعادة بناء هذه البنى التحتية من الجذور، ستظل السينما الجادة تُصارع في الفراغ، وتُنتَج من أجل مهرجانات لا من أجل بشر.
وفي حديث أجرَيتُه مع المخرج مراد مصطفى، طرحت عليه سؤالًا جوهريًّا: ما جدوى صناعة فيلم لا يشاهده الجمهور؟ ولماذا تنفصل أفلام المهرجانات عن الناس؟ فأجابني بوضوح: “هذا السؤال سيبقى محلّ نقاش حتى يوم الدين، لأنه يمسّ صميم الإشكاليات المعاصرة في صناعة السينما.”
يرى مصطفى أن لكل فيلم جمهوره وذائقته الخاصة، حتى أفلام “الآرت هاوس” (السينما الفنية التجريبية) التي يُروَّج لها على أنها نخبوية بلا جمهور، لها في الحقيقة قاعدة جماهيرية واسعة، ولكنها تتخذ أشكالًا ومساحات عرض مختلفة. فهذه النوعية من الأفلام تُعرض في مهرجانات دولية كبرى، وتُوزّع تجاريًّا في دول أوروبا والوطن العربي، على نحوٍ يفوق ما يحققه الفيلم التجاري المحلي، الذي لا يتجاوز سوقه حدود مصر والسعودية في أغلب الأحيان، وهو أمر محزن يعكس ضيق الأفق التجاري وغياب الرؤية الاستراتيجية لتسويق الفن العربي.
ويضيف مصطفى بشفافية لافتة: “دعونا نكون صرحاء، هناك فجوة معرفية ومزاجية عميقة بين ما يعتاده الجمهور، وبين ما تقترحه أفلام السينما الفنية، خصوصًا تلك التي تُصنع خارج الأطر التجارية التقليدية، وهو أمر ممتد منذ زمن يوسف شاهين.” هكذا تتبدّى أزمة السينما الجادة، لا في غياب الجمهور، بل في غياب الجسور الحقيقية التي تربط بين المزاج العام والاقتراحات الفنية الجديدة.
ولكلام مراد دلائله؛ فالأفلام التي كانت تُقابَل بفتور جماهيري في وقتها أصبحت اليوم تحظى بمتابعة واسعة، وعاد الجمهور، وخصوصًا من فئة الشباب، لاكتشافها من جديد، وتحليلها والتعبير عن تقديرهم لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات النقاش الفني. نرى هذا جليًا في أفلام مثل الحب في الثلاجة لسعيد حامد، والحريف لمحمد خان، والأقزام قادمون لماهر عواد، وغيرها من الأعمال التي لم تجد طريقها إلى النجاح الجماهيري لحظة صدورها، لكنها عادت إلى الحياة بفضل إعادة التقييم.
إن هذا التغير يؤكد وجود فجوة معرفية حقيقية بين ما تنتجه السينما الجادة، أو ما يُسمى بالأفلام المستقلة، وبين الذائقة العامة للجمهور. وهي فجوة لا ترتبط فقط بالأسلوب أو اللغة البصرية أو نوعية القضايا المطروحة، بل تمتد إلى ضعف التراكم النقدي الذي يصاحب هذه الأعمال، وقصور في أدوات التوصيل والتسويق التي تعجز عن مدّ جسور التواصل بين العمل الفني والجمهور.
إننا إذا أمام سياق ثقافي يعيد إنتاج فجوة مزمنة بين الإبداع والتلقي، وفي غياب مشروع نقدي مواكب، وإعلام ثقافي يملك أدوات الشرح والتقريب، تظل الأعمال النوعية معزولة، تنتظر فرصة لا تأتي إلا بعد عقد أو عقدين من الزمن، عندما تنضج الأذواق أو تتغير شروط التلقي بفعل التحولات الثقافية.









