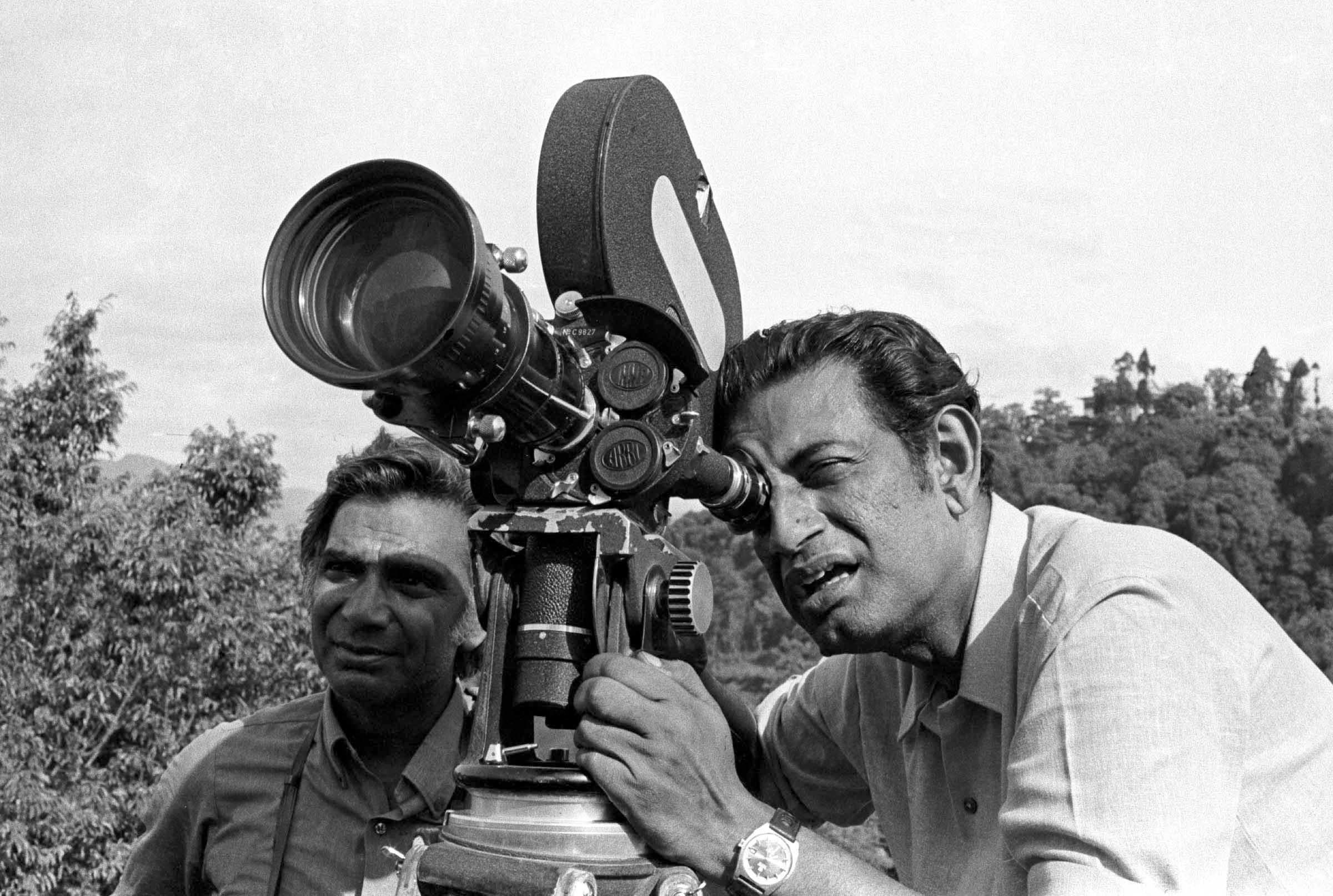معلّمة البيانو.. والجنون الذي يدنو على مهل

في العام 2001 قدّم المخرج النمساوي ميكايل هانيكه فيلمه المثير للجدل “معلّمة البيانو” The Piano Teacher، أو La Pianiste، المأخوذ عن رواية الكاتبة النمساوية إلفريده يلينيك، الصادرة في العام 1983. هذه الكاتبة، الحائزة على جائزة نوبل في العام 2004، من مواليد 1946. في أعمالها الروائية والمسرحية تتناول – حسب تقرير لجنة نوبل في الأكاديمية السويدية – “عبثية المسلّمات الإجتماعية، والصور النمطية، والسلطة الإستبدادية لتلك المسلّمات، وما لها من نفوذ طاغ على حياة المجتمع”.. ومعظم هذه الأعمال تتسم بالسوداوية والسخرية والتلاعب اللفظي، وتعالج موضوعات حساسة ومعقدة مثل العلاقات الجنسية والسلطة والنفاق الإجتماعي.
في “معلّمة البيانو” تقدّمي لينيك رؤية متطرفة لما يعنيه الإفتقار إلى السلطة الإجتماعية، الثقافية، والجنسية. وهي تنظر إلى مازوشية البطلة بوصفها نتاجاً لنظام فاشي. الرواية تركّز بؤرتها على امرأة ترغب بشدّة أن تكون مستقلة، كإنسانة وفنانة، في مجتمع محافظ يمارس الكبح والكبت، لكنها تخفق في تحقيق ذلك فتصبح عصابية غير مستقرة عقلياً.
من المعروف عن الكاتبة إلفريده يلينيك أنها تعيش في عزلة تامة، متجنبة الأضواء والظهور العلني. وهي تتصل بالعالم من خلال جهاز الكومبيوتر.. عن هذا تقول: “أعاني منذ أعوام، وبانتظام، رهاباً اجتماعياً يجعل من الصعب عليّ أن أطيق الحشود”.
عن روايتها “معلّمة البيانو” تقول: “إنها رواية ضد ابتذال الجنس واعتباره سلعة”.
وقد ترددتْ طويلاً في السماح لمنتج ما بتحويل الرواية إلى السينما لأن “أعمالي النثرية ذات توجّه لغوي، بمعنى أن الصور تحدث في الداخل وتُنقل عبر اللغة. لم أستطع أن أتخيّل أن بمقدور الصور السينمائية إضافة أي شيء جوهري. لكنني كنت دوماً أعرف أنني سوف لن أعمل إلا مع مخرج مثل هانيكه، القادر على مجاورة معياره الخاص عن الصور مع النص”.
وردّاً على سؤال حول التماثل بينهما، هي وهانيكه، حيث أنه يستخدم الكاميرا كمِشْرط، وهي تستخدم القلم للغرض نفسه.. تقول إلفريده: “لهذا السبب رأيت أن هانيكه مناسب جداً لتحويل هذه الرواية إلى الشاشة، لأننا كلينا نشرع في العمل على نحو تحليلي وبهدوء، ربما مثل علماء يدرسون حياة الحشرات”.
وبحسب هانيكه، فإن غياب التبرير السيكولوجي هو الذي جذبه إلى الرواية.
هانيكه (الذي كتب سيناريو الفيلم) مخرج ذو رؤية خاصة، ممسوس بما يكمن وراء المظهر المألوف للأشياء والظواهر والعلاقات. إنه يتخطى الأسباب الواضحة والمؤثرات المنطقية ليصل إلى السرّي والمتناقض والذي يستعصي على الإدراك المباشر.
هانيكه لم يلتزم حرفياً بالنص، مع إنه حافظ على العديد من التفاصيل الخاصة بالبطلة إيريكا، كما جاءت في الرواية، مثل: تخصصها في شوبيرت وشومان، المعاملة القاسية للتلاميذ، اقتحامها عالم البورنو الخاص بالرجال، كراهية الذات، الحاجة إلى إلحاق الأذى بالنفس.
الرواية تؤكد على وضع المرأة المحرومة من الحقوق الطبيعية أو الإنسانية، وما يفضي ذلك إلى البغض بين الجنسين. شخصية إيريكا، في الرواية، مرسومة بوصفها امرأة كئيبة، قاسية، ساخرة. تعيش مع أم بغيضة، وضمن محيط يهيمن عليه الرجال الذين يعاملون النساء كأشياء غير ضرورية ويمكن الإستغناء عنها.
في الرواية، نجد أن علاقة إيريكا بتلميذها فالتر مندمجة مع الصلات المدمرة بين الأم وابنتها.. وهي الثيمة الأساسية في الرواية. القارئ يجد نفسه أمام دراسة مركّبة ومتشائمة للمرأة التي تتوق بشدّة لأن تصبح ذاتاً مستقلةً، كإنسانة وكفنانة، في مجتمع محافظ.
بينما ينظر هانيكه إلى الصورة من زاوية أخرى: العزلة والإنسلاب تحدث بسبب رموز السلطة البورجوازية. إنه يؤكد على مسؤولية الأعراف المحافظة للمجتمع النمساوي في قمع الأفراد، إضافة إلى دور العائلة كخليّة أساسية تنتج كل التعارضات والتناقضات المحتملة في ما يتصل بالعلاقات بين الأفراد. هذه الحياة العائلية البورجوازية هي التي تنتج الشخصيات الشاذة، المعقدة، اللاسوية.
الفيلم يسبر نفسية شخصية مركّبة، متقلبة، بلا روابط اجتماعية ولا ميل إلى ممارسة متع الحياة. هي حية لكنها لا تعيش حياتها كما ينبغي. محكومة بالرتابة والخضوع. إنها إيريكا (إيزابيل أوبير) معلّمة الموسيقى. في الأربعين من عمرها. عزباء وتعيش مع أم نزّاعة إلى التملك على نحو ميئوس منه، أما والدها – الذي كان موسيقياً – فقد مات في مصح عقلي.
إيريكا شخصية متقلبة، متناقضة، متعارضة مع نفسها. إنها تحقق إنجازاً فنياً رفيعاً بالمشاركة في هيئة تدريس المعهد الموسيقيّ، في الوقت ذاته يدفعها الخلل النفسي إلى الوقوع تحت أسر الروح الإنتقامية، وممارسة أبشع أشكال إيذاء النفس وإذلال الذات. من جهةٍ، نراها تفرض سطوتها وهيمنتها على الآخرين، لكن من جهة أخرى، هي تقبل أن تكون ضحية مستسلمة. حيناً تكون مثيرة للتعاطف، وحيناً لا تثير أي تعاطف. إنها شخصية تراجيدية، أسيرة رغبات غريبة، تعاني من الإضطراب العصبي، والكبت العاطفي والجنسي، ومن استبدادية أمها التي تعيش معها.
الفيلم يبدأ (مثلما ينتهي) بلقطة لباب موصد. إيريكا تدخل وتعيد غلق الباب. تلقي التحية على أمها (آني جيراردو)، لكن أمها لا تكترث بتحيتها، بل تسألها بحدّة: لم تأخرت؟.. ثم فجأة تنتزع منها حقيبة يدها وتفتشها: تجد ثوباً جديداً فاضحاً. الإستجواب والتوبيخ يفضي إلى تصعيد التوتر والإنفعال، والذي يؤدي بدوره إلى العنف الجسدي. ينتهي المشهد ببكاء إيريكا واعتذارها من أمها.
هي تنام مع أمها في الغرفة نفسها، وعلى فراش واحد. لذلك هي خاضعة لرقابة الأم باستمرار. أحد المشاهد المبكرة يصوّر حفلاً موسيقياً تعزف فيه إيريكا، في حضور أمها التي تراقبها طوال الوقت، وإيريكا تخترع الأكاذيب لكي تفلت من تحديقة الأم.
العلاقة بين إيريكا وأمها تتذبذب بين توترات تتفجر إلى حالة من الغضب، والإحساس بالذنب، والتسوية والصلح. إن إيريكا تبذل كل ما بوسعها لتموّه رغباتها الجنسية عن أمها، لكنها في الوقت نفسه تتخيّل أنها ترغم أمها على اكتشاف هذه الرغبات.
كل منهما تعتمد على الأخرى، غير أن الأم تحرص من جانبها على أن تظل ابنتها معها، رافضة أن تدعها تستقل بحياتها، أو على الأقل أن تشعر بأنوثتها. هي بالأحرى تتعامل معها كطفلة، لذلك تصر على معرفة مكان وجودها كلما غابت عن البيت، وتراقبها باستمرار، وتتقاسم معها الفراش. من هنا نلاحظ تشوّش إيريكا بشأن هويتها، ورغباتها، وحاجاتها النفسية والإجتماعية.
العلاقة السادية بين الأم وابنتها، التي يكشفها الفيلم منذ البداية، هي – كما يراها هانيكه – صورة مصغّرة للمجتمع النمساوي البورجوازي، في إطاره الثقافي والإجتماعي.
إيريكا تعمل في المعهد الموسيقيّ بفيينا كمعلّمة للبيانو. هي جادة ورصينة وحازمة ومتحفظة. لكن تحت هذا المظهر الذي يبدو طبيعياً تكمن حياة سريّة، قاتمة ومنحرفة.
علاقتها بزملائها وتلاميذها فاترة، غير ودية، وتعوزها العاطفة. وهي لا تهتم بخلق علاقة طيبة بقدر ما يعنيها أن تفرض سطوتها وهيمنتها على تلاميذها الشبان، بفرض معايير قاسية، واللجوء إلى السخرية اللاذعة، وإذلالهم والتقليل من شأنهم. هذه القسوة التي تمارسها، وهذا الفتور، يتباين بشكل حاد مع رهافتها وحساسيتها عندما تعزف على البيانو. ويبدو أن الهيمنة التي تمارسها في المعهد بمثابة تعويض عن عجزها على مواجهة هيمنة أمها في البيت. هي لا تجد مجالاً للتعبير عما بداخلها، لا في البيت الموحش ولا في أروقة المعهد. ومن الجليّ أن علاقتها غير الصحية بأمها تؤثر سلباً في صلاتها بالعالم الخارجي، وفي أي ارتباط مع الآخرين. إنها تعمل على إبعاد أي شخص يحاول الإتصال بها.
هي ذات ميول سادية – مازوشية، تعيش حياتها الجنسية، غالباً، من خلال التخيّل والفنتازيا. إنها لا تختبر الإتصال الحسّي إلا عبر محلات البورنو حيث تتجول، وتمارس فعل التلصص على الذين يمارسون الجنس في السيارات أثناء عرض الأفلام، والتلصص على عروض الجنس الحية. الغريب أن رد فعلها إزاء كل هذا يكون متحفظاً وفاتراً ومحايداً.. كأنها تمارس ذلك بآلية. إنها تتفرج وهي جالسة على نحو صارم، ولا يبدو عليها أنها تسعى وراء الإثارة والإشباع الفوري، بل تبدو أشبه بباحثة جادة تدرس ظاهرة معينة.
هنا هي تخترق المجال الذكوري بجرأة نادرة، غير متوقعة.. فالمرأة لا يحق لها أن تنظر إلى ما هو بورنوغرافي. لا يجوز لها أن تبحث عن اللذة في ما يعتبر حقلاً خاصاً للرجال. النظر من حق الذكر فقط. إنه نشاط ذكوري. المرأة كائن منظور إليه، هي مادة للتحديق فحسب.
لكن إيريكا، بجرأة وبلا خجل، تقتحم هذا المجال المتمثّل في العروض الإباحية، تنتظر دورها لتشغل حجيرة خاصة للتلصص، وعندما يحدّق إليها الرجال، في وقاحة وبذاءة، هي ببرود تتجاهل تلك النظرات. وعندما يحين دورها، تتفرّج في حياد، ثم تمد يدها نحو سلة المهملات، وتحصل على لذّتها في استنشاق المناديل الورقية الملطخة بسوائل الرجال المنوية.
من خلال شخصية إيريكا نتعرّف على الجانب المخيف والمدمّر من الرغبة، هذه الرغبة التي تنبثق من الجزء الغامض، الذي لا نعرف عنه شيئاً، من ذواتنا. عن هذا الجانب يتحدث الناقد بيتر سينسبوري ويقول: “الواقعية السيكولوجية، مع إلحاحها على السلوك العاطفي الناجم عن أسباب واضحة ونتائج منطقية مجرّدة من التناقض، هي – هذه الواقعية – ببساطة غير وافية لتصوير آليات الرغبة المتناقضة، المشوّشة، اللامرئية، السريّة جوهرياً.. كما هي حال الرغبة التي نجدها عند إيريكا”.
إيريكا غير قادرة على تحقيق اتصال مع الآخر، جنسياً واجتماعياً، إلا من خلال التلصص والميول المازوشية، حيث تجد لذّتها في إيذاء وجرح نفسها (في الحمّام هي تشق أعلى فخذها بموسى الحلاقة). الفيلم يعرض بوضوح أشكال الإنحراف الجنسي عند إيريكا: من التلصصية إلى النزوع السادي – المازوشي.
في تحليله للفيلم، يفرّق الناقد مارك شابمان (Bright Lights Film Journal, Nov. 2011) بين نظرة فرويد للسادية “السادي دائماً يكون مازوشياً في آن واحد”، ونظرة جيل ديلوز المعارضة، والذي يرى بأن المازوشي يستمد لذّته من الحرمان المتواصل من الإشباع، وإنكار الشهوة الحسية، رغم أنه لا ينبغي الخلط بين هذا الإنكار والرفض التام للعاطفة. المازوشي يصبح مقنّعاً بواسطة الوجدانية ذات الحسيّة المفرطة، وبإعطاء الإيروسية شكلاً مثالياً، هذه الإيروسية التي تُظهر نفسها في صورة برود خارجي. ويستنتج الناقد بأن فيلم هانيكه يلتزم بصرامة بالنموذج الديلوزي للمازوشية.
إيريكا تنجذب إلى العازف الشاب فالتر كليمر (بينوا ماجيميل)، لكنها لا تُظهر له ذلك، بل إنها تصد كل محاولاته للتقرّب منها. وهو الذي افتتن بموهبتها أولاً، لا يتراجع ولا ييأس.
في الرواية، شخصية هذا الشاب مرسومة، منذ البداية، بوصفه ممثلاً حقيراً للذكورة، والذي باعثه الوحيد هو أن يقهر إيريكا ويدمرها.
في الفيلم هو عازف بارع، ورياضي، ويمتلك حساسية وجاذبية. يتعلق عاطفياً بإيريكا بعد أن شاهدها تعزف في صالون خاص. يحاول أن ينضم إلى المعهد ليدرس على يدها، وعلى الرغم من موقفها الرافض، العدائي، يتم قبوله في المعهد.
العلاقة بينهما تتطور لتصبح جامحة، معقدة، وموجعة. هي تختبر فيها نوازعها المازوشية التي ترعب الشاب فيبتعد عنها. إنها تستخدم تخيلاتها المازوشية لا لتستسلم كلياً له، وإنما لتدفعه بعيداً عنها.
في مشهد البروفة العامة، هي تراقب فالتر وهو يتحدث في انسجام مع إحدى طالباتها الموهوبات. وجهها لا يوحي بشيء، ولا يمكن قراءة شعورها على وجه لا يشي بأي انفعال محدد. لكن فجأة نراها تهشم كأساً وتضع شظايا الزجاج في جيب معطف الطالبة. بعد قليل، تصيح الطالبة في ألم حيث نرى يدها الدامية. في ما بعد، تحريات الشرطة ترجّح وجود طالب إرتكب هذا بدافع الغيرة.
هل تسببها في إيذاء التلميذة الشابة بدافع الغيرة الجنسية أم لأنها ترغب في إنقاذها من أمها المهيمنة؟ نحن لا نعرف الدافع.
مباشرة بعد ارتكاب هذا الفعل، تذهب إيريكا إلى الحمّام، يتبعها فالتر ويوشك على اغتصابها، إلا أنها تتمكن من منعه واستعادة السيطرة ومن ثَم التحكم فيه، وتحاول أن تعقد معه إتفاقاً: سوف تقبل بإقامة علاقة معه إذا هو امتثل للتعليمات التي سوف تسلمها له كتابياً.
في المساء، يتبعها فالتر حتى شقتها، ويقتحم غرفة نومها. هي ترغمه على قراءة رسالتها، التي تحتوي على قائمة بالمطالب المازوشية المتطرفة لإشباع رغباتها، إنها تريد علاقة تماثل علاقة السيّد والعبد، واصفة بالتفصيل ما يتعيّن عليه فعله بها من إيذاء وإساءة، ثم تسأله: “هل أثير اشمئزازك؟”. هو يغادر مصدوماً ومشوّشاً ومشمئزاً. هي تبكي فيما تقرأ رسالتها بصوت عال.
في يوم آخر، تذهب إلى صالة تزلج لتتفرج عليه وهو يشارك في مباراة في لعبة الهوكي على الجليد. بعد المباراة، تعتذر له وتبكي، وتعبّر له عن رغبتها فيه، وتحاول أن تشجعه على ممارسة الجنس معها في نفس المكان غير أنه يبعدها. تحاول ثانية فيستسلم، لكنها تتقيأ.
في منتصف الليل، هو يدخل شقتها، يوقظهما، يصفعها أمام أمها الذاهلة. يحبس أمها في الغرفة المجاورة، حيث تستطيع أن تشهد ما يحدث سمعياً. عندما تصدّه إيريكا، يضربها بعنف، فتنزف وتبكي. كل هذا لا يردعه، بل يغتصبها. إن فالتر، في بداية علاقتهما، كان يتعامل معها باحترام وحب، لكن تحوله في ما بعد إلى شخص عنيف، نجد مبرره في رغبتها هي إلى هذا العنف، خصوصاً بعد إعلانها عن تخيلاتها المازوشية. إن إيريكا تسكن في عالم من صنع خيالها وأوهامها. لقد وجدت في فالتر المرشح المثالي ليلعب دور الخاضع لهيمنتها وفق عالمها المتخيل، ففي هذا العالم لا وجود للحب، لكن الواقع يثبت عكس ما تتصوره.
في اليوم التالي، تأخذ إيريكا سكيناً من المطبخ، وتضعها في حقيبة يدها، وتذهب إلى حفل في المعهد يشارك فيه الطلبة. هناك تطعن نفسها في صدرها، ثم تغادر من دون أن يلاحظ أحد.
الفيلم يتحرّى الحالات العصابية لهذه المرأة المكبوتة بعمق، التي تنطلق حثيثاً نحو تدمير الذات. كما يتضمن تحليلاً مركّباً للعائلة وسياسة الكبح، ويقدمّ تأملاً في الصلات التي تربط الفن بقوى الكبت.
في الواقع، الفيلم لا يقدّم حلولاً وأجوبة، بل يطرح العديد من الأسئلة. ولا يعرض تفسيراً مباشراً للسلوك العنيف في العلاقة بين إيريكا وأمها، وبينها وبين الآخرين. إذ كلما أزال طبقة من شخصية البطلة، على نحو تدريجي، شعرنا بأن الأمور، التي تتصل بدوافعها وأفعالها ومبرراتها، لا تتكشّف وتتوضح بل تزداد غموضاً. إنك تشعر بأنها مرشحة لحالة مأساوية وشيكة.. حالة مخيفة لن تستطيع تفاديها.. كما لو أن الجنون الذي يدنو منها على مهل، ويحيط بها، سوف يلتهمها أخيراً.
هانيكه في أسلوب إخراجه يبدو مقتصداً ومحايداً، وهو لا يلجأ إلى دغدغة مشاعر وغرائز المتفرج بالصور الحسيّة، رغم إغواءات النص، ولا يتخذ موقفاً نقدياً من الشخصيات وعلاقاتها.. إنه يُظهر الأفعال بكل عريها، لا يبرّر ولا يتغاضى. ولا يعلّق على دوافع الشخصيات. وهذا الأسلوب ينسجم تماماً مع طبيعة شخصية إيريكا وعلاقتها بمحيطها وعالمها، فهي تعيش حياتها بلا عاطفة، بلا شغف، بلا أي محاولة للإتصال مع الآخرين، عائشة في الوهم والتخيّل أكثر مما في الواقع.
كاميرا هانيكه تعتمد على الإيحاء أكثر من التصريح. إنها نادراً ما تركّز بؤرتها على قلب الحدث، معطية المتفرج لمحات من دون الإقتراب من المرئي وحصر الشيء ضمن الكادر في لقطات قريبة. إننا نراقب انحدار إيريكا، ونتابعها محتفظين بمسافة بيننا، ولا يُسمح لنا بالإقتراب منها ومحاولة فهم دوافعها. وفي غياب صوت الراوي، أو الحوار الداخلي، الذي يشرح ويوضّح أفعال الشخصية، أو أي بيان تفسيري سردي، فإن عدم قدرة إيريكا على التعبير عما تريده بشكل مباشر، يحول دون غوص المتفرج في أعماق الشخصية، والإكتفاء بالمكوث عند السطح. هذا يعني أن المتفرج يكون محروماً من المشاركة أو التعاطف مع الشخصية، كما يحدث غالباً في السينما السائدة، وبدوره يتخذ المتفرج موقف المحايد.
يقول هانيكه: “كل تفسير هو تقييد، وكل تقييد هو كذب غير مباشر”.
حاز الفيلم على الجائزة الكبرى في مهرجان كان 2001، إضافة إلى جائزة أفضل ممثلة، وأفضل ممثل.
كذلك نال الفيلم جائزة الفيلم الألماني كأفضل فيلم أجنبي.
كما حازت إيزابيل أوبير على جائزة الفيلم الأوروبي، ومهرجان سياتل، ونقاد سان فرانسسكو كأفضل ممثلة.
أما آني جيراردو في دور الأم، فقد حازت على جائزة السيزار الفرنسية كأفضل ممثلة مساعدة.
أداء استثنائي ورائع من إيزابيل أوبير (التي تعد واحدة من أكثر الممثلات موهبة في السينما الفرنسية). إنها تؤدي معتمدة على وجهها، الذي يكاد يخلو من المكياج، باستثناء أحمر الشفاه، ومرتدية ملابس داكنة اللون. على وجهها تنعكس تلك المشاعر والإنفعالات المتضاربة، الغامضة. كما تكشف عن قدرة هذا الوجه على كبح تلك المشاعر، فلا يتراءى على السطح غير ظلال المشاعر المتوارية في العمق. أيضاً تكشف عن قدرة مدهشة على التحكم بحساسية عالية في كل حركة وإيماءة وتعبير.
هانيكه يجعل كاميرته تحاول إظهار ليس فقط العنف البدني على وجهها بل أيضاً الكشف عما هو أعمق وأكثر غوراً. في حالات عديدة، هو يجعل الكاميرا مركّزة عليها، محدّقة في وجهها. ليس غايته من ذلك فهم أو تفسير أفكار الشخصية، بل – كما يقول الناقد ريك بورك – محاولة فهم ما تفعله تلك الأفكار بها. في كل المشاهد التي تسبق لقاء إيريكا وفالتر في الحمّام، تكون هي في بؤرة أو مركز اللقطات القريبة أو المتوسطة، تعبيراً عن تحكمها في محيطها، وكيف أنها تقيّم وضعها وتخطط في سبيل المحافظة على هذا التحكم والسيطرة. لكن ما إن تضعف أمام فالتر، وتسلمه مطالبها حتى تفقد تلك القدرة على التحكم والسيطرة، واللقطات – معبّرة عن هذه الحالة الجديدة – تكتسب مظهراً آخر، ومعنى آخر. هي، في علاقتها بالكاميرا، لا تعود في المركز أو البؤرة، ويطغى حضور فالتر على حضورها. في نهاية الفيلم، مع ظهور وجهها المتوّرم – بفعل اعتداء فالتر عليها – هي تستعيد قدرتها على التحكم، وما طعن نفسها بالسكين إلا تعبير عن التحكم في مصيرها. الطعن ليس فعل يأس أو بدافع اكتئاب، بل الوسيلة التي بها تستعيد إيريكا السيطرة.. السيطرة على نفسها ووضعها وأفعالها، متجاوزة كل أذى أو إساءة.
في حديثها عن دورها، تقول إيزابيل أوبير: “الفيلم هو عن الإختلاف بين الحب والإغواء. إيريكا تريد أن تكون محبوبة، لا أن تخضع للإغواء. هي لا تريد أن تفقد السيطرة والتحكم، لا تريد أن تتعرّض للإيذاء”.
* * * *
حوار مع ميكايل هانيكه عن فيلم “معلّمة البيانو”
أجراه: كريستوفر شاريت
– في فيلمك “معلّمة البيانو”، يبدو أن الموسيقى الكلاسيكية، بينما تجسّد أفضل ما لدى البطلة إيريكا من حساسية ورقة شعور، فإنها أيضاً تتضمن في أعراض مرضها..
* نعم، بإمكانك أن ترى الموسيقى تعمل في ذلك الإتجاه، لكنك تحتاج أولاً أن تدرك بأننا في الفيلم نُظهر وضعاً نمساوياً جداً. فيينا هي عاصمة الموسيقى الكلاسيكية، وهي بالتالي مركز شيء استثنائي جداً. الموسيقى جميلة جداً لكن، مثل المحيط أو البيئة، يمكن أن تصبح أداة للكبح والقمع، لأن هذه الثقافة تضطلع بوظيفة اجتماعية تضمن الكبح، خصوصاً فيما الموسيقى الكلاسيكية تصبح مادة للاستهلاك. بالطبع يتوجب عليك أن تدرك أن هذه القضايا ليست مجرد موضوعات لسيناريو الفيلم، إنما هي أيضاً من اهتمامات رواية إلفريده يلينيك، حيث لدى المرأة فرصة، وإن كانت صغيرة، لتحرّر نفسها كفنانة فقط. هذا لا يتحقق، بالطبع، بما أن براعتها الفنية تنقلب ضدها من بعض النواحي.
– تبدو الأغنية السابعة عشر لشوبيرت محورية في الفيلم. البعض يرى أن هناك صلة بين إيريكا ومسافر شوبيرت في تلك الأغنية. هذا يقودنا إلى سؤال أوسع عما إذا كانت الموسيقى تمثّل الجانب الصحي من نفسية إيريكا أم أنها ببساطة تساعد في كبحها؟
* بالطبع، الأغنية السابعة عشر تحتفظ بمكانة محورية في الفيلم، ويمكن النظر إليها كشعار لإيريكا والفيلم نفسه. المجموعة كلها تؤسس فكرة إتباع طريق لم يسلكه الآخرون. وأظن هذا يعطي للفيلم تأثيراً تهكمياً. من الصعب الجزم بأن هناك ارتباطاً، علاقة متبادلة، بين عصابية إيريكا وما يمكن تسميته بالرسم النفسي لموسيقار عظيم مثل شوبيرت. لكن بالطبع هناك إحساس حاد بالحزن عند شوبيرت، والذي هو جزء أساسي من بيئة الفيلم. شخص لديه مشكلات هائلة، كالتي تحملها إيريكا، قد يُسقطها على فنان له حساسية شوبيرت المركّبة جداً. لا أستطيع أن أعطي تأويلاً إضافياً. الموسيقى العظيمة تسمو فوق المعاناة إلى ما وراء الأسباب المحددة. الأغنية السابعة عشر تسمو فوق التعاسة حتى في الوصف المفصّل للتعاسة. كل الأعمال الفنية الهامة، خصوصاً تلك التي تهتم بالجانب الأكثر قتامة من التجربة، على الرغم من توصيلها لأي يأس، تتخطى – هذه الأعمال – قلق المحتوى في تحقّق الشكل.
– فالتر كليمر يبدو بطلاً للفيلم، غير أنه يتحوّل إلى وحش..
* في الواقع، هذه الشخصية مصوّرة في الرواية على نحو سلبي أكثر مما في الفيلم. الرواية مكتوبة بصيغة ساخرة جداً. إنها تحوّله من أحمق، غرّ وصبياني، إلى وغد فاشيّ، بينما الفيلم يحاول أن يجعله أكثر جاذبية وإثارة للاهتمام. في الفيلم، علاقة الحب، التي هي ليست مركزية في الرواية، تكون متضمنة أكثر في العلاقة بين الأم والابنة. فالتر يقدح الكارثة فحسب. في الرواية، فالتر هو بالأحرى شخصية ثانوية والتي كانت تحتاج إلى تطوير يساعدها على أن تكون موضعاً معقولاً أكثر للكارثة.
– المرء يخرج، بعد مشاهدة الفيلم، شاعراً بأن العلاقات الجنسية مستحيلة تحت افتراضات المجتمع الراهن.
* نحن جميعاً مصابون بالأذى والضرر، لكن ليس كل علاقة تتمثّل في السيناريو المتطرف للعلاقة بين إيريكا وفالتر. ليس كل شخص يعاني من اضطراب عصبي مثل إيريكا. الحقيقة الشائعة تقول أننا لسنا مجتمعاً من الأفراد السعيدين، وهذا هو الواقع الذي أرسمه، لكنني لن أقول أن الصحة الجنسية مستحيلة.
– تبدو مهتماً كثيراً باللقطة الطويلة long take. هناك عدد من اللقطات الساكنة في أفلامك، مثل الصورة الختامية.. أيضاً تلك اللقطات التي تظهر الجدار العاري في الحمّام مباشرة قبل أن يندفع فالتر صوب إيريكا، كذلك العديد من اللقطات لوجه إيريكا. نجد هذا أيضاً في أفلامك الأخرى.
* ربما أستطيع أن أربط هذا بمسألة التلفزيون. التلفزيون يسرّع عاداتنا في الرؤية. أنظر، على سبيل المثال، إلى الإعلانات في هذا الوسط. كلما كان عرض الشيء أسرع، قلّت قدرتك على إدراكه كشيء يحتل مكاناً في الواقع الفيزيائي، وأصبح شيئاً مغرياً أكثر. وكلما بدت الصورة أقل حقيقية، سارعتَ أكثر لشراء السلعة المصوّرة.
بالطبع، هذا النموذج من الجمالية اكتسب سلطة وهيمنة في السينما التجارية. التلفزيون يزيد في سرعة التجربة، لكن المرء يحتاج إلى وقت لفهم ما يراه، وهذا ما تنكره الميديا السائدة ولا تجيزه. ليس مجرد الفهم على المستوى الفكري بل العاطفي. السينما لا تستطيع أن تقدّم إلا القليل جداً من الموضوعات الجديدة، فكل ما يقال الآن قيل سابقاً آلاف المرات، غير أن السينما ما تزال تملك القدرة والأهلية لتدعنا نختبر العالم بشكل جديد.
اللقطة الطويلة وسيلة جمالية لإنجاز هذا بتوكيدها الخاص. هذا كان مفهوماً منذ زمن طويل. فيلمي “شفرة مجهولة” يتألف من الكثير من اللقطات المتتابعة الساكنة، كل لقطة من منظور واحد، وذلك لأنني لا أريد أن أتفضّل على المتفرج أو أتلاعب به، أو على الأقل إلى أصغر درجة ممكنة. بالطبع، الفيلم دائماً عبارة عن تلاعب، لكن إذا كل مشهد هو مجرد لقطة واحدة، فعندئذ هناك على الأقل درجة أقل من الإحساس بالزمن الذي هو عرضة للتلاعب حين يحاول المرء أن يبقى قريباً من بنية “الزمن الحقيقي”. إن اختزال المونتاج إلى الحد الأدنى أيضاً ينزع إلى نقل المسؤولية من جديد إلى المتفرج، حيث يقتضي منه ذلك الكثير من التأمل.
عادةً طريقتي هي حدسية جداً، من دون أي شيء مبرمج. الصورة الختامية في “معلّمة البيانو” هي ببساطة إعادة توكيد للمعهد الموسيقيّ، التناسق الكلاسيكي لذلك المبنى الجميل في الظلام. المطلوب من المتفرج أن يعيد النظر فيه.
– هل يمكنك أن توضح مفهومك للعائلة كما صوّرتها في “معلّمة البيانو”؟
* هنا أردت قبل كل شيء أن أصف المحيط البورجوازي، وأن أثبّت العائلة بوصفها خليّة مفرّخة لكل التعارضات والنزاعات. لقد أردت دائماً أن أصف العالم الذي أعرفه، وبالنسبة لي فإن العائلة هي ميدان الحرب المصغّرة، الموقع الأول لكل حرب. عادةً المرء يربط الموقع السياسي – الاقتصادي الأكبر بالصراع أو الحرب، غير أن الموقع اليومي للحرب في العائلة يكون مهلكاً، بطريقته الخاصة، بالقدر نفسه، سواء بين الآباء والأبناء أو الزوجة والزوج. لو بدأتَ في سبر مفهوم العائلة في المجتمع الغربي فسوف لن تقدر أن تتجنب الإدراك بأن العائلة هي منبت كل التعارضات والنزاعات. لقد أردت أن أصف هذا بطريقة مفصّلة قدر الإمكان، تاركاً للمتفرج حرية الاستنتاج.
السينما كانت تميل إلى إغلاق موضوعات كهذه مرسلةً الناس إلى بيوتهم وهم في حالة رضا واطمئنان، بعد إشباع رغباتهم. بينما هدفي هو زعزعة المتفرج وإقلاقه، وانتزاع أي مؤاساة أو رضا عن الذات.
– البورنو والإيروسية تلعبان دوراً أساسياً في “معلّمة البيانو”، وهذا أثار الكثير من الجدل والخلاف. هناك نقاش مستمر بشأن البورنو، وما إذا له وظيفة محرّرة أم لا..
* أود أن يتذكّرني الناس لتحقيقي شيئاً فاحشاً لكن ليس فيلماً بورنوغرافياً. في تعريفي الخاص، أي شيء يمكن اعتباره فاحشاً ينطلق من المعيار البورجوازي. سواء أكان معنياً بالنشاط الجنسي أو العنف أو قضية محرّمة (تابو) أخرى، فإن أي شيء ينحرف عن المعيار هو فاحش. بقدر ما الحقيقة تكون دائماً فاحشة، آمل أن تحتوي أفلامي كلها، على الأقل، على عنصر من الفحش.
على نحو مغاير، البورنوغرافيا هي النقيض، ذلك لأنها تصنع مما هو فاحش سلعة تروّجها، وتجعل ما هو غير عادي شيئاً قابلاً للاستهلاك، والذي هو مظهر مخز وفضائحي حقاً من البورنو. إنه ليس المظهر الجنسي بل المظهر التجاري للبورنو الذي يجعله منفراً ومثيراً للاشمئزاز.
أظن أن أي ممارسة فنية معاصرة هي بورنوغرافية إن حاولت أن تضمّد الجرح، إن جاز التعبير، والذي يعني الجرح الاجتماعي والنفسي. يبدو لي أن البورنوغرافيا لا تختلف عن الأفلام الحربية أو الأفلام الدعائية من حيث أنها تحاول أن تجعل عناصر الحياة، العميقة أو الرهيبة أو المنتهكة، قابلة للاستهلاك. إن الأفلام الدعائية (البروباغندا) هي بورنوغرافية أكثر من الفيلم البيتي home videoالذي يظهر رجلاً وامرأة يمارسان الجنس.
– لاحظت أن محل البورنو الذي تزوره إيريكا يقع في مجمّع تجاري، والذي يبدو غريباً بالنسبة لنا..
* صوّرنا المحل في الموقع الأصلي. هكذا يبيعون البورنو في فيينا.. في مجمعات تجارية.
– يبدو أن هناك بعض الخلط أو التشوش بشأن عنوان الفيلم..
* في الأصل، عنوان الرواية باللغة الألمانية هو Die Klavierspielerinأي “عازفة البيانو”.. وهو عنوان غير ملائم على نحو مقصود، كما أنه تعبير غير مألوف في الألمانية. هذا العنوان يشير إلى الشخص الذي يكون في المقام الأسفل ضمن المرتبة أو الهرمية الإجتماعية. وتلك الكلمة لا تعادل Pianisitinوهي كلمة ألمانية تشير إلى الشخص الذي يكسب رزقه بالعزف على الآلة، وهو شخص يمتلك موهبة حقيقية، وهو أكثر من مجرد حرفي يعزف بمهارة. الترجمة الإنجليزية للرواية هي “معلّمة البيانو”، وهي ترجمة غير سليمة، بل أنها تحط من قدر البطلة. لقد أردت عنواناً يعبّر عن نبل البطلة.
– “معلّمة البيانو” هو من أكثر أفلامك رواجاً وشهرة.. هل تشعر أنه يمثّل، على نحو أفضل، حساسيتك وتطورك كمخرج سينمائي؟
* لن أتفق معك، طالما أن الفكرة ليست نابعة مني بل مأخوذة من رواية، في حين أن أفلامي الأخرى نشأت من أفكاري الخاصة. أنا أتعرّف على نفسي في تلك الأفلام أكثر مما أفعل مع أفلام مبنية على نصوص أخرى. بالطبع، أنا اخترت موضوع نص “معلّمة البيانو” لأنني كنت منجذباً إليه كثيراً، وما يمكنني أن أجلبه إلى هذا العمل. لكن هذا العمل، من بعض النواحي، بعيد عني.. إذ لا يمكنني أن أكتب رواية عن النشاط الجنسي عند المرأة. إن موضوع رواية يلينيك أثار اهتمامي، لكن اختياري لمصادر أخرى للفيلم سيبقى، على الأرجح، استثناءً.
– الملاحظ أن أفلامك الأخيرة ناطقة باللغة الفرنسية، مع أن الموقع يظل نمساوياً..
* هذا لكي يلائم المنتجين والممثلين. مصدر الدعم الأساسي يأتي من فرنسا، والممثلون أغلبهم فرنسيين: إيزابيل أوبير، جولييت بينوش، بنوا ماجيمل، آني جيراردو.. وجميعهم رائعون. صناعة السينما النمساوية محدودة بعض الشيء في الموارد. الإنتاج الفرنسي ساعدني كثيراً، كما إنني أشعر بالإرتياح مع اللغة الفرنسية.
المصدر:
Real Time, issue 53, Feb. Mar. 2003
* * * *
حوار آخر مع ميكايل هانيكه
أجرته: كارين شيفر، 2001
– “معلّمة البيانو” هو فيلمك الأول المعد عن رواية أثارت الكثير من الجدل للكاتبة إلفريده يلينيك. ما الذي أثار اهتمامك بشأن مادة الكتاب؟
* النص أثار اهتمامي لأنه يمضي بعيداً جداً على الصعيد السيكولوجي.
– عندما قرأت الرواية، هل كنت ترى بأنها قابلة لأن تتحول إلى فيلم سينمائي؟
* نعم، ذلك لأن بناء الرواية خطي جداً، وهذا يتلاءم مع إمكانية تحويلها إلى الشاشة، غير أن الشكل اللغوي للنص ليس مناسباً على الإطلاق. إن جوهر أدب إلفريده يلينيك لا يكمن في القصص بل في الشكل السردي. إن اهتمامها الرئيسي يكمن في اللغة، وهذه اللغة غير قابلة للنقل أو التحويل. القصة ذاتها يجب أن تُروى بالوسائل التي يقترحها الفيلم. أنا لم أصنع نسخة سينمائية من الرواية، بل رويت قصة. بهذا المعنى، فيلمي ليس نسخة سينمائية من عمل أدبي.
– السيناريو كان مكتوباً قبل عشر سنوات أو أكثر.. لم باشرت العمل في هذه المادة الآن؟
* أولاً، لأن شخصاً ما اقترحه عليّ. ثانياً، لأن الشيء المفروض بالقوة بشأن القصة هو حالات الرصد المركّبة جداً في ما يتصل بالمجتمع، والتي تتخطى العلاقات المتبادلة الخاصة. هذه القصة مليئة بالتداعيات من دون الإكتفاء برواية القصة وحدها. إضافة إلى ذلك، احتوى العمل على ثلاثة أدوار عظيمة. أحد شروطي، عندما رُشحت لتنفيذ العمل هو التعاقد مع إيزابيل أوبير لتأدية دور إيريكا.
– لمَ هي تحديداً؟
* لأنها في رأيي أفضل ممثلة في أوروبا، إن لم يكن في العالم بأسره. هي من جهة لديها الحساسية والقدرة على إظهار المعاناة، ومن جهة أخرى، هي قادرة على إظهار وحشية الشخصية. إضافة إلى جمالها.
– هل لنا أن نتوقع منك تحقيق المزيد من الأفلام المبنية على نصوص أدبية؟
* لا، لكن هذا لا علاقة له بالتجارب الجيدة أو السيئة، إذ لديّ ما يكفي من المواد التي أرغب في استخدامها. النقاش الذي يتعلق بالشكل والمحتوى، والذي يحسم خاصية وجودة الفيلم في النهاية، يسهل حلّه حين يكون كاتب السيناريو والمخرج شخصاً واحداً. أجد أن هذه القاعدة مثيرة للإهتمام أكثر.
– كيف تتعامل مع مسألة ترجمة اللغة إلى الفيلم على نحو وافٍ وملائم؟
* اللغة مستخدمة في الحوار فقط، وقد ابتكرت بضعة مشاهد لم تكن واردة في الرواية. لقد قمت بمحاولة وصف العالم الداخلي ذاته في الفيلم، في الوقت نفسه، لم أفكر أبداً في كيفية استخدام لغة يلينك. مثل هذا الشيء سوف لن ينجح أبداً، ومحاولة ذلك سوف لن تكون مفهومة. الفيلم شكل فني مستقل، وهو يوظّف الأدب لغايةٍ فكرية. إلفريده يلينيك نفسها كانت مفتونة بفكرة أن ترى كيف يستفيد شخص آخر من المادة التي توفرها.
– هل عملت مع الكاتبة أثناء كتابة السيناريو؟
* ناقشت معها الشخصية الرئيسية عدة مرات في البداية. المشكلة أن الرواية عمرها الآن 15 سنة، وهي تصف مرحلة معينة بكل تفاصيلها. بينما جعلت أحداث الفيلم تدور في الحاضر، فإن المسألة هي إلى أي مدى يمكن تجسيد العناصر المهمة بالنسبة لها. لكن بشكل عام، هي على نحو واعٍ أختارت أن تبقى في الخلفية. لم تطالب بالاعتراف بها كخالقة وحيدة للعمل.
– الشخصيات النسائية في أفلامك دائماً هنّ الأقوى والأكثر غموضاً من الرجال..
* لست على يقين من أنهن الأعمق والأكثر غموضاً. النساء والأطفال (وهناك عدد غير متناسب من الأطفال في أفلامي) يلعبون دوراً مهماً لأن الضحايا يثيرون اهتمامي أكثر من الآثمين. إجمالاً، أنا أكثر اهتماماً بالنساء.. الرجال يثيرون ضجري.
– المستوى الوحيد الذي لا تستطيع الرواية الإتصال به، والذي هو مثالي بالنسبة للفيلم، الموسيقى..
* تلك هي هوايتي أثناء تحقيق هذا الفيلم. شخصياً أرى أن موسيقى الفيلم لا مكان لها في الأفلام، لأن 99%من وظيفتها أن تكون تعويضاً عن عجزٍ ما في التشويق أو الإثارة. المشاعر التي لا يتم خلقها عبر الحبكة أو الحدث، التصوير أو بواسطة الممثلين، تكون عندئذ منتجة بصلصة موسيقية أسفل كل شيء. لهذا السبب لن تجد أي موسيقى في أفلامي، إلا إذا اقتضتها القصة. بالطبع، فيلمي “معلّمة البيانو” يوفّر فرصة حسنة لاستخدام الموسيقى. اخترت مقطوعات شوبيرت التي أشارت إليها يلينيك ضمنياً في روايتها. بالطبع ذلك وفّر لي كقارئ سبباً منطقياً لإظهار ولعي بموسيقى شوبيرت، وبالذات الأغنية الألمانية.
* * * *
حوار آخر مع هانيكه
أجراه ستيوارت جيفريز
في كل أفلامه، يعقّد هانيكه دور المتفرج ويجعله إشكالياً وغير ثابت. فيلمه “معلّمة البيانو” مبني على رواية قائمة على السيرة الذاتية للروائية والكاتبة المسرحية إلفريده يلينيك، التي اختارت العزلة والابتعاد عن الحشود والأضواء. ومثل الشخصية الرئيسية في العمل، نشأت يلينيك مع أم كاثوليكية، مستبدّة، من الطبقة المتوسطة، والتي كانت تريد منها أن تصبح عازفة بيانو. ومثل الشخصية أيضاً، والدها مات في مصح نفساني. لكن بينما الرواية تشجب الثقافة الموسيقية في وسط البورجوازية الصغيرة في النمسا، وتدين قمع النساء في المجتمع النمساوي، نجد أن إعداد هانيكه يجاهد في أن لا يقول شيئاً معيناً عن بلاده، وعوضاً عن ذلك، يركّز على ثيمات التلصصية، والنزعة السادية المازوشية، والقمع الثقافي، من دون أن يطلق أحكاماً قاطعة.
يقول هانيكه:
عندما عرضتُ فيلمي الأول “القارة السابعة” هنا، في النمسا، قبل 12 سنة، كان المتفرجون غير النمساويين يأتون إليّ متسائلين في دهشة “هل حقاً النمسا فظيعة ومخيفة إلى هذا الحد؟”. كنت أقول، هذا الفيلم ليس عن النمسا، بل عن الثقافات التي أصبحت صناعية، والموجودة في كل مكان. من اليسير على المتفرج أن يأخذ هذه العناصر التي تزعجه والتي أرغب منه في تلمّس طريقه بها ويقول “لا أريد أن أتعامل معها، هي لا تعنيني”. وفي حالة “معلّمة البيانو” سيكون من اليسير على المتفرج أن يضع اللوم على الثقافة الموسيقية في فيينا لما تعانيه إيريكا من مشاكل وأزمات. لهذا السبب لم أرد أن أبالغ في عرض العناصر الموسيقية في فيينا.
المقطوعات الموسيقية الموظفة في الفيلم هي في كل مكان.. خصوصاً سوناتات شوبيرت الأخيرة على البيانو.
يقول هانيكه:
“اختيار الموسيقى كان أحد الأشياء الممتعة في تحقيق هذا الفيلم. لكنني أكنّ احتراماً بالغاً للموسيقى يجعلني أتجنب استخدامها بشكل عشوائي في الفيلم، ولهذا السبب يندر استخدامي للموسيقى في أفلامي. عادةً تُستخدم الموسيقى في الأفلام لتغطية بعض النواقص. هنا الموسيقى تصبح جزءاً من الفيلم نفسه. بعض المقطوعات واردة في الرواية نفسها.. كونشرتو باخ على سبيل المثال. في الرواية، تقول إيريكا أن الموسيقييْن المفضلّين لديها هما شوبيرت وشومان، لكن مسألة اختيار المقطوعات كانت راجعة إليّ”.
دور الطالب فالتر كليمر (ماجيمل) هو صعب لأن، قرب نهاية الفيلم، هو منح إيريكا أغلب الأشياء التي طلبتها منه في رسالتها. مع ذلك، رغم أن هذا استدعى الكثير من العنف، فإن الفيلم يساعد المتفرج على فهم سلوك الشخصية.
يشرح هانيكه قائلاً:
“في الرواية، يلينيك على نحو متواصل تحقّر فالتر وتسميه الحمار. بإمكانك أن تفعل هذا في رواية ما ، لكن في الفيلم إن أطلقت صفة الحمار على الشخصية فسوف ترى، في خمس ثوانٍ، كيف ينتهي فيلمك. كان من المهم ترك فالتر كشخصية مفتوحة من أجل تطابق محتمل من خلاله يتفاعل معها المتفرج. إني أحاول أن أترك أفلامي مفتوحة قدر الإمكان. والأمر راجع إلى المتفرج إن أراد أن يمسك بما يراه ويحاول أن يجد تفسيراً ما”.
في نهاية الفيلم، إيريكا تتعرض للضرب والإعتداء الجنسي. هل علينا أن نعتقد بأنها ترحّب بمصيرها؟ أم الأسوأ من ذلك، أنها تستحق ما يحدث لها؟ وأن المعتدي لديه مبرراته؟
هانيكه يرفض أن يعطي أية إجابة سهلة:
“يتعيّن عليك أن توؤل ذلك بنفسك. أنا أتيح للمتفرج أن ينهي الفيلم في ذهنه”.
The Guardianعدد 24 مايو 2001