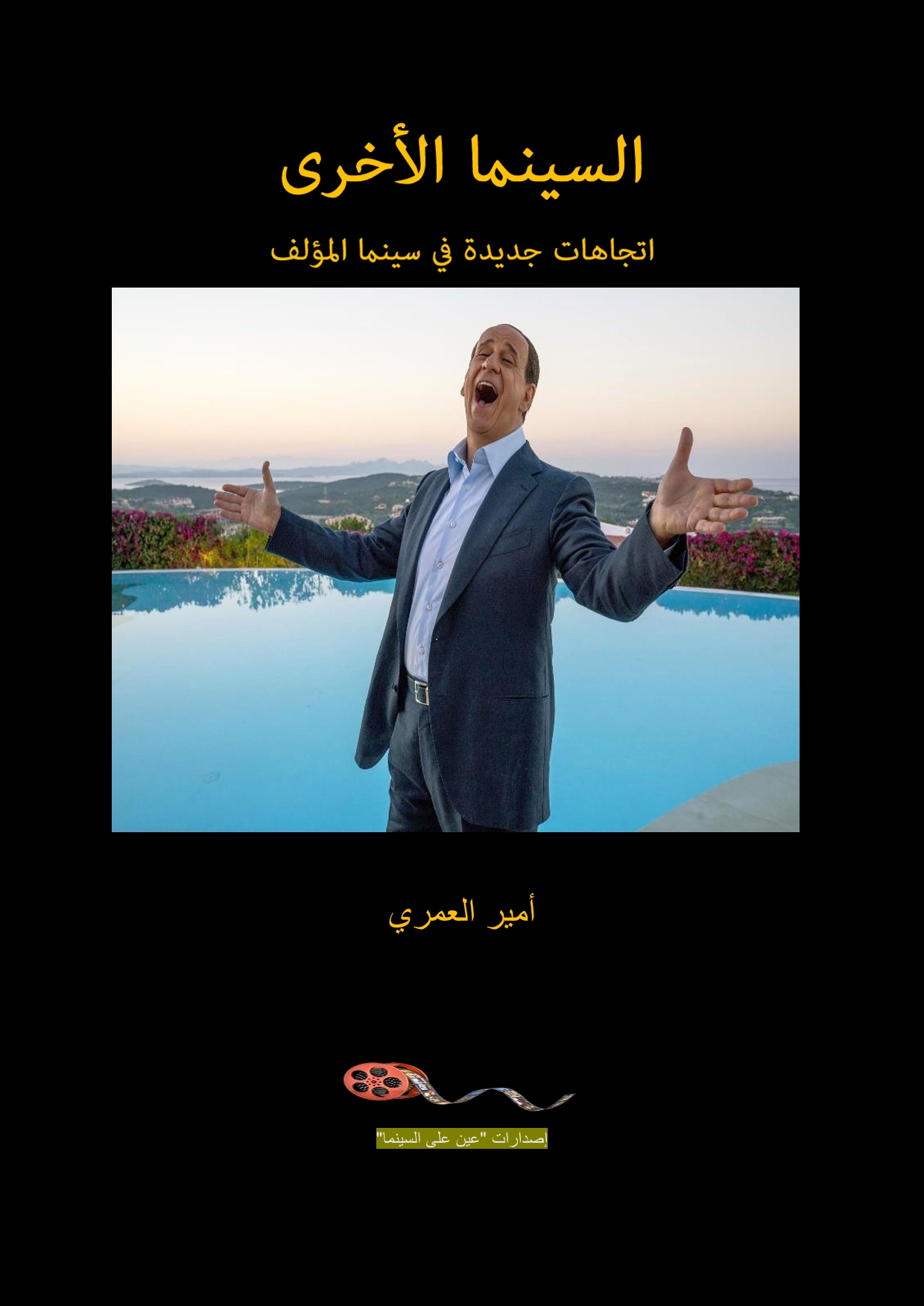“أميرة”عمل سينمائي جيد: مأزق الهوية
 أميرة وزياد.. لقطة من فيلم "أميرة"
أميرة وزياد.. لقطة من فيلم "أميرة"
عرض فيلم “أميرة” بمهرجان فينيسيا السينمائي في سبتمبر الماضي، ثم عرض بمهرجان الجونة، ثم بمهرجان قرطاج، واستقبل استقبالا حسنا، أو على الأقل، لم يثر أي اعتراض من جانب الذين شاهدوه. ولكن عندما عرض بمهرجان عرضه الكرامة لأفلام حقوق الإنسان في عمان، قامت قيامة الكثير من الأفراد والمؤسسات. صدرت بيانات رسمية، وانتشرت حمى النقد على مواقع التواصل الاجتماعي، من طرف مئات بل وآلاف الأشخاص الذين لم يشاهدوا الفيلم، لمجرد “ركوب موجة الوطنية” والحماسة بدعوى أن الموضوع يسيء الى صورة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
لم ينتظر أحد مشاهدة الفيلم، فلم يكن مهما مشاهدته كما أعلنوا وصرحوا بكل جرأة، بل المهم اللحاق بموكب الإدانة الرسمية التي انتهت الى اضطرار منتجي الفيلم إلى سحبه ووقف عروضه حتى في مهرجان جدة السينمائي. والغريب أن ينبري أيضا بعض الذين سبق أن شاهدوا الفيلم في المهرجانات الثلاثة وصمتوا عنه، للتعليق الغليظ ضده وكأنهم اكتشفوا الآن فقط، أن الفيلم يسيء للنضال الفلسطيني ولصورة الفلسطينيين عموما في حين أن أي نظرة مدققة يمكن أن ترى عكس ذلك. لكن أحدا لا يشاهد ولا يريد أن يشاهد.
كان من المؤسف للغاية، أن يكتب بعض من أعرفهم وأعرف جديتهم، عن فيلم لم يشاهدوه دون أن يحللوا حبكته وطريقته في عرض قصته، بدعوى أنهم يعترضون على قصته التي لم يعرفوا أصلا كيف تمت صياغتها في عمل سينمائي، والغرض الوحيد هو تأكيد “الوطنية” واللحاق بالموكب الغاضب. وهي ظاهرة لا وجود لها في أي مكان في العالم على قدر علمي!
ومن نافلة القول إن من حق أي شخص أن يختلف مع أي فيلم سينمائي، وأن يرفضه، ويرفض مشاهدته بل وأن يتظاهر ضده ويصدر ما يشاء من بيانات وبلاغات، ولكن ليس من حقه أن يطالب بمصادرة عمل لا يعجبه، وعقاب الذين صنعوه، فهذه هي الفاشية بعينها التي أصبحنا نعاني منها في المنطقة العربية عموما، نتيجة غياب المنابر التي تتيح النقاش الحر، وبسبب تدني الثقافة السينمائية عموما. وهي محنة ما بعدها محنة لأننا يمكن أن نحترق بنيرانها جميعا.
شاهدت الفيلم أخيرا. وأرى أنه عمل جيد، بل وجيد جدا، ليس فقط من الناحية السينمائية رغم بعض العيوب، ولكن من الناحية الفكرية والسياسية أيضا. وهو يضيف دون أدنى شك، إلى رصيد مخرجه المصري محمد دياب، وهذا هو فيلمه الروائي الطويل الثالث، وأول إنتاج مشترك بين مصر والأردن بتمويل من شركات في السعودية والإمارات، قائم على سيناريو كتبه مخرجه مع شقيقيه خالد وشيرين دياب. وجميع الذين شاركوا بالتمثيل في الفيلم، وغالبية طاقم منتجيه، هم من الفلسطينيين الذين لا يمكن التشكيك في إخلاصهم لقضية فلسطين بأي شكل من الأشكال.
أجد هنا لزاما علي بكل أسف، أن أبدأ قبل تناول الفيلم نفسه، بالقول مجددا، أن الأفلام ليست هي الواقع نفسه، بل صورة متخيلة لواقع آخر بديل، خيالي، قد يمزج الحقيقة بالخيال، وقد ينطلق من حادثة حقيقية، ليصنع سياقا خياليا يخدم فكرة أساسية، ويعبر عن رؤية صاحبها. ولعل الإشكالية التي أدت إلى كل ما ناله الفيلم من هجوم، ترجع إلى الفكرة المستقرة لدى الكثيرين، وهي أن الفلسطيني عموما، والفلسطيني المناضل خصوصا، لا يجب تصويره في صورة سلبية، وذلك حسب المفهوم السائد الممتد من “الواقعية الاشتراكية” حسب مفهوم ستالين ومنظره العقائدي الأدبي والفني، أندريه زدانوف Andrei Zhdanov، التي تقتضي أن يكون البطل- المناضل- رمز الطبقة العاملة والمضطهدين عموما، بطلا إيجابيا دائما، لا تشوبه شائبة. فماذا لو جاء فيلم يقول إن البطل المناضل الأسير الفلسطيني، “عقيم” لا يمكنه الإنجاب، وأن ابنته التي تعتز بكونها “ابنة البطل”، جاءت أصلا نتيجة خلط نطفة الأسير بنطفة حارس السجن الإسرائيلي؟ ثم كيف يمكن مشاهدة رد الفعل الذكوري البطريركي العنيف من جانب العائلة الفلسطينية، الذي يدين في البداية الأم المتهمة بخيانة زوجها البطل الأسير، الذي لم تمارس معه علاقة جنسية قط، قبل أن تتضح الحقيقة الصادمة، ليصبح مكتوبا على الابنة “أميرة” البريئة التي لم يكن لها دخل فيما حدث، الخروج من المجتمع الفلسطيني بأسره قبل أن تصبح ضحية لبعض المندفعين الذين يعشقون الإدانة والشجب والشطب، تماما مثل غالبية الذين هاجموا الفيلم من دون أن يشاهدوه!

في المشاهد الأولى من الفيلم نرى “أميرة” (تارا عبود) وأمها “وردة” (صبا مبارك) يسيران ضمن صفوف الزوار الذين يشقون طريقهم بصعوبة بين الحواجز الحديدية في طريقهم الى السجن حيث يوجد اقرباءهم وذويهم من الأسرى الفلسطينيين، هذه المشاهد الواقعية تماما تجعلنا نشعر بأن الفلسطينيين أصبحوا جميعا سجناء.. وكأنهم يذهبون الى مصائرهم.. والمشهد يشبه كثيرا، دفع اليهود داخل معسكرات الاعتقال الجماعي النازية في أفلام “الهولوكوست” وهو مشهد يعرفه جيدا الأوروبيون من مشاهدي السينما.
بعد العبور عبر الحواجز الحديدية، تمر الاثنتان بتفتيش الحقائب ثم التفتيش الجسدي بالأجهزة، ثم التجريد من الثياب بالكامل، قبل الانتقال في حافلة إلى سجن مجيدو. وهناك سيحدث اللقاء بين أميرة، ووالدها، وسنعرف أنها قيدت أصلا باعتبارها ابنة لعمها، بسبب التحايل الذي حدث والتلقيح بالنطفة التي تم تهريبها من السجن في الماضي.
كان الأسير “نوار” (علي سليمان) والد أميرة المفترض، قد تزعم اضرابا عن الطعام داخل السجن منذ فترة، وهو الآن يقول لزوجته وابنته أنهم بصدد انهاء الاضراب بعد أن قبلت إدارة السجن بعض مطالبهم، ويعرب عن رغبته في انتهاز فرصة تخفيف الإجراءات، في تهريب نطفة جديدة للحصول على طفل آخر.
سنعرف أن وردة تزوجت نوار بعد دخول السجن، أي أنها لم تعاشره جنسيا قط، وأن أميرة تحب الشاب زياد الذي يريد أن يتزوجها. وزياد يقول لأميرة إن أمها تعيش “نصف حياة” بعد أن تزوجت والدها دون معرفة حقيقية وبعد أن أصبح سجينا. لكن أميرة تقول لأمها في سياق لومها على “أنانيتها” و”تفكيرها في نفسها”- كما تزعم- أنها، أي وردة، إن كانت تعيش نصف حياة، فوالدها، لا يعيش على الاطلاق. وتبدو قسوة أميرة على أمها التي تتبدى في الجزء الأول من الفيلم، غير مبررة بل وغير مفهومة وإن كان المقصود تكثيف صلتها (الروحية) بوالدها المناضل الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة بسبب انغماسه في النضال، خصوصا وانها تضع باستمرار في الصور التي تصنعها بواسطة برنامج الفوتوشوب، صورتها الى جوار صورة والدها، مع استبعاد الأم من الصور. وأميرة مصورة مبتدئة لديها ستديو صغير، وهي في الوقت نفسه طالبة في المدرسة الثانوية.

ما سيحدث بعد تهريب النطفة الجديدة، أن يكتشف الطبيب أن نوار مصاب بالعقم من البداية، وليس كمرض طاريء، وهو ما يعني أن أميرة ليست ابنته البيولوجية رغم أنها ابنته الروحية.. الطبيب، وبعد اتهام الأم بالخيانة ثم تبرئتها، كما أسلفنا، سيستقر الأمر على أن الاحتمال الوحيد هو أن يكون الحارس الإسرائيلي المرتشي قد عبث بها واستبدل بها نطفته. وبالتالي أصبحت أميرة –بيولوجيا- نصف إسرائيلية نصف فلسطينية، أي تنتمي لأب إسرائيلي وأم فلسطينية والأهم أنها ليست ابنة نوار. وهو مأزق أميرة ومأزق الفيلم كله!
حبكة درامية قد تبدو مستحيلة لكن هذا لا يجردها من الاحتمالية، خصوصا وأن تهريب النطف من داخل السجون الإسرائيلية، وتلقيح زوجات الأسرى بها، حقيقة معروفة تقع منذ سنوات. أما استخدامها في الفيلم فلهدف سياسي واضح. فالفيلم يطرح إشكاليتين على درجة كبيرة من الأهمية: الإشكالية الأولى هي موضوع الهوية والانتماء. هل تكون الهوية بالجينات وبالحامض النووي حتى لو كانت مكوناته جاءت نتيجة التلاعب والتخريب المتعمد؟ أم أنها مشاعر وتكوين منذ الولادة وارتباط بالأرض والناس والوطن والأحلام المشتركة؟
أما الإشكالية الثانية فهي: ازدواجية القهر الواقع على الفلسطينيين من جانب الإسرائيليين: فالاحتلال لا يمارس القهر والعنف والتشريد وهدم البيوت وقصف الآمنين وترويعهم عن طريق الطائرات المسيرة التي تحلق ليلا ونهارا فوق رؤوسهم (كما نرى)، بل يتدخل بكل خسة ونذالة، ويحول بين رغبة الأسير في الانجاب، بالتلاعب بالنطفة بغرض الاذلال والترهيب. وهذا هو المغزى الحقيقي للموضوع الذي لا يسيء بأي شكل إلى الأسرى وذويهم، بل يجعلهم جميعا، ضحايا الاحتلال الإسرائيلي.
لا يدين الفيلم المجتمع الفلسطيني بشكل عام، لكنه يتوقف أمام حادثة محدودة، فبعد انتشار القصة، تتعرض أميرة من مضايقات من جانب زميلاتها في المدرسة، كما يرسم أحدهم نجمة داود على بيتها. وهي تصرفات قابلة للحدوث في الواقع. لكنه في الوقت نفسه، لا يجعل عائلة نوار تدين الفتاة، بل تتعاطف معها، وما رغبتهم في دفعها للابتعاد سوى لحمايتها من الظنون والشكوك وعدم الوقوع في متاهة الهوية الممزقة. ولكن الفيلم يحتار أن يدفع بها الى مصير تراجيدي، وهو احتيار يغلق الفيلم تماما، ولم يكن موفقا في رأيي.

يمتلئ الفيلم بصور ولقطات كثيرة نابضة بالحياة.. ويتعاون دياب مع المصور أحمد جبر، في الحصول على لقطات بديعة للأماكن تحاكي الأماكن الفلسطينية التي لم يمكن الوصول إليها ودار التصوير في مواقع بديلة في الأردن اختيرت بعناية ودقة بما في ذلك ما يشبه الجدار الفاصل، ومن أهم عناصر الفيلم ذلك الحرص الكبير من جانب المخرج على تكثيف العلاقة بين الشخصيات والأماكن، باستمرار، والاهتمام الكبير بوضع الشخصية في إطار كادرات تنبض بالحياة والحركة وصخب الواقع.
تتداعى الأحداث تدريجيا، وتتعقد الحبكة كلما مضى السرد إلى الأمام، مع الانتقال بين الليل والنهار، والداخلي والخارجي، مع إيقاع لاهث، وصورة خانقة مع إضاءة شاحبة، في المشاهد الداخلية، تكثف حالة الاختناق واللهاث القريبة من “الكلوستروفوبيا”، مع تحكم في التصوير الخارجي في الشوارع، وحركة المجاميع وضبط خلفية الصورة. وهو ما يعكس الجهد الكبير والجدية التي تكمن وراء تنفيذ الفيلم كله، بأعلى درجة من الاحترافية.
من أفضل مشاهد الفيلم، تكوينا وأداء وإخراجا، مع استخدام القطع المتوازي، مشهد المحادثة التليفونية بين نوار ووردة، بغرض أن تساعده وردة بإبداء مشاعر حب حقيقية، على الوصول لذروة الإثارة الجنسية ومن ثم الحصول على السائل المنوي الذي سيستخدم في التلقيح الاصطناعي كما كان مقررا.. والمشهد مكتوب ومصور ببراعة، من خلال حوار دقيق غير مبتذل، وتصوير وأداء شديد الصدق والعذوبة والرقة من قبل صبا مبارك وعلي سليمان.
والحقيقة أن أداء مجموعة الممثلين جميعا في الفيلم، يبدو متجانسا ومتناغما، فهم يؤدون وكأنهم يعيشون أدوارهم في الواقع، بإحساس مرهف، ودرجة لا تخفى من الاستمتاع بالعمل معا. هذه الكيمياء الرائعة بين صبا مبارك (وردة) تارا عبود (أميرة) و”نوار” (علي سليمان) ترتفع بالفيلم إلى مستوى الشعر في مشاهد عديدة.

ربما كان الجزء الأخير يقتضي بعض التهذيب وضبط المونتاج بل واستبعاد الكثير من التفاصيل التي أربكت الفيلم واضعفت نهايته وهبطت بالإيقاع العام، كما أن مصير أميرة كما يصوره الفيلم، يسقط في النمطية المباشرة، إضافة الى أنه لم يكن مقنعا، فليس من المعقول أن تصر أميرة على الانتقام من الحارس الإسرائيلي بقتله بعد مرور 17 عاما، وتتمكن بمساعدة حبيبها وصديقه، من اقتحام الحدود بغرض الذهاب إلى بيته في تل أبيب، قبل أن تتراجع عن نيتها قتله بعد أن تشاهد في اللحظة الأخيرة، بعض صوره مع أفراد عائلته على جهاز الهاتف المحمول.. فكيف لم تدرس حالته وتشاهد مثل هذه الصور من قبل.. وهي المصورة التي تستخدم الكومبيوتر في العمل؟!
شخصية المدرس “هاني” (الذي يقوم بدوره قيس ناشف) لم يكن لها ضرورة درامية، وكان يمكن استبعادها تماما من الفيلم أو تقليص مساحتها. ولم يكن مقنعا أن تطلعه وردة على تفاصيل المأزق كما حدث. لكن الغرض الدرامي الذي يغطي هذا الجانب الضعيف من الفيلم، هو القاء الشك على علاقة وردة بهذا المدرس قبل أن تتضح الحقيقة بالطبع.
الفيلم يكشف بوضوح على تترات النهاية، من خلال المعلومات التي تظهر على الشاشة، أنه “منذ عام 2012 ولد أكثر من 100 طفل بطريقة تهريب النطف، وأن طرق التهريب تظل غامضة، وأن كل الأطفال تم التأكد من نسبهم”. وسواء كان عدد النطف 100 أم 80، لم يهم، ولا يقلل من قيمة الفيلم، ولا يعد مأخذا عليه، فهذا على أي حال، ما حدث في “الواقع” الحقيقي in real life. أما الفرضية التي يطرحها الفيلم فهي فرضية نظرية متخيلة. لكنها فرضية تثير الفكر والتأمل وتطرح علينا تساؤلات كثيرة، صحيح أنها قد تكون شاقة وصادمة عند البعض، لكنها تظل في نهاية الأمر، جزءا من الخيال السينمائي وضمن دور الفيلم في عالمنا. أليس كذلك!