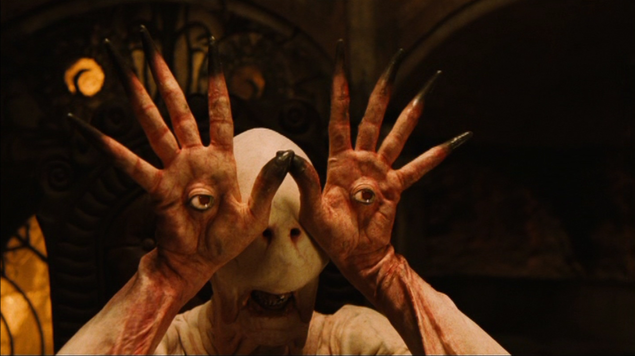لويس بونويل: ذلك العبقري الذي جعل الفيلم كقصيدة الشعر
 كاترين دينيف في لقطة من فيلم "حسناء النهار"
كاترين دينيف في لقطة من فيلم "حسناء النهار"
يعد بونويل واحداً من أعظم المخرجين في تاريخ السينما. قدّم انجازات فنية رائعة، وأبدع – خلال خمسين سنة من مسيرته السينمائية – أفلاماً ذات خاصية عالية، فكرياً وجمالياً، احتلت مكانة بارزة في عالم السينما.
في أفلامه، ذات الحس السوريالي، الهجائي، الساخر، نجد نقداً عنيفاً للقيم البورجوازية والدينية والعائلية، ولمؤسسات الدولة، من خلال رؤية ثورية، تتحد فيها النظرة الماركسية والفرويدية، موظفاً المخيلة السوريالية والدعابة التهكمية.
الطبقة البورجوازية – بكل مؤسساتها ونظمها وتقاليدهاورموزها وتفاؤليتها، وممارساتها الوحشية والقمعية، وجوعها إلى السلطة، وشعورها بالإثم – هذه الطبقة كانت هدفاً أساسياً لهجمات بونويل وسخريته اللاذعة وهجائه المرير ومحاولاته العنيدة، المتواصلة، لفضح أسسها ومقوماتها، لاستجواب بقائها واستمراريتها، ولتقويض عالمها الصقيل الخادع.

الإيروسية والموت
عن طفولته ونشأته، يتحدث بونويل، فيقول من كتاب: The World of Luis Bunuel، تحرير: جوان ميلين:
“ولدت في 22 فبراير 1900، في كالاندا، إحدى مدن إقليم تيرويل باسبانيا. أبي أمضى كل حياته تقريباً في أمريكا، حيث نجح كتاجر في جمع ثروة لا بأس بها. في الأربعين من عمره قرر أن يعود إلى بلدته الأصلية، كالاندا، وهناك تزوج المرأة التي أنجبتني، وكانت في السابعة عشرة من عمرها. وقد نتج عن هذا الزواج سبعة أبناء، كنت أولهم.
طفولتي انزلقت في مناخ شبيه بمناخ القرون الوسطى (كما هو الحال تقريباً في جميع المقاطعات الأسبانية). أشعر أن من الضروري توضيح (بما أن هذا يفسر إلى حدٍ ما اتجاه أعمالي المتواضعة التي أنجزتها فيما بعد) أن ثمة نزعتين أساسيتين هيمنتا عليّ منذ الطفولة وحتى مرحلة المراهقة: الأيروسية العميقة، المنصهرة في إيمان ديني حاد، والوعي الدائم بحضور الموت. إن تحليل الأسباب يتطلب مجالاً واسعاً ووقتاً طويلاً، يكفي القول بأنني لم أكن استثناءً بين زملائي، فقد كانت صفة مميزة أسبانية جداً. وفننا، الذي يمثّل الروح والشخصية الأسبانية، كان ملقّحاً بهاتين النزعتين، أو هذين العاملين. والحرب الأهلية (في أسبانيا)، الفريدة في ضراوتها وخاصيتها، فضحتهما بوضوح. سنواتي الثمانية، كطالب مع القساوسة اليسوعيين، غذّت ونمّت هاتين النزعتين عوضاً عن تقليصهما”.
كراهية الدراسة
ويواصل بونويل (المصدر ذاته): “حتى حصولي على البكالوريا، في السادسة عشرة من عمري، لم أكن أعتبر نفسي فرداً منتمياً إلى المجتمع الحديث. ذهبت إلى مدريد للدراسة: كان الانتقال من الإقليم إلى العاصمة مذهلاً بالدرجة نفسها التي يشعر بها صليبي وجد نفسه فجأة في الشارع الخامس في نيويورك.
عندما تخرجت حاملاً شهادة البكالوريا، سألني أبي عن المجال الذي أرغب في دراسته. كنت مولعاً أساساً بشيئين: الموسيقى (وقد سبق أن تدربت قليلاً على عزف الكمان) والعلوم الطبيعية. طلبت من أبي أن يسمح لي بالذهاب إلى باريس والالتحاق بمعهد موسيقي، غير أنه رفض بشدة وحاول إقناعي بأن الفنان عرضة للموت جوعاً. ذلك كان موقف أي أب أسباني (وربما أي أب في أي بلد آخر). ثم أخذ يطري اهتمامي الآخر: العلوم الطبيعية، وألح عليّ أن أذهب إلى مدريد لأدرس الهندسة الزراعية.
في 1917 وجدت نفسي مستقراً في مدريد، مقيماً في سكن الطلبة. الملفت للنظر أن مهنة مهندس زراعي، في أسبانيا، هي الأكثر صعوبةً، مع ذلك يسعى إليها الشاب لأنها مهنة مشرّفة جداً، أرستقراطية جداً. طموح الشاب الأسباني، الأرستقراطي، أن يصبح مهندساً أو دبلوماسياً. وهذه الدراسة كانت تقتضي ذكاءً ومورداً مالياً كافياً، بسبب التكاليف الباهظة بالقياس إلى أسلوب الحياة البسيطة والمتواضعة.
في مجال الهندسة الزراعية كان هناك وضع عبثي وسخيف، إذ من الضروري أن يدرس المرء الرياضيات لمدة ثلاث سنوات، وبذلك نجحوا في جعلي أكره الدراسة.
عندئذ قررت أن أتحرك حسب مشيئتي وأن أفعل بناءً على رغبتي الذاتية، لذلك قررت، في 1920، ومن غير أن أنتظر إذناً من والدي، أن أدرس الحشرات على يد عالم الحشرات الأسباني الدكتور بوليفار، مدير متحف التاريخ الطبيعي في مدريد.. رغم أن هذه الدراسة لا تخوّل المرء لتحقيق مكاسب مادية بعد التخرج. كرّست نفسي للحشرات لأكثر من عام، ثم توصلت إلى نتيجة بأنني كنت مهتماً بحياة أو أدب الحشرات أكثر من التشريح والتصنيف والوظائف الفسيولوجية”.
تأسيس النفس
ويقول بونويل (المصدر ذاته): “في ذلك الوقت، في سكن الطلبة، كوّنت صداقات حميمة مع مجموعة من الفنانين الشبان الذين كان لهم تأثير قوي في تشكيل ميولي، مثل: الشاعر فدريكو غارثيا لوركا، الرسام سلفادور دالي، الشاعر والناقد مورينو فيلا.. وغيرهم.
إن ميولي الأدبية الجديدة جعلتني أدرك بأن هدفي كان الفن والأدب، وليس العلوم الطبيعية، فقد كنت أفضّل المناقشات مع الأصدقاء في المقهى على الجلوس أمام الطاولة والتحديق عبر الميكروسكوب. لذلك غيّرت مجالي مرة أخرى وشرعت أدرس الفلسفة والأدب.
لا أستطيع الزعم بأني كنت طالباً مثالياً. وقتي كان موزعاً بين اجتماعات الأصدقاء اللانهائية، وكتابة الشعر والرياضة. في العام 1921 أصبحت بطل الملاكمة للهواة لأن الأعور، في بلد العميان، ملك.. كما يقول المثَل.
تخرجت من جامعة مدريد في العام 1924. بعد انتهائي من الدراسة وجدت نفسي تائهاً. المَخرَج الوحيد كان أن أمارس مهنة التدريس في معهد أو جامعة، وهي المهنة التي لم أشعر أنها تتوافق مع طبيعتي وميولي. كنت في الرابعة والعشرين، وكان عليّ أن أفكر بجدية في تأسيس نفسي وفق طموحاتي. مع ذلك شعرت بالتردد والارتباك أكثر من أي وقت مضى. هذا هو الخطأ الشائع بين الأسبان: عوضاً عن جعل الشاب ينمو وفق استعداداته وقابلياته وميوله، فإنهم يرغمونه على إتباع السبيل الذي رسمه والداه. الطالب، عندما يغادر حضن عائلته، ويجد نفسه مستقلاً، ينجذب إلى الحياة أكثر من الدراسة.
إن توتري وقلقي قد تبددا مباشرة حين وافقت أمي على سفري إلى باريس. أبي كان قد توفى قبل عام”.
في العام 1925 انتقل لويس بونويل من اسبانيا إلى باريس واستقر فيها. هناك برزت ميوله للعمل في السينما، فاشتغل مساعداً للمخرج جان ابشتاين في فيلمين.

بعد ذلك انضم إلى الحركة السوريالية، التي عنها يقول (كاييه دو سينما، يونيه 1954): “السوريالية علمتني أن للحياة مغزى أخلاقيالا يمكن تجاهله. عبر السوريالية اكتشفت أيضاً، وللمرة الأولى، بأن الإنسان ليس حراً. كنت أعتقد بأن حريتنا مطلقة، لكنني وجدت في السوريالية نظاماً ينبغي أن يُتبع. ذلك كان أحد الدروس العظيمة التي تعلمتها في حياتي. خطوة مدهشة وشعرية. ماذا تعني التجربة السوريالية بالنسبة لي؟ إنها تعني شيئاً واحداً: التضامن الجماعي”.
التأثرات
في البداية تأثر بونويل بفناني الكوميديا في السينما الأمريكية. وبالمخرج ستروهايم Stroheim”لكن الفيلم الذي ألهمني فعلاً، وجعلني أرى السينما – للمرة الأولى – كوسط فعال في التعبير الفني، كان فيلم فريتز لانغ: المصابيح الثلاثة”. (حوار بونويل مع الكاتب المكسيكي كارلوس فوينتس، مجلة نيويورك تايمز، 11مارس 1973) ويضيف في المقابلة ذاتها:
“إلى جانب الثقافة الأسبانية، قرأت فرويد، دو ساد، ماركس وإنجلز، ومؤلفات العالِم الاختصاصي بالحشرات جان هنري فابري. ميولي الأدبية متغيرة مثل الطقس”.
الكتابة: عمل شاق حافل بالشكوك
يتبع بونويل منهجاً خاصاً في العمل مع كاتب السيناريو، وهو يوضح هذا المنهج أو الطريقة في أحدحواراته قائلاً: “أحتاج دوماً إلى وجود كاتب ما يتعاون معي في الكتابة. ذلك لوجود عيب أساسي فيّ، وهو التكرار. لو كتبت وحدي فسوف أحتاج إلى ثلاثة أيام لكتابة مشهد واحد، والذي يمكن إنجازه خلال ثلاث ساعات مع وجود كاتب أتحدث إليه وأناقشه. لكن بما أنه فيلمي، فأنا موجود هناك، مع الكاتب، في كل مرحلة” (Show, April 1970).
بونويل عمل بالتعاون مع كاتب السيناريو الفرنسي جان- كلود كارييه في كل أفلامه منذ “يوميات خادمة” (1963). في مقالة كتبها كارييه، عن تجربته مع بونويل وعملية التعاون بينهما(المقالة منشورة في مجلة Show, April 1970) يقول كارييه:
“بونويل يكشف عن كل شكوك الفنان الخلاق وقلقه أثناء كتابة السيناريو. هو هنا مؤلف أكثر مما هو مخرج. مع ذلك فإن المفارقة تكمن في أنه لا يكتب إلا نادراً وبمشقة. عندما يتواجه مع الكتابة، فإنه يحتاج إلى شخص آخر يتعيّن عليه أن يدوّن بالقلم ما تم الاتفاق عليه بعد مناقشة الأفكار. أنا واعٍ تماماً لحقيقة أن عالم بونويل هو خاص جداً، شخصي جداً، إلى حد أن من العبث، أو من غير المجدي، اقتراح أفكار عليه والتي من المفترض أن تثير حماسته. عندما نواجه صعوبةً ما، فإنه يقترح نصف دزينة من الحلول الممكنة، وإذا هو طلب النصيحة فلكي يتلقى عوناً في اختيار أنسب الحلول. إن مخيلته متألقة وغير محدودة. وحين أعمل معه، غالباً ما يتكوّن لدي انطباع بأنني جمهوره الأول. أحياناً حسه النقدي، الذي هو حاد جداً، يغمر جانبه التخيلي. ويعاني فترات من الإحباط حين يبدو له كل شيء غبياً وطفولياً. في بعض الأحيان هو يحتاج إلى المساعدة لكنس شكوكه بعيداً، ولكي يجد اتجاهه مرة أخرى، ويمنح جانبه التخيلي الهيمنة من جديد. إنه يحب أن يعمل بانتظام لمدة خمس أو ست ساعات يومياً تقريباً. ذلك يعطيني الوقت الكافي لتخطيط ما تحدثنا بشأنه، ثم أكتب الحوار وأطبع المسودة. في المساء، حين نخرج ونرتاد مقاهي مدريد، لا نتحدث عن عملنا على الإطلاق. يفضّل أن يبتهج في حضور أصدقائه في أماكنه المفضّلة. في السيناريو هو يضمّن كل التوجيهات بشأن الملابس أو الديكورات، والتي سوف تساعده وقت التصوير، لكنه أبداً لا يضمّن أي تعليمات أو توجيهات تقنية. يفضّل أن يترك شيئاً للاكتشاف أثناء التصوير الفعلي، قائلاً: لو كان كل شيء مدوّناً في السيناريو، فلماذا نكلّف أنفسنا مشقة تحقيق الفيلم؟”.
يقول بونويل إن الفيلم، بالنسبة له، غالباً ما يتحقق في مرحلة الكتابة، فعندئذ تنشأ كل المعضلات التي ينبغي حلها قبل الشروع في التصوير.
أما بالنسبة للمادة أو القصة، أحياناً يختار موضوعات مباشرة، وأحياناً يلجأ إلى الإعداد من قصص وروايات مطبوعة. الصدفة هنا هي التي تحكم. والقصة، عند بونويل، غالباً ما تُبنى من صور غير مترابطة.

الفكرة
ينطلق بونويل، في بناء أفلامه، من صورة أو فكرة واحدة تفتنه وتتشبث به، والعمل بأسره يتدفق من هذه الصورة مثل نافورة.
يقول بونويل: “قد تكون صورة شاهدتها. على سبيل المثال، صورة القديسة فيريديانا، الصورة القادرة على إطلاق صور أخرى، والتي بدورها تفضي إلى فكرة كاملة. هناك أيضاً الواقع، كما هو منقول بواسطة مواد إخبارية يومية، والرصد المباشر”.
لقد نما فيلمه “فيريديانا” من رؤيته لرجل عجوز يحيط بذراعه فتاة عاجزة عن مقاومته لأنها واقعة تحت تأثير مخدّر ما.
وفيلمه “سيمون الصحراء” نشأ من صورة قديس يعتزل العالم ويعيش على قمة عمود. إنها قصة سيمون الناسك الذي فعل ذلك بالضبط في مكان ما بآسيا في القرن الرابع.
السرد
في أفلامه الأخيرة (بالذات: سحر البورجوازية الخفي، شبح الحرية) استخدم بونويل تقنية سردية فريدة واستثنائية. كل قصة في الفيلم تفضي إلى أخرى وإلى أخرى وهكذا.
في فيلمه “شبح الحرية” ليس هناك أي نقطة التقاء. القصص تنطلق ولا تعود أبداً، لا تلتقي عند نقطة معينة. ليس هناك توالٍ أو تعاقب للحبكة. نحن نبدأ داخل قصة ونتركها لنتتبع إحدى الشخصيات الثانوية في القصة، والتي سوف تصبح شخصية رئيسية في القصة التالية، ثم نتركها بدورها لنلاحق شخصية ثانوية أخرى.. وهكذا.
يقول بونويل (1953): “السينما صارت تكرّس نفسها لمحاكاة الرواية أو المسرح. إنها تكرر القصص نفسها التي سئم القرن التاسع عشر من روايتها، والتي لا تزال مستمرة في الأدب المعاصر”.
الرؤية
الإنسان، من وجهة نظر بونويل، كائن يصر على إنكار طبيعته الحيوانية، خالقاً مجموعة من القوانين أو القواعد أوالمبادئ التي لا تؤدي إلا إلى مضاعفة عبثيته وتكثيف اضطهاده.
بونويل لا يقيم حاجزاً، من أي نوع، بين الوهم والواقع، بين التلميح المباشر والتشبيهات الأخرى. أفلامه مبنية على المواجهات القاسية بين الواقع والوهم، الأوجه الإيجابية والسلبية، الجانب الصحيح والجانب الخاطئ من الظاهرة نفسها الموضوعة على مسار التعارض والتصادم، من أجل الاقتراب أكثر من حقيقة الشيء.
يقول بونويل: “سوف أستمر في تناول الموضوعات التي أستمتع بها دوماً: الدين والجنس. أنا ضد التعاليم الأخلاقية التقليدية، والأوهام المبتذلة، والنزعة العاطفية، وكل تلك القذارات الأخلاقية في مجتمعنا”.
بونويل يرفض التحليل النفسي لأجل البراءة الخالصة للمخيلة.
“لم أرغب قط في إثبات شيء في أفلامي. السينما التعليمية أو السياسية لا تثير اهتمامي. لا أحد، في الواقع، يستطيع أن يتهمني بشيء، لكنهم دائماً يجدون معانٍ ومدلولات مزدوجة في أعمالي”.
أفلام بونويل تمتلك القدرة على إقلاق المتفرج وإجفاله وزعزعته.
وهو يقول: “يقولون أن أفلامي عنيفة وهدّامة، أي لا أخلاقية. أنا لا أختار الموضوع أولاً – الخير، العذرية، الوحشية – ثم أقيّد شخصياتي بالمشاكل. ليس لديّ أجوبة مسبقة. أنا أنظر.. والنظر إحدى سبل السؤال”.

ويضيف: “هناك من يقول بأنني قاس ومنحرف. أنا على العكس تماماً، أسخر من الأصنام والشعائر التي تسبّب القسوة والانحراف. أنا أكره العنف والبورنوغرافيا. في شبابي، كانت السوريالية من أكثر الحركات الفنية عنفاً. كنا نستخدم العنف كسلاح ضد ما هو مؤسَس، لكن الآن من الصعب أن تفعل ذلك لأن المجتمع نفسه صار أكثر عنفاً”.
بونويل، في أفلامه، يكرر العديد من الصور والثيمات والحالات والوسائل السردية.
إيروسية
الجنس عنصر قوي جداً في أفلام بونويل لأنه محسوس أكثر مما هو مرئي. يقول: “أنا أؤمن بالإيروسية المحتشمة. تستطيع أن تعزو ذلك إلى تربيتي اليسوعية. اللذة الجنسية بالنسبة لي مرتبطة على نحو مباشر بفكرة الخطيئة، ولا توجد إلا في سياق ديني”.
الرمز: الكامن والظاهر
يرى بونويل ضرورة أن ينبثق الرمز من المادة السينمائية نفسها، لذلك هو لم يقع في فخ الرمزية التعسفية، المتصورة سلفاً. إنه يكره الاستخدام المقصود للرموز، مع أنه، كما يقول الناقد أميليو ريرا (Film Culture, Spring 1962)، يمنح شخصياته، على نحو حدسي، قوةً رمزية فعالة جداً إلى حد أن بإمكان المرء أن يكتشف بسهولة الرموز في كل مكان من فيلمه.
في حوار له مع المخرج فرانسوا تروفو، قال بونويل: “ربما أقدّم بعض العناصر اللاعقلانية، تحت ستار حلم ما، لكنني لا أقدّم عن قصد أشياء رمزية على الإطلاق”.
الذاكرة
يقول بونويل: “أفتقر كلياً إلى الذاكرة الذهنية. بالنسبة لي، الأشياء تصبح حية فقط بفضل الذاكرة البصرية”.
الكامن والمنجز
لم يكن بونويل يكتفي بالتلاعب بمظاهر الواقع الخارجية، المرئية، إنما أيضاً يسبر مظاهر اللاوعي ويدمجها بالحياة اليومية التي يصورها الفيلم. وهو في هذا الصدد يقول:
“لا أحب أن أرتاد صالات السينما، لكنني أحب السينما كوسيلة للتعبير. لا أجد هناك أي وسيلة أفضل لعرض واقع لا نلمسه نحن بأصابعنا كل يوم. من خلال الكتاب، من خلال الصحف، من خلال تجاربنا، نحن نعرف واقعنا الخارجي، الموضوعي. لكن السينما قادرة، بواسطة آلياتها، أن تفتح نافذة صغيرة على تمديد ذلك الواقع. طموحي كمشاهد للسينما أن أرى الفيلم يعرّي أو يكشف النقاب عن شيء ما.. لكن هذا لا يحدث إلا نادراً”.
في حديثه عن قوة الصورة السينمائية، يستعير ما قاله الشاعر المكسيكي باث: “قال أوكتافيو باث ذات مرة، أن رجلاً مقيّداً بالسلاسل لا يحتاج سوى أن يغمض عينيه كي يفجّر العالم. بصياغة أخرى أقول: يكفي أن تعكس عين الشاشة الفضية الضوء الخاص بها، على نحو لائق، لينفجر الكون. لكن، في الوقت الحاضر، نستطيع أن ننام في هدوء وأمان لأن الضوء السينمائي الذي يصلنا هو مقيّد بعناية. ليس هناك فن، من الفنون التقليدية، يكشف عن ذلك التفاوت الهائل بين ما هو كامن وما هو منجَز مثل السينما”. (Film Culture, Spring 1962)
ضد الواقعية
اتخذ بونويل موقفاً سلبياً من حركة الواقعية الجديدة، التي برزت في السينما الإيطالية في فترة الحرب العالمية الثانية، وانتشرت لتمارس تأثيراً كبيراً وفعالاً في أوساط السينما العالمية.
يقول بونويل (في العام 1954): “الواقعية الجديدة، في السينما الإيطالية، أدخلت عناصر قليلة لإثراء لغة التعبير السينمائي. إن واقعها ناقص، تقليدي، ومنطقي. بينما الشعر، والغموض، وكل ما من شأنه أن يتمّم ويوسّع الواقع، هو مفقود كلياً في هذه الأعمال. بالنسبة لأي واقعي، هذه الكأس مجرد كأس، ولا شيء آخر. هو يراها وهي تُملأ بالنبيذ ثم تؤخذ إلى المطبخ كي يغسلها الخادم أو ربما يكسرها، الأمر الذي سيؤدي إلى طرده أو عدم طرده، هكذا. لكن هذه الكأس نفسها، التي يراها عدة أشخاص مختلفين، يمكن أن تكون أشياء كثيرة ومختلفة، لأن كل شخص يسكب جرعة معينة من المشاعر الذاتية فيما ينظر إليه.. ذلك لأن أحداً لا يرى الأشياء كما هي، وإنما حسب ما تمليه رغباته وحالته الذهنية. أنا أناضل من أجل السينما التي سوف تجعلني أرى هذا النوع من الكأس، لأن هذه السينما سوف تمنحني رؤية شاملة عن الواقع، وتوسّع معرفتي بالأشياء والناس، وتكشف لي عالم المجهول المدهش وكل ما لا يمكن العثور عليه في صحيفة أو في شارع”.

شعرية السينما
في حديثه عن شعرية السينما أو العلاقة بين السينما والشعر، قال بونويل (في العام 1953): “الغموض، ذلك العنصر الجوهري في أي عمل فني، هو بشكل عام مفتقد في الأفلام. المؤلفون والمخرجون والمنتجون يبذلون جهداً عظيماً من أجل عدم تعكير صفو أمننا وطمأنينتنا، مصرين على أن تظل نافذة الشاشة المدهشة مغلقةً بإحكام في وجه عالم الشعر المحرّر. إنهم يفضلون جعل الشاشة تعكس موضوعات تشكّل استمراراً طبيعياً لحياتنا اليومية، وأن يكرروا، آلاف المرات، الدراما المبتذلة نفسها، وجعلنا ننسى الساعات المشحونة بالوجع والضجر في عملنا اليومي. لكن في كل الأفلام، الجيدة أو السيئة، وعلى الرغم من نوايا صانعي الفيلم، تكمن روح شعرية تناضل من أجل البروز إلى السطح والكشف عن نفسها”.
وفي موضع آخر، يقول بونويل:
“تم اختراع السينما، كما يبدو لي، من أجل التعبير عن حياة ما دون الوعي، التي جذورها تتغلغل على نحو عميق جداً في الشعر، لكنها لم تُستغل أبداً لتحقيق هذه الغاية”.
خاصية الغموض
عن الغموض في أعمال بونويل، كتبت الناقدة الأمريكية بولين كايل في كتابها Going Steady الصادر في 1969: “لا مبالاة بونويل، تجاه ما إذا كنا نفهم أعماله أم لا، قد تبدو وقحة ومتغطرسة، مع ذلك هي جزء من ذلك الذي يجعله جذاباً وآسراً. اللامبالاة يمكن أن تكون مثيرة في الفن، كما في العلاقة الغرامية. بإبقائنا على بُعد مسافة، في وسطٍ ضمنه يحاول أغلب المخرجين إشراكنا والتأثير فينا، يقوم بونويل، وعلى نحو مقصود، بتقويض مفاهيم هي بديهية تقريباً في الدراما (المسرح) والأفلام ذات النمط الجماهيري. الخاصية الأكثر تميّزاً عند بونويل نجدها في فقدان اليقين بشأن كيفية تعاملنا مع شخصياته، وكيف ينبغي أن نشعر تجاهها. المخرجون الآخرون يخبروننا كيف ينبغي أن نشعر”.
أما بونويل نفسه فيتحدث عن الغموض قائلاً: “إذا صار معنى الفيلم واضحاً، عندئذ لا يعود قادراً على إثارة اهتمامي. الغموض هو العنصر الجوهري في كل عمل فني”.
ويضيف: “لا أظن أن كل شيء في الحياة هو منطقي. الناس دوماً يريدون تفسيراً لكل شيء. إنها النتيجة المنطقية لقرون من التربية البورجوازية. وحين يستعصي عليهم شيء، يعودون إلى الله. الحياة التي تتضمن التباسات وتناقضات تثير اهتمامي. اللغز جميل”.
وبسخريته المعهودة من أجهزة الرقابة، يقول: “أعتقد أن الأسبان، بشكل عام، لا يحبون أفلامي.. فلماذا تمنع الجهات الرسمية عرضها؟ من المفروض أن تسمح بعرضها لكي تدين هذه الأفلام نفسها. في اليوم الأول والثاني سوف يدافع عنها الناس من باب التعاطف معي، لكن في اليوم الثالث لن يذهب أحد لمشاهدتها، والجميع سوف يتجاهلونها”.
الحلم
مشاهد الحلم تصبح قوة محرّكة في عدد من أفلام لويس بونويل (كمثال: حسناءالنهار، سحر البورجوازية الخفي).
بوصفه سوريالياً، الخلط بين عناصر الواقع وعناصر الحلم يفتح الطريق نحو واقعية أسمى، محرّرة، وإزاءها تبدو الواقعية التقليدية مبتذلة.
مشاهد الحلم في أغلب الأفلام تبدو محددة الهوية أسلوبياً، والحلم مرئي كواقع ثانوي، أما عند بونويل فالتصوير مختلف. الحلم هنا له واقع ملموس وأساسي، وهو يندغم مع الواقع المادي بحيث يصعب التمييز بينهما، ويضطر المتفرج إلى التساؤل: أين ينتهي الحلم وأين يبدأ الواقع.
أحلام بونويل دوماً تسبر العلاقات المركبة، المعقدة، بين الشخصي والاجتماعي، العقلاني والحسي. وأفلامه تعطي إحساساً بأن الحياة مجرد حلم.
منطق الأحلام، في أفلام بونويل، هو جوهرياً مرادف لمنهج المونتاج الذي يستخدمه. من بين أنواع المونتاج، ذاك الذي يقوم على العلاقات بين أشكال بصرية مختلفة تتعاقب من خلال إحلال (dissolve) صورة محل أخرى.
بونويل، كسوريالي، ليس مجرد فنان يخلق مشاهد حلم غير اعتيادية. أغلب أعماله مشرّبة بهذه الخاصية الشبيهة بالحلم. فيض من صور الحلم يستقبلها المتفرج دونما تفسير منطقي.
يقول (1953): “السينما سلاح رائع وخطير حين تستخدمه روح حرة. إنها الأداة الأمثل للتعبير عن عالم الأحلام والمشاعر والغريزة. الآلية الخلاقة للصور السينمائية، من خلال نمط العمل، هي من بين كل وسائل التعبير الإنساني، الآلية الأقرب إلى عقل الإنسان، بل أنها التي تحاكي وظيفة العقل في حالة حلم. لقد أشار جاك برونيو إلى أن الظلام الذي يجتاح ويستوطن، شيئاً فشيئاً، صالة السينما هو مرادف لفعل إغماض العينين. بعدئذ تبدأ الرحلة الليلية، على الشاشة مثلما داخل الكائن البشري، نحو ليل اللاوعي. الصور، كما في الحلم، تظهر وتختفي من خلال إحلال مشهد محل آخر بطريقة تدريجية ((dissolve، ومن خلال التضاؤل التدريجي للقطة (fade out). الزمان والمكان يصبحان مرنين وقابلين للتكيّف، الزمن يرتد ويمتد، ينكمش ويتمدد ساعة يشاء المرء. النظام الكرونولوجي (المتسلسل زمنياً) والقيم النسبية للأمد، لا تعود تنسجم مع الواقع. الحدث الدائري يمكن أن يتحقق في دقائق قليلة أو عدة قرون. الانتقالات من حركة بطيئة إلى سريعة تصعّد وتضاعف تأثير كل منها”.

بريشت
يقول ريمون دورغنات (في كتابه: لويس بونويل، 1967): “في انفصاله عن غنائيته الخاصة، بونويل يكون أكثر بريشتية من بريشت. هو لا يحتاج إلى مؤثرات التغريب، التي تبهجنا جمالياً عند التطبيق، بالتالي هي لا تغرّب نفسها. في نظرياته، بريشت كان بلاغياً، مولعاً باللغة المنمقة، وهو يدفع ثمن ذلك. بونويل لا يحتاج إلى مؤثرات التغريب لأن تعقيد شخصياته ومآزقها، وتحفظات أسلوبه، ترغم المتفرج على إصدار الأحكام الأخلاقية عند كل منعطف”.
التقنية
تقنية بونويل اعتيادية، متحررة من النزعة الفنية. يقول: “التقنية خاصية ضرورية للفيلم، كما لكل عمل فني، وفي الواقع، لكل نتاج صناعي. لكن لا يجب على المرء أن يصدّق بأن هذه الخاصية هي التي تحدّد تفوق وامتياز فيلم ما. هناك خاصيات في الفيلم يمكن أن تكون ذات شأن أكثر من التقنية”.
وهو يتفادى صنع صورة جميلة، متجنباً الزوايا غير العادية، أو حركات الكاميرا المتكلّفة، أو الحيل في المؤثرات، مفضلاً أن يأسر الأحاسيس والمشاعر من خلال وسائل أقل جلاءً، مثل كثافة الصورة والتجاور اللاعقلاني وتوظيف الصوت.. يقول: “التقنية لا تسبّب لي أية مشكلة أو صعوبة. أنا أمقت زوايا الكاميرا غير العادية في التصوير، أحب أن أصور ببساطة وبشكل مباشر، من غير مؤثرات تقنية تقدمها الكاميرا”.
لقد لجأ بونويل إلى اتخاذ مثل هذا الموقف الحاد والصارم تجاه حيل الكاميرا لأنه شعر بأن عمل الكاميرا غالباً ما يُستخدم كبديل عن المحتوى. لذلك نجد أن حتى حركة الكاميرا تبدو نادرة نسبياً.. يقول: “ما إن تبدأ الكاميرا في الرقص وتصبح هي نجمة الفيلم حتى أفقد اهتمامي بالعرض وأغادر الصالة”.
وهو لا يكره التقنية بل يمقت “التحايل والتلاعب، أكره التقنية الاستعراضية. حضور الكاميرا لا يجب أن يكون محسوساً. عندما أبدأ في رؤية التكنيك في فيلم ما، وبشكل مفرط، فإنني أكف عن الاهتمام به. في أفلامي، أحاول دائماً أن أجعل التكنيك غير محسوس.. ما إن يكشف عن نفسه حتى يصبح الفيلم باهتاً وضعيفاً” (مجلة نيويورك تايمز، 11 مارس 1973)
بونويل لم يكن غافلاً، أو غير مدرك، لإمكانيات الكاميرا، هو فقط كان يستخدم هذه الإمكانيات حين تساعده في التعبير عن أفكاره، ومن أجل الحصول على تأثيرات أقوى أو توكيد حالات معينة. لذلك يؤكد أن “الكاميرا هي عين المدهش. عندما ترى عين السينما حقاً، فإن العالم بأسره سوف يشتعل”.
إنه يرفض السماح بحضور الكاميرا عندما تكون زائدة أو غير ضرورية في فيلمه، كما لو أن ذلك سوف يقوّض أو يضعف استقلال الفيلم بوصفه عالماً حياً يتعايش مع عالمنا، متماثلاً مع الحضور المساوي في الدرجة لحيواتنا الواعية واللاواعية.
وهو قلّما يستخدم اللقطات الكبيرة أو القريبة، مفضلاً استخدام اللقطات العامة واللقطات takes المديدة، الطويلة نسبياً.. إذ تساعد هذه اللقطات على ربط الشخصيات بخلفية الصورة، وببعضها البعض. كما أن اللقطات المصاحبة tracking بالكاميرا المتحركة، وحركات البان pan، هي طفيفة ومقتضبة في أفلامه. أيضاً قلما يستخدم الحركة البطيئة. أما الإضاءة فغالباً ما تكون مسطحة flat، ولا تقوم على التلاعب بالضوء والظل. إن تقنيته السينمائية تعتمد على المونتاج، الذي من خلاله يتنامى الفيلم عبر تجاورات العناصر المتباينة والمتناقضة.
بونويل كان ضد التكنولوجيا الجديدة، وهو في هذا الشأن يعبّر عن رؤية تشاؤمية، إذ يقول: “يبدو لي أن صنع الفيلم هو فن مؤقت، زائل، ومهدّد لأنه متصل على نحو محكم، وعلى نحو لا ينفصم، بالتطورات التكنولوجية”.
عملية تصوير الفيلم
بونويل يصور أفلامه في هدوء وصفاء وثقة.. يقول: “أضع الممثلين أمام الكاميرا وأتابعهم في الموقع قدر استطاعتي. وعندما لا أعود أعرف ما ينبغي فعله، أتوقف وأغيّر زاوية التصوير”.
لكن هل يستمتع بونويل بتصوير الفيلم؟.. يرد قائلاً:
“لا. أبداً. أكره ذلك. أكره حالة الفوضى والتشوّش في الموقع أثناء التصوير. أكره الضجيج. لا أستطيع احتمال الإصغاء إلى أكثر من شخص واحد يتحدث إليّ، في الوقت نفسه. أكره إصدار الأوامر”. (مجلة نيويورك تايمز، 11 مارس 1973)
مع ذلك، يُقال أن بونويل وهتشكوك هما الأسرع والأكثر دقةً والأكثر ثقةً بما يفعلان من بين جميع المخرجين السينمائيين. يقول بونويل: “أنا أحضّر واجبي وأحل فروضي في المنزل. قبل حلول اليوم الأول من التصوير في الموقع، أكون عارفاً تماماً وبدقة كيفية تصوير كل مشهد، وكيف سيكون المونتاج النهائي. لقد تعلمت كل حيل التصوير في ظرف أسبوعين في المكسيك. بمقدوري أن أتولى مونتاج الفيلم في يومين. ذلك يتيح لذهني حرية الارتجال أثناء التصوير، ويراقب بعناية الجو العام والتفاصيل الدقيقة التي تحوم فوق وأسفل عملية التصوير الفعلية”.
في حديث لرفيق بونويل في كتابة السيناريو جان كلود كارييه ( Show, April 1970) يقول: “اعتاد بونويل أن يصل إلى الموقع دون أن يعرف بالضبط أين سيضع الكاميرا. هو أبداً لا يحضّر سيناريو التصوير. إنه يتطلع حواليه في الموقع على نحو وجيز، وبسرعة يتخذ قراره. هو عادة يختار الحل الأبسط، أو أحياناً يختار الأيسر. إنه ينظم الممثلين والمجاميع بعناية شديدة، لكنه لا يقلق كثيراً بشأن تفاصيل الخلفية. إنه ينظر كثيراً من خلال الكاميرا محاولاً التيقن من صلاحية المنظور. وهو لا يعطي الممثلين أي توجيه، بل يضعهم في الأماكن الملائمة ويصحح لهم فيما يؤدون. وهو يعطي المصور توجيهات بسيطة، لكن دقيقة جداً”.

في الموقع، يخلق بونويل اتصالاً مباشراً مع الممثلين والفنيين. ثمة إحساس عميق بالتناغم، حميمية، احترام متبادل عميق، دعابة، وشعور بالبهجة. والمعروف عنه أنه منظم جداً، مقتصد جداً، ملتزم بمواعيد التصوير.
وهو يعمل على نحو سريع، ويصور بسرعة بالغة، إذ نادراً ما يحتاج إلى أكثر من إعادتين أو ثلاث للقطات.. “وإلا فإنني أشعر بالضجر”.. كما يقول.
وهو يترك مساحة كبيرة للارتجال، خصوصاً في ترك الممثل يعالج شخصيته ويملأ الفراغات.
عن علاقته بالممثلين، يقول بونويل:
“أنا أنسجم بشكل جيد مع الممثلين، لكنني أعتقد أنهم لا ينسجمون جيداً معي”.
“في البداية، بسبب قلة الإمكانيات المادية، استخدمت العديد من الممثلين الهواة، بالإضافة إلى مساهمات الأصدقاء”.
الموسيقى كبعد إضافي
بونويل من المخرجين الذين يعتمدون على الموسيقى الكلاسيكية (فاجنر، براهمز).
لقد أبدى بونويل اهتماماً جاداً بالموسيقى وهو في الثالثة عشرة من عمره، حين بدأ في تعلّم العزف على الكمان والبيانو. كان مولعاً بشكل خاص بموسيقى ريتشارد فاجنر، حتى أنه كوّن فرقة موسيقية تولى قيادتها في الكنيسة.
في أول فيلمين حققهما: كلب أندلسي (1929) العصر الذهبي (1930) هو اعتمد بشكل كبير على موسيقى فاجنر، خصوصاً “تريستان وإيزولد”، التي أعجب بها كثيراً منذ صغره. كما وظف موسيقى فاجنر في أكثر من فيلم، مثيراً بذلك الانفعالات العنيفة للحب. إن استخدام بونويل لموسيقى فاجنر، من أجل إثارة المظهر السامي للحب، يشير إلى تعويله على الصوت في إعطاء أفلامه بعداً إضافياً. الموسيقى في أفلامه تتبنى عدداً من الأدوار المختلفة، فهي من جهة تؤكد الناحية العاطفية وتدعم الانفعالات الحسية، ومن ناحية أخرى توظَف بطريقة ساخرة أو تهكمية.
لكنه، في أواخر الخمسينيات، نصح المخرجين الشباب بالحذر في استخدام الموسيقى لأن “المرء ينتهي بخيانة الصورة”.
كذلك عبّر عن نفوره من التوظيف السطحي للموسيقى في الأفلام، قائلاً: “أكره بشدة الموسيقى في الأفلام. إني أميل إلى كبحها، ووضع حدٍ لها، لأنها سهلة إلى أبعد حد. كم فيلماً سوف يصمد لو حذفنا الموسيقى؟”
بونويل كان يؤكد مراراً أن الصمت يؤثر فيه كثيراً، وأن الموسيقى ليست ضرورية بل هي “عنصر متطفل” و “ضرب من الخداع”.
في عدد من أفلامه (مثل: يوميات خادمة، جميلة النهار، تريستانا) هو لم يستخدم الموسيقى على الإطلاق.
من البداية، كانت اعتراضات بونويل موجهة ضد تقديم الموسيقى بوصفها مصاحبة للصور السينمائية بطريقة تؤكد الصورة أو تلازمها. بتعبير آخر، هو كان يعارض استخدام الموسيقى لدعم الصورة أو مناصرتها. إن دعم الصورة السينمائية بهذا الشكل يعد تقويضاً لها.
الجمهور
بونويل، عبر أفلامه، يحاول أن يصدم المتفرج، أن يفاجئه، يربكه، يقلقه، يزعجه، لا أن يسليه أو يرفّه عنه أو يجيب عنأسئلته. إنه يخرّب باستمرار توقعات المتفرج. مع أنه يصرّح قائلاً: ” لا أحاول أبداً أن أصدم الناس، لكنهم أحياناً يصدمون أنفسهم”.
وفي موضع آخر، يقول: “شخصياً أحب أن أستمر في تحقيق أفلام والتي، بصرف النظر عن تسلية الجمهور، تنقل إلى الناس اليقين المطلق بأننا لا نعيش في أفضل العوالم الممكنة. عبر أفلام كهذه أعتقد بأن أهدافي ستكون بنّاءة جداً. كيف يمكن أن نأمل بتحسين مفاهيم الجمهور ما دامت الأفلام تخبرنا أن مؤسساتنا الاجتماعية ومفاهيمنا، عن الوطن والحب وغير ذلك، هي استثنائية وضرورية، في حين أنها ناقصة؟ الامتثالية هي أفيون الجمهور” (Film Culture, Spring 1962)

بونويل من المخرجين القلائل الذين يحققون أفلامهم لإرضاء وإشباع أنفسهم. يقول: “أنا لا أحقق أفلاماً للجمهور العام. إذا كان هذا الجمهور تقليدياً، محافظاً، ضيّق الأفق، ومضللاً، فذلك ليس ذنبه بل ذنب المجتمع. من الصعب جداً، ولا يحدث إلا نادراً، أن يتمكن مخرج من تحقيق فيلم يرضي الجمهور، إضافة إلى أصدقائه وأولئك الذين يقدّر أراءهم وحكمهم”.
عن تأثير السينما، يقول (1953): “الفيلم يؤثر بشكل مباشر على المتفرج، إذ يقدّم له شخصيات وأشياء مادية. في سكون وعتمة الصالة يبدأ الفيلم في عزل المتفرج عما يمكن تسميته بجوّه النفسي المألوف. السينما قادرة على إثارة المتفرج ووضعه في حالة من النشوة على نحو فعال أكثر من أي شكل آخر من أشكال التجربة الإنسانية، لكنها أيضاً قادرة – أكثر من أي شكل آخر – على إفساده وتخديره. ويبدو أن أغلب الأفلام الراهنة لا تؤدي سوى هذه المهمة: الإفساد والتخدير. الشاشات تقدم كل يوم برهاناً على الخواء الفكري والأخلاقي الذي تتمرّغ فيه السينما. المتفرج عبر هذا النوع من الكبح التنويمي، يفقد نسبة كبيرة من طاقته الفكرية أو النقدية”.
ويقول أيضاً في المقالة ذاتها:
“إن شخصاً متوسط الثقافة سوف يقذف بازدراء أي كتاب يحتوي على أحد المواضيع التي تتحدث عنها أفلامنا، غير أن هذا الشخص، الجالس بشكل مريح في صالة معتمة، منبهراً بالضوء والحركة التي تمارس عليه سلطة شبيهة بالتنويم المغناطيسي، مسحوراً بالوجوه البشرية والتغيرات السريعة للمكان، هذا الشخص سوف يقبل، برباطة جأش، موضوع الفيلم أو أفكاره مهما كانت تافهة ومبتذلة”.
النجاح والفشل
الجودة لا تتصل دائماً بنجاح العمل.. يقول بونويل: “السينما الجيدة نادراً ما تأتي من خلال النتاجات ذات الميزانية الضخمة، أو تلك التي نالت إطراءً نقدياً أو قبولاً جماهيرياً”.
النقد
في حديثه عن النقد يقول بونويل: “النقاد يقارونني بالرسام جويا. هذه نظرة سطحية جداً. النقاد يتحدثون عن جويا لأنهم يتجاهلون أولئك العظام الذين أنجبتهم أسبانيا. الثقافة، لسوء الحظ، أصبحت غير منفصلة عن القوة الاقتصادية والعسكرية. الدولة القوية صارت قادرة على فرض ثقافتها ونشرها عالمياً. فنانون من الدرجة الثانية، مثل إرنست همنجواي، شهرتهم جاءت نتيجة القوة الأمريكية. أما أسبانيا، فإن ضعفها يعني تجاهلاً عالمياً لأدبها المدهش”.
مشاهدة
بعض المخرجين يعيدون مشاهدة أفلامهم المرة تلو الأخرى، من باب إعادة التقييم أو الاستمتاع أو الحنين، أو لأي سبب آخر. بونويل لا يحب ذلك..”ما إن ينتهي الفيلم حتى أفقد اهتمامي به، حتى أنني لا أشاهده”.
الأخلاقية البورجوازية
يقول بونويل:
“شخصياً لم أحاول قط أن أثبت شيئاً أو أستخدم السينما كمنبر لإلقاء المواعظ. ربما سيكون هذا التصريح مخيباً للكثيرين، لكنني أعرف أن الناس سوف يستخلصون من أفلامي الكثير من الرموز والمعاني”.(Film Culture, Spring 1962)
“التعاليم الأخلاقية عند البورجوازية هي، بالنسبة لي، لا أخلاقية، وينبغي محاربتها. هذه التعاليم أوجدتها وكرّستها المؤسسات الاجتماعية الأكثر جوراً: الكنيسة، الوطنية، العائلة، الثقافة.. باختصار، كل ما يُسمى أعمدة المجتمع”.
“القيم البورجوازية.. هي التي أردت أن أهاجمها وأحاربها طوال حياتي. قبل أربعين سنة، كان بوسعنا أن نهاجم البورجوازية، أن نفاجأها، لأنها كانت واثقة جداً من نفسها ومن مؤسساتها. لكن كل ذلك قد تغيّر. الدعاية ووسائل الإعلاماستطاعت أن تمتص كل شيء وتجعله حميداً، أليفاً، ومقولباً. أعتقد أن على المرء أن يغيّر منهجه في الهجوم، لكن دون أن يغيّر أهدافه. ما أهدف إليه هو أن أدمّر قوانين الامتثالية التي توهم الفرد بأنه يعيش في عالم فاضل ومثالي”.
“أنا متشائم، لكنني أرجو أن أكون متشائماً حقيقياً. في أي مجتمع، يتعيّن على الفنان أن يتحمل المسؤولية. فعاليته محدودة، بالتأكيد، ولا يستطيع أن يغيّر العالم، لكنه يملك القدرة على الاحتفاظ بروح متمردة ترفض الخضوع والامتثال. بفضله، لا يستطيع أصحاب السلطة الجزم بأن كل فرد يقرّ ممارساتهم وسلوكهم ويتفق مع أفعالهم. هذا الفرق البسيط هام جداً، حين تشعر السلطة بأنها مبرّرة ومصدّق عليها بالإجماع، فإنها مباشرة تدمّر كل حرية نملكها..وهذه هي الفاشية” (مجلة نيويورك تايمز، 11 مارس 1973)
“أتفق مع إنجلز.. الفنان يصور العلاقات الاجتماعية الحقيقية بغرض هدم الأفكار التقليدية بشأن تلك العلاقات، ويقوّض أساس التفاؤلية البورجوازية، مرغماً الجمهورعلىأن يرتاب في معتقدات النظام المؤسس”.
الاعتزال
كان بونويل في سنواته الأخيرة، بعد الانتهاء من كل فيلم يخرجه، يتعهد بأن يكون فيلمه الأخير.. تماماً مثل المخرج السويدي إنجمار برجمان. بدأهذا منذ عام 1967 عندما أعلن بونويل بعد انتهائه من فيلمه “حسناء النهار” أنه سوف يتوقف ولن يحقق بعد اليوم أي فيلم آخر. مع ذلك استمر في تحقيق الأفلام حتى عام 1977.. كان يقول:
“لا أريد أن أستمر في إخراجالأفلام لمجرد كسب الرزق. إذا لم يبق من عمري غير عام واحد، فإنني لن أبدّد وقتي في العمل، بل سوف أستمتع بالحياة. سوف أرغب في رؤية أصدقائي، وأن آكل وأشرب، أو أجلس بهدوء في غرفتي أراقب الذباب يئز من حولي، أو أتطلع إلى حذائي”.
الشيخوخة
يتحدث بونويل عن الشيخوخة فيقول: “في السبعين من عمرك، أنت ترى الأشياء بعاطفة مختلفة، ومن وجهة نظر مختلفة. لقد تغيّر العالم في السنوات الثلاثين، ويتعيّن عليك أن تهاجم بأسلحة مختلفة”. (كتاب: عالم لويس بونويل، تحرير جوان ميلين)
لكن مشاعره وقناعاته لم تتغير..
“مثل أي شخص آخر، أنت تراكم تجاربك خلال طفولتك وشبابك، ثم تمضي إلى ركن هادئ وتحاول أن تتذكر. هناك يحين وقت حيث من الحماقة الاعتقاد بأن عليك أن تعيش من أجل أن تخلق. لا.. مجرد جحر وعنكبوت ينسج شبكته، وأنت تحاول أن تتذكر كيف كان العالم في الخارج”. (حوار مع كارلوس فوينتس، مجلة نيويورك تايمز، 11 مارس 1973)
الموت
بشأن تأملاته في الموت، نجد:
“أنا لا أخاف من الموت، بل أخشى أن أموت وحيداً في غرفة بالفندق، بينما حقائبي مفتوحة، والسيناريو على المنضدة. أريد أن أعرف أصابع من التي سوف تغمض عينيّ”.
“لا أحب السفر بالطائرة، ليس لأنني أخاف من الموت، إنما لأنني أشعر بالقلق حين أدرك بأنني هناك، في السماء، ولا أستطيع أن أفعل شيئاً”.
“أخاف أن أموت أثناء عملية الانتقال من مكان إلى آخر. لا مانع لدي في أن أموت، لكن ليس أثناء الانتقال”.
“عندما تصبح في الرابعة والسبعين، لن يهمك بماذا تموت، بل كيف تموت”. (أنظر كتابه: النفس الأخير)
قالوا عن بونويل

أندريه تاركوفسكي:
لو اتجهنا الآن، من أجل توضيح فكرتي، إلى أعمال واحد من المخرجين السينمائيين الذين أشعر أنهم الأقرب إليّ، لويس بونويل، فسوف نجد أن القوة المحركة لأفلامه تكمن دائما في مقاومة الامتثال والخضوع. إنها ضد الإمتثالية. احتجاجه – الغاضب، العنيد، والموجع- يجد تعبيره قبل كل شيء في النسيج الحسي للفيلم، وهو مُعْدٍ عاطفيا. هذا الاحتجاج ليس مدروسا، ليس عقليا، ليس معدّاً وفق صيغة فكرية. لدى بونويل الكثير من حاسةالتمييز الفني التي تحول دون وقوعه في شرك الإيحاء السياسي، والذي هو في رأيي دائما زائف حين يتجسد على نحو صريح في العمل الفني. من جهة أخرى، الاحتجاج السياسي والاجتماعي المعبر عنه في أفلامه سيكون كافيا لعدة مخرجين من ذوي المكانة الأقل شأنا.
بونويل هو، قبل أي شيء آخر، حامل الوعي الشعري. إنه يعرف بأن البنية الجمالية لا تحتاج إلى بيانات بالأهداف والدوافع، وأن قوة الفن لا تكمن هناك بل في القدرة على الإقناع العاطفي، في طاقة الحياة الفذة التي ذكرها جوجول.
أعمال بونويل متجذرة بعمق في الثقافة الكلاسيكية في أسبانيا، المرء لا يستطيع أن يتخيله بدون ارتباطه الملهم بسرفانتس والجريكو، لوركا وبيكاسو، سلفادوردالي وأرابال. إن أعمالهم المشحونة بالعاطفة المتقدة، بالغضب والرقة، بالتوتر والتحدي، هي من جهة وليدة حب عميق للوطن، ومن جهة أخرى نتاج كراهية شديدة للبنى الميتة، وللاستنزاف الوحشي، الموجع، للأدمغة. إن مجال رؤيتهم، المتقلص بفعل الكراهية والازدراء، يستوعب فقط ما هو متقد وزاخر بالتعاطف الإنساني، والوميض السماوي، والمعاناة الإنسانية المألوفة، وتلك الأشياء التي لقرون قد تسربت في الأرض الأسبانية الصخرية، الحارة.
(من كتابه: النحت في الزمن)
انجمار بيرجمان:
“عن طريق بونويل اكتشفت حبي للسينما. إنه لا يزال الأهم والأعظم من وجهة نظري. إني أؤيد تماما نظريته حول الصدمة البدئية لاجتذاب اهتمام الجمهور. (..) لم أكن قادراً على تقدير بونويل حق قدره. هو اكتشف في مرحلة مبكرة أن من الممكن اختراع حيل حاذقة وبارعة، تمكّن من رفعها إلى نوع خاص من النبوغ، خاص ببونويل، ثم راح يكرر حيله وينوّعها. ودوماً يتلقى الإطراء والتصفيق. بونويل حقق دوماً أفلاماً بونويلية.
لذلك فقد حان الوقت لأن أنظر إلى المرآة وأسأل: إلى أين نحن ذاهبون؟ وهل بدأ بيرجمان في تحقيق أفلام بيرجمانية؟”
(من كتابه: Images, My Life in Film, 1990)
جان لوك جودار:
“بونويل يعزف على السينما مثلما كان باخ يعزف على آلة الأرْغُن”.
توني ريتشاردسون:
“أنبياء السينما قليلون ووحيدون، وليس هناك من هو أكثر ضخامة من الأسباني بونويل”.
(Sight and Sound, Jan- Mar. 1954)