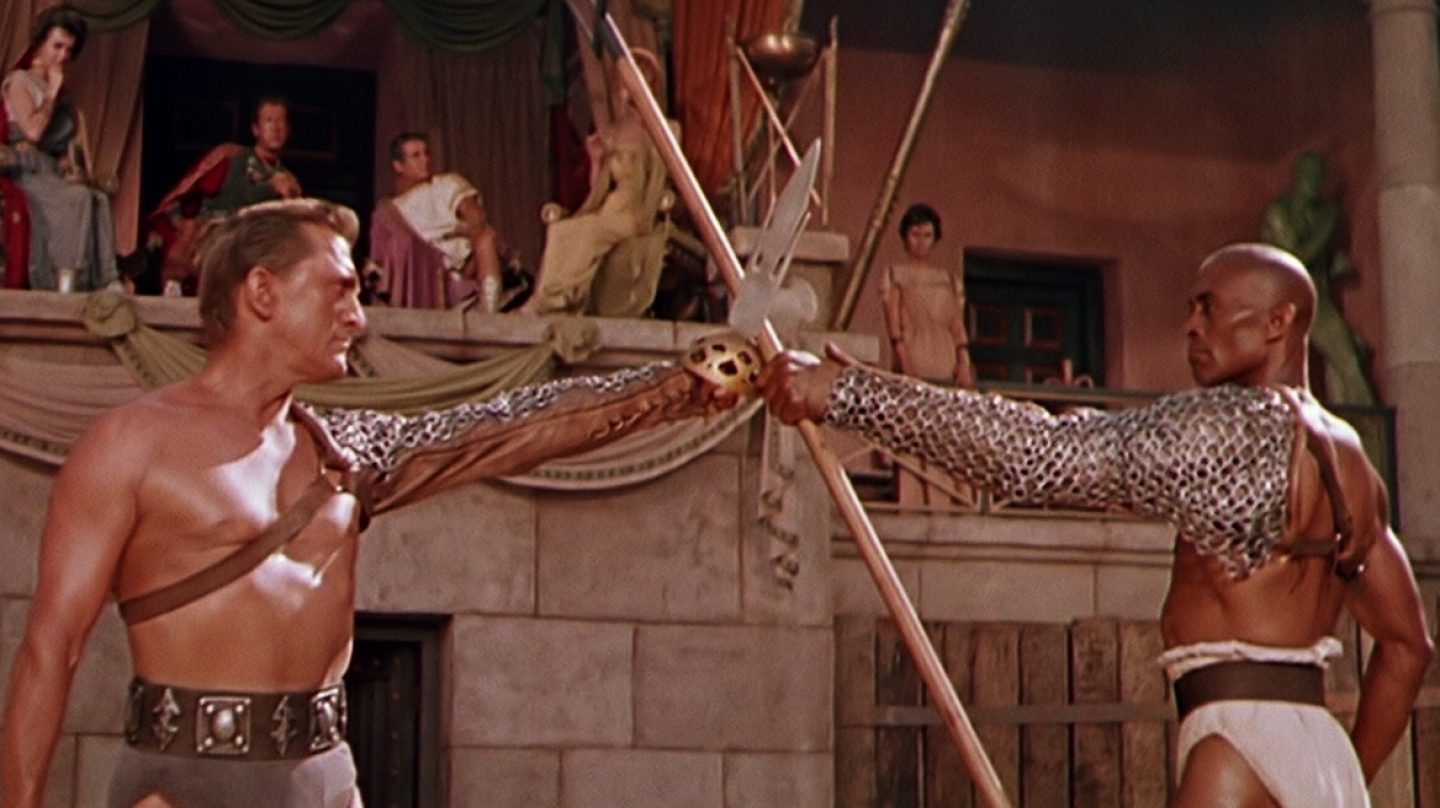فيلم “الحرام”.. حين يضحك الجُناة

فى بداية فيلم “الحرام” نرى نقطة سوداء صغيرة وسط حقول زراعية تحيط بها من كل مكان. هذه النقطة الصغيرة ترصدها الكاميرا بطريقة عين الطائر الذى يهبط من السماء إلى الأرض، أى أن النقطة آخذة فى التمدد شيئًا فشيئًا حين تنزل إليها الكاميرا إلى أن نتبين فيها أخيرًا قرية من قرى الدلتا، بيوتها من الطين وأسقفها من القش، بيوت شبه متداعية تتكئ على حوائطها الواطئة بعض النساء، والعجائز.
يلعب الأطفال فى شوارعها الضيقة الملتوية بشبه كساء بينما يجلس رجالها على الجسور فى انتظار زيارة الناظر “فكرى أفندى” الموسمية إلى المقاول لاستئجار أنفار لمقاومة دودة القطن؛ كى لا ينتشر بيضها فى الأوراق، فيفقس ويلتهم المحصول.
هذه بداية فيلم “الحرام” التى يرافقها صوت الراوى من الخارج “حسين رياض” وهو يحدد زمن الحكاية بعام 1950، أى فى قمة عصر الإقطاع الزراعى والطبقية التى كانت تُسمم علاقات الناس بعضهم ببعض، ليس فقط علاقات الطبقة الإقطاعية أو الأرستقراطية بطبقة الفلاحين الفقراء وعمال التراحيل، بل أيضًا العلاقة بين الفلاحين الفقراء المقيمين فى عزب التفتيش بعمال التراحيل الأفقر منهم. كأن كل واحد يحتقر ويقهر من أهو أفقر منه. ستدور الحكاية فى قرية من قرى الدلتا بلا اسم مُعيَّن، هى إذًا تمثل رمزًا لكل قرى وعزب مصر فى ذلك الوقت.
الزمن القصير نسبيًا بين إنتاج الفيلم عام 1965 وبين الزمن الذى تدور فيه أحداث الرواية 1950 كان له جانبه الإيجابى فى الفيلم، إذ اعتمد التصوير على المناظر الطبيعية فى فضاء مفتوح، وذلك قبل أن تتمدد القرى فتبتلع معظم ما حولها من أراضٍ مزروعة، وقبل أن تتهدم البيوت القديمة فتُقام مكانها بيوت جديدة بالطوب الأحمر والأسمنت المسلح.

تحكى رواية “الحرام” لـ”يوسف إدريس”، المأخوذ عنها الفيلم، عن “عزيزة”، وزوجها “عبد الله”.. أسرة ريفية عملها موسمى، يسعون وراء اليومية أينما كانت، لكن البلهارسيا تكسر ظهرهم، فيقعد “عبد الله” مريضًا برفقة الأطفال بينما تسعى “عزيزة” على الجميع فى يوميات متقطعة معرضة للإذلال والتحرش إلى أن يغتصبها “ابن قمرين” ذات يوم فتحمل سفاحًا، تحاول إجهاض نفسها لكن الجنين، ابن الحرام، لابد فى الأحشاء. لا يكف عن حصارها بتمدده، فتحاصره بأحزمة تلفُّ بها بطنها، ثم تضعه وحيدة على حواف الترعة، وتكتم أنفاسه حتى لا يفضحها، فيموت.
تثير الرواية عدة نقاط أولها: رفض الحكم الأخلاقى على الآخرين دون معرفة عميقة بهم، وهذا جوهر الفن الذى يسعى لإنارة البصيرة بالأحداث، والمشاعر، والظروف حتى يتماهى ضمير القارئ بالحكاية، فيتخلى عن الإدانة المباشرة، وتتشكل لدية رؤية جديدة للعالم من حوله تُزيح فيها الألوان المتنوعة هذه المسافة الصفرية بين الأبيض والأسود.
وثانيها: أن كل جريمة لا يقف وراءها مجرم واحد، بل كثير من الجناة يتناثرون فى مواقع عدة، وينكشفون واحدًا إثر واحد. فى عالم يوسف إدريس الحكائى تتحول الجريمة العلنية إلى مرآة، أو ضوء كاشف يُزيل القناع عن الجميع، ويجعلهم يقفون مرعوبين أمام أنفسهم، أو أمام الآخرين فى جلسات النميمة التى تكشف الستر عن الفساد والجرائم السرِّية التى كان يمارسها أفراد الجماعة البشرية بلا مبالاة، وباطمئنان كامل؛ لذا يكون الشغل الشاغل للجميع هو كشف تفاصيل الجريمة العلنية مبكرًا، والخلاص ممن سقط منهم فيها، وغالبًا ما تسقط الضحية وحدها وتدفع الثمن دون الجانى؛ لأنه الطرف الأضعف فى عالم طبقى يحكمه القهر من القمة إلى السفح. سيحرصون على محو آثارها بأقصى سرعة؛ حتى لا يَكرُّ الخيط وينتهى التهديد الذى يحاصرهم.
هذه الرؤية نقلها يوسف إدريس فى قصص قصيرة أخرى، فكرة الجريمة العلنية التى يسعى الناس للخلاص من صاحبها حتى يعودوا إلى جرائمهم السرية بأمان، ففى قصة (الشيخ شيخه) من مجموعته (آخر الدنيا) يمارس الرجال والنساء حياتهم السرية أمام رجل أبله، لا يعرفون أصلًا إن كان رجلًا أو امرأة، ولا يأبهون لذلك، بل يتحملون قَدَر وجود المجنون فى قريتهم بصدر رحب، كأنه بركة من السماء، يتسلون به فى رواحهم ومجيئهم لأنه أصم أبكم، وذات يوم ينطق بجملة مفيدة أمام بعضهم فيكون زلزال ورعب فى البلدة كلها.
هذا الرعب ينتهى فى الليلة نفسها بمقتل الشيخ شيخة فى الخرابة الكائنة فى آخر الحارة. لن نحتاج طبعًا إلى معرفة هوية القاتل أو القتلة، ففعل القتل هنا رمزى أيضًا، إنه أمنية الجميع للعودة بأمان إلى ازدواجيتهم وحياتهم السرية التى يتآلفون معها تمامًا.

وهذا الأعمى فى قصة (بيت من لحم) من مجموعة بالاسم ذاته يشك فى عِشرته للنساء الثلاث فى البيت لا زوجته فقط، لكنه يُسكت هواجسه طالما أنه أعمى وليس على الأعمى حرج، كما تُسكت النساء هواجسهن فى بعضهن البعض طالما أن كل شىء يحدث فى الظلام لا فى النور.
أليس “فكرى أفندى” مأمور الزراعة فى رواية (الحرام) شريكا فى الفساد حين يتفق والمقاول على نسبة معروفة من يوميات الأنفار القليلة؟ أليس ابنه “صفوت” و”أحمد أفندى إسماعيل” جزءًا من الجرم أيضًا بالتغرير بفتيات القرية، ونساء التراحيل بحكم سلطتهما، أو سلطة آبائهما؟!
سنمد الخيط لنرى “لِنده” ابنة “مسيحة أفندى” الباشكاتب وهى تتبادل الغرام مع “صفوت” ابن الناظر، ثم تهرب مع “أحمد أفندى سلطان”، ونرى قصة “محبوب” ساعى البريد وزوجته الخائنة، وسنضحك مع كل اجتماع لأهل القرية وهم يرمون هذا أو تلك بالجريمة قبل أن تُكتشف التفاصيل لما يعرفوه سابقًا عن كل واحد وواحدة منهم.
وثالثها: أن الأطفال وحدهم كانوا أكثر أهل الأرض نقاءً، فلا تحكم المصالح علاقاتهم، ولا تُسمم الطبقية نظرتهم للآخرين. هم أول من أقام علاقات صداقة ولعب مع أولاد الغرَّابة (عمال الترحيلة). حين تُشيَّد بعد ذلك جسور الثقة بين أهل القرية والغرابة إثر المأساة سيكتشف الجميع أن ظروف معيشتهم متقاربة، وهو ما يجسد حالة وعى تتأسس حين يقتربون من بعضهم البعض؛ ليعرفوا قاهرهم، ويدركوا أسباب الظروف التى تنتج مآسيهم يومًا وراء يوم.
التزم فيلم “الحرام” بعالم الرواية وأحداثها إلى حد كبير في الفيلم الذى أخرجه هنرى بركات وكتب له السيناريو سعد الدين وهبه، وقام بتجسيد أدوار شخصياته فاتن حمامة فى دور عزيزة، وزكى رستم فى دور فكرى أفندى الناظر، وعبد الله غيث فى دور عبد الله زوج عزيزة، وحسن مصطفى فى دور الخفير عبد المطلب، وعديد من الممثلين الآخرين.. لكنه أيضًا أضاف للأحداث جماليات الصورة السينمائية، وقدرتها على الإيحاء بالمعانى والدلالات بما تملكه الكاميرا من زوايا تعبيرية ثرية، وبما يتمازج مع الصورة من نبرات الصوت والحوار، والموسيقى التصويرية.
تلك اللقطات التى تُصوِّر مثلًا عمال التراحيل وهم يصعدون إلى صندوق السيارات دون أن تقف على ملامح وجوههم وتمايزهم الجسمانى فى بداية الفيلم، كأنهم فقط مجرد كتلة بشرية لا تلفت الانتباه غير أنها فى نهاية الفيلم وحين تبدأ المأساة فى جمع الأطراف بعضها ببعض تبدأ وجوههم فى التمايز.
ثمة لقطة بانورامية تتكرر أكثر من مرة حين ترصد طابور العمال وساقية تدور فى نفس المشهد مما يشير إلى دوران الزمن، واستمرار العمال فى أداء نفس العمل الشاق دون توقف. وتلتقط الكاميرا شقاء العمال حين تصنع مفارقة فى مشهد يجمع بين انحناءة ظهور العمال على أعواد نبات القطن ووجه الناظر الذى يمتطى حماره وفى خلفيته السماء فى إشارة إلى سلطته المطلقة عليهم، وفى لقطات القطع الموازى بين شقاء “عزيزة” أثناء الولادة ورقص العمال وصخبهم فى المساء بعد انتهاء العمل.
هناك نقطة أخيرة تتعلق بالزمن. يستهل “يوسف إدريس” الرواية بمشهد الخفير “عبد المطلب محمد البحراوى” الخفير وهو يصعد من الترعة بعد اغتساله، فيكتشف اللقيط الميت أمامه، بينما يبدأ الفيلم من زيارة “فكرى أفندى” ناظر الزراعة إلى مقاول الأنفار ليعطى منطقًا زمنيًا مستقلًا للفيلم، لأن الشخصيات تظهر بالرواية تباعًا حسب الأحداث، ثم يوقف الراوى، كُلِّى المعرفة، الأحداث مؤقتًا ليمضى فى تقديم سمات الشخصيات، وحكايتها بطريقة الارتداد إلى الزمن السابق للحكاية “الفلاش باك” بينما يتبع الفيلم أسلوبًا زمنيًا خطيًا لا يقطعه سوى تَذكُّر “عزيزة” لحياتها وزواجها وجنينها أثناء إصابتها بالحمى، وهو تذكُّر يقدم الأحداث بمنطق فيلم سينمائى حكائى.

واستُبدل لقب مأمور الزراعة فى الرواية بالناظر فى الفيلم، ربما لتبدل الزمن، أو ما يمكن أن توحى به كلمة المأمور من التباس فى ذلك الوقت. وإذا كانت الرواية قد صورت عالمها بأسلوب سردى يطعم الفصحى بعامية أهل الدلتا، وأمثالهم وخبراتهم الحياتية وقد قدَّم الفيلم ذلك ببراعة فنية، فإنه تحاشى المباشرة التى كللت الصفحات الأخيرة من الرواية والمكتوبة بأسلوب تقريرى عن انتهاء الظلم بعد 1952م على أيدى الضباط الأحرار، وحصول الفقراء وعمال الترحيلة على أراض يزرعونها ويأكلون من ثمارها، فجثة “عزيزة” العائدة على عربة إلى قريتها هى تجسيد للمعاناة والقهر فى عصر الإقطاع دون احتياج إلى تفسير، أو مقارنة، أو دعائية؛ لأن الفن لا يرتبط بقضية سياسية آنية رغم تأثره بها، وإنما يُعبِّر عن الإنسان فى كل زمان ومكان.
باستثناء هذه الاختلافات البسيطة بين الرواية والفيلم والتى لها منطقها الخاص، فقد أفرد كل منهما نفس الرؤية التى تختزل الطبقية والقهر الاجتماعى فى حكاية واحدة من حكايات كثيرة.. لقد أفلت الجناة جميعًا فى الرواية والفيلم من العقاب، وتحمَّلت الضحية وزر الجريمة، فدفعت حياتها ثمنًا لذلك، وباستثناء بعض التعاطف الذى لم يُغيِّر مصيرها لم يكن ثمة ظل يحنو عليها فى لحظات الاحتضار سوى الظل الأبدى لشجرة مورقة تفرد ذراعيها فوق الجميع كأم رءوم بينما ظَلَّ الجناة، فى نفس مواقعهم، يبحثون عن ضحايا جُدد وهم يضحكون.