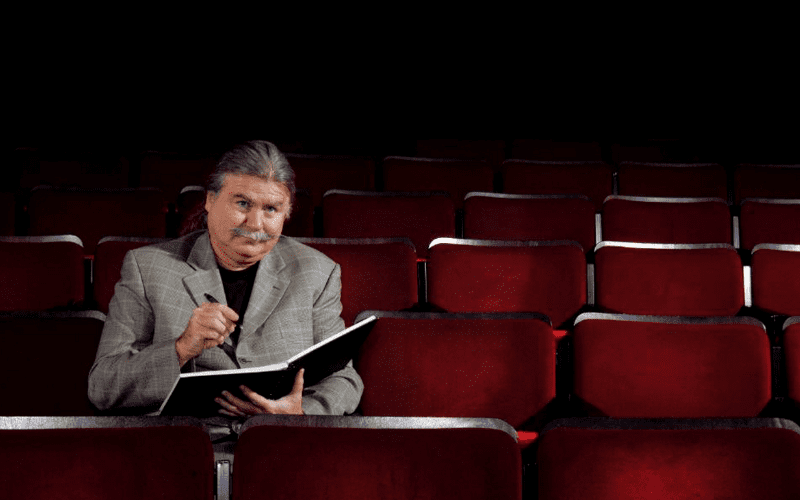نقاد السينما في زمن التدهور وهل لدينا نقاد سينما حقا؟

هل لدينا نقاد سينما حقا؟
سؤال نسمعه كثيرا. والاجابة: نعم لدينا نقاد قليلون مجتهدون، ولدينا أيضا الكثير من الصحفيين الذين يكتبون في السينما وعن السينما ويركزون على الجوانب الخبرية واجراء المقابلات الصحفية مع المخرجين.
ومستوى الكتابة عن الأفلام يتباين بالطبع. فهناك من يكتب من قلب الفيلم، وهناك من يكتب حول الفيلم أي من خارجه فيما يعتبر أقرب الى التحقيق الصحفي الانطباعي. لكن لا بأس. أما السمة التي تصبغ الغالبية العظمى ان لم يكن (كل) كتابات الأجيال التي ظهرت خلال الثلاثين عاما الأخيرة فهي أنهم يكتبون فقط عن (الأفلام) وأغلب الوقت عن “الأفلام الجميلة” وأحيانا يجدون أيضا أن (كل الأفلام جميلة) وأن العثور على سلبيات فيها يمكن أن يجلب لهم المشاكل مع صناعها خاصة لو كانوا من “الأصدقاء”..
ويميل الصحفيون منهم الى (الفرقعات) كأن يركزون مثلا على ما يقع في حفلات افتتاح المهرجانات، لكنهم جميعا يمتنعون عن الاشتباك مع قضايا السينما في بلادهم: مثل الرقابة ودور الدولة وطبيعة العلاقة بين السينمائيين والنقد، ونظرة المجتمع الى السينما، ومشاكل دور العرض والجمهور وفلسفة المهرجان السينمائي ودوره الحقيقي كما ينبغي أن يكون، ومشاكل معاهد السينما ودراسة السينما بوجه عام، وصولا إلى القضايا والاشكاليات الثقافية العامة والقضايا الفكرية ثم القضايا الجمالية: ما هي الواقعية، وهل هي المنهج الأفضل، ولماذا نعلي من شأن مخرج ما: هل بسبب اهتمامه بتناول الواقع على حساب المستوى الفني للفيلم والجماليات، وهل الموضوع السياسي أهم من الجمالي، وما الذي استفاده النقد السينمائي من النقد الثقافي، وهل موضوع الجندر مثلا أساسي في فهم الفيلم… الخ
كلها وغيرها قضايا يمتنع معظم النقاد الشباب بوجه خاص عن الخوض فيها. لماذا؟ لأنهم يؤثرون السلامة. فهم لا يريدون الاصطدام بالسلطة وهي ليست فقط السلطة السياسية بل سلطة الانتاج والنشر والتسويق والتوزيع والترويج والمهرجانات الشمالية والجنوبية، فهم يتقاتلون من أجل الحصول على الدعوات فكيف يتجرؤون وينقدون من يمنحون الدعوات، وهم يتكالبون على العمل لدى شركات الانتاج والتوزيع وقد ارتضوا جميعا، بينهم من يكتبون النقد منذ الستينات ايضا، اي من الجيل الذي يسبقني، بأن يكونوا ضمن مجموعة تمنح سنويا جوائز الفيلم العربي باسم النقاد تقيمها وتنظمها وتشرف عليها شركة للترويج السينمائي للأفلام!
وطبيعي أنك عندما تتطلع أن تكتب السيناريوهات أو تعمل لدى شركة انتاج أو تكون ناقدا توقفت عن النقد أو مخرجا توقفت عن الاخراج، والتحقت بالعمل في هذا المهرجان أو ذاك، أن تحرص على الصمت فالصمت من ذهب والكلام يجلب المتاعب. فلكي تكون “مستقلا” في مناخ فاسد تابع رديء يجب أن تكون قديسا.. هذا ما يقولونه ويبررون به السقوط.في أواخر الستينات وطوال عقد السبعينات كانت هناك حركة نقدية في العالم العربي قد نشأت واحتضنت الدعوة الى “السينما الجديدة” أي التي تهتم بالجوانب الفنية وتنفي السنيما التجارية” أي “سينما التسلية البورجوازية” ثم أطلق عليها الذين اجتمعوا من السينمائيين والنقاد في مهرجان دمشق الأول (والأخير) لسينما الشباب في 1972 “السينما البديلة

عمل النقاد الجدد وقتها أمثال سامي السلاموني وسمير فريد ورؤوف توفيق وهاشم النحاس وفتحي فرج في مصر كمثال، جنبا الى جنب مع السينمائيين (الشبان) المتطلعين الى تحقيق سينما أخرى تنتهج أشكالا جديدة في التعبير عن الواقع. وكانت هناك أصوات نقدية كثيرة أخرى في لبنان وسورية والمغرب وتونس، تدعو للسينما الجديدة، أي أن الحركة النقدية هي في الواقع التي أسست لفكرة السينما الجديدة، وكان هذا الهدف هو الذي يجمعها، وكانت تدور بين النقاد مناقشات طويلة عميقة حول مفهوم السينما الجديدة، وقد استمر هذا المشروع حتى كامب ديفيد في أواخر السبعينات بعد أن تفرقت القبائل العربية وتناحرت وانغلق كل ناقد على “مشروعه الشخصي” الذي لم يعد مشروعا فكريا بقدر ما أصبح مشروعا يقوم على “الوصول” إلى مراكز النفوذ ويصبح مؤثرا فقط على طريق التحاقه بالسلطة الثقافية (والسياسية) بعد سقوط مشروع العمل باستقلالية عن الدولة مثلا من خلال حركة “السينما الجديدة” في مصر أو السينمات الأخرى الشابة في بلدان أخرى.والمشكلة أن حركات التجديد كانت تعمل من داخل مؤسسة السينما المصرية التي أغلقها السادات في 1971 ومؤسسة السينما السورية التي ظلت أسيرة توجهات حزب البعث السوري، أما في العراق فالحال كان أكثر مأساوية منه في أي بلد آخر. وكانت بيروت وقتها العاصمة العربية الوحيدة التي ترحب بنشر كل ما يتم منعه في سائر بلدان العالم العربي من كتب وكتابات. وقد ظهرت في لبنان أيضا أسماء ساهمت في تطوير الحركة النقدية والسينمائية الجديدة في السبعينات.
كانت “سياسات السينما” او المغزى السياسي في الفيلم أي ما يعرف بالانجليزية باسمpolitics of film هاجسا يسيطر ربما أكثر من الضروري على شباب الحركة النقدية. فقد كانوا في غالبيتهم العظمى ينتمون لليسار، وكانت حركة الرفض والغضب إزاء ما وقع في 1967 تأتي من اليسار تحديدا. وكانت السينما الجديدة حركة مضادة للهزيمة. لكن وقعت مغالاة كبيرة في تقدير المغزى السياسي للفيلم على حساب الجماليات.
أتذكر شخصيا أن الناقد سامي السلاموني طلب مني في خريف عام 1976 أن أكتب دراسة عن فيلم “شيء من الخوف” لحسين كمال في إطار أسبوع سينمائي كانت تنظمه على ما أتذكر جماعة السينما الجديدة. وقد وجدت في الفيلم الكثير من الجوانب البديعة في الإخراج واستخدام لغة السينما ورمزية الموضوع الذي يدور حول رفض القهر والتسلط ولايزال الفيلم يعتبر حتى يومنا هذا من العلامات البارزة بل ويتخذ الكثيرون من شباب (وشيوخ) الفيسبوك مثلا من العبارة التي يرددها يحيى شاهين في الفيلم ضد عمدة القرية المتجبر الظالم محمود مرسى “زواج عتريس من فؤادة باطل” شعارا يرفعونه في مواجهة الظلم. وبعد أن انتهيت من كتابة الدراسة وقرأها السلاموني ثم اعترض عليها بشدة وأخذ يحاول أن يقنعني بأن هذا الفيلم رجعي وأن عتريس رمز لعبد الناصر خاصة وأن الفيلم مقتبس عن قصة الكاتب (اليميني) ثروت أباظة الذي يعتبر من غلاة الرجعيين، فكيف وأنا الشاب “الثوري” أكتب بشكل إيجابي عن الفيلم. ولم نتفق أبدا وأصررت على ما كتبته وعلى رؤيتي وقد نشرت الدراسة بالفعل كما هي.

ورغم ذلك كانت صفحات نشرة نادي القاهرة للسينما تمتليء بالكثير من المقالات والكتابات التي تعكس كأفضل ما يكون زخم الحركة النقدية وقتها: ومنها معارك خاضها السلاموني وسمير فريد مثلا مع سمير سيف (الذي كان يكتب النقد وقتها) حول الفكر السياسي في فيلم “كلاب القش” لسام باكنباه، وكثير من المعارك والجدل حول أفلام ومفاهيم أخرى.
ما الذي وصلنا إليه اليوم. وما الذي يجمع بين النقاد الموجودين على الساحة إن كان يجمعهم أي شيء، أو ما الذي يفرقهم ويجعلهم يستغرقون في محاربة بعضهم البعض ولماذا، وكيف تبدو صورة “شباب النقد”، وماذا يريدون، وهل لديهم هدف “فكري”، أم ماذا بالضبط يجمع بينهم؟
لدينا نقاد ونقاد من المستوى الجيد أيضا ولكن العدد قليل جدا ومحدود وأنا لا أقصد في مصر فقط بل حديثي يشمل العالم العربي كله. ولدينا أيضا صحفيون سينمائيون يعرفون جيدا وظيفتهم وأهميتها ولا يعتبرونها أدنى من وظيفة “الناقد”، فالكتابة الإخبارية والتحقيقات والمقابلات الصحفية مع السينمائيين، مهمة للتعريف بالأفلام. أما نقد الأفلام وتحليلها فمسألة أخرى. ولكن الاثنان يكملان بعضهما البعض.
كنت دائما اتحاشى الكتابة عن النقاد وكنت أكتب فقط عن النقد. ففي ظني أن الناقد يجب أن ينشغل أكثر بالكتابة عن الأفلام والقضايا السينمائية، لا أن يعطي دروسا للآخرين أو يحدد من هو الناقد ومن هو غير الناقد وكنت أرفض الإجابة على مثل هذه الأسئلة التي كانت توجه إلي. ولكني مضطر أن أكتب اليوم عن النقاد بشكل عام، وليس عن “نقاد” محددين بالاسم رغم وفرة الأسماء عندي.. وأعرف مسبقا أن البعض سيفتح نار جهنم علي، ولكن ما هو الجديد؟ وهل يجب أن أكترث؟
شخصيا كنت دائما أعتبر نفسي من هواة السينما، وعندما أكتب عنها فإنني أكتب لكي استمتع باكتشاف مزايا أو نواقص العمل، وأستمتع بالتعبير عن رؤيتي الخاصة وكيفية استقبالي للأعمال السينمائية، ولا تهمني صفات ناقد وأستاذ ومؤرخ وعالم وخبير ومحلل.. إلى أخر هذه الصفات التي يعتبرها البعض مبرر وجوده. فقد بدأت ومازلت أكتب حبا في السينما واهتماما بأمرها واعتبرها جزءا أساسيا في ثقافة أي مجتمع حديث.
وقلت فيما سبق أن هناك نقادا لكن ليست هناك حركة نقدية، وشرحت ما أقصده. لكن المسؤولية هنا ليست في الحقيقة مسؤولية “الدولة” التي نعلق دائما عليها كل أخطائنا وخطايانا، بل في النقاد أنفسهم. فعندما يغيب “الهم” النقدي والرغبة الحقيقية في تطوير السينما أو تغيير السينما السائدة، تغيب القيم وتنعدم أيضا الأخلاق. فالغالبية العظمى من نقاد الأجيال الجديدة لا يهتمون أصلا بتاريخ السينما، أو بالكلاسيكيات، فكم منهم شاهد أفلام كارل دراير الدنماركي مثلا؟
وهم لا يهتمون بالعثور على أرضية فكرية مشتركة تجمع بينهم. فما يجمع الكثيرين منهم هو “تبادل المصالح” فقط. وهم يجلسون معا لا لكي يتناقشوا في مفهوم كل منهم للسينما، بل لكي يستعرضون علاقاتهم العامة والخاصة، والتخطيط للسفر والحصول على الدعوات وتبادل الدعوات، والثرثرة الفارغة واغتياب الآخرين والطعن فيمن لا يعجبونهم والتقليل من شأنهم تحت تصور أن هذا سيجعل لهم شأنا. ويتشدق الكثيرون منهم بمعرفتهم بالسينما الفرنسية أو الأمريكية مثلا، أكثر من معرفتهم بسينما البلد الذي يعيشون ويعملون فيه، وعندما يكتبون عن فيلم “محلي” يكتبون بتعال واستعلاء.

حدث ذات مرة أن كتبت لي مخرجة ممن يعتبرونها من رائدات حركة “السينما المستقلة” تقول انها لا تحب أفلام فيلليني وترى أننا بالغنا كثيرا في قيمتها، وأنها لم تستفد شيئا منها، ولم يعجبها سوى فيلم واحد من أفلامه. هكذا بكل جرأة. وهو سلوك منتشر أيضا عند الكثير من النقاد الجدد تجاه عمالقة السينما من الأجيال القديمة، فقد يحدثونك بسخرية عن جودار نفسه مثلا. وقد يحدث- كما حدث- أن يستهزئ “ناقد” ما ويتساءل في سخرية بعد أن يقرأ ما نكتبه عن انتفاضة السينمائيين في فرنسا 1968: وما الذي حققه جودار وجماعته بعد كل هذا الضجيج؟
لكن هذا الناقد نفسه، تجده يعود ليكتب بشكل احتفالي سطحي يشيد بفيلم جودار الجديد بعد أن يشاهده بمهرجان كان خشية أن يقال انه جاهل.
المشكلة الأخرى أن معظمهم لا يقرأون الكتب النظرية في السينما أو في كتب نظرية الفن وعلم الجمال عموما، اكتفاء بقراءة المراجعات السريعة التي تنشر على المواقع الأجنبية على شبكة الانترنت. ويميل غالبيتهم الى التعصب الشديد لما يكتبونه عن فيلم ما ولا يقبلون أبدا برؤية أو رأي مختلف بل يسخرون من كاتبه ويقللون من شأنه وهي ظاهرة لا شك في كونها مرضية تعود أساسا الى التربية والنشأة والتكوين والعزلة والمناخ الفاسد الذي جعل معظم هؤلاء “بلا قضية”، وأقرب الى العدميين في مواقفهم من القضايا السياسية والاجتماعية، وكتاباتهم بالتالي تخلو من الحرارة والاحساس بالاشتباك مع الواقع.
يعتمد وجود “الناقد” أساسا على جهده الشخصي وقدرته على التفرغ لتطوير ادواته الثقافية: القراءة والمشاهدة وإعادة المشاهدة وحضور بعض المحاضرات التي يقدمها خبراء السينما، أو مشاهدتها والاستماع إليها عبر وسائل الاتصال الحديثة، والرغبة في السفر الى بعض المهرجانات، لا للاستمتاع بجلسات النميمة واستعراض “القدرات الخاصة”، بل للسعي وراء اكتشاف الجديد، سواء الأفلام أو الاتجاهات الجديدة.
وليس من الضروري أن يكتب الناقد يوميا، وليس شرطا أن يشاهد كل الأفلام أو أن يربك نفسه بجدول معقد مليء بعشرات الأفلام بحيث لا يجد وقتا للاسترخاء والاستمتاع بما شاهده و”هضمه” وتدوين بعض الملاحظات التي قد تنفعه فيما بعد إن لم يكن يكتب يوميا. فالإقبال على المشاهدة الكثيرة يؤدي الى “عسر في الهضم” أي هضم الأفلام، وتداخل المشاهد والصور، والارتباك الشديد. فالناقد انسان أيضا، يجب أن يجد وقتا لتناول الطعام والشراب وربما أيضا زيارة بعض المتاحف لتأمل أعمال الفن التشكيلي الذي ترتبط به السينما ارتباطا وثيقا.
هناك في رأيي فرق كبير بين الناقد الذي يريد أن يتعامل مع الفيلم بعين تحليلية فاحصة، وبين “هاوي السينما” (يميل البعض هذه الأيام الى تعريب كلمة اجنبية لا أرتاح إليها شخصيا هي السينيفيلي!). هاوي السينما يهمه مشاهدة أكبر عدد من الأفلام. وقد يعتبر كل الأفلام التي شاهدها جميلة أو كلها رديئة. فهو انطباعي سريع الأحكام. أما الناقد فيجب أن ينتقي ويختار ثم يكتب عما يثير اهتمامه وليس عن كل شيء وأي شيء أو عما تحبه سيادتك وتراه عظيما فالذوق الشخصي هو أساس النقد ومن دونه يصبح الناقد “ميكانيكي أفلام” وليس مثقفا مفكرا متذوقا، ومن دون حب السينما وروح الهواية يكره الناقد عمله وما يعمله لأنه يجده مجرد وظيفة لو وجد أفضل منها وأكثر فائدة من الناحية المادية، لالتحق بها فورا، وهو ما يحدث يوميا (ومثال ذلك من يهجرون الكتابة ويلتحقون بالعمل لحساب شركات الدعاية والتوزيع والإنتاج وكومبارس المهرجانات.. الخ).
ومن حق الناقد ألا يجد وقتا لمشاهدة بعض الأفلام لأنه يكون مشغولا بهضم ما شاهده والكتابة عنه خاصة لو لم يكن من النوع الذي “يسلق” الفيلم في بضعة أسطر. ومن حق الناقد أيضا كما يفعل جميع نقاد العالم، أن يترك الفيلم الذي لا يشعر أنه يمكنه أن يتفاعل معه سلبا أو إيجابا، فلا هو يشعر بالمتعة ولا بالحماس للكتابة عنه فما الفائدة من البقاء؟
هل مشاهدة كل الأفلام واجب مقدس بما فيها الأفلام الرديئة التي لا تثير شيئا في خيال الناقد ولا توحي له بفكرة جديدة؟ هذه فكرة رومانسية ساذجة مستقرة للأسف لدى بعض هواة السينما عن الناقد.

ولكن الناقد لا يكتب بالطبع عن فيلم لم يشاهده. وقد وُجد من نقاد الغرب الذين يعتبرهم بعض إخواننا العرب عجولا مقدسة، من يغرد على تويتر من داخل قاعة العرض مستخدما أقسى الألفاظ، لإدانة مخرج معين بعد دقائق من عرض فيلمه كما حدث مؤخرا من جانب ناقد أمريكي وهو يشاهد في مهرجان فينيسيا الفيلم الجديد للمخرج الدنماركي لارس فون تريير. وهو السبب الذي دفع مهرجانات كبرى مثل كان وفينيسيا الى عرض الأفلام للنقاد والصحفيين في نفس وقت عرضها العام لكي لا يؤثر ما يكتببه بعضهم على وسائل التواصل الاجتماعي من خزعبلات وبذاءات في حق الأفلام أثناء عرضها. لكن عندنا يواصل الكثير ممن يحبون أن يسموا أنفسهم “السينيفليين” كتابة التعليقات السريعة بلغة متدنية سوقية تتصف بالوقاحة، يردمون فيها على كبار الفن السينمائي في العالم لأنهم لم يستوعبوا أفلامهم، فكل الكبار الذين أسسوا للفن السينمائي لا قيمة لهم، وحضرته لأنه امتلك جهاز لاب توب، أصبح قادرا على الشطب عليهم بضغطة على الكيبورد!
من حق الناقد أن يختلف مع غيره وأن يعبر عن “رؤيته” الخاصة للفيلم. وقد تكون مختلفة تماما عن سائر الكتابات الأخرى، من دون أن ينبري له ناقد آخر أو صحفي مبتديء، لكي يرد عليه ويقلل من شأن كتابته، مستعرضا عضلاته وانتصاراته الوهمية أمام “شلته” على الفيسبوك.
يمكن لأي كاتب أن يكتب ويرد على أي رأي لا يعجبه ولكن من خلال طرح فكري وجمالي مضاد يعبر من خلاله عن “رؤيته” الخاصة ان كانت لديه رؤية أصلا، وهي مسألة يمكن أن تفيد النقد وتدعمه.
ومن الظواهر السلبية الأخرى أن تجد من يكتب فيتباكى على أن غيره من النقاد، لا يكتب عن حركة الكاميرا ولا يفرد مساحة للتكوين والجماليات.. الخ وعندما تسأل: لماذا لا يفعل هو ليعطينا دروسا نستفيد منها في هذا المجال؟، تفاجأ بأنه يرد بالقول إن المساحة المخصصة له لا تسمح بهذا.
ومثله مثل كثير من إخواننا “السنيفيليين” أو المولعين بالسينما الذين يجدون السينما أهم من الحياة بينما السينما أداة فنية ابداعية تساعدنا على فهم الحياة والاستمتاع بها، وليس ممكنا أن تكون بديلا عنها.. فهؤلاء مغرمون بإلقاء الحجارة على من يجتهدون من النقاد العرب بدعوى أنهم أيضا لا يكتبون عن “سينمائيات” الفيلم ويركزون على مضمونه. ولكن الغريب أن هؤلاء لا يتجرأون على توجيه مثل هذا القول إلى ناقد مثل “روجر ايبرت” الأمريكي صاحب الكتابات الانطباعية.
وربما يكون مفيدا إعادة التذكير بهذا المقال الذي كتبته من قبل لأنه يدخل في صلب هذه الموضوع..
النقد الانطباعي ليس عيبا
جريدة “العرب”- الأربعاء 2017/02/08
عندما يحاول البعض، خاصة من الأكاديميين، التقليل من شأن بعض ما يكتب وينشر في مجال النقد، يصفونه عادة بـ ”الانطباعي”، فهم يعتبرون الانطباعية أقل شأنا من غيرها من مناهج النقد، ولكن الحقيقة أن للانطباعية نقادها الكبار المرموقين، ففي الأدب العربي مثلا، يعتبر الكثيرون طه حسين ناقدا انطباعيا.
ويعرف أناتول فرانس النقد الانطباعي بأنه “مغامرة الروح بين التحف الفنية”، فالناقد يعبر عن انطباعاته الشخصية عن العمل الفني أو الأدبي، ويستخدم عادة، ضمير الأنا في التعبير عما يشعر به أثناء مشاهدته الفيلم، ويعبر عن أحاسيسه ومشاعره تجاه شخصيات الفيلم، وربما يتوقف عند مشهد معين يعتبره الأهم في العمل، مع إغفال الكثير من المشاهد والأحداث الأخرى التي قد لا تقل أهمية عن ذلك المشهد، فالنقد الانطباعي في اعتماده على المشاعر الشخصية للناقد، لا يخضع العمل الفني لمقاييس محددة أو مناهج صارمة في التقييم، فهو غير مهتم بتقديم بيان تفصيلي شامل، بل المهم أن يعبر عن كيف كان استقباله هو للعمل الفني.
ومع ذلك، يجب أن يكون الناقد الانطباعي مثقفا ومطلعا ومشاهدا جيدا (للأفلام)، يعرف تاريخها وعلاقتها بما أنجزه صاحبها من قبل، ولكنه لا يهتم كثيرا بوضعها في سياق تاريخ السينما والمقارنة بينها وبين ما سبقها من أفلام للمخرج نفسه، فهو يرى العمل كوحدة مستقلة قائمة بذاتها، يدوّن عنها ما انطبع في ذهنه من انطباعات، ما أحبه وما لم يحبه، وأحيانا دون أن يقدم تبريرا أو رصدا للعوامل التي جعلته يصل إلى هذا الشعور (بالحب أو عدم الحب) غير إحساسه بالبهجة والسعادة، وهو ما يعبر عنه بوصف المشهد ووصف مغزاه كما وصل إليه، كما قد يعبّر عن شعوره بالامتعاض والضيق أمام عمل آخر (ربما يراه غيره تحفة فنية)، بينما يجده هو غامضا، صعبا، يقتضي الكثير من الجهد الذهني.
من أعلام المنهج الانطباعي في النقد السينمائي العربي الدكتور رفيق الصبان رحمه الله، الذي كان يستخدم الكثير من التعبيرات الأدبية البديعة العامة في وصف الأفلام التي يكتب عنها. وقد كتب عنه قيس الزبيدي يقول إن الصبان “يستعمل ‘الفيلم’ ليعبر، أدبيا، عن مزاجه وتذوقه الخاص، لكن وفق قدرة أدبية مميزة تحول خطابه النقدي إلى أدب خالص وجميل قلما نقرأ مثله حتى عند بعض النقاد العرب الذين يكتبون في ‘أدب السينما’، وأن منهجه ‘يتشكل من تداخل قاعدتين: قاعدة الإدراك الانطباعي المباشر، وقاعدة الاستقراء التي تقوم على مراجعات عامة لكلية الأجزاء/العناصر وتغفل قاعدتي التحليل والتركيب.
ولم يكن هذا يعيب الصبان، بل كان ما يكتبه مفيدا في جذب الكثير من الشباب من عشاق السينما إلى الاهتمام الجاد بالأفلام الفنية الرفيعة التي كان الصبان يعشقها ويحتفي بها في كتاباته. أما أكبر أعلام النقد الانطباعي في أميركا والغرب عموما، فهو الناقد الراحل روجر إيبرت الذي ظل يواصل كتابة النقد لأكثر من خمسين عاما، وكانت له بعض الآراء التي تصدم عشاق السينما “الأخرى” الفنية، فقد كتب، على سبيل المثال، يعبر عن شعوره الشخصي بعد مشاهدة فيلم “الاشتراكية” للمخرج الفرنسي جون لوك غودار (نبي السينما الجديدة في العالم منذ الستينات)، يقول “في فيلم ‘الاشتراكية’ الذي أخرجه وهو في التاسعة والسبعين، انجرف رائد الموجة الجديدة الفرنسية إلى البحر، هذا الفيلم هو إهانة، إنه عمل غير متماسك، يثير الحنق، مبهم عمدا، ينحرف تماما عن الطرق التي يشاهد الناس من خلالها الأفلام”.

ومع ذلك يواصل عدد من النقاد الأميركيين الإبقاء على “مدونة” روجر إيبرت على الإنترنت، يكتبون لها محاولين محاكاة أسلوبه وطريقته، كما أنشأ بعض هواة السينما العرب صفحة خاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مقالاته بعد ترجمتها إلى اللغة العربية.
يجب أن أعيد التأكيد على أن ما أكتبه هنا يعبر عن “رؤيتي” الخاصة للمسألة التي اتناولها وليس المقصود فرض وجهة نظري على أحد أو اعتبار ما أكتبه غير قابل للنقد. فالنقد مشروع بناء، أما التهجم والتطاول فهو من شيم المراهقين والمتطفلين والعاجزين عن التحقق.
نعم لدينا نقاد. ولكن الخلط وقع والتداخل حصل ويحصل، والادعاء والمزاعم زادت بشكل خانق. وقد سبق أن نشرت مقالا (أصبح منتشرا كثيرا) تحت عنوان “الوصايا العشر للناقد المحترم”.
وكنت أعبر من خلاله عما ألتزم به شخصيا في علاقتي بالوسط السينمائي. ولكن البعض أراد أن يفهمه على اعتبار أنه “موجه” ضد شخص معين أو مجموعة أشخاص محددين، بينما الصدفة وحدها يمكن أن تكون قد أوحت بذلك بسبب التشابه بين سلوكيات البعض وبين بعض ما جاء في المقال. وكان ما كتبته أقرب الى “بروتوكول أخلاقي” ولم يكن له علاقة بما يجب أن يكتبه الناقد أو لا يكتبه أو بالمناهج والأسس النقدية في التعامل مع السينما.. وقلت إنها كلها أمور متروكة لاجتهاد كل منا. ولكن الصديق الكبير قيس الزبيدي أرسل الي مقالا نشرته في موقع “عين على السينما” قام فيه بمد الموضوع على استقامته وناقش بعض مفاهيم للحكم على ما يكتب في مجال النقد وهل هو نقد أم لغو. ولم يكن هناك بأس في ذلك بالطبع. فالباب مفتوح لشتى الاجتهادات. لكن مقالي الأصلي أزعج الكثيرين فأضافوا أنفسهم إلى قائمة الكارهين واللاعنين. لا بأس. فهل كنت أبدا أكترث!
أعود إلى السؤال الذي يشغلنا: هل لدينا نقاد؟
نعم. لدينا.. ولكن لدينا نوعان من النقاد.
الناقد الرسمي والناقد المستقل
هناك الناقد المستقل والناقد الرسمي. الأول يكتب دون أي اعتبارات لإرضاء “المؤسسة” والقائمين عليها. والمقصود بـ “المؤسسة” الجهات التي تتحكم في العملية السينمائية والثقافية على الصعيد الرسمي أو على مستوى مؤسسات الإنتاج والتوزيع والعرض وجماعات السينمائيين الذين تجمعهم مصالح معينة بل تحول معظمهم في بلاد العرب الى شلل لتبادل المنافع أيضا على غرار شلل وميليشيات الصحفيين من جماعة تبادل المصالح الذين تمتلئ بهم عادة مهرجانات السينما العربية، والذين يجلسون على شاطئ البحر (في المهرجانات البحرية)، أو في ردهات الفنادق في المهرجانات (الداخلية) تأكلهم الغيرة مما حققه هذا أو ذاك من نجاح من خارج محيط شللهم البائسة. وهي ظاهرة يلاحظها الجميع ويغضون الطرف عنها.
أما “الناقد الرسمي” فهو يكتب وعينه على “المنصب”- أي منصب- حتى لو كان منصبا شرفيا لا قيمة له، لكنه يمنحه “الاعتراف” الرسمي الذي يتوق إليه ويعشقه ومن دونه لا يشعر بأنه موجود. وقد رأينا كيف وصل مثل هذا الناقد “الرسمي” في وقت ما، إلى مناصب نافذة- في المشرق وفي المغرب- أتاحت له فرصة “إرضاء” الكثيرين وتوزيع “المنافع” و”العطايا” عليهم خاصة أهل الصحافة من القابلين للارتشاء بوجه خاص، فأصبح “معبودا” عندهم، يكيلون له ليلا ونهارا عبارات الثناء الفارغ، والكثيرون منهم اعتبروه “مفكرا سينمائيا” عظيما لا يشق له غبار، وهناك الناقد الرسمي الذي يلعب في حضن “المؤسسة” فعلاقاته بمن يسمونهم “الفنانين” مكشوفة، ولكن ماذا يمكن أن يكتب هو عن أفلام “الفنانين” و”الفنانات” الذين يحضرون ويرقصون ويرقص معهم في حفلاته الخاصة في الزواج والميلاد والطلاق والهلس، والذي منه؟
“الناقد المستقل” يحكم ذائقته الشخصية في التعامل مع السينما، ويكتب من دون حسابات، ليس هدفه لا أن يرضي أو يغضب أحدا، بل أن يعبر عن “رؤيته” الخاصة في العمل السينمائي وأن يفهم الفن السينمائي أكثر ويحاول أن يفك بعض ألغازه وأسراره وسحره. وليست كل الأفلام تصلح لتطبيق منهج نقدي رفيع المستوى عليها، فكثير من الأفلام ليست من النوع الذي يندرج في إطار “الإبداع” أو “الظاهرة الإبداعية” بل يمكن اعتبارها في الحقيقة جزءا من “الظاهرة الاستهلاكية”.
ويمكن للناقد المستقل أن يتولى قيادة عمل له علاقة بالثقافة السينمائية، لا في مجال “تصليح السيناريوهات” مثلا، لكنه لا يتخلى عن دوره كناقد سواء وهو في المنصب أو بعد أن يتركه، وليس كما يحدث عندما “يتقاعد” الناقد عن مهمته الأساسية إكراما للمنصب، ورضوخا لمن منحوه إياه.
من المهم دون شك، أن يتعامل الناقد مع أفلام بلده كلما أمكن، وأن يعرف تاريخ السينما في بلده ويلم به ويعرف كيف نشأ هذا الفن وتطور ومن الذين شاركوا في تطويره، وأن يراجع ويعيد النظر في الكثير من المقولات التي كانت سائدة في الماضي عن بعض المخرجين، ويزيل الأتربة من فوق الصور التي ترسبت لأعمالهم من الذاكرة الثقافية. لكن لدينا في العالم العربي من يكتبون عن كل شيء في السينما الفرنسية أو الأمريكية مثلا، لكنهم يتعففون عن الكتابة عن أفلام بلادهم. وهناك من الناحية الأخرى من يكتبون كثيرا عن أفلام بلادهم لكنهم يقتبسون مناهج أوروبية (فرنسية بوجه خاص) لتطبيقها عنوة وقصرا على أفلام بسيطة كل البساطة في بنيتها وتكوينها، وهم في ذلك كما سبق أن قال الناقد الراحل مصطفى المسناوي- يضعون هيكلا عملاقا فوق كيان هش ضعيف البنيان فينهار العمل تحت ثقل المنهج!

من الناحية الأخرى هناك من يرى أنه يتعين على الناقد السينمائي أن يتصدّى إلى نقد كل الأفلام المحلية التي تنتج في بلده، بكل أنواعها، بما فيها الأفلام التجارية السائدة مهما بلغت سطحيتها وسوقيتها وابتذالها.
ولا شك أن دور الناقد هو أن يعثر على صلة للوصل، بين الفيلم والجمهور، وأن يلعب دورا في تقريب الفيلم من الجمهور، بغض النظر عما إذا كان تعامله بالنقد مع الفيلم سيكون بالسالب أو بالموجب. وهو أمر صحيح، ولكن نقد الأفلام وحده لا يكفي، بل يجب تناول الظواهر والاتجاهات والقضايا السينمائية التي تعج بها الساحة، سواء محليا أو عالميا.
أن يمتلك الناقد الجرأة على توجيه النقد إلى منتج سينمائي ما، لكونه يصنع أفلاما متدنية في قيمتها من وجهة نظر الناقد، ليس معناه أن يتغاضى عن توجيه النقد إلى المنظومة الثقافية التي تشجع وتدعم وتفرز مثل هذا المنتج، في وقت تتقاعس عن تشجيع التجارب الشبابية الجديدة التي يمكنها أن تساهم في تقدم الوعي بدور الفيلم في المجتمع.وهذه هي احدى فوائد “النقد الثقافي” رغم أنني لست شخصيا من المولعين به، لأنه يمكن أن يطغى على النقد الجمالي الذي يسمو على كل شيء في نظري.
والنقد السينمائي لا يوجد فقط في الصحف المطبوعة اليومية أو الأسبوعية أو حتى الصحافة السينمائية المتخصصة، بل وأيضا، في التلفزيون والإذاعة وعلى شبكة الإنترنت من خلال المواقع المتخصصة، والتي تخصص نافذة للنقد السينمائي والاهتمام بقضايا السينما باعتبارها فنا شعبيا يتطوّر يوما بعد يوم. وربما يكون ظهور الناقد على شاشة التلفزيون أكثر تأثيرا من عشرات المقالات، إذا عرف كيف يطرح مادته بعمق وفي أسلوب جذاب، لا أن يتحول كما يحدث، إلى حكواتي ومسلياتي.
يظهر سنويا عدد كبير من الأفلام الاستهلاكية، التي تتكرر موضوعاتها، وتتشابه حبكاتها وشخصياتها ونهاياتها، ومنها الكثير من الأفلام المقتبسة بطريقة ساذجة عن أفلام أجنبية، ولكن بعد أن يتمّ تمييعها وإخضاعها لمقتضيات السوق والذوق السائد.
وإذا تفرغ الناقد أسبوعا وراء أسبوع، مخصصا مقالا مستقلا لكل فيلم من هذه الأفلام، فسوف يتدنى الجوهر من فكرة النقد نفسها، لأنه سيكرر نفس الأفكار والآراء والخلاصات، ويعجز عن تطبيق المناهج النقدية المتقدمة على هذه الأفلام الهزيلة، بل سيكتفي دائما بالتعامل معها في إطار “الظاهرة الاجتماعية”، لا باعتبارها جزءا من ظاهرة الإبداع الفني فحسب، بما في ذلك ضياع الجهد والوقت، بل أيضا تمييع قيمة النقد ذاتها.
والأجدى أن يكتفي الناقد بتناول بعض نماذج هذه الأفلام، في إطار رصد الظاهرة الاجتماعية وتأثيرها على المنتجات الفنية التي يتم تعليبها لجمهور السينما السائدة.على أن يتفرغ لنقد الأعمال التي يمكنها أن تثري الجدل النقدي والتفكير في الجماليات وتطوير أدوات النقد وأدوات التعبير السينمائي أيضا إذا أمكن أو اذا اهتم السينمائي بقراءة النقد أصلا.
إن دور النقد ليس فقط دورا ذيليا، أي اللهاث وراء كل ما يظهر من أفلام يوما بعد يوم، فإذا تأخر ظهور فيلم أو أكثر، تعطل النقد وغاب دوره وتوقف، بل على النقد أن يتعامل أيضا مع القضايا الفكرية للسينما، استنادا إلى تاريخها الثري في العالم، وأن يبحث أيضا في ما يمكن أن ينقل الفن السينمائي إلى الأمام، ويدرس وينظر إلى علاقة الفيلم بغيره من الفنون، ويعتبر الفيلم نتاجا إبداعيا يعبر عن رؤية المبدع الفلسفية وتأمله في ما يحدث من حوله في العالم، وليس مجرّد أداة لنقل رسالة مباشرة ساذجة معينة للجمهور: أخلاقية أو أيديولوجية.
إن لم يلعب النقد السينمائي دوره الحقيقي المفترض، فسينكمش ويتراجع ويصبح نتاجا ذيليا، يقتفي أثر المنتج السينمائي أيا كان مستواه، يعلو معه إذا ارتفع، ويهبط مع هبوطه.
ولأن السينما عالم متجدد فالنقد أيضا يتجدد، وإذا عجز عن متابعة الجديد، في السينما وفي تطور الأنواع الفنية وتطور النقد أيضا، يتلاشى، أو يصبح بوقا دعائيا فاقدا للقيمة والدور والتأثير.
الناقد الرسمي
الناقد الرسمي الذي سبق أن أشرت إليه هو الناقد الموالس المداهن المنافق الذي يطوع كتاباته لمصلحته الشخصية، الذي يضع عينا على الفيلم والأخرى على المنصب أو المكسب الذي سيجنيه من وراء ما يكتبه.
النقد عموما مشروع تمرد على الثقافة السائدة، فهو يريد تغييرها بل ويحلم أيضا بتغيير العالم، أي تغيير ما فيه من قبح من خلال السينما والفنون العظيمة الإنسانية. لذلك فهو ينشغل بالبحث عن الجديد ومذاهب التجديد ويولها ما تستحقه من دراسة، لا يكرس السائد المتخلف ويمجده بل يريد أن يهدمه فالسينما السائدة جزء من الثقافة السائدة، ثقافة التضليل والتطبيل وأبلغ دليل على أفلام التطبيل هي أفلام المناسبات التي يقال لها “الوطنية” وهي مناسبات تخص السلطة القائمة أساسا ولا تخص الشعب فمحظور على السينما الاقتراب من الاحتفال مثلا بالثورات الشعبية الحقيقية، بل بأعياد انتصارات الحاكم الوهمية… ولعل في هدم السينما المتخلفة دعوة الى ظهور السينما الجديدة.
النقد والتمرد على الثقافة السائدة
الناقد بهذا المعنى هو متمرد أو حتى ثائر على الثقافة السائدة الاجتماعية والسياسية والدينية.. الخ، وليس من الممكن لناقد حقيقي مستقل سواء من اليمين أو من اليسار، أن يكون متوائما متماثلا مع السلطة خاصة لو كانت السلطة القمعية المتخلفة التي تقف في وجه التجديد والتطور، تقمع الفكر والرأي الحر، وتعادي حركة التاريخ نفسها.
الناقد متمرد يسبح ضد التيار سواء كان من اليسار أم من اليمين (الحقيقي) وليس الفاشي التافه.
ناقد اليمين يدافع عن القيم الليبرالية وعن ضرورة اتاحة الحرية للجميع، وناقد اليسار ينتصر للجديد، الثوري في الفن وفي الفكر. لكن الناقد الموالس المدلس المداهن يسخر من الثورات، ويدافع عن السلطة لأنه لا يستطيع أن يوجد من خارجها بل يظل دائما يدور في فلكها لذلك فهو ليس مثقفا حقيقيا بل متطفل على الثقافة، يلمس قشور الثقافة ويحمل من المزاعم والادعاءات أكثر كثيرا مما يعرف عن السينما وعن العالم. وهو بهذا المعنى ناقد ساقط صاحب مصلحة في بقاء التخلف وبقاء السينما التقليدية العتيقة لأنه يتعيش عليها وعلى صناعها، يحقق مكاسبه من خلالهم ويعمل في دروبهم. وعندما يدعي الدفاع عن تجربة سينمائية جديدة جريئة في الغرب مثلا يمكنك ان تكشف بسهولة كذبه وتفاهته وسطحيته وادعاءاته. إنه يعيش ويتعيش على السقوط فقط.
ومن جهة أخرى هناك أيضا الناقد المسلياتي الذي لا يرى في غير سينما التسلية شيئا جديرا بالكتابة عنه. فهو مثله مثل الراقص في الحلبة، يريد أن يذوب تحت أقدام السفهاء الذين يدفعون له أجره. وهو مسلياتي لكنه ثقيل الظل، سليط اللسان، ضعيف اللغة، تافه الحجة، كلبي النزعة، يترمم على الأحداث والظواهر والمهرجانات، يبحث عن أي فرصة بأي ثمن لإثبات وجوده لكنه تعيس يعاني بسبب عدم تحققه واحتقار المثقفين له!