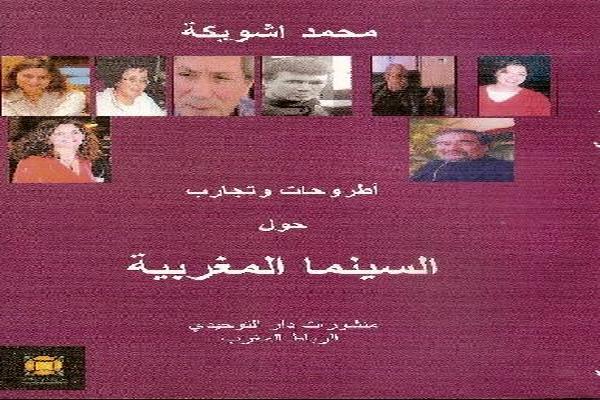محمود عبد الشكور: من الدرجة الثالثة الى سينما المقاعد الخالية!

عُدتُ منذ وقت قريب الى أوراق مكتوبة بخطوط باهتة أروى فيها حكايات متناثرة من دفتر الذكريات فى دور العرض السينمائية. تستطيع أن تقول أنها “نوستالجيا” فى حب السينما تكشف عن اعتقادى الذى دافعت عنه مراراً بأن مشاهدة الأفلام طقسٌ متكاملٌ لا يتحقق إلا داخل دور العرض. لا أتكلم فقط عن شروط المشاهدة الفنية كما أرادها صاحب العمل، ولكنى أتحدث أيضا عن دار العرض كمكان تسكنُه الذكريات، عن الرائحة والمناسبة والمعنى، عن مشاهدة الأفلام كحكاية لا تقل متعة عن الحكايات التى تعرضها الأفلام .
فى هذه السطور مثلا حكاية أول مرة ذهبتُ فيها الى سينما الدرجة الثالثة…
كنا خمسة أو ستة طلاب جامعيين (زى الورد) يعانون ملل ما بعد تناول وجبة العشاء فى المدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة ذات ليلة شتوية باردة . لا أذكر تحديداً منْ الذى اقترح أن نقتل الملل بأن نذهب (بربطة المعلم) الى سينما الدرجة الثالثة الشهيرة الكائنة فى قلب ميدان الجيزة. الشئ المؤكد أننى لم أكن صاحب الإقتراح رغم شهرتى كأحد “دراويش” السينما، فقد كنت أشترط أن تكون الأفلام معروضة فى صالات الدرجة الأولى، لأن سمعة الصالات الترسو “مش ولا بُدّ”، ولكن التردد العابر سرعان ما تلاشى عندما قال أحد الخبثاء إن “البروجرام” حافل هذا المساء ودرّته اليوم فيلم “المذنبون” الذى طبّقت حكايته مع الرقابة المصرية الآفاق، والذى اختير فى تلك الفترة (منتصف الثمانينات تقريباً) ضمن قائمة نشرتها مجلة “آخر ساعة” من أفضل عشرة أفلام فى تاريخ السينما المصرية.
توكلنا على الله، وكان منظرنا مهيبا حقاً ونحن نتجاوز البوابة الكبرى للمدينة الجامعية كعصبة من أولى القوة يبدون كما لو أنهم يحتشدون لمؤازرة زميلهم “الفالح” فى رحلته للدفاع عن أطروحته للماجستير أو الدكتوراه. ولأن المسافة ليست بعيدة فقد قررنا أن نقطعها سيراً على الأقدام ، وأصرّ أحد أفراد الجروب على أن نذهب عن طريق الشارع الذى يوجد فيه تمثال نهضة مصر الشهير لكى يكرّر طقساً وثنيّاً فيما يبدو، وهو أن يُسمعنا قصيدة “ثورة الشك” لأم كلثوم ونحن ممدّدين فوق النجيل أمام التمثال. حرصاً على تماسك الجروب وافقنا على تحمّل صوت صاحبنا الأجشّ الذى يثير أكبر “ثورة شك” فى نفس أى دورية شرطة راكبة أو مترجلة ، بعدها قفزنا بسرعة لاستكمال الرحلة حتى ظهرت السينما من بعيد تعلوها أفيشات باهتة اختلطت ألوانها، ويتحلّق أسفلها حفنة من بائعى اللب والفول السودانى.
أول ما لفت نظرى أن الأفيشات الأربعة التى تعلن عن البروجرام ليس من بينها أفيش فيلم “المذنبون”، ولكن صديقنا أفتى بأن ذلك لا يعنى شيئاً فى هذه الصالات التى تعتمد على المفاجآت. اخترنا أن نحجز “لوج” تحت وطأة تضخم شعورنا الطبقى. لا أعتقد بأى حال من الأحوال أن كل هذا الجيش قد دفع أكثرمن عشرة جنيهات، ولأن العرض مستمر، فقد أخذنا نتخبط وسط الظلام الدامس يقودنا “بلاسير” قصير وله كرش ضخم، وطوال رحلة العبور هذه لم يتوقف الرجل عن إلقاء التعليمات: “خُشّ يمين” .. “ارفع رجليك”.. “افرد الكرسى وصللى على النبى” .. “امسك إيدين أخوك”، والمدهش أنه لم يكن يحمل معه إلا “مشروع كشاف” مرتعش الضوء أوشكت بطاريته على النفاد.
كان حتمياً أن نصطدم بالأقدام والأرجل، وسمعنا من ألفاظ جمهور “اللوج” ما لا يقل سوءاً عن ألفاظ جمهور الصالة، واكتشفنا فى غمار المعركة أن حائطاً واطئاً يفصل بين الجمهورين، أما الشاشة فكانت تتراقص عليها خيالات باهتة تجعلها أقرب الى اللوحات التجريدية. وعندما استويتُ أخيراً على المقعد، أفادنى أقرب متفرج بأننا نشاهد فيلماً “شديدا” بعنوان “امرأة ورجل” بطولة رشدى أباظة و ناهد شريف. الحقيقة أن شريط الصوت كان يصدر حشرجة تؤكد “شدة” الفيلم والمشهد المعروض، لكن الصورة كانت غائبة تقريباً، أو لنقل أنها تحتاج الى بعض الخيال على أساس أننا فى “دار الخيالة”.
لا تسألنى عن الأفلام المعروضة لأننى لم أشاهد أو اسمع شيئاً، ولكن فى منتصف العرض تقريباً (لستُ متأكداً بالضبط لأننى فقدت الإحساس بالزمن) حدثت واقعة لا تُنسى. فجأة انفجر هرجٌ ومرج، واختلطت الأصوات والصرخات، واندفعتُ فى برهة من الزمن تحت ضغط المندفعين لأجد نفسى عابراً للحائط الواطئ، وطائراً الى قلب الصالة، وبنفس السرعة عدنا الى أماكننا فى “اللوج” وكأنك أعدت شريطاً سينمائياً الى الأمام ثم الى الخلف. من بعيد جاءنا صوت “البلاسير” القصير البدين عاتباً ومستنكراً: “معقولة يا أفنديات تجروا كدة عشان واحد (….) اتخانق فى الصالة ؟!”.. الرجل لم يسكت أيضاً عندما عرف أن أحد أعضاء الجروب من طلبة الحقوق، استنكر “البلاسير” بشدة ان يهرب زميلنا مذعورا، ويقفز خائفاً، لأن هذا التصرف لا يصحّ أن يصدر من طالب يمكن أن يكون “افتراضياً” وكيلاً للنائب العام .
انفجرنا ساعتها فى ضحك هيستيرى لم يتوقف حتى بعد خروجنا سالمين دون أن نكمل “البروجرام” اللعين، وكان أفضل ما حدث لنا فى طريق العودة أن زميلنا (بتاع ثورة الشك) خرج الشك من عقله الى الأبد، فلم يجرؤ على اسماعنا قصيدته المفضلة أسفل التمثال. الحقيقة أنه خاف منا لأننا كنا فى حالة جاهزة لإسماعه قصيدة “أيها الراقدون تحت التراب”!
أُفضّل عادة الذهاب لمشاهدة الأفلام فى حفلات صباحية حتى أستطيع التركيز ثم الكتابة بعد ذلك . لستُ ممن يكتبون أبداً أثناء المشاهدة ، وأكتفى فقط بتسجيل نقاط سريعة أقرب الى العناصر فى نوتة صغيرة فى أثناء الإستراحة رغم اعتراضى أصلاً على فكرة الإستراحة التى تخلّ بتدفق الفيلم وإيقاعه وبنائه وأسلوب استقباله كما أراده صانعوه. المعنى: أحب الحفلات الهادئة، ولكنى بالتأكيد ضد الحفلات الخاوية التى تجعلنى “وحدى فى السينما” على وزن الفيلم الأمريكى الناجح “وحدى فى المنزل” ، ولكن هذا ما حدث فعلا وفى أفلام لا يمكن تصنيفها إطلاقاً على أنها من الأفلام الرديئة .. إنما نعمل إيه ؟ حكمة ربنا”.

هذا مثلا فيلم شاهدته فى صالة خاوية تماماً، رأيته بمفردى بالمعنى الحرفى وكأنى فى عرض خاص أقيم على شرفى، يعنى وحياتك كنت أنا والصالة والفيلم وعامل آلة العرض الذى يظهر ويختفى داخل الكابينة فى نهاية الصالة، وحتى أكون دقيقاً فقد كانت هناك أيضا قطة بيضاء تتجول بين المقاعد الخاوية بكبرياء مدهش جعلها ترفض أى دعوة منى لتشاطُر المشاهدة. الفيلم المعروض اسمه ” سيلينا” انتاج سورى عن مسرحية “فيروز” الشهيرة ” هالة والملك”، ومن بطولة دريد لحّام وميريام فارس وباسل خيّاط وإخراج حاتم على، أما المكان فهو إحدى دور العرض فى المول التجارى الشهير فى شارع الهرم السياحى، والزمان: حفلة الثالثة والنصف عصراً فى أحد أيام الصيف.
ما ضاعف شعورى بغرابة التجربة أن عامل العرض لم ينزعج أبداً من وجود مشاهد “يتيم”، وتعامل مع الموقف وكأنه يدير الفيلم فى حفلة تكتظ بمئات المتفرجين. عندما حان وقت الإستراحة، أوقف الرجل العرض مع أننى لم أغادر المكان ولكنها الأصول. أعجبنى جداً هذا السلوك “الإنجليزى” فى التعامل ، ولو كنت فى إحدى صالات وسط البلد الأكثر شعبية، لما سمحوا أبداً بهذا العرض “الشخصى” حتى لو كان “فيللينى” نفسه هو المتفرج الوحيد . كنت سعيدا بالهدوء والتركيز، ولكنى لم أكن سعيداً بسبب هذا الكساد الذى لا يستحقه قطعاً هذا الفيلم رغم ملاحظاتى الكثيرة على العمل، والتى سجلتها فى مقال طويل نشرته فى جريدة “روز اليوسف”، ولم أنس أن أسجل فى مقدمة المقال هذه المناسبة الشخصية التاريخية: أن أشاهد فيلما بمفردى فى صالة عرض خاوية.
فى مناسبات أخرى، كنتُ وسط أفراد لا يزيد عددهم عن ثلاثة فى صالة عرض واسعة ( يرمح فيها الخيل) . عندما عُرضت تحفة “رضوان الكاشف” الرائعة ” عرق البلح”، قررت أن ألحق أشوف الفيلم قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. ذهبتُ قبل حفلة الواحدة والنصف الى سينما “ريفولى” الشهيرة. لا أذكر هل كان ذلك قبل تقسيمها على عدة صالات أم بعد قرار التقسيم . ما أذكره أن موظف شباك التذاكر نظر الىّ باشمئناط ممتزج بالدهشة ومعجون بالقرف، وقال لى رداً على طلبى بحجز تذكرة لمشاهده الفيلم : “حفلة الساعة واحدة اتلغتْ.. ما حدش عايز يحجز للفيلم”. بدلاً من أن تفتّ هذه العبارة فى عضدى زادتنى حرصاً على مشاهدة “عرق البلح”، بل لقد خالجنى شعور قوى ( ثبت أنه صحيح) أن هذه المقاطعة الشعبية لا تليق إلا بتحفة حقيقية. على أقرب مقهى جلستُ بعد ان اشتريت جريدة اليوم، ونجحت بحمد الله وتوفيقه فى قتل الوقت حتى موعد حفلة الثالثة والنصف.
كم كانت سعادتى عندما وافق موظف شباك التذاكر على أن يحجز لى تذكرة دون أى تعليق رغم أن قناع القرف كان مازال فى مكانه، فلما دخلت الى الصالة، اكتشفتُ أننا ثلاثة متفرجين بالعدد، ونظرا لأن الساحة خالية، فقد اتنتشرنا على مقاعد متباعدة لدرجة أنك لو دخلت المكان ستظن أن الصالة خالية. الحقيقة أن قرارى بالعودة فى حفلة الثالثة والنصف كان من قراراتى الحكيمة القليلة إذ أن الفيلم والبلح والعرق تم رفعهم تماما من سينما “ريفولى” فى اليوم التالى، وأظن أنهم راعوا فى هذا القرار ظروف صاحبنا موظف الشباك ذو الوجه العابس المكفهرّ.
كنا ثلاثة أيضا عند مشاهدة فيلم “صياد اليمام” فى حفلة الواحدة والنصف ظهرا فى سينما كريم واحد. عُرض الفيلم سراً تقريباً وبدون دعاية، ونجحتُ فى معرفة مكان عرضه بمساعدة أجهزة استخبارتية قوية. عندما طلبتُ تذكرةً بصوت خفيض مهموس من موظفة الشباك، قالت بنفس درجة الإشمئناط سالفة الوصف: “استنى شوية لما يحجز اتنين كمان .. وبعدين الفيلم اسمه صياد اليمامة مش صياد اليمام “. كنت لحظتها فى حالة إرهاق تمنعنى من الجدل معها بشأن عدد طيور الفيلم أوحتى نوعها. وقفتُ (على جنب) أمام السينما فى انتظار “جودو”، وهو فى حالتنا هذه اثنان من الجمهور العشوائى الذى قد يدخل الفيلم من باب الفضول أو من باب قتل الوقت. كنتُ محظوظا فعلاً بظهور اثنين “جودو” مرة واحدة ، ولكن ما أن استوينا على مقاعدنا داخل الصالة حت بدأ على الشاشة عرض فيلم آخر. عُدنا ثلاثتنا الى الخارج لإبلاغ الإدارة بعد أن فشلنا فى إسماع صوتنا لعامل آلة العرض الذى يبدو أنه أدار أقرب “بوبينة” أمامه ثم ترك الكابينة لكى يصطاد اليمام . بحمد الله وتوفيقه، نجحت الجهود، وبدأ عرض الفيلم المطلوب. عند المغادرة كنت فى حالة أفضل مما دفعنى الى أن أقول لموظفة الشباك متحدياً: “على فكرة الفيلم اسمه صياد اليمام مش صياد اليمامة “. رمقتنى بنظرة نارية ولم تعلّق.
وفى فيلم “ملك وكتابة” أيضا كنا ثلاثة فى سينما “كايرو بالاس” فى حفلة الثالثة والنصف عصراً. طبعا مارستُ الطقوس نفسها بانتظار العثورعلى اثنين من المتفرجين حتى تصبح الحفلة ” شرعية”. لحُسن الحظ كان أحدهما عاشقاً للسينما، وجاء للمشاهدة مع سبق الإصرار والتربص مثلى، وقد أمضينا وقتا ممتعا فى المشاهدة والمناقشة بعد العرض. الحقيقة أن “ملك وكتابة” لم يصمد فى دور العرض، ولكن المخرجة هالة خليل قدمت فى فيلمها “قص ولزق ” التحية لزميلتها “كاملة أبو ذكرى” مخرجة “ملك وكتابة”. ففى أحد المشاهد ، يذهب أبطال فيلم هالة الى سينما “كايرو بالاس” ويخرجون من المبنى الذى يعلوه أفيش فيلم ” ملك وكتابة”، ويحيط بهم حشد هائل من الجمهور الذى خرج بعد انتهاء العرض . أرادت “هالة” أن تقدم صورة “افتراضية” لما كان يجب أن يُستقبل به فيلم زميلتها. مجرد حلم لم يتحقق فى فيلم يتحدث بأكمله عن القص واللزق وزمن الأحلام المجهضة.
لاأحب أبداً أن أشاهد الأفلام فى قاعات خاوية . يارب ما تكتبها عليّا تانى. وإن كنت سأظل دائما من أنصار الحفلات ” الرايقة “.
طويت أوراق الذكريات السينمائية سعيدا منتشياً . أردتُ فقط ان أقول لك إن السينما ليست مجرد صور وعيون . السينما تجربة انسانية ثرية وطقس وزمان ومكان ومذاق ورائحة . لا تتنازل أبداً عن كل ذلك . السينما تحكى عنا ، فلا تنس أنت أيضاً أن تحكى عنها .