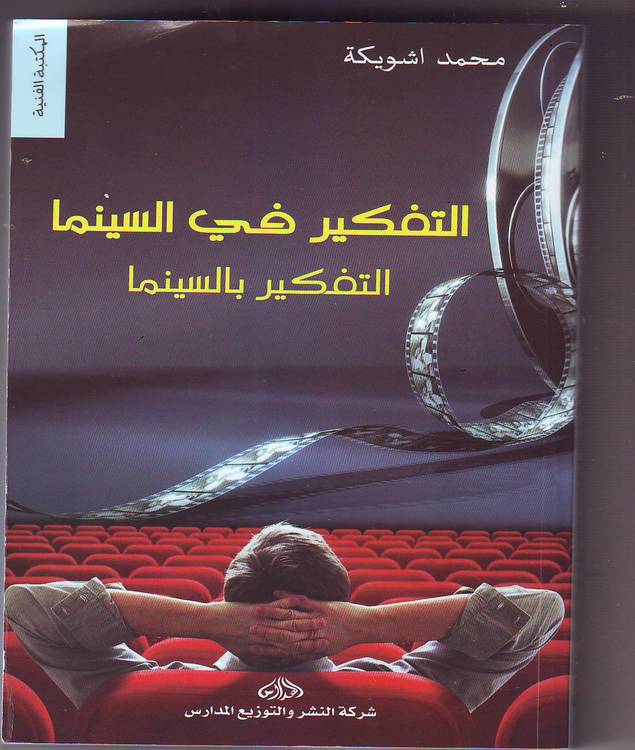الناقد محمود عبد الشكور بكتب عن تجربته في عالم السينما

أسأل نفسى دائما :” ماذا تمثل لى السينما ؟ وكيف أنظر الى إدمان مشاهدة مئات من الأفلام بكل لغات العالم بعد كل هذه السنوات هواية واحترافا؟”
الآن لدى إجابة واحدة لا تتغير : السينما ليست بديلا عن الواقع ،ولا هى محاولة للهروب منه، لأننى اكتشفت ببساطة أنها “الواقع” نفسه ولكن من كل الزوايا، وليس من زاوية واحدة فقط.
أما فى بداية اكتشافى لعالم الأفلام فقد كانت لدى إجابات كثيرة مختلطة تمتزج فيها التسلية بالإكتشاف، والثقافة بالبهجة، ولذة الفسحة بسعادة وونس الصحبة. الآن لم أفقد أبدا شيئا من ذلك، ولكنى أضفت إلى كل ذلك روعة أن تخرج من دار العرض لكى ترى البشر والحياة من منظور أوسع.
أصبحت الأفلام عندى كالكتب، فإذا كان الكتاب “إنسانا مقروءا” فإن الفيلم السينمائى هو “الإنسان مصورا”، وأصبحت الفكرة عندى بهذا الوضوح البسيط: نحن نخرج من الأفلام لنعود فنرى العالم بصورة أفضل .
أنتمى الى الجيل الذى عرف أفلام السينما من خلال التليفزيون، وإن كان أبى روى لى، والعهدة عليه، أنه كان يصطحبنى مع الأسرة لمشاهدة الأفلام فى دور العرض وأنا فى سن السادسة تقريبا، وأننى كنت أفسد عليهم العرض بالبكاء والنحيب، بالتأكيد لا أتذكر شيئا من ذلك، ولكنى أتذكر الأفلام الأولى التى شاهدتها فى تليفزيون منزلنا العملاق (حاجة معتبرة ناشيونال عشرين بوصة موديل السبعينات أبيض وأسود يابانى أصلى). كانت الأفلام المصرية تعرض فى ايام محددة من الأسبوع، وكنا ننتظرها بشغف، وكان ترتيب الجلوس طبقيا وشبه عنصرى: الكبار يجلسون على “الطقم المُدهب”، والأطفال (نحن) نجلس على السجادة . لا بأس .. المهم أن نرى الأفلام . لن أنسى فيلم ” حسن ونعيمة”، ولا تلك المرأة الطفلة التى كانت تردد طوال الوقت عبارة “نعم ياسى حسن”.. لن أنسى إحساسى بالرعب بعد مشاهدة فيلم “ملاك وشيطان” الذى كان يحكى عن اختطاف طفلة صغيرة فى مثل عمرى.. ولن أنسى “نيللى” وهى تغنى لزوجها “صلاح ذو الفقار” فى فيلم انمحى اسمه من الذاكرة، ولعله لم يدخلها أصلا.
أتذكر أيضا المرة الأولى التى دخلت فيها السينما، واعيا ومدركا لا باكيا أو منزعجا . لم يكن أبى ضد السينما، بل كان عاشقا لها، وحكى لنا أكثر من مرة عن ذهابه فى طفولته ضمن وفد ضخم من قريته لمشاهدة فيلم “عبد الوهاب ” الجديد ” الوردة البيضاء” فى دار العرض الضخمة بمدينة قنا، كانت روايته تنتهى دائما بوصف الحريق الذى شب فى القاعة، وهروبه مع الوفد الزائر، بدون أن يتنسموا عبير الوردة.
كان أبى يحب السينما ولكنه كان يرفض دوما أن نذهب لمشاهدة الأفلام إلا فى دور عرض الدرجة الأولى، ولما كانت هذه الدور نادرة فى الصعيد حيث نعيش، فقد كانت ترجمة القرار عمليا ألا نذهب لمشاهدة الأفلام فى دور العرض على الإطلاق .. لم تكن هناك فى الغالب سوى دور عرض الدرجة الثالثة حيث لا صوت ولا صورة ولا أخلاق . لحسن الحظ ، كانت لدينا فى مدينتى النيلية الجميلة ” نجع حمادى” دارللسينما لا تدخل ضمن هذا التصنيف الصارم. كانت دارا صيفية صغيرة بالقرب من النيل العظيم وتحمل اسمه، وتذكرنى على نحو ما بدار عرض ظهرت فى فيلم ” سينما باراديزو الجديدة “، لحسن الحظ أيضا ، كانت سينما النيل تستأثر ببعض أفلام العرض الأول، ولكن فى الأعياد فقط .
انتظرت حتى العيد الكبير لأدخل السينما لأول مرة، ربما كنت فى الصف الأول الإبتدائى، كان معى أخى الذى يكبرنى بثلاث سنوات، أو بمعنى أدق، كنت أنا معه مخفورين بعدد من شباب الجيران “خمسة أو ستة” لكى نصبح فى “أيد أمينة”.. أذكر أن قائد “الفوج” اشترى لنا ساندوتشات طعمية ساخنة بالفلفل الأخضر والطماطم لم أذق ألذ منها حتى اليوم .. لا أتذكر مشهدا واحدا من الفيلم المعروض، فقط احتفظت الذاكرة باسمه: “من البيت الى المدرسة ” ، ورغم أننى متأكد أن أبطال هذا الفيلم أنفسهم لا يتذكرونه وعلى رأسهم “نور الشريف”، إلا أننى خرجت من دار العرض مسحورا مبهورا، فيما بعد، قال لى أخى: “فضحتنا .. كنت تصرخ بصوت عال كلما اقتربت سيارة من الكاميرا “. دخلت سينما النيل بعد ذلك أكثر من مرة فى الأعياد، شاهدنا فيها أفلاما متواضعة المستوى مثل: “أونكل زيزو حبيبى” و” الى المأذون يا حبيى”، وكلها أفلام “عرض أول وكل سنة وانت طيب”. ما زلت أتذكر زحاما هائلا على هذه السينما لأنها ستعرض فيلم ” السكرية”، مازلت أتذكر متفرجا يصرخ خلفى لأن ” فريد شوقى” يستعين بصديق لاقتحام أحد الأبواب فى فيلم “الى المأذون .. ” فيما يستطيع الملك أن يقوم بالمهمة بمفرده لأن “الدهن فى العتاقى”، مازلت أذكر طريقة الإعلان البدائية عن عرض فيلم الموسم ” حكاية بنت اسمها مرمر” بعد طول انتظار: رجل يحمل طبلة، وخلفه رجل آخر يحمل أفيش الفيلم الملون، وخلفهما عدد لا نهائى من الأطفال يصفقون فى سعادة لا حدود لها فى الشارع الرئيسى بالمدينة.
لم تدم بهجة سينما النيل. أبى مدرس الفلسفة انتقل بحكم العمل الى مدينة أخرى صغيرة ذات طابع ريفى زراعى. توجد فى هذه المدينة قاعتا عرض من الدرجة الثالثة ينطبق عليهما تصنيف والدى لدور العرض التى لا ينبغى لأبناء مدرس مرموق الإقتراب منها. وللمفارقة كانت إحدى الصالتين تجمل اسم “سينما الجمال”، وبالطبع لا علاقة لها بالجمال من قريب أو بعيد، ببساطة، كان علينا أن نقنع بمشاهدة أفلام الأبيض والأسود التليفزيونية، وكلها جديدة بالنسبة لنا، أو ننتظر الذهاب الى نجع حمادى” فى الأعياد لمشاهدة الأفلام الملونة، ثم المبيت فى منزل عمتى، وفى معظم الأحيان كنا نقنع بما يقدمه التليفزيون من أفلام قديمة جديدة، ولكنى كنت أستمع الى مايرويه زملاء الفصل عن الأفلام التى كانوا يشاهدونها فى سينما الجمال مرارا وتكرارا، ومنها مثلا فيلم ” الأبطال” الذى كان بندا ثابتا فى “البروجرام”، وكان مشهورا وقتها بأنه أول فيلم كاراتيه مصرى.
دارت الأيام، وحضرت الى القاهرة للدراسة، فانفتحت بوابة السينما على آخرها، من دور العرض كلها تقريبا الى المراكز الثقافية الأجنبية، من سينما على بابا الشعبية الى سينما مترو وريفولى ثم سينما كريم والتحرير وصولا الى صالات المولات الفاخرة. أصبحت مشاهدة الأفلام عملية طقسية متكاملة، حياة خاصة لها طقوسها وناسها ومعاناتها وبهجتها ونافذتها ومفاتيحها السحرية، أصبحت دار العرض مرتبطة بالأفلام: سينما مترو وبكاء الفتيات فى نهاية فيلم تيتو” . سينما “كريم” وفرحة الإعجاب بعبقرية “محسن محى الدين” فى فيلم ” اليوم السادس”. سينما أوديون ومشاهدتى الأولى لفيلم “أبى فوق الشجرة” فى إحدى إعاداته المتكررة . سينما ريفولى ومتعة اكتشاف تحفة اسمها “عرق البلح”. سينما التحرير وبهجة عودة “سعاد حسنى” فى فيلم الراعى والنساء”.
با ختصار، أصبحت مدينا للسينما لأنها أدخلتنى الى الحياة، بل لأنها جعلتنى أعيش ألف حياة، لم يكن الخيال وسيلة للنسيان، ولكنه كان وسيلة للعودة لمواجهة الواقع بصورة أقوى، كان محاولة لكى أكتشف زوايا ملهمة يمكن من خلالها مواجهة المشكلات، كانت السينما أمّا مواسية ، وعشيقة ملهمة، وأختا حنونا، وأباً عاقلا يدفعنى للتأمل، الآن فقط أستطيع أن أقول ذلك، ربما لأن عشق الأفلام مثل عشق النساء يحتاج الى مسافة لنتأمله، ونستطيع التعبير عنه.
* ناقد سينمائي من مصر