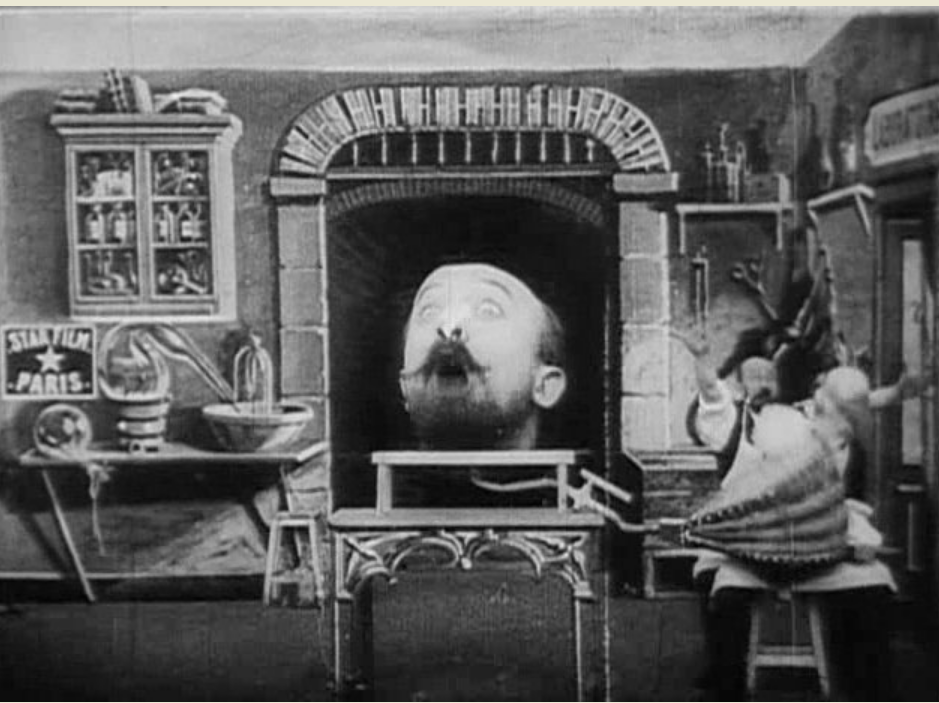“عايش”.. الحياة على الناصية الأخرى
 المخرج عبدالله آل عياف
المخرج عبدالله آل عياف
خالد عبد العزيز
“الأفراد يُمثلون المجتمع، بشكل أو بأخر. وتناولي لقصص الأفراد في أفلامي نتيجة لرغبتي في خوض مكنونات النفس البشرية، بشكل أكبر من مجرد تناول قضايا عامة”.
هذا ما يقوله الكاتب والمخرج السعودي “عبدالله آل عياف” عن السينما، وكيفية تعبيره عن القضايا الإنسانية والمجتمعية التي يتعرض لها في أفلامه، من زاوية أكثر رحابة، تتناول الداخل الإنساني بعين مُتسعة تلتقط التفاصيل الصغيرة، المُشكلة في مجموعها نسيجا أكبر في حاجة لبصيرة، لا تخلو منها أفلامه.
أخرج “آل عياف” للسينما الروائية القصيرة أربعة أفلام، وللسينما التسجيلية فيلمه الأول والوحيد “السينما 500 كم”، الذي يُسلط مضمونه الضوء على قضية عدم توفر دور عرض سينمائي في السعودية في بدايات الألفية، فنحن إزاء مخرج يملك بالفعل هَماً ما، يرغب في البوح به، والتعبير عنه، لكن وفق رؤيته وبصمته الخاصة، التي تعتمد في ظاهرها على الإنسان، وتشتبك في باطنها، مع القضايا الكبرى والمجتمعية بذكاء وحساسية في آن.
في فيلمه “عايش”- إنتاج عام 2009- يطرق موضوع الحياة والموت، يعقد مقارنة بالغة الرقة والعذوبة بينهما، ويطرح سؤالاً مُستتراً قوامه كيف يُمكن أن تتغير دفة الحياة من هذا المنعطف إلى ذاك؟
أحداث الفيلم تدور حول “عايش” (إبراهيم الحساوي) الذي يعمل حارس أمن في مشرحة إحدى المستشفيات، وعلى إثر تخلف زميل له عن الدوام ذات يوم، يتم نقله مؤقتاً للعمل في قسم حضانات الأطفال، وهناك تتبدل بوصلة حياته وتتغير لتتخذ اتجاها مغايرا.
عوالم مُتضادة
يبدأ الفيلم بلقطة تأسيسية نرى خلالها قدم “عايش” أثناء نومه، ثم تنتقل الكاميرا لباقي الجسد والرأس من زوايا أخرى، تُظهر استغراقه في النوم، ثم يُفاجئنا رنين المنبه، مُعلناً ميعاد استيقاظه، ليعقب هذا المشهد، لقطات تكشف عن روتينه اليومي الرتيب، الذي لا يكاد يتغير.

هكذا يبدأ الفيلم مُقحماً المتفرج في صلب الموضوع مباشرة، من دون أدنى تمهيد، لا حفاظاً على زمن الفيلم الذي لا يتعدى الثمانية والعشرين دقيقة، لكن لأن ما سيأتي تباعاً من مُلابسات وتفاصيل، كفيل بكشف ما سُتر من تفاصيل ومعلومات دافعة الأحداث للأمام، فقد جاء نسيج السيناريو في السرد بحيث يدور بين عالمين، كل منهما يملك مُعطياته الخاصة، ويسير في فلك مُضاد للأخر، ولا يتلاقيا سوى عبر شخصية “عايش”، فهو العامل المشترك بين هذا العالم وذاك.
الموت هو العالم الأول الذي يدور بين حوافه الشق الأول من الأحداث، “عايش” الذي يعيش مُنفرداً، وينام كالأموات على فراش أقرب إلى القبر منه إلى مكان للنوم، حيث تُطالعنا هيئته من زاوية علوية، تكشف عن لون دثاره الأبيض القريب في تكوينه من الكفن، يُمارس حياته في بطئ في مصفوفة متكررة لا تكاد تتبدل، عمله في أسفل بناية المستشفى في المشرحة، فالهدوء والسكون هما المسيطران على أجواء عالمه، دون ظهور أدنى بادرة توحي بالتغيير.
في المقابل يواجه “عايش” عالماً مُعاكساً لما ألفه عندما يأتيه المدير المسئول ويطلب منه العمل بدلاً من زميله في قسم حضانات الأطفال، فقد جعل السيناريو من هذا المشهد عاملا مُحفزا لما سيأتي من أحداث مُقبلة، وكذلك من تَغيرات طارئة في مسار السرد والشخصية، لذا نراه أثناء مراسم استلام عمله الجديد في قسم الأطفال، يُفاجأ بالصخب المُصاحب للزائرين والمرضى على السواء، بينما كان السكون هو السائد في عالمه السابق.
عند هذه اللحظة المحورية في مسار السرد، يلتقي “عايش” بعالمه الجديد، المُغاير تماماً عما يُدرك، فالمشرحة ليست سوى مجاز للموت، وفي قسم الأطفال تكمن الحياة بعفويتها وبراءتها.. يلتقي بطلنا بأصناف مُتعددة من البشر الزائرين للمرضى، وبالأطفال الحديثي الولادة، لتنشأ نقطة صراع مُبطنة، مُغلفة بنسيج رقيق من المشاعر المُختلطة التي تًصيب الشخصية الرئيسية، وتنعكس بدورها على المتفرج.
أزمة وجودية
يستكمل السيناريو مساره مُفخخاً بنقاط حبكة تدفع السرد إلى الأمام، وتبث سهام التغيير في حياة البطل، فبعدما يُنقذ “عايش” أحد الأطفال من الموت المفاجئ نتيجة خطأ طبي داخل الحضانة، يُكافأه المدير بزيارة للداخل يحمل فيها الطفل الناجي، في مشهد مغزول بطبقة كثيفة من الشاعرية، ينظر خلالها “عايش” للطفل، وعيناه تحوي بداخلهما بئرا فياضا من الدموع، فالطفل و”عايش” كل منهما ارتبط مصيره بالأخر، كل منهما أنقذ الأخر، دون أن يدري كلاهما.
في البدء لا ينساق “عايش” لهذه الوظيفة الجديدة، المُمتلئة حتى آخرها بدفقات الحياة، فالاعتياد على الموات خَلف لديه شرنقة ذاتية أودع نفسه بين جنباتها، لذا بدا بناء الشخصية يُعاني من أزمة وجودية، تتمثل في خلق نقطة صراع جوهرية بين الحياة والموت، ففي أحد المشاهد نراه يقف بجوار أحد آباء الأطفال ساكني الحضانة، وبدلاً من تهنئته بالمولود الجديد، يقول له “أذكر الله وشد حيلك”، ثم يتدارك سريعاً ما تفوه به، ويُلقي عليه التهنئة الاعتيادية، وهكذا يظل يُقاوم داخلياً الولوج إلى هذا العالم، وكلما سقطت دفاعاته الذاتية، يُشيد غيرها بدأب لا يُفنى.
رسم السيناريو الشخصية، يظهر أنها رغم انتمائها الأصيل لعالمها، إلا أنها تكن حنيناً خفياً للحياة، لا يَبرز سوى على استحياء، وبما يتناسب مع الهيئة العامة لها، ففي المشاهد الأولى يُطالعنا مُجسم مُصغر لدراجة نارية على بجوار الفراش، وأثناء انتظاره الحافلة التي سَتُقله إلى عمله، يشاهد في إنجذاب واضح دراجة نارية مَعروضة للبيع، ولا يُخفى ما لهذه الوسيلة من رمزية جلية للإنطلاق والجموح.
ملامح عامة
يقول الكاتب والمحاضر “يات كوبر” عن العلاقة بين الفيلم الطويل ومثيله القصير “حرية الفيلم القصير بالمقارنة مع الفيلم الطويل، تكمن في استخدام المجاز والأدوات الأدبية الأخرى لرواية القصة، وهي ميزة غير متاحة في الفيلم الطويل ذي النزعة الواقعية والتوجهات التجارية”.
وبنظرة بانورامية على فيلمنا هذا، يُمكن ملاحظة العناية بالتفاصيل الصغيرة للسرد، وبناء الشخصية وكل ما يتعلق بها من زوائد درامية، تُساهم بشكل أو بأخر، في إضفاء حيوية ما على الفيلم ككل، وهنا تتجلى حرفية السيناريو المتعوب عليه بالفعل في صياغته، وكذلك أسلوبية الإخراج، الذي استطاع بوسائل درامية وبصرية ذكية ولماحة، تمرير بعض المعلومات والرسائل عن الشخصية المحورية التي تدور عنها الأحداث، فالتعبير البصري هنا دقيق، وبالتالي الإيقاع محكم مشدود، فلا لقطة زائدة أو ناقصة، وكل مشهد يوصل للمشهد الذي يليه في مصفوفة سردية، يملك كل صف منها دلالته المقصودة تماماً والمُحركة للأحداث وفق المطلوب منها.

في هذا الإطار تأتي دلالة الاسم المُباشرة وما تحمله من كناية للحياة، لكنه في الواقع يملك نفوراً مُعاكساً منها، ويستمر الفيلم في التعبير عن فكرته مُستعيناً بالأدوات السابق ذكرها، لذا عندما يكتشف “عايش” أن والد طفل الحضانة ترك هديته، الدمُية الكبيرة، بمحاذاة الباب، لا يتردد في الاحتفاظ بها، ويظهر في المشهد التالي وهو يقود دراجة نارية وفي الخلف تجلس الدُمية، ثم نصل للمشهد الختامي وينغلق قوس الحكاية من نفس المكان، حجرة “عايش” وهو نائم، لكنه هذه المرة، يختار وضع الجنين والإبتسامة تعلو وجهه، في اشارة ضمنية على تبدل مساره من المنعطف المائل لمُقابله الصاعد المُنفتح للحياة، تلك الحياة التي ذاق رحيقها “عايش” بعد طول جفاء.
تُرى كم من “عايش” يعتقد أنه حي؟ بينما الحياة تقع على الناصية الأخرى.