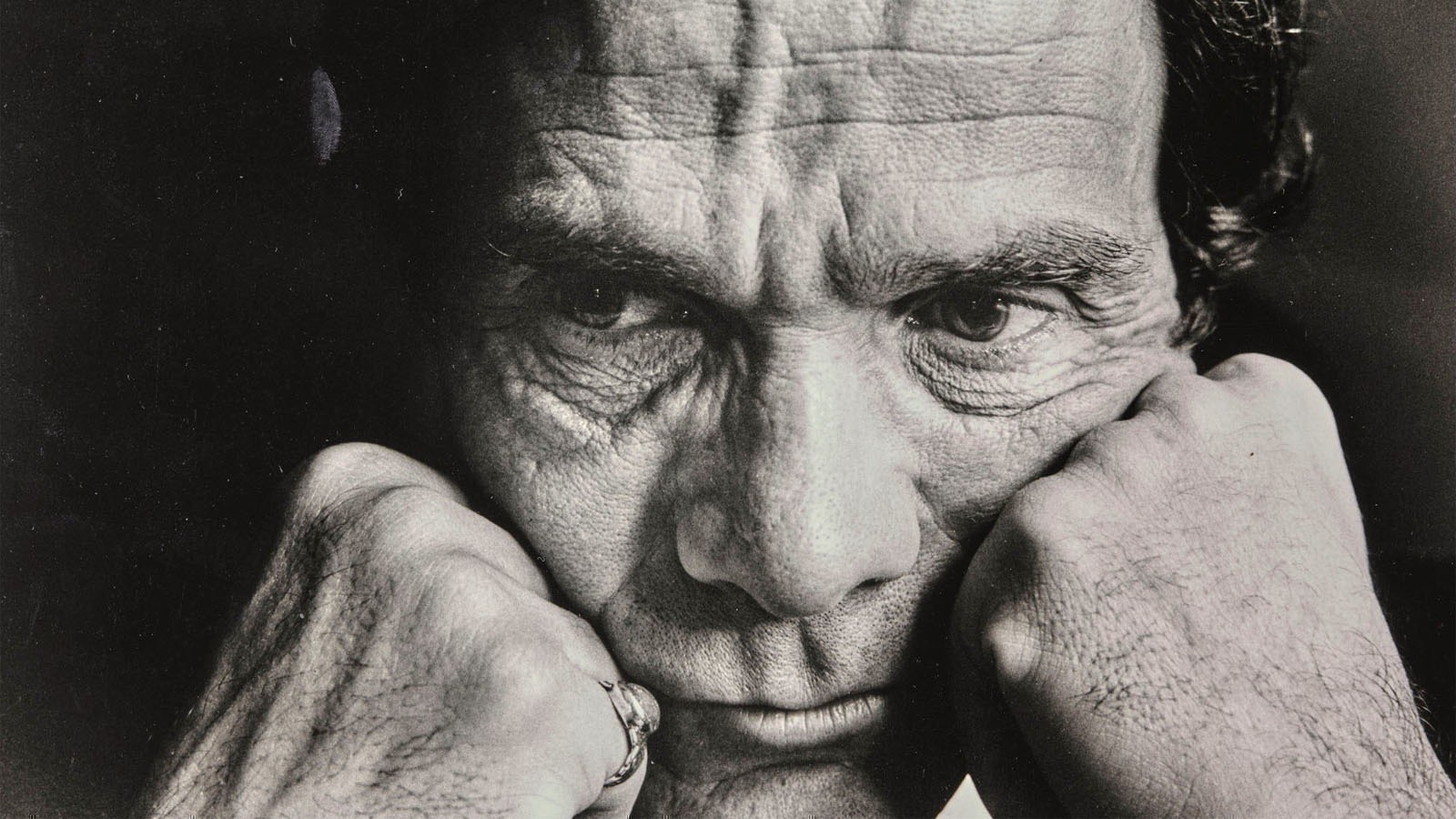سينما ما بعد الحداثة: تعايش الثقافات وتراجع المركزية الغربية

لعل من أبرز الظواهر السينمائية الجديدة ظهور ما يسمى بسينما ما بعد الحداثة، والتي تمثل الامتداد أو التعبير المرئي عن موجة ما بعد الحداثة، التي بدأت في العقد السادس من القرن العشرين وامتدت إلى يومنا، على أيدي عدد من المفكرين في الغرب وأبرزهم الفيلسوف الأمريكي المصري الأصل”إيهاب حسن”، والفيلسوف”آلان تورين”، والأكاديمي الفلسطيني”إدوارد سعيد”وغيرهم كثيرون. ولعل الظاهرة اتضحت جليا من خلال ما يمكن أن نسميه بأفلام الإدانة، التي راحت تعرض الآثار المدمرة للاستعمار الغربي، في أقطار العالم المختلفة، وما فعلوه في حق الشعوب المغلوبة على أمرها، تحت شعارات ظاهرها رسالة الإنسان الأبيض المتحضر، وباطنها نهب خيرات الشعوب وثرواتها، بجانب ما فعلوه مع مشكلة الزنوج، كما هو واضح في فيلم”12 عاما مع العبودية”، للمخرج ستيف ماكوين، وقد فاز بالأوسكار العام 2013، وفيه إدانة شديدة للممارسات الاستعمارية مع السود في الولايات المتحدة، ومع العبيد المجلوبين من أفريقية السوداء، أي أنها تراجع ممارسات السلطات مع الشعوب المستضعفة.
سينما ما بعد الحداثة
عندما نطلق مصطلح”سينما ما بعد الحداثة”، فإننا نعني التجربة السينمائية التي تحاول تقديم مراجعات وأفكار مستلهمة من طروحات ما بعد الحداثة، ومراجعاتها، ونقدها، لفلسفة الحداثة الغربية ؛ المشكّلة للعقلية الأوروبية الحديثة.
لقد استفاد الفكر ما بعد الحداثي من الانتقادات الحادة الموجهة ضد الحداثة الغربية، التي رافقت وللأسف حقبة الاستعمار الأوروبي لبلدان العالم الفقير (في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية)، وما حاولوا تصديره في هذا الشأن، من إعلاء النموذج الغربي، بوصفه النموذج واجب الاحتذاء أمام الشعوب، وقد حمل – فيما حمل – احتقار الثقافات الأخرى، والنظر إلى الرجل الأبيض على أنه سيد العالم، بل أصبح كل ما هو أوروبي علامة على التمدن والتحضر، في مواجهة الملونين من الشعوب الأخرى المحتلّة أو المتحررة من الاحتلال والهيمنة. كما أنه تضمن– فيما تضمن أيضا– الحجج التبريرية التي ساقتها أوروبا الاستعمارية بأنها صاحبة رسالة تنويرية نحو شعوب العالم، لتخفي أطماعا في الثروات، وسعيا حثيثا لامتلاك مقدرات الشعوب، وتبريرا لممارسات استعمارية ضد همجية الشعوب التي (تقوم ) الرجل الأبيض الذي جاء لتحريرها من التخلف، وكان من أبرز مظاهر التحضر تقليد العادات الغربية في الطعام والشراب والملبس وإتباع فن الإتيكت.
هذا من ناحية الإنسان الغربي الذي غزا الدول الفقيرة المتأخرة، وراح يصدّر لها رؤاه وتقاليده ومعاييره في التقدم، وللأسف ارتبط بهذه القناعات الغربية، ونسوا أو تناسوا أن التقدم العلمي لا هوية له، وإنما معايير تتمثل في حفظ كرامة البشر وحقوقهم وحرياتهم وتوفير حاجاتهم الأساسية، دون الإلزم باتباع ثقافة بعينها.
ويثور سؤال آخر : حول نظرة الإنسان الغربي إلى الهجرات القادمة من دول العالم الثالث للاستقرار والعيش في دول أوروبا، وترحيب الدول الأوروبية بهذه الهجرات، لأنها تمثل أيدي عاملة رخيصة، ومطلوبة، مع تناقص الشعوب الأوروبية، ورفاهيتها العالية، فباتت دولا مستقبلة للهجرات، ومن ثم نشأت مشكلات وقضايا تتصل بوجودهم في المجتمعات الأوروبية، حول ثقافتهم وتجنسهم بجنسيات أوروبية جديدة، أي أسئلة: الانتماء والهوية والثقافة وغيرها.
وقد نظر الغربيون إلى هؤلاء المهاجرين نظرة تجمع بين الشفقة والعنصرية، ورأوا ضرورة تحلّيهم بأخلاق ومبادئ وقيم الغرب، وساد هذا التصور فترة طويلة، حتى جاءت طروحات ما بعد الحداثة، لتطرح تساؤلات أهمها : لماذا لا يعي الإنسان الغربي ثقافة الشعوب الأخرى، ويقبلها ويتعايش معها ؟ ولماذا لا ينظر إلى تلك الثقافات بنظرة إيجابية أساسها الاحترام والتقدير والقبول، ثم التعاطي مع الإيجابي منها، والتعايش مع أبنائها دون فرض ثقافة وافدة عليهم؟
هذه أسئلة مهمة، لأنها نابعة من جوهر فكر ما بعد الحداثة القائم على الاعتراف بالخصوصيات الثقافية للشعوب دون احتقار أو إقصاء أو استعلاء لثقافة على غيرها، بل إن الأمر تطور من احترام الخصوصية الثقافية إلى التفاعل معها بمعنى التحاور، بمعنى : النظر إلى ما في هذه الثقافات من إيجابيات، ومن ثم قراءتها بوعي، بهدف الإفادة والإضافة والإثراء.
كثيرة هي الدراسات التي تناولت الفكر ما بعد الحداثي، وكذلك الفنون والآداب التي تعاطت وتأثرت به، وقليلة هي السينما التي وعت طروحات ما بعد الحداثة، وسعت إلى تبنيها في منظومة قيمها وفلسفتها، بما يتماشى مع شعارات أفكار ما بعد الحداثة، التي هي بلاشك ستحدث ثورة في مضمون الأفلام السينمائية.
فيلم “زيجات سيئة”
ويأتي الفيلم الفرنسي”زيجات سيئة”(2014)، الذي كتب له السيناريو والحوار”جاي لوران”، وأخرجه”فيليب تشاوفيرون”، ليمثّل نموذجا لسينما ما بعد الحداثة، في تعاطيها الإيجابي مع قضية المهاجرين إلى فرنسا ذوي الأصول والثقافات والديانات المختلفة، وتناولها في إطار كوميدي عائلي اجتماعي.
تدور أحداث الفيلم حول عائلة فرنسية أصلية مكونة من أب وأم وأربع فتيات، اختارت كل واحدة منهن زوجاً من عرق مختلف، ليدخلن في صراع ولكن بشكل يعتمد على كوميديا الموقف، دون افتعال كلمات، أو تصنّع حركات، بل إن السرد يتدفق بنا، غير قادرين على ترك المشاهدة ولو لحظات، فتتابع المشاهد، وتكثيف الحوار، وتسارع الأحداث يجعل المتلقي في حالة لهاث، مصحوبة بضحكات صافية، وترقب لما ستسفر عنه اللقطات المتسارعة، وتلاقي الشخصيات.
في الفيلم، نجد أنفسنا أمام عائلة فرنسية قادمة من إحدى المدن البعيدة المحاذية للريف الفرنسي، تتكون من أب وأم لديهما أربع بنات، ثلاث منهن تزوجن على غير المتوقع من أزواج من أعراق/ ثقافات مختلفة، فإحداهن تتزوج فرنسياً مسلماً من بلاد المغرب العربي، والثانية فرنسياً يهودياً، والثالثة فرنسيا بوذيا من ذوي الأصول الصينية . ولنتأمل جيدا، هذه الفسيفساء الثقافية، التي باتت تجمعها أرض فرنسا المعاصرة، وكلهم حاصلون على الجنسية الفرنسية، ويعتبرون فرنسا وطنا لهم، ولا عجب أن نجد أنهم وأنهن يقفون جميعا عند عزف موسيقى السلام الوطني الفرنسي، ويرددون كلماته بشكل عفوي معتاد. فالرسالة واضحة : هذا هو المجتمع الغربي، بكل ما فيه من تنوّع ثقافي وعرقي، وعلى الجميع تقبل هذا، تحت مظلة العلم الفرنسي، بل ويجب أن يستوعب الجميع أهمية التعايش، والاندماج، وقبول ثقافات الآخر في الطعام والشراب والتوجهات.
فالفيلم فرنسي الهوى والثقافة والتوجه، بل يكاد يكون موجها إلى الجمهور الفرنسي خاصة، من أجل القبول بالتعايش الثقافي والاجتماعي مع الأعراق المختلفة التي تتخذ من فرنسا وطنا ثانيا، بدلالة حضور العلم الفرنسي والسلام الوطني الفرنسي في أحد مشاهد الفيلم، حيث وقفت الأسرة كلها ثابتة أمام العلم تردد كلمات النشيد الوطني الفرنسي. وبالتالي، فإن الفيلم ذو رسالة إلى الداخل، في وقت تتزايد نزعات العنصرية في القارة الأوروبية، مع كثرة المهاجرين إليها، خصوصا أن فرنسا من أوائل الدول التي استضافت مهاجرين ولاجئين إليها من مستعمراتها السابقة مثل بلدان المغرب العربي والدول الإفريقية، أو من دول أخرى عديدة. وهذا جزء من الوعي الجديد، والذي يندرج تحت الفكر ما بعد الحداثي، فلا ثقافة أفضل من ثقافة، ولا جنسية أفضل من جنسية، فالوطن يتسع للجميع، وفنون الشعوب وتقاليدها تقف متساوية، دون استعلاء أو احتقار.
وقد مثّلت الأسرة تلك الرسالة خير تمثيل، عندما كانت تجتمع على مائدة واحدة، فهناك من يأكل لحم الخنزير، وآخر لا يأكل إلا اللحم الحلال المذبوح على الطريقة الإسلامية وهو المغاربي، وتتنوع الأطعمة، والكل ضاحك متقبل، دون استعلاء أو احتقار. بل يصل الأمر أنهم راغبون في تذوق اللحم الحلال، ويبدون إعجابهم به. ونمر بمشاهد من قبيل الختان الذي مارسه اليهودي حسب شريعته، وأيده في ذلك المسلم، وأبدى الأب والأم انزعاجهما من هذه القسوة، ولكنهما تقبلا الأمر في النهاية.
لقطة من فيلم “زيجات سيئة”
لقد كان تململ الأب والأم واضحا فقد كانا يمنيّان نفسيهما بزوج واحد على الأقل من أصل فرنسي عريق أو حتى من الديانة المسيحية الكاثوليكية، وتعلقا بأمل أن تتزوج ابنتهما الرابعة من زوج فرنسي كاثوليكي، ولكنها تختار شابا إفريقيا أسود البشرة، يعمل ممثلا في أحد المسارح، ويشتد الحب بينهما، ويقرران الزواج. فتكون المفاجأة غير المتوقعة، رفض الأسرة : الأب والأم والأزواج الثلاثة لهذا الزواج والسعي ثم التآمر لمنعه بكل السبل، فقد تنامت العنصرية المخفية في قلب كل فرد من أفراد هذه الأسرة المتداخلة، لدخول فرد «أسود”لهذه العائلة المتعددة عرقياً ودينياً في التنامي ويبلغ ذروته من فرد لآخر، كما نرى في اجتماع الأزواج الثلاثة في عرض مسرحي للعريس الأسود، ومراقبته سعيا لاكتشاف أي مأخذ عليه، ويرونه بالفعل مع إحدى الفتيات الإفريقيات ويصورونه، ويخبرون عروسته، فتضحك وهي ترى الصور، وتقول إنها شقيقة خطيبي.
المفارقة تكمن أيضا على الجانب الآخر، عندما ترفض أسرة الإفريقي في كينيا الزواج، ويفضلون أن تكون عروسة ابنهم سوداء من القبيلة، وكان الحوار بالفرنسية بين والدي العروس، ووالدي العريش، عبر الإنترنت، فوالد العريس متجهم رافض يشدد في طلبات العرس، ونفس الأمر مع والد العروس، وعلى العكس تتفاهم الأمهات، ويحببن بعضهم، واستمر هذان الشعوران المتناقضان بين الحموين والحماتين، عندما حضرت الأسرة الإفريقية من كينيا وأقامت في منزل العروس، واشتد الصراع بين والد العريس ووالد العروس، فالأول عابس دائما، والثاني لا يطيق الأول، ويذكره بأنه تنازل عن غرفة نومه الخاصة لاستضافة الوالدين الإفريقيين، ولكن كما يقول المثل : ما حبّ إلا بعد عداوة، حيث ينقلب الكره إلى حب بين الرجلين، ويتبادلان الملابس، الأب الفرنسي يلبس الزي الإفريقي الذي حضر به والد العروس، والإفريقي يلبس الزي الأوروبي لوالد العروسة.
ويتفاجأ الجميع، بأن العروس/ الابنة الرابعة، والتي واجهت عنف الأسرة وتشددها وسخريتها من خطيبها الأسود، تستسلم للضغوط، وتقرر فك الخطبة والعودة لباريس في قطار، لأنها أدركت استحالة التعايش بين الأسرتين، وخصوصا بين والحموين، إلا أن الحموان – بعد تصافيهما وتحاببهما – يسارعان إلى محطة القطار، للحاق بالابنة، مؤكدين أنهما تفاهما وتصادقا بعد عداوة، وينتهي الفيلم نهاية سعيدة، بانضمام العريس الأسود إلى عضويتها.
الدلالة المعكوسة للعنوان
إن عنوان الفيلم”زيجات سيئة”يعطينا دلالة معكوسة عن أحداث الفيلم، فهل كانت زيجات بنات الأسرة سيئة كما رأيناها، أم العكس هو الصحيح ؟ لاشك أن العكس هو الصحيح، لأن الفيلم بدأ بزيجات ناجحة للبنات الثلاث، بأزواج من عرقيات ثلاث، ومن ثم تصاعدت الأحداث مع الزيجة الرابعة التي انتهت بالنجاح أيضا. إذن دلالة العنوان معكوسة، فلو افترضنا أن الفيلم تعنون بـ”زيجات سعيدة”لكان عنوانا تقليديا كاشفا لنهاية الفيلم وأحداثه، أما العنوان المطروح فهو عنوان بسيط في تركيبه، يضاد الدلالة المفترضة، لأن المشاهد حتما سيتوقع أنه أمام فيلم عن مشكلات زوجية، وفي الحقيقة أنه فيلم يرسخ التعايش المجتمعي في أبهج صوره، فمن العبث تخيل أن ثقافة ما، أيا كان عمقها أو تسطحها الفكري والحضاري يمكن محوها، من خلال فرض ثقافة أخرى، وكانت تجربة فرنسة الجزائر فاشلة مع نهاية الاستعمار الفرنسي للجزائر، صحيح أنهم ربّوا نخبة متفرنسة، ولكن أكثرية الشعب انحازت وأحيت الهوية العربية الإسلامية.
رسالة الكوميديا الجديدة
لقد جرت أحداث الفيلم كلها في إطار من الكوميديا اللطيفة التي تعتمد الموقف دون افتعال، وعلى المفارقة غير المتوقعة، وتناقض الأفكار دون إساءات لفظية تمس الأديان أو الأعراق أو الطوائف، وهي سخرية ضاحكة، لأنها تمس قلوبنا، وتصحح مفاهيمنا عن الأعراق موضع النزاعات والاختلافات، وعن احتقارنا للديانات أو الثقافات، أي أنها كوميديا الموقف ذات الرسالة الإنسانية التعايشية.
لقد كان الفيلم واقعيا بشكل كبير، فهو لم يقدّم التعايش بشكل رومانسي، ينسى فيه الأزواج والوالدان انتماءاتهم الثقافية والدينية والعرقية، وما يرتبط بها من تحيزات وقناعات مسبقة، لن تفلح الهوية الفرنسية في محوها، وهذا أمر متوقع، ولكن يمكن أن تستوعبها في إطار وطني فيه من الانفتاح الثقافي ما يشمل الجميع. لقد كانت التحيزات حاضرة في نقاشات الأسرة، وفي اختيارات الأزواج، وملامح الأبناء، بل وفي همسات الأزواج والوالدين، وهم يستحضرون تراثا من السخريات والتهكمات على الأفارقة في أطعمتهم وملابسهم وعاداتهم وتقاليدهم. وتلك المشاعر تحولت إلى عنصرية عندما يشاهدون الزوج الرابع المفترض أسود، فكلهم ذوو بشرة بيضاء، إلا هذا الدخيل شديد السواد، الذي فاز بقلب الابنة الصغيرة ؛ إلا أنه كان حضورا منطقيا ومتوقعا، ودون تعصب أو احتقار، فمن غير المنطقي ألا يكون موجودا، فانحيازات الفرد كائنة، وإن تعايش وتحدث ودرس بثقافة أخرى.
أكاديمي وناقد فني- الكويت