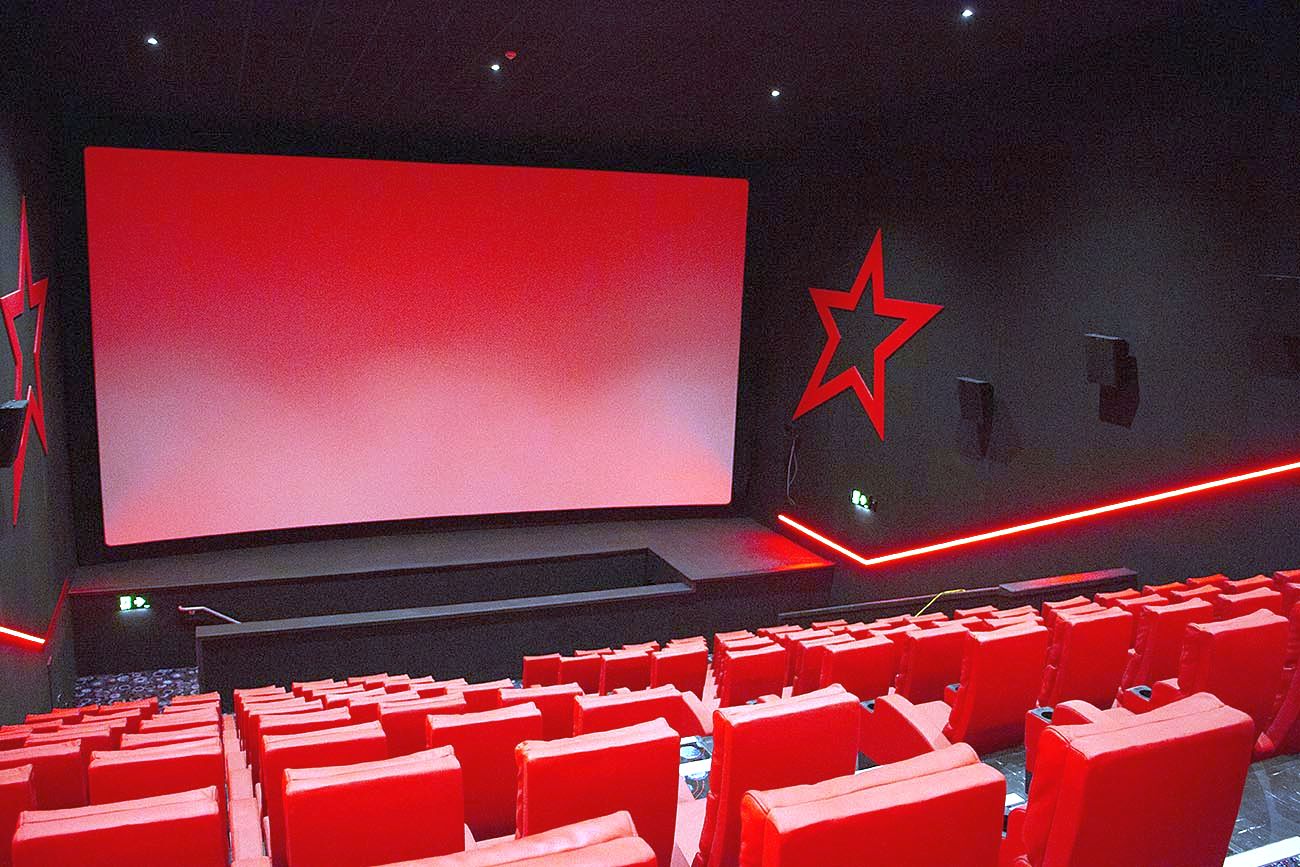الفيلم الوثائقي المغربي من وجهة نظر نسوية

مبارك حسني
عرفت الساحة السينمائية المغربية في السنوات الأخيرة ظهور نساء قمن بإخراج أفلام وثائقية لاقت نجاحا واسعا، وحازت جوائز في مهرجانات مغربية ودولية. وهو الأمر الذي يستحق طرح أسئلة جديدة وهامة حول هذا التوجه الإخراجي الذي ليس اختيارا أولياً في الغالب الأعم. فإلى حدود سنوات قليلة خلت، كان الكثيرون والكثيرات يحلمون بإخراج أفلام روائية، اعتقادا منهم أنها أكثر إبداعية أو حتى أكثر “جدية”.
هذا من جهة، من جهة ثانية، أن تكون هناك نساء شابات مفعمات بالحماس ومقتنعات بالسينما، هن من ينحين هذا المنحى لَأمر يستدعي الاحترام، ويفتح الباب على رؤى مختلفة ومغايرة حول الفيلم الوثائقي المغربي ذاته، الذي يغتني كمياً أولا، ومعنوياً ثانيا، بوجود تجارب جديدة لها بالتأكيد خصائص مميزة.
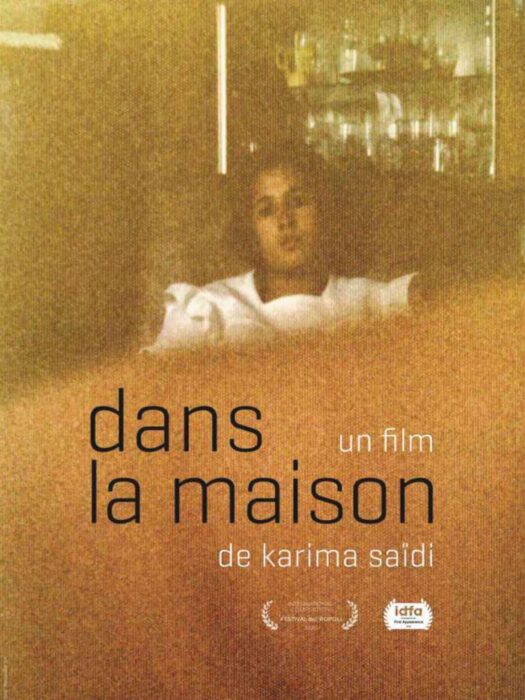
وهذا ما سنحاول التطرق إليه عبر مساءلة منتوج ثلاث مخرجات قدمن أفلاماً أقل ما يقال عنها أنها مُوفقة ومثيرة للنقاش، وهن كريمة السعيدي عبر فيلمها “في المنزل”، وأسماء المدير من خلال فيلمها ” في زاوية أمي” وأخيرا مريم عدو بفيلمها “المعلقات”. لكن قبل ذلك، لا بد من التصريح بأن وجود مخرجات سينمائيات، مغربيا، ليس ظاهرة جديدة، بل رافق تطور السينما المغربية وتنامي عدد الأفلام التي يتم انتاجها سنويا، حيث توجد المرأة خلف الكاميرا. فالسياق الفني العام يمكِّن من وجود سلسلة من الأنواع السينمائية بغض النظر عن كونها روائية أو وثائقية. وهذا ما سمح ببروز هؤلاء المخرجات ضمن أخريات.
حضور المرأة بالطول والعرض

الشيء الذي لا تخطئه العين منذ الوهلة الأولى، عند مشاهدة هذه الأفلام الثلاثة، هو تركيزها أولا على حياة نساء في أماكن محددة، أو على تجارب النساء في مجالات معينة؛ وثانيا على أصوات هؤلاء النسوة من أجل سرد القصص، مانحة لهن الفرصة للتحدث عن تجاربهن الخاصة، وعرض وجهات نظرهن على العالم؛ وثالثا استخدام أسلوب تصويري يركز عليهن، أي على صورهن ومشاعرهن واعترافاتهن. لكن ذلك، لم يأت عبثا، أو تبعا لنزوة، بل انطلاقا ًمن هم شخصي طاغٍ فرض التسجيل.
إنقاذ حياة من التلاشي التام
ذات يوم، نسيت والدة المخرجة وضع منديل الرأس، وتكرر الأمر بعد ذلك. حينها أدركت المخرجة بأنها أصيبت بمرض الزهايمر، الشيء الذي دفعها لمحاربة التلاشي بتدارك ما بقي عالقا بالذاكرة، وشرعت في تصويرها وإلقاء الأسئلة عليها ومحاورتها.
الفيلم هو هذا الغوص في ذاكرة ماضي حياة مهددة بالاندثار الكامل. وهو إذن تسجيل حي ينطلق من حاضر النسيان نحو ماض النبض الحياتي لامرأة قامت باختيارات قاسية لها ولأولادها، ما بين مدينة طنجة ومدينة بروكسل ببلجيكا. الفيلم صريح جدا، ولم يتوخ المداراة ولا الكذب. الحديث عبر الصور الثابتة، عن الرجال الذي عرفتهم، وخاصة رجل ارتبطت به، سنراه ولن نعرف عنه شيئا. عن المآسي التي كان الأبناء وراءها، عن مغادرة إحدى البنات المنزل. لا ماكياج ولا إخفاء، بل شجاعة وجرأة قلما نلتقيها في السينما المغربية.
ويحدث هذا في أجواء تصويرية تحار ما بين الأبيض والأسود والألوان، لعب فيها المونتاج دورا رئيسيا، تنتقل الأحداث المروية بين أزقة المدينة العتيقة بطنجة حيث الأصل، ودهاليز مؤسسة الرعاية الصحية في بلجيكا، في تقابل يحيل على رمزية الطريق، نحو الحياة المُستدعاة ونحو الموت الأكيد. هنا نتتبع قدرة حساسية مرهفة لمخرجة امرأة على خلق العاطفة الجياشة التي ترقى بالنظر رغم قساوة مضمون ما يُحكى.
البحث عن الذاكرة الأولى
تحضر الأم أيضا في فيلم أسماء المدير، التي انطلقت من بطاقة بريدية لمنطقة زاوية أحنصال في عمق أعماق جبال الأطلس الكبير، حيث ولدت والدتها، فقررت أن تحولها إلى فيلم ناطق بالحياة. فاختارت طفلة وأنطقتها طيلة زمن الفيلم، أي حاولت تصوير القرية بعيون هذه الطفلة ومن خلال حياتها في المدرسة والقرية، وخاصة ضمن عائلتها.
هي مغامرة تحبل بالخطر. لان ما شُوهد هي القرية حاليا، وليست كما كانت عليها في عهد والدتها، الشيء الذي قد يوقع في إسقاطات غير مبررة، كأن يتحدث العمل عن مشاكل اجتماعية لا يمكن لطفلة أن تعيها حقا.

إلا أن الذي أنقذ الشريط، هو فنيته وحركة الكاميرا السَّلِسَة التي تضمخه بعاطفة محمودة. لقد جعلت الطبيعة الجبلية الخلابة جزءا فاعلا جنبا إلى جنب بورتريهات عائلة الفتاة، وعلاقاتهم فيما بينهم. بحيث يتم المرور من حياة عائلية في المنازل القروية إلى شساعة الجبل بمساربه وشعابه وأعاليه، بحنينية مرصودة بدقة.
جمال يتحد والمعاناة الإنسانية التي يمنح عنها صورة بليغة علاقة البنت مع جدها المريض. هناك نوع من الفتوة المميزة للشباب في مقاربة المخرجة، عنوانها العفوية المؤسسة على الأمانة والمحافظة على المشاعر المراد نقلها.
التحرر القانوني من الرجل
لأنها اشتغلت كثيرا على الوثائقي في المجال التلفزي، تملَّكت مريم عدو تجربة في التقاط ما هو هام فيما يعرضه الواقع. وبالتالي، حين التقت في إطار بحث ميداني نساء يحاولن الطلاق من أزواج غير متواجدين جسديا، لم تتردد في تسميتهن بـ”المُعلقات”، أي لا متزوجات ولا مطلقات. فتقفت آثار حيوات نساء حُرَّات بدون أن تكُنَّ كذلك.
حدث هذا في مدينة داخلية عند أقدام الجبل اسمها بني ملال. هذا الانتقال هو ما يكْفُل الشريط طابعه الإبداعي، لأننا سنكون إزاء حيوات متفرقة لشخصيات مختلفة، تتبع كل واحدة منها مصيرا خاصا، في إطار البحث عن وثائق رسمية، أو البحث عن عنوان الزوج الغائب، أي كل ما قد يضمن الطلاق نهائيا، والحصول على حرية التصرف في الجسد، الذي يصير بقامة الحياة ككل. وبالتالي، ينتقل الفيلم بدوره إلى مستوى حكائي متناغم. الجديد يضمنه أيضا مظهر هؤلاء النسوة الحائرات ما بين عيش البداوة والسكن في حي مديني هامشي، بجلابيبهن ومناديل الرأس. هذا بالإضافة إلى وجود شخصية رجالية طبعت الشريط بنكهة عالية العاطفة، وهي الكاتب العمومي، الذي يحرر العقود الادارية والرسائل والمُعِين الهام في كل ما يخص النزاعات القضائية والأسرية، بحكم التجربة. يبدو في مكتبه الصغير، أمام الأوراق يحرر وينصح بأريحية محببة، خادما وناصحا. وجوده هذا التقابل ما بينه وبين النسوة، أعطى للشريط ملمحا صافيا، اكتفت المخرجة بتدبيره دون تدخل أو تقديم وعظي أو متعال، وهو الذي أنجح العمل ككل.

انحسار الأنثوية أمام المرأة اجتماعيا
من خلال هذه التجارب الثلاث، نستشف علاقة خاصة ما بين الوثائقي والمرأة المخرجة، لا دخل للإبداع فيها ما دام أنه مُحقَّقٌ أصلا. هنا المرأة لا غير، أم بين زمنين وجغرافيتين تحاول أن تحقق فيها التوافق لها ولعائلتها رغم أنها لم تكن مستعدة لذلك.
طفلة “مُستعارة” كي تحكي قصة أمٍّ بالوكالة، فتحكي كيف تقضي يومها في بيئة جبلية جميلة لكن وعرة. ثم المرأة عندما تُصارِع كي يكون لها وضع اجتماعي محترم تتحرك فيه إراديا. اننا إذن أمام حالات المرأة في مجتمع ليست فيه أنثى. بل امرأة لا غير، بلا جسد، الذي يتوارى لديها إلى الخلف الجانب الأنثوي، والذي غالبا ما يطفر في أفلام المخرجين الرجال. العين هنا مختلفة، لأنها منشغلة بالوضع العام وليس الخاص والحميمي في المقام الأول.