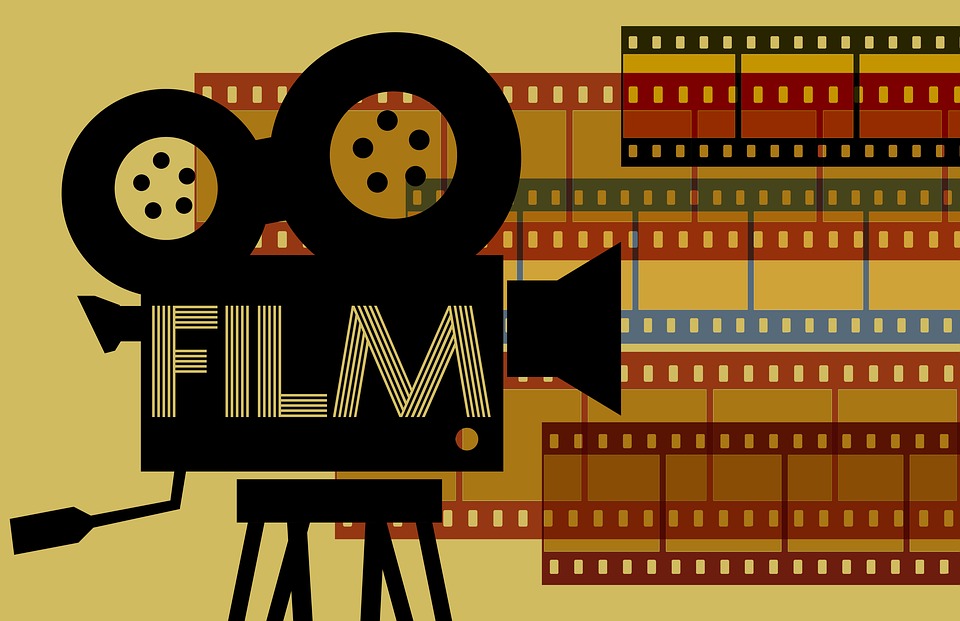التجربة الواعدة للمخرج أحمد سمير في أفلامه القصيرة

شهاب بديوي
عندما نبدأ في الكتابة عن الأفلام القصيرة تكون الرغبة في دعم صناع الأفلام القصيرة هي الدافع الذي يقودنا للبحث والمشاهدة، والكتابة. ولكن صراحة الآن، وبعد مشاهدة عدد معتبر من الأفلام القصيرة أصبح لدي شغف أكبر لمتابعة هذه النوعية من الأفلام لأغراض أخرى، منها: أنها أفلام طموحة فهي التجارب الأولى لصناعها قبل أن تنخرط في تعقيدات الصناعة، ويصبح لديهم قائمة من المعتبرات التي يجب مراعاتها أثناء صناعة الفيلم، وهي قيود خفية، وأن كان أثرها جلي تغلب على الصناع أصحاب الخبرات على الساحة.
أضف إلى ذلك الرغبة في الاكتشاف، وهي شعور عظيم يضاهي اكتشاف، وتقديم المخرجين أسماء جديدة من الفنانين أصحاب المواهب. لذلك والأشياء أخرى يجب الاهتمام بصناعة الفيلم الكثير من جانب النقاد فعلى الناقد دور كبير في تسليط الضوء على الأفلام القصيرة، ولفت الانتباه لها، ولصناعها، ويبقى دور لا يقل أهمية من جانب دور العرض في تبني هذه المشاريع، ومنحها مساحة عرض مناسبة لتصل إلى الجمهور العام، ويبقى في الأخير الحديث عن الأفلام القصيرة من جانب النقاد دور مهم جدا، ولو لم تكن الأفلام متاحة للجمهور فمن المهم أن نسلط الضوء على صناع هذه الأعمال، والمساهمة في إبراز الأسماء الجيدة إلى العلن.
من هذه المقدمة أدخل إلى صلب المقال لتناول أعمال مخرج موهوب، يختلف في كون يمتلك أسلوبا خاصا، وميلا إلى نوع خاص من الأفلام نستطيع القول أنه جديد على السينما المصرية.

الفيلم الأول “زفة”
في فيلم “زفة” للمخرج أحمد سمير موقف مربك في ليلة زفاف شاب نبدأ معه الفيلم بصوت بكاءه متخفيًا، والذي يبدو أنه مُقدم على زيجة يبدو مجبرا عليها، وعلى غير المعتاد الشاب هنا هو المُجبر، وليس الفتاة، وهذا يقودنا إلى اللانمطية التي يحاول سمير تقديم أعماله من خلالها، والهرب من النمطية والكليشهات.
لا يهتم سمير بتقديم تفسيرات في فيلمه بقدر ما يهتم بوضع المشاهد مكان الشخصية المأزومة في ليلة زفافها. فنحن لا نفهم لماذا يبكي البطل، ويخشى هذه الزيجة، وما الذي أجبره على ذلك سوى كلمات عابرة يخبرها والده بها.
كأن سمير كان مهموم بنقل مشاعر شخصيته مأزومة تجد نفسها في مأزق، أكثر من اهتمامه بأي شيء آخر من خلال السرد البصري الذي يتميز به سمير، والذي نلاحظ اسمه موجود في تيترات بعض أفلامه كمونتير، وهذا يفسر لنا قدرته على جعل إيقاع الفيلم مشدود، ومتماسك رغم أننا تطور الأحداث على السيناريو بطيء إلا أنه من خلال السرد، وقطعات المونتاج نجح في جعل المشاهد مشدودًا للقصة حتى النهاية.
رغم أن هذا الفيلم يظهر فيه بعض عيوب التجارب الأولى إلا أننا نستطيع أن نلمس بعض أدوات المخرج التي سيحافظ عليها في أفلامه القادمة، ويطور منها، ومن هذه الأدوات طريقة الحكي، والمونتاج المتميز، والغموض الذي يفضل سمير أن يضع المشاهد فيه.
الفيلم الثاني: ميراه “Mirah“

في عالم جديد، ومختلف تمامًا يقدم لنا سمير فيلمه الجديد “mirah“، والذي يُقدِّم معالجة درامية مكثّفة لقضية الهوية الممزقة بين الوطن والمنفى، بين الأصول والاندماج، عبر سرد بصري مكثف وسينوغرافيا تعكس الاضطراب الداخلي لشخصيته المحورية.
إنه يحكي لنا في هذا العمل عن “ميراه” الفتاة المصرية المهاجرة، والتي تعمل في ألمانيا، وتواجه مشكلة في الاندماج مع عالمها الجديد الذي يبدو أنه لا يتقبلها بسبب هويتها التي يرمز لها داخل العمل بالحجاب الذي ترتديه.
ورغم الصراع الذي تخوضه البطلة للحفاظ على هويتها المحافظة نرى من خلال قطعات المونتاج المميزة حياة أخرى تعيشها الشخصية حيث نراها داخل ملهى ليلي ترقص مرتدية خوذة دراجة نارية!
هكذا يضعنا المخرج في عالم غريب، ويقحمنا فجأة، ومن أول لقطة في عالمه كما فعل في فيلمه “زفة”، ليمتليء رأس المشاهد بالأسئلة حول هذه الشخصية، ودوافعها، والعالم الذي نراها فيه.
يطرح المخرج من خلال الفيلم سؤالًا وجوديًا عميقًا: متى تصبح الهوية عبئًا؟ ومتى تتحوّل إلى قناع؟
فميراه، الشابة المصرية المهاجرة إلى ألمانيا، تجد نفسها مضطرة لاختراع “هوية سرية” لتمارس بها حريتها، بعيدًا عن أعين المجتمع – سواء مجتمعها الأصلي المحافظ أو المجتمع الألماني الذي يرفض أن يحتضنها. هذه الهوية الليلية ليست فقط وسيلة للهروب، بل أيضًا إعلان ضمني عن انشقاق داخلي بين ماضٍ لا يمكن طمسه، وحاضر لا يمكن اتكاؤه.
أحمد سمير يتعامل مع هذه الثيمة الشائكة دون شعارات، بل من خلال سرد صامت غالبًا، مكتنز بالإشارات البصرية والرمزية، مما يخلق تجربة سينمائية تتطلب يقظة فكرية من المتفرّج.
وهذه احدى ميزات أحمد سمير حيث يصنع شخصياته، ويطلقها في العالم الذي اختاره لها دون أن ينصب نفسه حكما على شخصياته.
قدم المخرج سيناريو محكما، يعتمد على الحدّ الأدنى من الحوار، ما يعزز الإحساس بالانعزال الذي تعيشه البطلة. الانتقال بين زمنَي النهار والليل لم يكن فقط تقنيًا، بل وظيفيًا؛ فقد استخدمه المخرج لكشف التحول النفسي الذي يطرأ على ميراه بين لحظة وأخرى، بين قيد وحرية، بين “من تكون” و”من تتظاهر أن تكونه”.
غير أن قصر مدة الفيلم جعل بعض التحولات الشعورية تبدو متسارعة، ولم يُتح مساحة كافية لتعقيد الشخصية أو تصعيد الصراع الداخلي، وهو ما كان سيمنح الفيلم عمقًا إضافيًا.
قدم أحمد سمير رؤية إخراجية تنمّ عن وعي سينمائي واضح، وقدرة على توظيف الصورة لخدمة الدراما النفسية. برلين، كما تظهر في الفيلم، ليست مجرد خلفية جغرافية، بل شخصية بحد ذاتها – صاخبة، متوحشة، ومليئة بالضجيج الرمزي.
كان أداء الممثلة الرئيسية التي جسدت دور ميراه، أداء يتسم بالتماسك والقدرة على التعبير عن مشاعر معقّدة دون اللجوء إلى مبالغات. لغة الجسد، تعبيرات الوجه، والتردد في اتخاذ القرار كانت كلها عناصر تُحسب لها. ومع ذلك، كان من الممكن العمل أكثر على السيناريو لتقديم شخصية أعمق.
الفيلم الثالث: تيتا

في جوٍّ من الغموض، يضعنا المخرج أحمد سمير هذه المرة أمام عملٍ بطله طفل يُدعى عُمر، يعتقد أن والدته الحامل تحمل في أحشائها جدته التي توفيت.. بين خيال الابن الواسع وأفق الأم الضيّق، يسرد لنا سمير حكايةً عجيبةً غرائبية عن طفلٍ يتوقّع من أمه الحامل أن تلد جدّته. يبدو أن الطفل متعلق بجدته تعلقًا شديدًا، فهو دائم الحلم بها، ويتكرر أمامنا مشهدٌ يضع فيه عمر رأسه على بطن أمه محاولًا أن يسمع صوت جدته.
من خلال طريقة السرد التي يتبعها المخرج، يبقى المشاهد مشحونًا بالأسئلة والمشاعر المختلطة داخل عالمٍ غير مفهوم. ويُعزَّز الغموض بمشاهد وأحداثٍ غير مفسَّرة؛ إذ ترى الأم خيال الجدة يتحرك داخل الشقة في ليلةٍ ممطرة، ويظهر كتكوتٌ يخرج من بيضةٍ كان الطفل يُمسك بها قائلًا لأمه إنه يسمع صوتًا بداخلها. كما يرن الهاتف في منتصف الليل دون أن يخرج منه صوتٌ حين تردّ الأم، وفي أحد المشاهد، وهو الأكثر غرابة، يخرج ضوءٌ من بين فخذي الأم، ليصل المخرج بذلك إلى أقصى حدود الفانتازيا البصرية.
يقدّم أحمد سمير في فيلمه «تيتا» تجربة بصرية ونفسية مكثفة، تبحر في أعماق العلاقة المعقدة بين الأمومة والموت، بين الحضور والغياب، وبين ما هو مرئي وما يسكن الذاكرة.
ينتمي «تيتا» إلى نوعية نادرة من أفلام الرعب النفسي التي لا تبحث عن الصدمة، بل عن الإدراك. فالرعب هنا ليس خارقًا للطبيعة، بل نابع من هشاشة الإنسان أمام الموت ومن عجزه عن تقبّل الغياب. بهذا المعنى، يتحول الفيلم إلى مرآة للوجدان، يطرح أسئلة عن الحب والفقد والحنين دون أن يقدم إجابات جاهزة. ومن خلال بساطة البناء وعمق الإحساس، ينجح أحمد سمير في تقديم عمل قصير يُلامس المشاعر بصدق، ويؤكد أن السينما لا تحتاج إلى صخب كي تكون مؤثرة، بل إلى رؤية تعرف كيف تصنع من الصمت معنى ومن الخوف جمالًا.
نجح أحمد سمير في تقديم فكرته ضمن نوعٍ نادرٍ ما نراه في السينما المصرية، وهو الرعب النفسي؛ إذ غالبًا ما تفشل التجارب التي تقترب من هذا النوع، فتنقلب إلى كوميديا هزلية “مسخرة” يضحك عليها المشاهد من شدّة رداءتها.
لكن في هذه المرة، ومن خلال فيلمه القصير «تيتا»، استطاع أن يقدّم عملًا متماسكًا إلى حدٍّ كبير، يعزف على أوتار المشاهد بخفةٍ وذكاء، ويُدخل الرعب النفسي إلى نفسه ببطءٍ متصاعد عبر الأحداث لا بالصراخ أو المفاجآت، بل بتسلّل الخوف من داخل الشخصيات إلى وعي المتلقي.
قدّمت الممثلة منى هلا أداءً قويًا رفع من جودة العمل؛ فهذه المرة يعتمد سمير على ممثلة محترفة تمتلك حضورًا وتجربة فنية واضحة، على خلاف أعماله السابقة التي راهن فيها على الوجوه الجديدة. وقد أضاف أداؤها صدقًا إنسانيًا إلى التجربة، جعل من الخوف شعورًا واقعيًا لا مفتعلًا.
يمكن القول إن فيلم «تيتا» يُعد تجربة مميزة وسط مشهدٍ سينمائيٍ نادرًا ما يغامر في مناطق الرعب النفسي والغرائبية. نجح أحمد سمير في تقديم عمل جيد يستحق التقدير، رغم بعض السلبيات التي يمكن التغاضي عنها أمام ما حمله من جرأة فنية وحسّ بصري عالٍ. غير أن الغموض، الذي يُعد أحد عناصر جاذبية الفيلم، امتد أحيانًا ليشمل فكرة العمل نفسها، فصار المشاهد يتأرجح بين الإعجاب بالحالة البصرية والحيرة أمام معناها. ومع ذلك، يبقى «تيتا» تجربة تستحق الالتفات، لأنها تفتح بابًا جديدًا للتعبير في السينما المصرية، وتؤكد أن الرعب الحقيقي ليس فيما نراه، بل فيما لا نستطيع تفسيره.
في المحصلة، يمكن القول إن تجربة الأفلام القصيرة باتت مساحة تستحق أن نلتفت إليها بجدية أكبر، فهي الحقل الذي تُختبر فيه المواهب الحقيقية، وتُصقل فيه الرؤى قبل أن تنطلق إلى فضاء السينما الطويلة.
ويُعد المخرج أحمد سمير أحد أبرز هذه المواهب الصاعدة؛ فهو مخرج يمتلك أدواته السينمائية بوعي وإتقان، ويختار موضوعاته بجرأة وتحدٍّ يحسب له. من خلال أعماله القصيرة، أثبت سمير قدرته على بناء عالمٍ بصريٍ مميزٍ، يجمع بين العمق الإنساني والابتكار في السرد.
ومن الطبيعي أن تُعلّق عليه الآمال عند خروجه بأول أعماله الروائية الطويلة، إذ يُتوقع أن يضيف إلى المكتبة السينمائية المصرية عملًا مختلفًا يحمل بصمته الخاصة ويعكس نضجه الفني ورؤيته المتفردة.