فلسفة الفيلم (1)
 لقطة من فيلم "شجرة الحياة"
لقطة من فيلم "شجرة الحياة"
توماس وارتنبرج
نشرت في 18 أغسطس 2004 في “موسوعة ستانفورد الفلسفية”
أصبحت فلسفة الفيلم الآن مجالًا فرعيًا راسخًا في فلسفة الفن المعاصرة. على الرغم من كونهم من أوائل الأكاديميين الذين نشروا دراسات حول هذا الشكل الفني الجديد في العقود الأولى من القرن العشرين، إلا أن هذا المجال لم يشهد نموًا كبيرًا حتى ثمانينيات القرن العشرين عندما حدث نهضة.
هناك العديد من الأسباب وراء النمو الذي شهده هذا المجال في الآونة الأخيرة. يكفي أن نقول هنا إن التغييرات في الفلسفة الأكاديمية والدور الثقافي للأفلام بشكل عام جعلت من الضروري للفلاسفة أن يأخذوا الفيلم على محمل الجد باعتباره شكلاً فنياً على قدم المساواة مع الأشكال الفنية الأكثر تقليدية مثل المسرح والرقص والرسم.
ونتيجة لهذا الارتفاع في الاهتمام بالفيلم كموضوع للتأمل الفلسفي، أصبحت فلسفة الفيلم مجالا مهما للبحث في علم الجمال. يتم تنظيم هذه المداخلة حول عدد من القضايا التي تشكل محور فلسفة الفيلم. إنهم يستكشفون جوانب مختلفة من الفيلم كوسيلة فنية، مما يوضح مجموعة المخاوف التي يتم تناولها ضمن فلسفة الفيلم.
1. فكرة فلسفة الفيلم 2. طبيعة الفيلم 3. الفيلم والتأليف 4. المشاركة العاطفية 5. السرد السينمائي 6. الفيلم والمجتمع 7. الفيلم كفلسفة 8. الاستنتاجات والتشخيص فهرس الأدوات الأكاديمية موارد الإنترنت الأخرى إدخالات ذات صلة
1. فكرة فلسفة الفيلم
هناك سمتان لفلسفة الفيلم تحتاجان إلى مناقشتهما قبل الخوض في قضايا أكثر تحديدًا. الأول هو أن علماء السينما الذين ليسوا فلاسفة محترفين قدموا العديد من المساهمات في هذا المجال. (انظر، على سبيل المثال، تشاتمان (1990) وسميث (1995).) وهذا ما يميز هذا المجال عن العديد من التخصصات الفلسفية الأخرى. وفي حين أن علماء الفيزياء يكتبون في كثير من الأحيان عن فلسفة العلم، فإن التخصص الأكاديمي في فلسفة الفيزياء يهيمن عليه الفلاسفة المحترفون. ولكن الأمر ليس كذلك في فلسفة الفيلم. ونتيجة لذلك، فإن استخدامي لمصطلح “فيلسوف الفيلم” سيكون واسع النطاق، ويهدف إلى تضمين كل المهتمين بالقضايا النظرية المتعلقة بالسينما.
الميزة الثانية هي أنه داخل دراسات الأفلام – وهي في حد ذاتها مجال مؤسسي للدراسة الأكاديمية – يوجد مجال فرعي لنظرية الفيلم يتداخل بشكل كبير مع فلسفة الفيلم على الرغم من أن غالبية ممارسيها يعملون على افتراضات فلسفية مختلفة بشكل كبير عن الفلسفات الأنجلو أمريكية للفيلم.
وفي ميزان هذه المدخلة، سوف أقوم بإدراج كلا المجالين تحت عنوان فلسفة الفيلم، على الرغم من أن التركيز الأساسي ينصب على مساهمات المنظرين الأنجلو أمريكيين وسوف أميز أحيانًا بين هذا المجال ونظرية الفيلم كما تمارس في مجال دراسات الفيلم. من خصائص الفلسفة كعلم أنها تتساءل عن طبيعتها وأساسها. وتشترك فلسفة الفيلم في هذه الخاصية مع المجال بشكل عام. في الواقع، فإن القضية الأولى التي يجب على فلسفة الفيلم أن تتناولها هي أسباب وجودها في حد ذاتها. وهذا لا يتضمن فقط مسألة الشكل الذي ينبغي أن يبدو عليه المجال، بل يشمل أيضا ما إذا كان هناك أي سبب لوجودها على الإطلاق.
هل هناك حاجة إلى تخصص فلسفي منفصل مخصص للسينما بالإضافة إلى الدراسات التجريبية للسينما التي يتم إجراؤها تحت رعاية دراسات السينما نفسها؟
على الرغم من أن هذا السؤال لم يحظ دائمًا بالاهتمام الذي يستحقه من الفلاسفة، إلا أنه في الواقع سؤال مُلح، لأنه يطلب من الفلاسفة تبرير اهتمامهم الجديد بالفيلم باعتباره أكثر من مجرد دمج انتهازي لشكل شائع للغاية من أشكال الثقافة الشعبية في مجالهم. ولكن بمعنى ما، لا يحتاج الفلاسفة إلى تبرير اهتمامهم بالفيلم، لأن الجماليات الفلسفية كانت دائماً مهتمة، ليس فقط بالفن بشكل عام، ولكن أيضاً بأشكال فنية محددة. وبدءًا من كتاب أرسطو “فن الشعر” ـ وهو العمل المخصص لشرح طبيعة المأساة اليونانية ـ سعى الفلاسفة إلى شرح الخصائص المحددة لكل شكل فني مهم في ثقافتهم. ومن وجهة النظر هذه، لا يوجد سبب يدعو إلى التشكيك في وجود فلسفة الفيلم أكثر من وجود فلسفة الموسيقى أو فلسفة الرسم، وهما مجالان مقبولان جيداً كمكونات للجماليات. وبما أن الفيلم يشكل شكلاً فنياً مهماً في عالمنا المعاصر، فربما يكون من الواجب على الفلسفة أن تتحمل مسؤولية التحقيق في طبيعته.
ومع ذلك، هناك بعض الأسباب التي قد تجعل وجود مجال أكاديمي منفصل لفلسفة الفيلم يبدو أمرا إشكاليا. وبما أن دراسة الفيلم أصبحت مؤسسية بالفعل داخل الأوساط الأكاديمية في مجال دراسات الفيلم، ولأن هذا المجال يتضمن مجالًا فرعيًا منفصلاً لنظرية الفيلم، فقد يبدو أن الفيلم، على عكس الأدب والموسيقى، على سبيل المثال، يحظى بالفعل بخدمة جيدة من خلال هذه القاعدة المؤسسية. ومن وجهة النظر هذه، فإن فلسفة الفيلم أصبحت زائدة عن الحاجة، إذ تشغل مساحة تم تخصيصها بالفعل من قبل تخصص بديل.
المشكلة هي أن المجال الفرعي لنظرية الفيلم ضمن دراسات الفيلم كان يهيمن عليه مجموعة من الالتزامات النظرية التي لا يشاركها العديد من الفلاسفة الأنجلو أمريكيين. ولذلك شعر العديد من هؤلاء الفلاسفة بالحاجة ليس فقط إلى إجراء تعديلات طفيفة في هذا المجال وفهمهم للسينما، بل إلى بداية جديدة في دراسة الفيلم لا تشترك في الافتراضات الإشكالية لنظرية الفيلم نفسها. ولهذا السبب، فضلاً عن وجهة النظر التي سبق ذكرها بشأن الفيلم باعتباره موضوعاً مشروعاً في إطار علم الجمال، فقد شعروا بأهمية تطوير أسلوب تفكير مستنير فلسفياً حول الفيلم. ولكن بمجرد منح فلسفة الفيلم الاستقلالية باعتبارها مجالًا فرعيًا منفصلاً عن الجماليات، يثور السؤال حول شكلها. وهذا يعني أن الفلاسفة مهتمون بمسألة كيفية تشكيل فلسفة الفيلم كمجال للدراسة. ما هو الدور الذي يلعبه تفسير الأفلام؟ كيف ترتبط دراسات أفلام معينة بالدراسات الأكثر نظرية للوسيلة بحد ذاتها؟ وما هو حال الفلسفة في السينما، وهي نمط شائع من التفكير الفلسفي حول السينما؟ هل هناك نموذج موحد يمكن .استخدامه لتوصيف هذا المجال الحيوي الجديد للاستقصاء الفلسفي

الطريقة التي أصبحت شائعة بشكل متزايد للتفكير في فلسفة الفيلم هي أن نجعلها نموذجًا للنظرية العلمية. وعلى الرغم من وجود خلاف حول التفاصيل الدقيقة لمثل هذا الاقتراح، فإن أنصاره يحثون على التعامل مع دراسة الفيلم باعتبارها تخصصًا علميًا يتمتع بعلاقة مناسبة بين النظرية والأدلة. بالنسبة للبعض، يعني هذا وجود مجموعة تجريبية من تفسيرات الأفلام التي تؤدي إلى تعميمات نظرية أوسع. بالنسبة للآخرين، فإن هذا يعني تطوير مجموعة من النظريات صغيرة النطاق التي تحاول تفسير جوانب مختلفة من الأفلام وتجربتنا معها. ويتم التركيز هنا على تطوير نماذج أو نظريات للميزات المختلفة للأفلام.
لقد كانت فكرة نمذجة تخصص فلسفة الفيلم على أساس العلوم الطبيعية بارزة بين منظري الفيلم المعرفي (بوردويل وكارول 1996؛ كوري 1995). يؤكد هذا النهج سريع التطور على المعالجة الواعية للأفلام من قبل المشاهدين، على النقيض من التركيز داخل نظرية الفيلم التقليدية على العمليات اللاواعية.
وبشكل عام، يميل هؤلاء المنظرون إلى رؤية دراسة الفيلم باعتبارها مشروعًا علميًا. لقد تم الطعن في فكرة أن فلسفة الفيلم يجب أن تصمم على أساس نموذج علمي من خلال مجموعة متنوعة من وجهات النظر. وقد شكك بعض الفلاسفة، استناداً إلى كتابات البراجماتيين مثل ويليام جيمس، في فكرة أن العلوم الطبيعية توفر طريقة مفيدة للتفكير فيما يفعله الفلاسفة في تأملاتهم حول الفيلم. وهنا يتم التركيز على خصوصية الأفلام باعتبارها أعمالاً فنية، على النقيض من الرغبة في الانتقال إلى نظرية عامة للفيلم.
ويتساءل آخرون، مستفيدين من أفكار فيتجنشتاين المتأخرة فضلاً عن تقاليد التأويل، عن مثل هذا التوجه العلمي الطبيعي للتأملات الفلسفية حول الفيلم. يرى هذا المعسكر أن دراسة الفيلم هي تخصص إنساني من غير المفهوم عند دمجه مع العلوم الطبيعية.
إن المناقشات حول الشكل الذي ينبغي أن تبدو عليه فلسفة الفيلم بدأت للتو. ويرجع ذلك إلى أن المفهوم العلمي لفلسفة الفيلم لم يظهر إلا مؤخراً كمنافس. ولكن على الرغم من الشعبية المتزايدة للنهج المعرفي للسينما، فإن هناك قضايا أساسية حول بنية فلسفة الفيلم لا تزال بحاجة إلى تسوية. إحدى القضايا الأساسية هي ما هي الوسائط التي ينبغي أن تندرج تحت مصطلح “فيلم”. على الرغم من أن “الفيلم” يشير في البداية إلى مخزون السيلولويد الذي تم تسجيل الأفلام عليه، فإن تقييد المصطلح على الأعمال المعتمدة على السيلولويد فقط سيكون تقييدًا غير مبرر. بعد كل شيء، فإن العديد من الأفلام التي نشاهدها اليوم إما تم تسجيلها رقميًا أو عرضها رقميًا أو كليهما. من الواضح أن مثل هذه الأعمال هي جزء من نفس الشكل الفني للأفلام التي تعتمد على السيلولويد، وبالتالي فإن مصطلح “فيلم” يجب أن يشمل الأعمال المصنوعة على كلا الوسيطين. ثم يأتي التلفاز. على الرغم من أن العديد من علماء السينما وفلاسفة السينما لديهم وجهة نظر ازدرائية للتليفزيون، فإن ظهور برامج مثل The Sopranos وThe Wire أدى إلى ترسيخ التليفزيون كوسيلة لإنتاج أعمال فنية قيمة. ونتيجة لذلك، فمن المنطقي أن ندرج مثل هذه العروض تحت فئة الأفلام.
أدى هذا التوسع في مفهوم “الفيلم” ليشمل الأفلام غير السيلولويدية والتلفزيون والوسائط الأخرى ذات الصلة إلى دفع بعض فلسفات الفيلم إلى اقتراح استبدال مصطلح “فيلم” بفئة أوسع، مثل الصور المتحركة. ولكن حتى الآن، لم تؤدي مثل هذه الاقتراحات إلى تغيير الطريقة التي يتم بها تحديد هذا المجال، لذا فإنني أحتفظ بمصطلح “فلسفة الفيلم” في جميع أنحاء هذه المداخلة.
2. طبيعة الفيلم
كان السؤال الذي هيمن على البحث الفلسفي المبكر في مجال السينما هو ما إذا كان من الممكن اعتبار السينما – وهو مصطلح يؤكد على البنية المؤسسية التي يتم من خلالها إنتاج الأفلام وتوزيعها ومشاهدتها – شكلاً فنياً.
كان هناك سببان يجعلان السينما تبدو غير جديرة باللقب الشرفي للفن. الأول هو أن السياقات المبكرة لعرض الأفلام كانت تتضمن أماكن مثل عروض الفودفيل والعروض الجانبية للسيرك. وباعتبارها شكلاً ثقافياً شعبياً، بدا الفيلم وكأنه يحمل قدراً من الابتذال جعله رفيقاً غير مناسب للمسرح والرسم والأوبرا وغيرها من الفنون الجميلة.
وكانت المشكلة الثانية هي أن الفيلم بدا وكأنه يستعير الكثير من أشكال الفن الأخرى. بالنسبة للعديد من الناس، بدت الأفلام المبكرة وكأنها مجرد تسجيلات للعروض المسرحية أو الحياة اليومية. وكان السبب وراء الفكرة الأولى هو إمكانية نشرها على نطاق أوسع من الجمهور الذي يمكنه مشاهدة عرض حي. لكن بدا أن الفيلم ليس سوى وسيلة للوصول إلى الفن وليس شكلاً فنياً مستقلاً بذاته.
من ناحية أخرى، بدا الأخير بمثابة إعادة إنتاج مباشرة للحياة بحيث لا يمكن اعتباره فنًا، لأنه بدا وكأنه لا يحتوي على وساطة تذكر من جانب أي وعي توجيهي.
من أجل تبرير الادعاء بأن الفيلم يستحق أن يُعتبر شكلاً فنياً مستقلاً، قام الفلاسفة بالبحث في البنية الوجودية للفيلم. وكان الأمل هو تطوير مفهوم للفيلم يوضح أنه يختلف في نواحٍ مهمة عن الفنون الجميلة الأخرى. ولهذا السبب، كان السؤال حول طبيعة الفيلم سؤالاً حاسماً بالنسبة لمنظري الفيلم خلال ما يمكن أن نسميه الفترة الكلاسيكية.
كان هوغو مونستربرج، الفيلسوف الأول الذي كتب دراسة عن هذا الشكل الفني الجديد، يسعى إلى تمييز الفيلم من خلال التقنيات أو الأدوات التقنية التي استخدمها في تقديم رواياته (مونستربرج 1916).
تعتبر لقطات الماضي أو الفلاش باك، واللقطات القريبة، والمونتاج بعض الأمثلة على الوسائل التقنية التي يستخدمها صناع الأفلام لتقديم رواياتهم والتي يفتقر إليها المسرح. بالنسبة لمونستربيرج، فإن استخدام هذه التقنيات يميز الفيلم عن المسرح كشكل فني. وتساءل مونستربيرج عن كيفية تمكن المشاهدين من فهم الدور الذي تلعبه هذه الوسائل التقنية في صياغة السرد السينمائي. وكانت إجابته هي أن هذه كلها تجسيدات للعمليات العقلية.
على سبيل المثال، يقدم التقريب في شكل بصري علاقة مع الفعل العقلي المتمثل في الاهتمام بشيء ما. يفهم المشاهدون بشكل طبيعي كيفية عمل مثل هذه الوسائل السينمائية لأنهم على دراية بكيفية عمل عقولهم، ويمكنهم التعرف على هذه الوظائف العقلية الموضوعية عندما يرونها.
على الرغم من أن هذا الجانب من نظرية مونستربيرج يربطه بالفلسفات المعرفية المعاصرة للسينما، إلا أنه لا يفسر كيف يعرف المشاهدون أن ما يشاهدونه هو وظائف عقلية موضوعية.
تمت كتابة رواية مونستربيرج خلال عصر السينما الصامتة. لقد أدى تطوير الموسيقى التصويرية المتزامنة للفيلم – “الفيلم الناطق” – إلى تغيير صناعة السينما إلى الأبد. وليس من المستغرب أن يثير هذا الابتكار المهم تأملات نظرية مثيرة للاهتمام. وقد ادعى عالم النفس الفني الشهير رودولف أرنهايم بشكل مفاجئ أن الأفلام الناطقة تمثل تراجعاً عن ذروة السينما الصامتة. (أرنهايم 1957) استنادًا إلى فكرة مفادها أنه لكي يكون الفيلم فنًا فريدًا، يجب أن يكون صادقًا مع وسيطه المحدد، فإن أرنهايم ينتقد الفيلم الصوتي باعتباره مزيجًا من وسيطين فنيين مختلفين لا يشكلان كلًا مرضيًا.
بالنسبة لأرنهايم، حقق الفيلم الصامت مكانة فنية من خلال التركيز على قدرته على تقديم الأجساد المتحركة. في الواقع، بالنسبة له، كان الجانب الفني للسينما يتلخص في قدرتها على تقديم التجريدات، وهي القدرة التي فقدت تماما عندما بدأت الأفلام تستخدم الموسيقى التصويرية المتزامنة. في كتابته مع اقتراب فجر السينما الناطقة، لم يستطع أرنهايم أن يرى ما نعتبره الآن تطوراً طبيعياً لهذا النوع من الفن إلا باعتباره تراجعاً عن الارتفاع الذي تم تحقيقه في السابق.
ورغم أن أندريه بازان ليس فيلسوفًا محترفًا أو حتى أكاديميًا، فإنه رد على تقييم أرنهايم في سلسلة من المقالات التي لا تزال تمارس تأثيرًا مهمًا على هذا المجال. (بازين 1967؛ 1971) بالنسبة لبازان، فإن الثنائية المهمة ليست بين الفيلم الناطق والفيلم الصامت، بل بين الأفلام التي تركز على الصورة وتلك التي تؤكد على الواقع.
على الرغم من أن المونتاج قد ظهر عند العديد من الأشخاص مثل سيرجي آيزنشتاين باعتباره الجانب المميز للفيلم، إلا أن بازان يعود إلى عصر السينما الصامتة ليثبت وجود وسيلة بديلة لتحقيق فن الفيلم، ألا وهي الاهتمام بالسماح للكاميرا بالكشف عن الطبيعة الفعلية للعالم استناداً إلى مفهوم أن الفيلم يتمتع بطابع واقعي بسبب أن أساسه يكمن في التصوير الفوتوغرافي، يزعم بازان أن مستقبل السينما كشكل فني يعتمد على تطوير هذه القدرة على تقديم العالم لنا “متجمداً في الزمن”.
في عرض حجته، يشيد بازان بأسلوب الفيلم الذي يطلق عليه الواقعي، والذي يتميز باللقطات الممتدة والتركيز العميق. يرى بازان أن جان رينوار وأورسون ويلز والواقعيين الجدد الإيطاليين هم صناع الأفلام الذين بلغوا ذروة هذا التقليد التصويري لصناعة الأفلام، الذين أدركوا الإمكانات الحقيقية للوسيط.
في دراسته الرائدة لما سماه “نظرية الفيلم الكلاسيكية”، زعم نويل كارول (1988) أن هناك العديد من الافتراضات غير المشروعة التي لعبت دوراً في محاولات المنظرين الكلاسيكيين لتحديد طبيعة الفيلم. وعلى وجه الخصوص، اتهمهم بالخلط بين أنماط معينة من صناعة الأفلام ومطالبات أكثر تجريدا حول طبيعة الوسيلة نفسها. ويبدو أن اتهاماته كانت تعني نهاية مثل هذه المحاولات لتبرير أنماط الأفلام من خلال استنادها إلى طبيعة الوسيلة. ولكن في الآونة الأخيرة، عادت إلى الحياة من جديد ادعاءات بازان حول واقعية السينما، وإن كانت خالية من الإسراف الموجود في كتابات بازان نفسه.
في بحث مؤثر للغاية (1984)، زعم كيندال والتون أن الفيلم، بسبب أن أساسه يرجع الى التصوير الفوتوغرافي، هو وسيلة واقعية تسمح للمشاهدين برؤية الأشياء التي تظهر على الشاشة بالفعل. لقد كانت أطروحة الشفافية موضوعًا لقدر كبير من النقاش بين الفلاسفة وعلماء الجمال. على سبيل المثال، يرفض جريجوري كوري أطروحة الشفافية في حين يظل يدافع عن شكل من أشكال الواقعية. ويزعم أن واقعية الفيلم هي نتيجة لحقيقة مفادها أن الأشياء التي يتم تصويرها على الشاشة تثير نفس القدرات التعريفية التي تستخدم لتحديد الأشياء الحقيقية.
تظل مناقشة الطابع الواقعي للفيلم موضوعًا للنقاش الساخن بين فلاسفة الفيلم. وفي الآونة الأخيرة، أثار ظهور التقنيات الرقمية لتشكيل الصورة أسئلة أساسية للغاية حول مدى معقولية هذا الرأي.
3. الفيلم والتأليف
الأفلام هي نتاج عمل العديد من الأفراد معًا. وهذا واضح عندما نشاهد التترات الختامية لأي فيلم هوليوودي حيث نرى أسماء عديدة تمر أمامنا. وبعبارة أخرى، فإن الأمر يتطلب قرية بأكملها لصنع فيلم. ولذلك قد يبدو من المدهش أن هناك ميلاً كبيراً بين علماء السينما إلى التعامل مع الأفلام باعتبارها نتاج فرد واحد، مؤلفها أو مخرجها. وعلى هذا الخط من التفسير، فإن مخرج الفيلم هو الذكاء الإبداعي الذي يشكل الفيلم بأكمله بطريقة موازية للطريقة التي نفكر بها، مثلا، في الأعمال الأدبية التي يتم تأليفها.
كانت فكرة المخرج كمؤلف أول من اقترحها فرانسوا تروفو – الذي أصبح فيما بعد أحد المخرجين الاساسيين في حركة الموجة الفرنسية الجديدة. وقد استخدم تروفو هذا المصطلح جدليًا للهجوم على النمط السائد في صناعة الأفلام آنذاك والذي كان يؤكد على اقتباس الأعمال الأدبية العظيمة إلى الشاشة. وفي محاولته لتثمين أسلوب مختلف في صناعة الأفلام، زعم تروفو أن الأفلام الوحيدة التي تستحق أن تُوصف بالفن هي تلك التي كان للمخرج فيها سيطرة كاملة على إنتاجها من خلال كتابة السيناريو بالإضافة إلى توجيه الممثلين. فقط الأفلام المصنوعة بهذه الطريقة هي التي تستحق الحصول على صفة الأعمال الفنية.
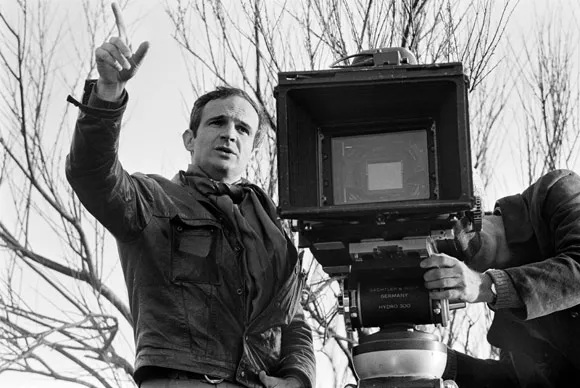
وقد تبنى الباحث والناقد السينمائي الأمريكي الشهير أندرو ساريس نظرية تروفو من أجل إضفاء الشرعية على دراسات الأفلام باعتبارها تخصصًا أكاديميًا. بالنسبة لساريس، كانت نظرية المؤلف بمثابة نظرية لتقييم الأفلام، لأنها أوحت له بأن أعمال المخرجين العظماء كانت الأعمال المهمة الوحيدة. وفي استخدامه الغريب إلى حد ما للفكرة، زعم أن الأعمال المعيبة التي قدمها كبار المخرجين كانت أفضل فنياً من روائع المخرجين الصغار. وكان الجانب الأكثر قابلية للدفاع عنه في أفكاره هو التركيز على جميع أعمال المخرج.
في دراسات الأفلام، ينبع التركيز على الدراسات الموجزة للمخرجين الأفراد من نسخة ساريس لنظرية المؤلف. إن إحدى العواقب السلبية لتأثير التعصب هو الإهمال النسبي للمساهمين الآخرين المهمين في صنع الفيلم. يقدم الممثلون، والمصورون السينمائيون، وكتاب السيناريو، والملحنون، والمخرجون الفنيون مساهمات كبيرة في الأفلام التي تقلل نظرية المؤلف من شأنها.
وفي حين أن تروفو قدم المصطلح بشكل جدلي لدعم أسلوب جديد في صناعة الأفلام، إلا أن المنظرين اللاحقين مالوا إلى تجاهل سياق تصريحاته. وبالتالي، باعتبارها نظرية عامة للسينما، فإن نظرية المؤلف معيبة بشكل واضح. لا يمكن أن تُعزى جميع الأفلام – حتى العظيمة منها – إلى سيطرة المخرج. الممثلون هم الأمثلة الأكثر وضوحًا للأفراد الذين قد يكون لهم تأثير كبير على صنع فيلم معين لدرجة أنه يتعين علينا أن ننظر إلى الفيلم على أنه يعود إليهم بشكل أكثر أهمية من المخرج.
وعلى الرغم من أن الأفلام مثل أفلام تروفو قد تكون (في الغالب) نتاجًا له كمؤلف، فإن أعمال كلينت إيستوود تدرين بقدر كبير من نجاحها الى وجود هذا الممثل. ومن الخطأ أن نتعامل مع جميع الأفلام كما لو كانت مجرد نتاج لفرد واحد أساسي هو المخرج. ومع ذلك، فإن العادات القديمة تموت ببطء، ولا تزال الأفلام تُستشهد بها من خلال مخرجيها.
إن الانتقاد الأكثر عمومية لنظرية المؤلف هو تركيزها على الأفراد. معظم المخرجين العظماء الذين تمت دراستهم من قبل منظري السينما عملوا في مؤسسات محددة جيدًا، وأشهرها هوليوود. ومحاولة فهم الأفلام دون وضعها في سياق إنتاجها الأوسع كانت تعتبر بمثابة عيب حقيقي في النظرية. وقد حظي هذا النوع من النقد للذاتية بصياغة أكثر نظرية في مرحلة ما بعد الحداثة، مع إعلانها الشهير (أو السيئ السمعة) عن موت المؤلف.
إن ما تؤكده هذه البادرة البلاغية المتعمدة هو أن الأعمال الفنية، بما في ذلك الأفلام، لا ينبغي أن ننظر إليها باعتبارها نتاجًا لذكاء مسيطر واحد، بل ينبغي أن ننظر إليها باعتبارها نتاجًا لأزمنتها وسياقاتها الاجتماعية. لا ينبغي أن يكون هدف الناقد إعادة بناء نوايا المؤلف، بل عرض السياقات المختلفة التي تفسر إنتاج العمل وكذلك حدوده. في حين أن السياق المؤسسي العام له أهمية حاسمة بالتأكيد لفهم الفيلم، فإن نظرية المؤلف توفر مع ذلك تركيزًا مفيدًا لبعض الجهود في الدراسة العلمية للفيلم: استكشاف أعمال المخرجين الأفراد. ولكن حتى هنا، كان هناك قلق من أن النظرية تبالغ في التركيز على مساهمة المخرج على حساب أشخاص آخرين – الممثلين، ومديري التصوير، وكتاب السيناريو – الذين قد تكون مساهماتهم بنفس القدر من الأهمية في صنع بعض الأفلام على الأقل.

4. المشاركة العاطفية
يبدأ النقاش الفلسفي حول تفاعل المشاهد مع الأفلام بالسؤال الذي تم طرحه حول العديد من أشكال الفن: لماذا يجب أن نهتم بما يحدث للشخصيات الخيالية؟ بعد كل شيء، بما أنهم خياليون، فإن مصائرهم لا ينبغي أن تهمنا بالطريقة التي تهم بها مصائر الأشخاص الحقيقيين. ولكن، بطبيعة الحال، نحن نتدخل في مصائر هذه الكائنات الخيالية. السؤال هو لماذا. وبما أن العديد من الأفلام التي تجذب اهتمامنا هي أفلام خيالية، فإن هذا السؤال يعد من الأسئلة المهمة التي يتعين على فلاسفة الفيلم الإجابة عليها.
إحدى الإجابات الشائعة في تقاليد نظرية الفيلم هي أن السبب وراء اهتمامنا بما يحدث لبعض الشخصيات الخيالية هو أننا نتعاطف معهم. ورغم أن هذه الشخصيات مثالية للغاية، أو ربما بسبب ذلك – فهم أكثر جمالاً وشجاعة وذكاءً وما إلى ذلك من أي إنسان حقيقي – فإن المشاهدين يتماهون معهم، وبالتالي يعتبرون أنفسهم مرتبطين بهذه الكائنات المثالية. لكن بمجرد أن نرى الشخصيات كنسخ من أنفسنا، فإن مصائرهم تصبح مهمة بالنسبة لنا، لأننا نرى أنفسنا منغمسين في قصصهم.
وفي أيدي المنظرين النسويين، تم استخدام هذه الفكرة لشرح كيفية استخدام الأفلام لمتعة مشاهديها لدعم مجتمع متحيز جنسيا. لقد ثبت أن المشاهدين الذكور للأفلام يتماهون مع نظرائهم المثاليين على الشاشة ويستمتعون بتشييء المرأة من خلال صور الشاشة التي يشاهدونها بسرور وكذلك السرد الذي تتجسد فيه الشخصيات الذكورية التي يتماهون معها وهي تمتلك الشخصية الأنثوية المرغوبة.
لقد زعم فلاسفة السينما أن التعريف أداة بدائية للغاية لا يمكن استخدامها لتفسير تفاعلنا العاطفي مع الشخصيات، لأن هناك مجموعة واسعة من المواقف التي نتخذها تجاه الشخصيات الخيالية التي نراها معروضة على الشاشة. (انظر، على سبيل المثال، سميث (1995)) وحتى لو كنا نشعر بالانتماء إلى بعض الشخصيات، فإن هذا لن يفسر لماذا كانت لدينا أي ردود فعل عاطفية تجاه شخصيات لم نشعر بالانتماء إليها.
ومن الواضح أن الأمر يتطلب تقديم حساب أكثر عمومية لتفاعل المشاهد مع الشخصيات السينمائية والأفلام التي تظهر فيها. إن الخطوط العريضة للإجابة التي قدمها فلاسفة الفيلم على سؤال انخراطنا العاطفي في الأفلام هي أننا نهتم بما يحدث في الأفلام لأن الأفلام تجعلنا نتخيل أشياء تحدث، أشياء نهتم بها. ونظرًا لأن كيفية تصورنا للأمور تؤثر على عواطفنا، فإن الأفلام الخيالية لها تأثير عاطفي علينا. هناك تفسيران أساسيان طرحهما الفلاسفة لتفسير تأثيرات الخيال علينا. تستخدم نظرية المحاكاة تشبيهًا حاسوبيًا، وتقول إن تخيل شيء ما يتضمن استجابة عاطفية معتادة تجاه المواقف والأشخاص، إلا أن العواطف هي التي تخرج عن نطاق السيطرة.
ما يعنيه هذا هو أنه عندما يكون لدي استجابة عاطفية مثل الغضب ازاء موقف متخيل، أشعر بنفس المشاعر التي أشعر بها عادةً، فقط أنا لا أميل إلى التصرف بناءً على هذه المشاعر، على سبيل المثال، بالصراخ أو الاستجابة بطريقة غاضبة، كما لو كانت المشاعر مشاعر كاملة.
إن ما يفسر هذا، إذن، هو سمة تبدو متناقضة في تجربة ذهابنا إلى السينما: حيث يبدو أننا نستمتع بمشاهدة أشياء على الشاشة نكره رؤيتها في الحياة الواقعية. إن السياق الأكثر وضوحًا لذلك هو أفلام الرعب، لأننا قد نستمتع برؤية أحداث وكائنات مرعبة نرغب بشدة في عدم مشاهدتها في الحياة الواقعية. فآخر شيء أود رؤيته في الحياة الواقعية هو قرد عملاق هائج، ومع ذلك أشعر بالفضول لمشاهدة مثل هذه الكائنات على الشاشة.
يقول منظر المحاكاة أن السبب في ذلك هو أنه عندما نشعر بمشاعر خارج الانترنت قد تكون مؤلمة في الحياة الواقعية، فإننا نستطيع في الواقع الاستمتاع بهذه المشاعر في أمان الوضع غير المتصل بالإنترنت.
وإحدى المشكلات التي تواجه منظري المحاكاة هي تفسير ما يعنيه أن تكون العاطفة غير متصلة بالإنترنت. ورغم أن هذه الاستعارة مثيرة للاهتمام، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان منظر المحاكاة قادراً على تقديم وصف كاف لكيفية الاستفادة منها. هناك تفسير بديل لاستجابتنا العاطفية للسيناريوهات المتخيلة أطلق عليه اسم نظرية الفكر.
الفكرة هنا هي أننا يمكن أن يكون لدينا استجابات عاطفية لأفكار الأم. عندما قيل لي إن أحد زملائي الصغار حُرم ظلماً من إعادة تعيينه، فإن مجرد التفكير في هذا الظلم كافٍ لجعلني أشعر بالغضب. وبالمثل، عندما أتخيل مثل هذا السيناريو في علاقة مع شخص ما، فإن فكرة الأم في معاملته بهذه الطريقة يمكن أن تسبب غضبي. إن مجرد التفكير يمكن أن يؤدي إلى إثارة مشاعر حقيقية. ما تدعيه نظرية الفكر بشأن استجابتنا العاطفية للأفلام هو أن عواطفنا تنشأ من الأفكار التي تخطر ببالنا أثناء مشاهدتنا لفيلم. عندما نرى الشرير الخبيث يربط البطلة البريئة بالسكك الحديدية، نشعر بالقلق والغضب من مجرد التفكير في أنه يتصرف بهذه الطريقة وأنها بالتالي في خطر. ومع ذلك فإننا ندرك طوال الوقت أن هذا مجرد وضع خيالي، وبالتالي لا يوجد إغراء للاستسلام للرغبة في إنقاذها. نحن ندرك دائمًا أن لا أحد في خطر حقيقي. ونتيجة لذلك، لا توجد حاجة، كما يقول منظر الفكر، إلى تعقيدات نظرية المحاكاة من أجل تفسير سبب تأثرنا بالأفلام.
هناك بعض المشاكل مع نظرية الفكر أيضًا. لماذا يجب على الأم أن تفكر، بدلاً من الاعتقاد، في شيء يثير استجابة عاطفية منا؟ إذا كنت أعتقد أنك كنت مخطئًا، فهذا شيء آخر. لكن فكرة تعرضك للظلم فكرة أخرى. نظرًا لأننا لا نستطيع أن نمتلك معتقدات كاملة حول الشخصيات الخيالية في الأفلام، فإن نظرية الفكر تحتاج إلى تفسير سبب تأثرنا الشديد بمصائرهم. (انظر Plantinga and Smith (1999)










