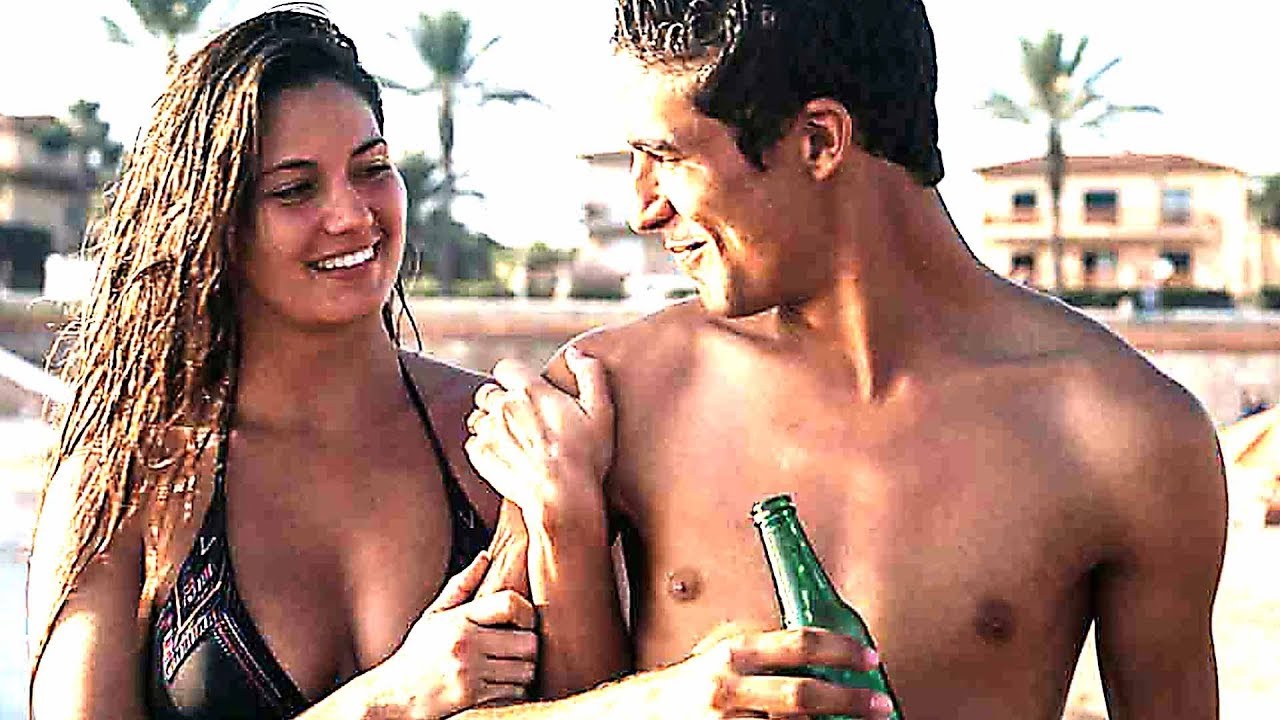يوميات مهرجان فينيسيا الـ 77 (4)


أمير العمري
عندما أقول أن كل شيء يسير على ما يرام والمهرجان أثبت وجوده وأن دورته الحالية لا تختلف كثيرا عن الدورات السابقة، فلست أعني بذلك أنه لا توجد اختلافات، فهي موجودة، بل قصدت أن عروض الأفلام منتظمة، والمؤتمرات الصحفية لمناقشة الأفلام تتم دون أي تأخير، والحضور ممتاز، والإجراءات الاحترازية مطبقة بشكل صارم، لكن تظل هذه الدورة في جميع الأحوال ورغم كل شيء، دورة استثنائية خاصة.
هناك غياب واضح للنقاد والصحفيين الأجانب الذين كانوا يأتون من أرجاء العالم المختلفة، وهو أمر مفهوم بالطبع وشرحت أسبابه من قبل. وهناك غياب لأفلام هوليوود الكبيرة التي يمكن أن تصل لترشيحات الأوسكار لكن السبب أن هذه الأفلام تأجل عرضها بقرار الشركات التي أنتجتها الى العام القادم بعد تأجيل مسابقة الأوسكار نفسها.
لم يعد مسموحا بوقوف الجمهور أمام السجاد الأحمر لمشاهدة النجوم، ولكن المرور على السجاد الأحمر موجود ومستمر ولكن بالكمامة. وأظن أن الكمامة أصبحت الشعار الحقيقي للمهرجان هذا العام بحيث يمكن أن نسميها دورة الكمامة!
حدث أن الكمامة انزلقت قليلا عن أنفي وأنا خارج من أحد العروض فوجدت أحد
المراقبين الرسميين يتوجه الي وينبهني إلى ضرورة ضبط الكمامة. وتكرر الأمر اليوم وأنا مستغرق في مشاهدة أحد الأفلام، عندما فوجئت بحضور احدى الفتيات المشرفات على قاعة العرض الى مقعدي والتنبيه بضرورة أن أضبط الكمامة بحيث تغطي أنفي تماما. هناك مراقبة للجميع في الظلام. وهي مسألة معلنة من قبل الإدارة والمكتب الصحفي من البداية. كما أن تغيير المقاعد ممنوع. عندما حاول صديقي الناقد محمد رضا أمس أن يغر مقعده ويجلس في مقعد خال لا صاحب له، حضرت المشرفة ونهبته الى ضرورة العودة الى مقعده. والسبب أنهم يرصدون ظهور أي اعراض على أي شخص، وفي هذه الحالة سيعودون الى رقم مقعده ويتصلون بكل من كانوا جالسين بالقرب منه. وأنت إذن محدد في المقعد الذي حجزته برقمه. فإن انتقلت الى مقعد آخر لتسبب هذا في صعوبة متابعتك لو حدث شيء لا قدر الله!
انت ملتزم بالكمامة سواء داخل أو خارج قاعات العرض. ربما يمكنك فقط التملص من هذه الكارثة إذا جلست في أحد مقاهي أو مطاعم المهرجان.
أكثر فيلم أعجبني حتى الآن من بين كل ما شاهدته، الفيلم البريطاني “الدوق” The Duke وهو من اخراج روجر ميتشيل.. أحد كبار مخرجي المسرح والسينما والتليفزيون في بريطانيا. وفيلمه هذا هو رقم 15 في قائمة أفلامه. وهو من بطولة هيلين ميرين وجيم برودبنت. هذا أقرب الأفلام الى التحف السينمائية. لكنه موجود خارج المسابقة في فينيسيا ولا أعرف السبب!
إنه نموذج في السيناريو لما يمكن أن نسميه الاتقان التام Perfection. فعلى الرغم من تعدد الشخصيات في الفيلم إلا أن السيناريو يتميز بالتوازن وباتاحة مساحة لكل منها للتعبير والوجود دون الاخلال بالموضوع الرئيسي والشخصية الرئيسية. وهو كذلك عمل كبير بأداء ممثليه من المستوى الرفيع، والإخراج الذي يحافظ على روح الفكاهة والتعليق الاجتماعي الساخر، كما يهتم بكل تفاصيل الفترة من أوائل الستينات، من طرز السيارات والملابس والديكورات حتى النظارات التي يرتديها بطله من تلك الرخيصة التي يمنحها التأمين الصحي للعاطلين عن العمل.

اشترك كل من ريتشارد بين وكلايف كولمان في كتابة سيناريو الفيلم عن أحداث حقيقية وقعت في عام 1961، بطلها رجل في الستين من عمره يدعى “كمبتون بانتون”، ظل يطرد من عمل بعد آخر بسبب كثرة احتجاجه على ظروف العمل ورفضه أي نوع من الاستغلال، كما أنه يتمتع بخفة ظل وميل للمداعبة وثقافة خاصة دفعته الى كتابة القصص والسيناريوهات الاذاعية ظل يرسلها بانتظام الى بي بي سي. هذا الرجل نموذج لرفض المؤسسة والتمرد عليها، ووصل الأمر الى حد تنظيمه حملة تدعو لرفض الالتزام بدفع “رخصة التليفزيون” التي فرضتها الحكومة مقابل خلو خدمة بي بي سي من الإعلانات، ورأى انها نوع من الضريبة الإضافية التي لا يجب أن يتحملها المتقاعدون الذين يصبح التليفزيون هو تسليتهم الوحيدة، كما أنه قام بحظر مشاهدة بي بي سي داخل منزله، لكي يصبح ذريعة أمام منفذي القانون. لكن حيلته لم تجدي. وبسبب تمرده الدائم، عوقب وسجن لمدد كثيرة، إلا أن جاءته فكرة سرقة لوحة دوق ويلينغتون التي رسمها الفنان الاسباني غويا، التي اشتراها المتحف الوطني بمبلغ 140 ألف جنيه إسترليني. وكانت الفكرة أن يحصل على هذ القيمة نفسها مقابل ارجاع اللوحة وتوزيع المبلغ على نحو 3500 أسرة لدفع قيمة رخصة التليفزيون التي لا يستطيعون تحملها.
من خصائص هذه الشخصية الغريبة، التي تتمتع بفلسفة خاصة، ويسلك طريقا مشابها لما سلكه سلفه روبن هوود، أنه رغم كل المشاكل التي تسبب فيها لعائلته وزوجته بوجه خاص التي تحملت أنانيته واصراره على التضحية بكل شيء من أجل أفكاره، أنه كان شديد الإخلاص لفكرة خدمة المجتمع، والاهتمام بالآخرين، الفقراء، والتضامن الطبقي والاجتماعي، والرغبة في تنوير الوعي، والاحتجاج على القرارات الحكومية الظالمة كما يراها.
إلا أن الفيلم يتناول هذه الشخصية المركبة، من خلال الكوميديا الاجتماعية الخفيفة التي تصل الى الجميع، فالسلطة البوليسية تعتقد أن وراء سرقة اللوحة رغم الحراسة المشددة، عصابة كبيرة منظمة، أو لص إيطالي محترف. والإبن الأصغر للرجل يكن اعجابا كبيرا بأفكار أبيه ويساعده فيما يقوم به بعد أن تنتقل اللوحة الثمينة الى منزلهما في مدينة نيوكاسل، ويخفيانها داخل خزانة عتيقة في الغرفة العلوية، وكيف تصبح المكافأة التي أعلنت السلطات عنها لمن يدلي بمعلومات للعثور على اللوحة (5 آلاف جنيه) دافعا لصديقة الابن الأكبر بعد ان ترى اللوحة مصادفة، لأن تعرض على كمبتون الإبلاغ عنها معا واقتسام المكافأة، أي حتى يبدو كما لو كان قد عثر عليها مصادفة ولم يسرقها.

سيفضل الراجل تسليم اللوحة والاعتراف بأنه سرقها، ويتم القبض عليه ويقف أمام المحكمة العليا، يرفض الاغتراف بانه مذنب ويسوق من الحجج والمبررات التي تتمتع بالوجاهة والمنطق كما تثير الضحك بقدرته على المناورة والاقناع، ويتعاطف معه المحلفون.
يبرع الممثل جيم برودنت في أداء الدور ويثبت أن الممثلين البريطانيين هم الأفضل في العالم، الى جانب هيلين ميرين في دور الزوجة التي تعاني بسبب حماقات زوجها، ولكنها لا تملك في النهاية سوى الوقوف بجانبه والاقرار بأنها كانت لتساعده في سرقة اللوحة لو أنه أطلعها على نواياه. إنها تبدو هنا رمادية الشعر، ذات ملامح تجعلها قريبة من ملامح الملكة اليزابيث الثانية بعد أن مضى بها قطار العمر.
مشاهدة فيلم كهذا متعة للقلب وللعين وللأذن. فهو يقول كل شيء، عن حياتنا وعن الانسان وعن العالم، السياسة والثقافة والشعر والفن، ولكن في سياق ممتع، يثير الفكر والخيال. يبدأ الفيلم من حيث انتهى بطله أمام المحكمة ليرتد في الزمن 6 أشهر الى الوراء لكي نرى القصة من أولها ونتابع الشخصية في تعقيداتها المختلفة.
هناك استخدام جيد لحركة الكاميرا، والأماكن الطبيعية، والألوان القاتمة القوية التي تمنح الصورة طابع الفترة، والإخلاص الشديد للواقعية في كل التفاصيل الخاصة بالحركة والأداء واللغة والديكورات وتوزيع الممثلين الثانويين في خلفية المشاهد. هنا ليس هناك مجالا للارتجال أو ترك الأمور تمضي وتركيز الاهتمام فقط بما يقوله الممثلون، بل هناك اهتمام بكل تفاصيل الصورة، من الخلفية إلى المقدمة. وهذه هي صناعة الفيلم التي تتضافر فيها جميع العوامل والعناصر الفنية لتحقيق تلك النتيجة المدهشة من دون أي استعراض للعضلات.
أما الفيلم التونسي الذي يحمل توقيع المخرجة كوثر بن هنية وعنوانه الغريب “الرجل الذي باع ظهره”، فهو فعلا فيلم غريب كل الغرابة، ويمكن القول انه فيلم متعدد الجنسيات، ليس فقط لأنه من الانتاج المتعدد الأطراف، بل بسبب طبيعة موضوعه وتعدد اللغات من الانجليزية للعربية والفرنسية.. ومن سورية الى بلجيكا، وأساسا، بسبب طموح مخرجته في طرح الموضوع السوري ولكن من خلال رؤية فلسفية تتعلق بنظام العولمة وفكرة ضياع الانسان وضياع روحه لحساب المصالح الاقتصادية. هل نجحت المخرجة في تحقيق التماسك بين كل هذه الأفكار، وهل كان استخدام مونيكا بيلوتشي في الفيلم في دور رئيسي موفقا؟ وهل كانت نهاية الفيلم مفهومة وواضحة للجمهور؟
غدا نكمل…