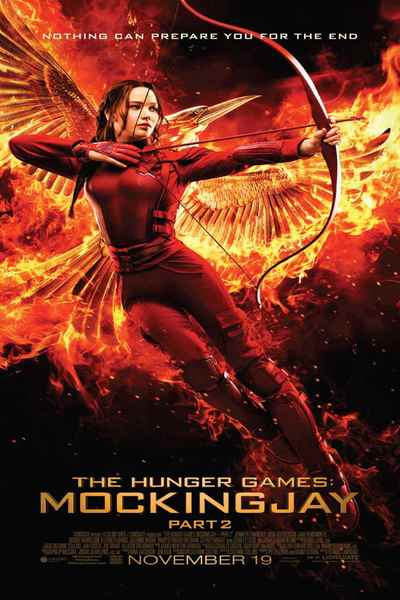من صحافة آخر السنة: إنجازات وانكسارات وأوهام!

فيكي حبيب تكتب في “الحياة” استطلع أو تسترجع صورة ما يسمى بالسينما العربية والربيع العربي، ومن ضمن ما تقوله نقتبس التالي:
لم يقف السينمائي العربي متفرجاً على ما يدور حوله من أحداث سياسية عاصفة. امتشق كاميرته. صوّر ما وقعت عليه عيناه. حلم بالتغيير… ويا حبذا لو أمسك بيديه الثورة. لكنّ الثورة هنا… فأين السينما؟
في كل مكان. في الميادين والشوارع والساحات. في مصنع الأحداث والأزقة والباحات. سينما وثائقية. سينما روائية… لا يهمّ. المهم أن السينما هنا والثورة هنا. ولكن هل حقاً هذه هي السينما؟ ثم، لماذا يُقال إن الثورة مثلما لم تستطع أن تفرز قائداً يليق بها كذلك لم تستطع أن توجد عملاً فنياً يليق بها؟
قد يكون مثل هذا الكلام مجحفاً. وقد يكون فيه كثير من الحقيقة. وفي الحالتين لا بد من أن يحيلنا إلى سؤال: هل خسرت السينما أمام السياسة للعام الثاني على التوالي بعد اندلاع حركات ما سُميّ بـ “الربيع العربي”؟
للوهلة الأولى يبدو الجواب حاسماً: كمّ الأفلام التي أفرزتها الثورة طغى على النوعية. أفلام حُكي أنها نفّذت تحت الطلب لتشارك في مهرجانات دولية مهتمة بدول الربيع العربي. وأخرى آثر أصحابها أن يركبوا الموجة رغبة في شهرة.
وثالثة نُفذت على عجل وإن بنيّة طيبة، انطلاقاً من قناعات أصحابها الثورية.
وفي الأحوال كافة، خسرت السينما وربحت السياسة. ولكن هل هذا كل شيء؟ وهل ننعى السينما المحققة على أبواب التغيرات السياسية الكبيرة التي تشهدها المنطقة؟ ربما يبدو الأمر كذلك في دول المشرق العربي حيث غلبت السياسة كل ما عداها من عناصر فنية يُشترط أن تقترن بأي فيلم سينمائي، فجاء الخطاب أولاً والفن أخيراً انطلاقاً من حراجة الواقع وسخونة الأحداث.
الاتجاه إلى المغرب
لكنّ الأمر قد يبدو مختلفاً في دول المغرب العربي حيث برزت شرائط عبقت بالسياسة، ولكن من دون أن تغيب عنها السينما. وهكذا، منذ مهرجان برلين الذي يعقد مطلع كل سنة، مروراً بمهرجان كان الذي يعقد في الربيع، ومهرجاني كارلوفيفاري والبندقية وتورونتو في الصيف وصولاً إلى مهرجانات العرب في الخريف (أبو ظبي والقاهرة والدوحة ومراكش ودبي) والأفلام المغربية تثير إعجاب أهل السينما وتطرح مخاوف شعوبها من شبح الأصولية المتطرفة… من دون أن تتلوّن بألوان الفصول التي تعرض فيها.
“موت للبيع”(للمغربي فوزي بن سعيدي)، “يا خيل الله”(للمغربي نبيل عيوش)، “المغضوب عليهم”(للمغربي محسن لبصري)، “التائب”(للجزائري مرزاق علواش)، “مانموتش”(للتونسي نوري بو زيد)… أفلام سينمائية آتية من المغرب العربي عكست هماً واحداً وإن تفاوتت درجات فنيتها: الخوف من التيارات السلفية. خوف على الحريات الفنية… ولكن أيضاً خوف على الأمل الذي نُسف ما إن أطل برأسه.
ولكن في كل حال، يمكن القول إن الحصاد السينمائي الفلسطيني في العام 2012، كان وفيراً، ليس فقط على صعيد الجوائز التي نالتها الأفلام الفلسطينية، روائية كانت أم وثائقية، بل كذلك على مستوى الكمّ الإنتاجي، والتنوع في المواضيع والأشكال، وأيضاً على صعيد المساهمة الفاعلة لكثير من السينمائيين الفلسطينيين الذين حضروا في محافل سينمائية عالمية متميزة، كأن تكون الممثلة هيام عباس عضو لجنة تحكيم في مهرجان كان السينمائي، وأن تتولّى المخرجة مي المصري، رئاسة لجنة تحكيم مسابقة “المهر الآسيوي الأفريقي للأفلام الوثائقية”في “مهرجان دبي السينمائي الدولي”.
كل الأفلام الفلسطينية عبقرية
وعن الأفلام الفلسطينية في 2012 التي يمنحها قيمة عظمى مهما تباينت مستوياتها الفنية يكتب بشار ابراهيم في “الحياة” أيضا:
ليس من المغالاة في شيء القول إن فيلم “عالم ليس لنا”، إخراج مهدي فليفل، سيكون أحد أهم إنجازات السينما الفلسطينية في العام 2012، لأنه يشكل محاولة متميزة على صعيد تقديم الموضوع الفلسطيني وثائقياً، اتكاء على شخصيات فلسطينية من لحم ودم، لها قدرتها على التعبير عن قاع الواقع الفلسطيني في مخيم عين الحلوة، إلى درجة نال بسببها أبو إياد محبة كل من قُيّض له مشاهدة الفيلم. يغوص الفيلم في الحال الفلسطينية، ويمارس أنواعاً مدهشة من الجرأة في قول كثير من المسكوت عنه، بأسلوب فني رائق، وبمحبة تليق بهذا الفتى المخرج ابن المخيم نفسه، والذي لا يخفي محبته للمخيم وناسه.
من ناحيتها، ترصد المخرجة باري القلقيلي فيلمها “السلحفاة التي فقدت درعها”، للتعرّف إلى والدها، هذا الفلسطيني الذي هاجر إلى ألمانيا، ولم يكفّ على رغم زواجه من امرأة ألمانية عن العودة بين الفينة والأخرى إلى فلسطين، مؤمناً بالكفاح والنضال، لينوس بين مكانين وزمنين، ولكن في سبيل انتماء واحد لفلسطين لا غير. هذه الفتاة المولودة لأبيها من أمّ ألمانية تعقد ببراعة جلسات طويلة مع والدها، متجاهلة أمها الألمانية إلى حدّ كبير، راغبة في فض سرّ هذا الانتماء الفلسطيني الذي لا يستكين.
وفي أول إطلاله له يتمكّن المخرج خالد جرّار من تقديم وثائقيه “المتسللون”. خالد جرار القادم من عالم الفن التشكيلي، والفيديو آرت، يرصد فيلمه لمتابعة المحاولات المستمرة التي يقوم بها الفلسطينيون للتسلل عبر الجدار العازل، سواء من أجل العلاج أو الصلاة في الأقصى، أو من أجل شؤون اجتماعية أو اقتصادية… متابعة عبر كاميرا حيوية، ومونتاج متدفق، ومادة غنية التقطها المخرج عبر سنوات من التصوير، والتواجد في عين الأمكنة التي يتسلل منها الفلسطينيون إلى وطنهم.
أفلام مهرجانات
أما طارق الشناوي فيكتب في “التحرير” عن العام السينمائي في مصر ودلالاته:
عشنا عاما من القحط السينمائى، لم تكن الحصيلة تليق بتاريخ السينما المصرية. البعض يقول هل هذه السينما التى ننتظرها بعد الثورة، وكأن الثورات فى العالم تمنع الفن الردىء، والحقيقة أن الفن سواء جاء بعد هزيمة أو انتصار لا يمكن أن يخلو من رداءة، 25 يناير لا تتحمل مسؤولية التردى الفنى.
أهم ما أنجزناه سينمائيا لم يكن فى الأفلام الـ27 التى عرضت هذا العام، ولكن الأفلام التى شاركت فى المهرجانات السينمائية، واستطاعت أن تحقق لمصر قيمة تليق بها. كانت هالة لطفى بفيلمها “الخروج للنهار”قد شاركت فى مهرجان أبو ظبى أكتوبر الماضى وحصدت جائزتين الفيبرسى للنقاد كأفضل فيلم عربى ومن لجنة التحكيم جائزة أفضل مخرجة عربية ثم برونزية قرطاج، بعد ذلك اقتنصت قبل ثلاثة أيام جائزة الوهر الذهبى من وهران السينمائى.
نادين خان قبل عشرة أيام حصلت بكل جدارة على جائزة لجنة التحكيم من أبو ظبى عن فيلم “هرج ومرج”، بينما شاركت ماجى مورجان بفيلم “عشم”فى مهرجان الدوحة، ولم تحصل على أى جائزة، ورغم ذلك فإنها قدمت قيمة إبداعية على الشريط السينمائى.
المخرج إبراهيم البطوط وعمرو واكد بطل فيلم “الشتا اللى فات”حققا جوائز من مهرجانى القاهرة ودبى. الأفلام الأربعة تنتمى إلى ما يعرف بالسينما المستقلة، ورغم أن التوصيف نفسه يحتاج إلى توصيف، ولكن هذه قصة أخرى.
كانت تلك هى أفلامنا فى المهرجانات، ولكن أفلامنا فى دور العرض تجد أفضلها “ساعة ونص”لوائل إحسان، أما على مستوى جودة الصنعة فإن الأفضل هو «المصلحة» لساندرا نشأت الذى جمع بين أحمد السقا وأحمد عز لأول مرة. ونتوقف أمام أحمد السقا مرة أخرى فى فيلم “بابا”لعلى إدريس، حيث رأينا الممثل السقا وهى حالة لم نألفها للسقا الذى لعب بطولة فيلمين. أحمد عز فعلها أيضا فى “حلم عزيز”لعمرو عرفة، فكرة مغايرة للسائد، كانت بحاجة إلى نفس أطول للتأمل والتفكير. تامر حسنى قدم الجزء الثالث من فيلمه “عمرو سلمى”، فكان فى أضعف حالاته، عاد محمد هنيدى فى “تيتة رهيبة”لسامح عبد العزيز بعد غياب عامين، ولكنه فى الحقيقة لم يعد إلى مكانته الرقمية التى تعود عليها.
إلا أن حالة هنيدى أفضل بكثير من فيفى عبده التى شاهدناها مجددا بعد عشر سنوات غياب بفيلم “مهمة فى فيلم قديم”، فكانت تبدو مثل عربة كارو شاركت فى سباق سيارات الدفع الرباعى. ياسمين عبد العزيز خيبت التوقعات فى “الآنسة مامى”، كانت الدراما تصطدم بجدار يحول دون تدفقها، كما أن ياسمين عندما لم تجد شيئا يضحك قررت الافتعال. “عبده موتة”هو المفاجأة الرقمية فى هذا العام. الفيلم صنعه أحمد السبكى على مقاس الجمهور، شخصية البلطجى أحدثت مع المشاهدين قدرا من التماهى، فتحققت إيرادات فاقت التوقعات، صَدق الكثير من الشباب شخصية عبده موتة، ودخلوا إلى دار العرض وهم يحملون السنج والمطاوى.