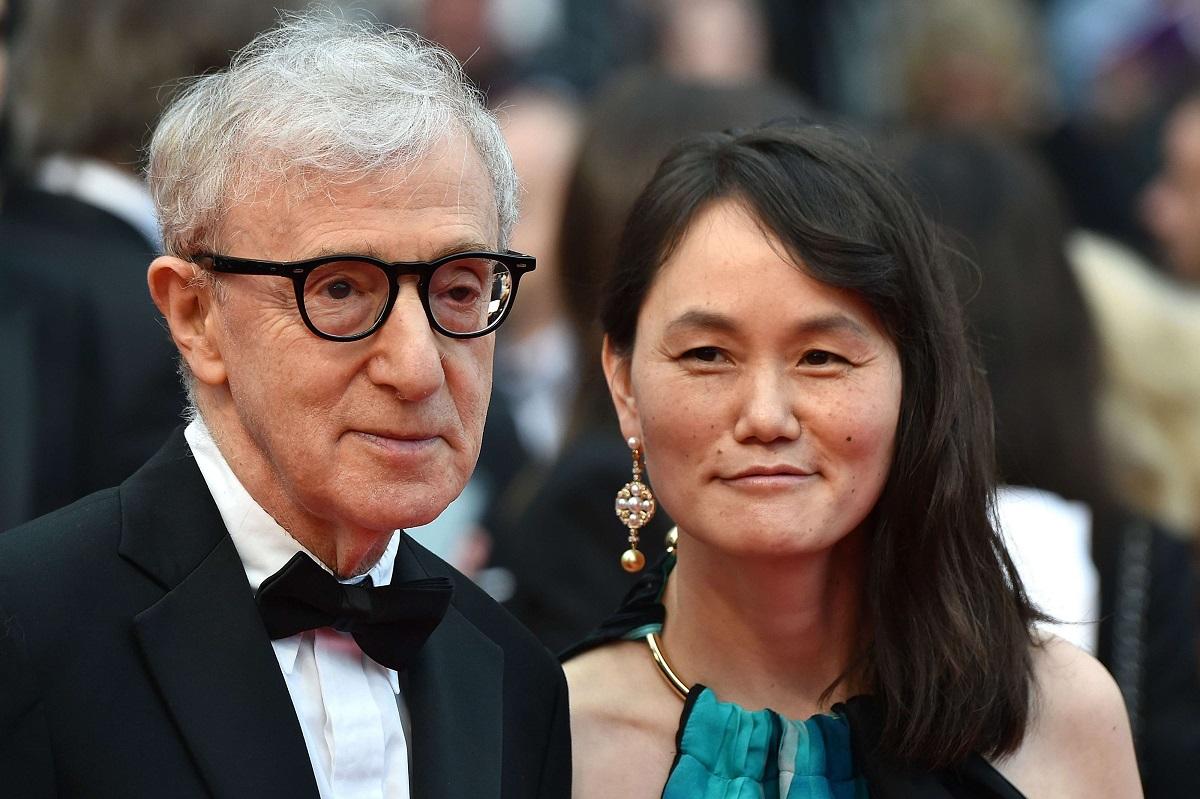“سائق التاكسي” بطل سكورسيزي المأزوم والمهزوم

أمير العمري
(من الفصل الثالث في كتاب “مارتن سكورسيزي: سينما البطل المأزوم”)
حصل سكورسيزي على سيناريو “سائق التاكسي” من صديقه المخرج بريان دو بالما، الذي كان قد حصل عليه بدوره، من كاتبه “بول شريدر” وكان وقت كتابته، في السادسة والعشرين من عمره. ويروي شريدر لناقد صحيفة “الجارديان” البريطانية، جيوفري ماكناب، بعد مرور ثلاثين عاما على ظهور الفيلم، أنه كان في ذلك الوقت، يمر بأزمة حياتية قاسية بعد أن انفصل عن زوجته، ثم عن عشيقته التي ترك زوجته من أجلها، كما فقد وظيفته في معهد الفيلم الأمريكي، وظل لأسابيع يبيت في سيارته، وتراكمت عليه الديون، فأفرط في الشراب وفي مشاهدة الأفلام الجنسية، ثم أصيب بقرحة في المعدة. وفي المستشفى اكتشف أنه لم يتحدث إلى أي إنسان منذ عدة أسابيع. وعندما بدأ كتابة “سائق التاكسي” كان في الحقيقة يكتب عن نفسه، عن رجل وحيد يجوب الشوارع في سيارته، غالبا وهو يشعر بالقرف من العالم كله، كنوع من “العلاج الذاتي” بغرض “طرد الأرواح الشريرة” التي تلبسته. 1

مرة أخرى، يعود سكورسيزي إلى اهتمامه الكبير بالشخصية في إطار المكان، مع الموسيقى التي تعمق من إحساسنا بالشخصية، أي بالبطل المأزوم الذي يندفع تدريجيا بتأثير عوامل عدة، نحو الجنون، مع سيطرة فكرة التطهير عن طريق القتل. أما البطل المأزوم فهو “ترافيس بيكل” (روبرت دي نيرو) وهو شاب في السادسة والعشرين من عمره، يلتحق بالعمل كسائق تاكسي. والمكان ليس “إيطاليا الصغيرة”، بل نيويورك الكبيرة. وترافيس لا يستطيع النوم ليلا، لذا فهو يختار العمل طوال الليل، لا يمانع من الانتقال إلى أي بقعة في المدينة التي تتخذ في الليل شكلا مغايرا للبراءة الظاهرية التي تبدو عليها في النهار. فهو يمر أثناء قيادة سيارته، على كثير من العاهرات والقوادين والصعاليك ومروجي المخدرات والسكارى واللصوص والشواذ جنسيا. ورغم خطورة هذه الأجواء إلا أنه لا يجد مفرا من التعامل مع كل هذه الأصناف البشرية، لكن شعوره بالقرف والرفض يتصاعد. إنه- كما يقول- يشم الروائح القذرة من حوله، روائح التدني والسقوط، يريد أن يرى كل هذه الكائنات وقد جرفتها مواسير المجاري.
نحن في نيويورك منتصف السبعينيات: هنا تتردد أصداء فيتنام وفضيحة وترجيت والكساد الاقتصادي الذي أدى إلى ارتفاع البطالة، وتقليص قوة الشرطة وارتفاع نسبة الجرائم في المدينة. كانت هناك أيضا أصداء محاولة اغتيال الرئيس جيرالد فورد في كاليفورنيا. أما “ترافيس بيكل” فهو جندي المارينز السابق الذي خدم في فيتنام، وعاد يعاني من اضطرابات نفسية تدفعه لتعاطي المهدئات، وتحرمه من النوم ليلا. وهو يتناول الأطعمة السريعة، ويتردد على دور السينما التي تعرض أفلاما إباحية. يركب معه ذات يوم، رجل ملتح (يقوم بالدور سكورسيزي نفسه) يجعله يتوقف أمام عمارة سكنية. يطلب منه التطلع إلى نافذة مضاءة في الطابق الثاني. هناك امرأة. إنها زوجته. لكن الشقة ليست شقته، بل شقة “زنجي”- كما يقول. زوجته تخونه وهو يريد أن يقتلها بمسدس ضخم من عيار 48. المشهد قد يكون الوحيد في الفيلم الذي يعكس حالة الهلع الشخصي بأسلوب كوميدي يتضح من المبالغة في الأداء والحوار السريع الذي يعكس الهستيريا التي تسيطر على الرجل، فهو يطالب ترافيس بعدم الرد على أسئلته، وأن ينصت له فقط. وترافيس يتطلع إليه في المرآة وهو صامت لا يجيب ولا يدري ماذا يفعل.. ماذا سيحدث بعد ذلك؟ لا يهم، فالمهم أن هذه الحادثة ستضاعف من شعور ترافيس بيكل بالغثيان، كما ستزوده بمعلومة مهمة حول المسدس عيار 48.
“الغثيان” هي أكثر كلمة يمكن أن تنطبق على فيلمنا هذا. ولا شك أن بول شريدر قد استمد فكرة البطل المضطرب الذي يشعر بالغثيان، من رواية سارتر الشهيرة بالإسم نفسه، بل إن بطل “سائق التاكسي” مثل بطل “غثيان” سارتر، يسجل يومياته في دفتر خاص، ويصف ما يمر به في يومه، ونحن نتعرف من البداية على قصته من خلال ما يسجله في يومياته. هذه الفوضى البصرية الإنسانية المخيفة يجسدها سكورسيزي بالصورة والصوت والأضواء والحركة، بحيث يجعلنا نشعر حتى بروائح الأماكن التي يمر عليها بطله المأزوم في المدينة التي تشبه الجحيم، في دورانه المستمر بسيارة التاكسي في شوارع المدينة المضاءة بأضواء النيون الملونة المصطنعة الكاذبة.

وسط هذه الصورة “الجحيمية”، يشاهد ترافيس ذات يوم، فتاة الأحلام المستحيلة.. فتاة رائعة الجمال ترتدي الملابس البيضاء، تبدو وسط كومة “النفايات” البشرية- كما لو كانت قادمة من السماء. يراقبها فيجد أنها تعمل في وكالة مكلفة بالحملة الدعائية للمرشح الرئاسي “بالانتين”. يتجرأ بعد ذلك مدفوعا بهاجس قوي في داخله، ويقترب منها ويطلب أن تخرج معه لتناول القهوة. ومع إلحاحه الشديد، توافق الفتاة التي سيعرف أن اسمها هو “بيتسي” (سيبيل شيبرد) ولكن كل حديثه معها سيتركز على نفوره من زميلها في العمل (ألبرت بروكس)، فهو يشعر بالغيرة الشديدة منه. ترافيس بيكل، الشاب الوحيد الحزين الذي لا يجد أحدا يتحدث معه، بل فقد القدرة على التواصل مع زملائه من السائقين الذي يلتقي بهم في المقهى الذين يقضون فيه فترة الراحة، يقابل فتاة هي أقرب إلى الحلم منها إلى الحقيقة. وعندما تخرج معه في يوم آخر، لا يعرف سوى أن يصحبها إلى دار السينما التي تعرض الأفلام الإباحية التي أدمن عليها، إما لأنه لا يعرف غيرها، كما يقول، أو لأنه مضطرب عقليا ونفسيا ومحروما ويريد الانفراد بها في الظلام. وتكون النتيجة أن تفر الفتاة هاربة من قاعة السينما، ثم ترفض الرد على اتصالاته التليفونية أو قبول ما يبعث به إليها من باقات الورود.
لا يقبل ترافيس بالهزيمة، بل يندفع داخل الوكالة التي تعمل فيها “بيتسي” لكي يعنفها ويدينها ويصفها بأنها “مثل الآخرين”. هذا الموقف سيفجر كل ما في داخله من غضب تجاه المدينة والناس ونفسه والعالم. يشتري أولا مجموعة من الأسلحة والمسدسات. يهجر الطعام الرديء السريع، يتدرب تدريبات عنيفة لتقوية عضلات جسده، ثم يتدرب على التصويب وإطلاق الرصاص، يرتدي سترة عسكرية، ويذهب لكي يدرس موقع الخطاب المرتقب للمرشح الرئاسي الذي تعمل لحسابه “بيتسي”، لكنه يثير شكوك رجال الأمن المكلفين بتأمين المكان.
ستتاح له الفرصة لاختبار دقته في التصويب عندما يطلق النار دون تردد فيقتل لصا (أسود) سطا أمامه على دكان البقالة أثناء وجوده هناك. وسيلتقي في طريقه، أكثر من مرة، بعاهرة صغيرة في الثانية عشرة من عمرها تدعى “أيريس” (جودي فوستر)، تلفت نظره، كثيرا، فهي تعمل تحت وطأة قواد فظ يدعى “سبورت” (هارفي كايتل). يحاول ترافيس أن يقنعها بالتخلي عن هذه المهنة القذرة والعودة إلى بلدتها واستئناف تعليمها، لكنها تسخر منه. وبعدما يفشل في اغتيال المرشح الرئاسي بالانتين، يقرر القيام بعملية انتحارية، فيرسل كل ما معه من مال الى “أيريس”، ثم يقتحم الفندق الصغير الذي تعمل فيه ويطلق الرصاص فيصيب أولا سبورت، ثم يقتل الرجل الذي يقبض المال في الداخل، ثم الزبون الموجود معها قبل أن يقضي على سبورت نفسه برصاصة في رأسه، ولكن ترافيس يصاب في رقبته، وتكون رصاصاته قد نفذت. وعند وصول رجال الشرطة، يتطلع إليهم ويمثل بإصبعه أنه يطلق النار على رأسه لينتحر، ويتدلى رأسه فوق كتفه، ويبدو لنا أنه قد غادر الحياة متأثرا بجروحه.

هذه النهاية من أكثر نهايات الأفلام إثارة للجدل. لكننا سنأتي إليها بعد قليل، بعد أن نحاول أولا، تفكيك مفاصل هذا الفيلم المثير الذي يبدو بطله من البداية، متجها بإصرار، نحو مصيره المحتوم. هناك دون شك، نفسٌ وجودي في هذا الفيلم، فبطله يشعر بأن الجميع من حوله فاقدون للقيمة والمعنى والهدف، وأن ما جعلهم كذلك هو أولا المدينة بشرورها المتعددة”، ثم السياسيون الذين يسرفون في الوعود الكاذبة، وقبل كل شئ، فقدان الحب. إن “ترافيس” في شعوره القاسي بالوحدة، هو إنسان حزين، لكن حزنه يدفعه إلى الغضب، ومن الغضب إلى العنف، إلى تصفية الحساب مع أشرار المدينة. وبعد فشله في الخروج من عزلته وتعجله الوصول إلى “الحب” مع “بيتسي” التي تنجذب إليه في البداية لكونه “يختلف عن كل من عرفتهم”- كما تقول له، سرعان ما تكتشف أنه يجهل قواعد السلوك الاجتماعي المهذب، ربما لأنه يريد اختصار الطريق والوصول إلى هدفه سريعا بعد أن أدمن مشاهدة الأفلام الجنسية.
إن أول لقطة تظهر في الفيلم (قبل العناوين) هي لقطة أبخرة أو دخان كثيف يتصاعد من جوف المدينة، مع دقات وموسيقى نحاسية منذرة. وهي صورة “سيريالية” تكثف فكرة “الجحيم”. أما أول لقطة تظهر (بعد العناوين) فهي لقطة كبيرة جدا big close up لجزء من وجه ترافيس بيكل”، تحديدا لعينيه الحزينتين الدامعتين اللتين تتحركان في بطء من اليمين إلى اليسار. فنحن سنرى الأمور من منظوره الخاص دائما. وعندما يجلس ليدون يومياته يبدأ بتوجيه الشكر لله على هطول المطر، لأنه “يغسل القمامة الموجودة على الأرصفة”. تتحرك الكاميرا في بطء داخل غرفته الحقيرة المليئة بالصحف المبعثرة في كل مكان. وفيما بعد نراه وهو يقود سيارة التاكسي، حيث يركز سكورسيزي أكثر، على شوارع نيويورك في الليل، أضواء النيون الملونة تلمع في كل مكان والناس يتحركون، وفتيات ذوات سيقان عارية، بينما ترافيس يصف لنا مشاعره: كل الحيوانات تخرج في الليل: عاهرات، صعاليك، شواذ، مدمنون، مرضى وفاسدون. ذات يوم سيأتي المطر ليجرف كل هذه القاذورات بعيدا ويغسل الشوارع”.
من أكثر عناصر التميز في الفيلم، لمسات الإضاءة والتصوير الليلي في الشوارع بفضل براعة وفهم مدير التصوير الكبير مايكل شابمان (1935- 2020) الذي يجعل الصورة ضبابية، غائمة، ويعرف كيف يستفيد من الحركة المستمرة لسيارة التاكسي، ليعكس ذلك الشعور بالدوار الذي ينتاب البطل المأزوم. كما تعكس برودة الصورة وظلالها القاتمة قسوة المدينة. وتبدو أضواء النيون وكأنها تهزأ من البطل الوحيد وتسخر من وحدته. وتساهم موسيقى برنارد هيرمان، الذي توفي بعد أن انتهى من كتابة موسيقى الفيلم عام 1975، في تعميق الشخصية: دقات الطبول المتدفقة السريعة تجسد القلق والتوتر وتصاعد الجنون، ونغمات الساكسفون وموسيقى الجاز الحزينة تكثف حزن ووحدة وفراغ الروح عند البطل “المأزوم” الذي يعترف لنا عبر شريط الصوت بأنه يعاني من الوحدة: “كانت الوحدة تطاردني طوال حياتي، في كل مكان.. في الحانات، في السيارات، فوق الأرصفة، في المتاجر، في كل مكان. ليس لي من مهرب. أنا رجل الله الوحيد”.
هذا المونولوج الذي يصف فيه شعوره بالمكان والبشر من حوله، يلخص حالة “الغثيان” الوجودية التي يشعر بها. إنه يبدو لنا في البداية، وكأنه غير قادر على التكيف مع”مظاهر التدهور” في المدينة، وهو قد عاد منذ فترة، من فيتنام إلى مدينة أمريكية أخرى في وسط الغرب الأمريكي قبل أن يأتي إلى نيويورك. إنه أقرب إلى بطل فيلم “راعي بقر منتصف الليل” المأزوم (إخراج جون شليزنجر-1970)، فهو مثله، يرفض المدينة الشريرة التي لم يقدم لها السياسيون شيئا، إلا أنه يعاني من الاضطراب الناتج عن الصدمة (من تجربة فيتنام). وهو في الوقت نفسه، يحاول العثور على فتاة أحلامه، النقية البيضاء، التي يمكنه أن يبوح لها بأسراره، لكنها تنفر من سلوكه الغريب، وتتخلى عنه. وهذا “الفقدان”، فقدان الحلم، سيدفعه إلى العنف وإلى الإصرار على تصفية الحساب مع المدينة. وهو يختار ما يعتقد أنه أصل هذه الشرور: القوادين والحثالة الأخلاقية، الذين يفسدون البراءة. وهو ما يؤدي به إلى ارتكاب تلك المذبحة التي يقضي خلالها على مجموعة الأشرار وينقذ الطفلة التي سقطت في شباك الدعارة. ولكن هل يتعاطف سكورسيزي مع بطله في لجوئه إلى هذا الحل؟ هل يعني العنف وإراقة الدماء في النهاية، نوعا من “التطهير”؟ هل العنف الفردي الدموي المدفوع بالغضب والجنون، يمكن أن يغسل قذارة المدينة؟ هذا السؤال يظل مفتوحا بالطبع.

المشكلة الأخرى التي تزيد من اغتراب الفيلم عن الواقع، هي نهاية الفيلم. فبعد أن نعتقد أن “ترافيس بيكل” قد لقي مصرعه، بدليل أن اللقطة الأخيرة من المشهد هي لرأسه وهو يسقط على كتفه، بينما تبقى عيناه مفتوحتين جامدتين، يأتينا مشهد جديد يشي بأن ترافيس قد أصبح بطلا، وقد تعافى وغادر المستشفى (ونما شعره بعد أن كان قد حلقه على طريقة الموهيكان)، أشادت به الصحف كما نعرف من القصاصات المعلقة على جدار حجرته، كما تلقى رسالة من والد “أيريس” يشكره على ما بذله من جهد لتحرير ابنته، ويخبره أنها عادت إلى كنف الأسرة، واستأنفت دراستها. ثم نرى ترافيس يقود التاكسي في شوارع نيويورك وهو يبدو أكثر هدوءا. تشير إليه “بيتسي” توقفه وتركب معه، وتهنئه على بطولته. وعندما ينزلها قرب منزلها، تحاول أن تدفع له أجره، لكنه ينطلق في طريقه.
هل هذه نهاية منطقية للأحداث الدامية؟ أم أنها نهاية “متخيلة”، أي متداعية من خيال “ترافيس” وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة؟ بول شريدر كاتب السيناريو، يصر على أنه لم يقصد أن تكون هذه النهاية، متخيلة، بل يؤكد أنه أرادها واقعية تماما، وهو ما يوقع الفيلم في شراك تبرير الحل “الفاشي” الفردي العنيف لغسل أدران المدينة الشريرة. فهل كان سكورسيزي يروج لمثل هذا الحل؟ لم يكن هذا ممكنا بالطبع، بل إن سكورسيزي اختار أن يجعل المشهد النهائي بين دي نيرو وشيبرد، أقرب إلى الحلم منه إلى الواقع، من خلال أسلوب التصوير الناعم، والألوان الهادئة التي تتناقض مع صورة نيويورك السابقة في متن الفيلم نفسه.
لا شك أن سكورسيزي ودي نيرو وشريدر، كانوا جميعا يشعرون بالغضب الشديد على الواقع في تلك الفترة من منتصف السبعينيات، ربما كانوا يرغبون أيضا في تدمير العالم. لذلك كانوا راضين تماما عن مشهد “المذبحة” التي تسيل فيها الدماء داخل فندق الدعارة. ولكن سكورسيزي وجد نفسه- كما يقول أندرو ج. روش، واقعا تحت ضغط شديد من شركة كولومبيا صاحبة حقوق التوزيع، فقد كانت تخشى أن يحصل الفيلم من مكتب تصنيف الأفلام على علامة (إكس X) التي تمنح للأفلام الجنسية عادة، وقد طالبه مديرها، بضرورة تخفيف هذا المشهد من بعض لقطات العنف وإلا ستقوم الشركة نفسها بقطع مثل هذه اللقطات من المشهد، وقد ثار سكورسيزي وهدد بإطلاق الرصاص على مدير الشركة، لكنه لم يفعل بطبيعة الحال. وكان الحل الوسط الذي تم التوصل إليه، أن يصبغ سكورسيزي المشهد بلون الدم الأحمر القاني المبالغ فيه لكي يجعله يبدو غير واقعي. 2
رغم ذلك، تعرض الفيلم لانتقادات كثيرة، حتى من جانب النقاد الذين أعجبهم الفيلم، بسبب الإفراط في العنف في هذا المشهد تحديدا. فالناقدة بولين كيل التي أشادت بالفيلم وقالت إن سكورسيزي يقدم فيه صورة تعبيرية لنيويورك، حذرت- رغم ذلك- في مقالها الطويل قائلة: “نورمان ميلر أشار إلى أنه عندما ينتقم قاتل من المؤسسات التي يشعر بأنها تضطهده، فإن اندلاع العنف قد يكون له تأثير إيجابي عليه. والجانب الأكثر إثارة للصدمة في فيلم “سائق التاكسي” هو أنه يتناول هذا العنصر بالذات، الذي تم استغلاله بشكل عام في جذب الجمهور، ويضعه في بؤرة وعي المشاهد، فالعنف هو الوسيلة الوحيدة عند ترافيس للتعبير عن نفسه. إنه لم يستطع هدم الحواجز التي تحول بينه وبين أن يصبح مرئيا يمكن أن يشعر به الآخرون. فقط عندما يندفع، تكون هذه هي طريقته الوحيدة لكي يخبر المدينة بأنه موجود. ونظرا إلى وحدته وزهده، فهذه هي النشوة الحقيقية الوحيدة التي يمكنه الحصول عليها”. 3
أما الناقد روجر إيبرت فاعتبر أن الفيلم “كابوس رائع. ومثل كل الكوابيس فإنه لا يخبرنا بنصف ما نريد أن نعرفه. فلم يتم إخبارنا من أين أتى ترافيس، وما هي مشاكله بشكل محدد، وما إذا كانت ندبته القبيحة حدثت في فيتنام – لأننا لسنا أمام دراسة حالة، ولكن فقط “بورتريه” لبعض الأيام من حياته. هناك لحظة في مشهد الحشد السياسي حيث يبتسم ترافيس وهو يرتدي نظارات داكنة، بطريقة تذكرنا بصورة (آرثر بريمر) قبل أن يطلق النار على (جورج) والاس- (يقصد محاولة الاغتيال التي وقعت عام 1972 في ولاية ميريلاند). هذه اللقطة لا تخبرنا بشيء، ولكنها تقول لنا كل شيء: إننا لا نعرف تفاصيل مشكلة ترافيس، لكن بطريقة تقشعر لها الأبدان، نعرف ما نحتاج إلى معرفته عنه”. 4
سيعود الجدل بشأن العنف في الفيلم وما يمكن أن يولده في الواقع، ليشتعل مجددا في 30 مارس عام 1981، عندما يقوم شخص يدعى وارنوك هينكلي بإطلاق الرصاص في محاولة لاغتيال الرئيس رونالد ريجان، ويلقى القبض عليه فيعترف بأن الفكرة جاءته بعد أن شاهد “سائق التاكسي” 15 مرة، وأنه أراد أن يلفت نظر جودي فوستر التي فتن بها بعد مشاهدة الفيلم. وسيعود بول شريدر ليعترف لصحفي الجارديان البريطانية “جيوفري ماكناب” بعد مرور 30 سنة، بأن ضباط المباحث الفيدرالية حققوا معه بعد هذا الحادث، وسألوه إن كان “هينكلي” قد اتصل به، وأنه كذب عليهم وقال إن هذا لم يحدث، في حين أنه في الحقيقة كان قد تلقى خطابا من هينكلي يطلب منه مقابلة جودي فوستر، إلا انه تخلص من هذا الخطاب. وأوضح شريدر أنه لو كان قد أطلعهم على الحقيقة، لفتح أبواب الجحيم على نفسه وعلى سكورسيزي ودي نيرو أيضا. 5

أعتقد أن الأمر الجدير بالتوقف أمامه حقا، ليس العنف في حد ذاته، الذي يمثل بالقطع، نوعا من “التطهير” بالنسبة للشخصية الرئيسية المأزومة، بل ويتناسب مع قناعة ترافيس بيكل الدينية، بأنه موكل من الله، لتطهير المدينة من الشر (أنا رجل الله الوحيد)، وبأنه بتخليصه الفتاة الصغيرة، أو الطفلة- العاهرة، سيعيد إليها براءتها، فالتساؤل الأهم يتعلق بالسبب (أو الأسباب) التي، دفعت ترافيس بيكل لأن يصبح على ما أصبح عليه، أي سبب أزمته، عاهته، جنونه، انفلاته، وحدته القاتلة، وإيمانه الفردي بأنه موفد العناية الإلهية لتطهير المدينة. هل هي حرب فيتنام؟ أم كراهيته للمدينة؟ ولكن إذا كانت حرب فيتنام قد جعلته مختلا وهو احتمال كبير بالطبع، فلماذا لم يقتل “بيتسي” مثلا، التي رفضته وازدرته وقاطعته بعد أن وصفته بالعبارة الملتبسة، أي أنه “كتلة تناقضات تسير على قدمين”؟
هذا السؤال لا يشغل بال سكورسيزي، فهو يقصد إحاطة الشخصية بمثل هذا الغموض، إما لأنه “لا يعرف”، أو لأنه “لا يهتم بالأمر”، أي لا يهمه تقديم أي تفسير، تماما كما لا يهتم بتفسير النهاية التي أدت إلى كثير من الجدل والانقسام حولها سواء من جانب الجمهور أو النقاد. وهذا “الغموض” سر من أسرار سكورسيزي في أفلامه، ولعله ما يمنحها أيضا رونقها وسحرها.
ومع ذلك، يقدم أندرو ج. روش، تفسيرا مثيرا للاهتمام لأحد جوانب شخصية “ترافيس بيكل”، وهو جانب يتعلق أيضا بنظرته الدينية المسيحية: “يركز فيلم “سائق التاكسي، مثل كثير من أفلام سكورسيزي الأخرى، على عقدة “العذراء- العاهرة”، والحقيقة أنها أكثر وضوحا هنا، وتوجد في بؤرة موضوع الفيلم أكثر مما هي في أي فيلم آخر من أفلام سكورسيزي. فعندما يلتقي ترافيس مع بيتسي لأول مرة، فإنه يراها فتاة بريئة نقية، ولكن بعد ازدرائها له، تصبح نظرته مشوشة، ويبدأ في النظر إليها كشيء قذر يفتقر للنقاء. ولكنه يرى في “أيريس”، التي هي بالفعل عاهرة، شيئا غير نقي يمكنه أن ينقذه، وبالتالي يعيدها إلى العذرية”، كما فعل المسيح مع مريم المجدلية. 6
كان يمكن أيضا توجيه الاتهام للفيلم بتمجيد العنف، أو بالموافقة الضمنية على سلوكيات ترافيس بيكل “العنصري” الذي يعرب أكثر من مرة عن كراهيته للسود والمثليين، ولا يتردد في تصويب مسدسه وقتل اللص الأسود المسكين في برود تام، خصوصا أن الفيلم يجعل من ترافيس بطلا في النهاية في أنظار الرأي العام. غير أن الحقيقة أن النهاية الرمزية التي تشبه الحلم أو المتخيل الساخر، هي نهاية هجائية، تسخر من الصحافة الأمريكية السائدة، فالصحافة تخلع البطولة على قاتل عنصري فاشي. وأما زملاء ترافيس من السائقين الذين يهنئونه كما تفعل بيتسي، فإنهم يتبنون فكرة “البطل”، فهم جميعا يمثلون الرأي العام الذي تقوده وتغسل أدمغته، الصحافة الاستهلاكية.
يصف سكورسيزي بطله بأنه “يؤمن بأن مسلكه صحيح، تماما مثل سانت بول، فهو ينشد تنقية العقل، وتطهير الروح. إنه روحاني للغاية، ولكن على غرار روحانية تشارلز مانسون (زعيم عصابة الهيبز التي ذبحت الممثلة شارون تيت ومثلت بجثتها)، وهو ما لا يعني أنه أمر جيد. إنها قوة الروح ولكن في المسار الخطأ”. 7
إلا أن الباحثة أنيت ويرنبالد ترى أن نهاية الفيلم تشبه كثيرا نهاية فيلم “سايكو” Psycho وأن المؤلف الموسيقي برنارد هيرمان، الذي كتب موسيقى “سايكو” وهو نفسه الذي كتب موسيقى “سائق التاكسي”، يختتم الفيلم بالجمل الموسيقية الثلاث نفسها التي اختتم بها “سايكو”، وتخلص بالتالي، إلى أن “ترافيس” ينتهي مثلما انتهى “نورمان بيتس” في فيلم هيتشكوك، أي إلى التوحد، رغما عنه، مع صورته في المرآة، بنفس الابتسامة المرسومة على وجهه وهو يقود التاكسي مجددا في شوارع نيويورك، والتي تشي بأنه بلغ مرحلة الجنون التام، وأنه يمكن أن يعود لينفجر مجددا في ثورة غضب وعنف وقتل. 8

اعتمد سكورسيزي كعادته، على كثير من الارتجال الذي أنتج بعض أفضل وأشهر المشاهد في الفيلم، منها مشهد الحوار بين دي نيرو وسيبيل شيبرد في المقهى، فقد أخذ دي نيرو المبادرة، واستجابت شيبرد، وجاء الحوار والمشهد كله ربما، الأكثر تعبيرا عن شخصية ترافيس بيكل في الفيلم كله. وأما المشهد الثاني، فهو مشهد تدرب ترافيس أمام المرآة في حجرته، على استخدام المسدس. وقد ترك سكورسيزي لبطله دي نيرو، حرية ارتجال ما يمكن أن يقوله، فلابد أن يقول شيئا وهو يخرج المسدس بسرعة من حزامه، فكانت العبارة الشهيرة التي ارتبطت بالفيلم في أذهان الجمهور في العالم، وأصبحت أيقونة لدى جمهور السينما وهي “هل تتحدث معي؟”. وأما طريقة سكورسيزي في الارتجال فهي أن يترك المجال للممثل أو للممثلين، وهو ما حدث أيضا في المشهد الذين يدور بين دي نيرو وهارفي كايتل أمام فندق الدعارة حيث كان كايتل يتحرك في موقعه حركة مستمرة وكأنه يرقص في مكانه، بينما كان ترافيس جامدا يتحدث إليه في شكل أقرب للذهول وكأنه لا يصدق أنه أمام شخصية حقيقية. ثم كان سكورسيزي يعود بمساعدة الممثل/ الممثلين، لكتابة الحوار المرتجل، ثم يقوم بتصوير المشهد حسب الإضافات الجديدة.
رغم كل ما أخرجه سكورسيزي من أفلام، سيظل “سائق التاكسي” أكثر أفلامه جرأة وإثارة للجدل، ورغم كل ما فجره من خلافات بلغت أحيانا حد الاتهامات بالتسبب حتى في وقوع جرائم قتل (خصوصا بعد إطلاق النار على الرئيس ريجان)، ورغم أن السيناريو انطلق أساسا مما كان يشعر به مؤلفه بول شريدر عام 1972 وهو يمر بأسوأ فترة في حياته بلغت به حد أنه فكر في الانتحار، إلا أنه جاء أيضا الأكثر تعبيرا عما كان يجول في خاطر سكورسيزي في تلك الفترة من منتصف السبعينيات. هل كان يعتزم حقا قتل مدير شركة كولومبيا الذي أراد أن يستبعد بنفسه لقطات العنف والدماء من مشهد المذبحة الدموية؟!
سكورسيزي يقول إنه لم يكن يريد أصلا تمثيل دور الرجل الذي يتعقب زوجته التي تخونه ويقول لسائق التاكسي أنه يريد أن يقتلها بمسدس اشتراه لهذا الغرض. ولكن تأخر الممثل الذي كان يفترض أن يؤدي الدور لمدة يومين، دفعه إلى القيام بالدور بنفسه. ويضيف أنه بسبب الميزانية المحدودة للفيلم، فقد قام برسم جميع اللقطات لكي تبدو كالحلم. وبلغ الأمر أن كان يضع الممثل فوق “دوللي” (عربة متحركة تستخدم في التصوير) بحيث يمكننا أن نرى من فوق كتفيه وهو يتحرك صوب شخصية أخرى. وأن الفكرة كانت “المزج بين الرعب القوطي وأسلوب جريدة أخبار الصباح في نيويورك”- يقصد بين الخيالي والتسجيلي. 9
كان يمكن أن يجعل سكورسيزي بطله المأزوم، ينتحر فعلا في النهاية، فنحن نراه يلتقط مسدسا ويصوبه نحو رأسه ويحرك الزناد عدة مرات، لكنه يكتشف أن المسدس فارغ من الرصاصات، فهو لم يكن مسدسه بل مسدس “سبورت”، فيصوب إصبعه أمام الشرطيين اللذين وقفا يصوبان نحوه السلاح على باب الغرفة الضيقة داخل الماخور، ولكنه يبتسم ابتسامة تشي بجنونه وهو يمثل إطلاق النار على رأسه ثلاث مرات مع إصدار صوت مكتوم من فمه. لكن في هذه اللحظة، أي بعد أن تسقط رأس ترافيس بيكل على كتفه وكأنه مات، نرى اللقطة من زاوية عين الطائر (أو عين الرب) أي من زاوية رأسية، للغرفة وعلى أرضيتها ترافيس وإلى جواره القواد القتيل، وعلى الجهة الأخرى “أيريس” ترتعد وتبكي. وهي لقطة تشي بأن روح ترافيس تصعد إلى أعلى، وتحلق على المشهد. لكن الصورة القاتمة الحمراء المصبوغة بالدماء لا تبدو حقيقية، بل مراوغة، عن عمد، عن رغبة في إيهامنا بأن المهمة لم تنتهي بعد.
هوامش:
1 Geoffrey Macnab ‘I was in a bad place’, The Guardian, 6 July 2006.
2 Andrew J. Rausch: The Films of Martin Scorsese and Robert de Niro. The Scarecrow Press Inc. Leham, Toronto 2010.
3 Pauline Kael: Underground Man. The New yorker, 9 February 1976.
4 Roger Ebert: Chicago Sun-Times, 1 January 1976.
5 Geoffrey Macnab ‘I was in a bad place’, The Guardian, 6 July 2006.
6 Andrew J Rausch. المرجع السابق
7 Scorsese on Scorsese, page 62.
8 Annette Wernblad: The Passion of Martin Scorsese. مصدر سابق
9 Scorsese on Scorsese, page 54.