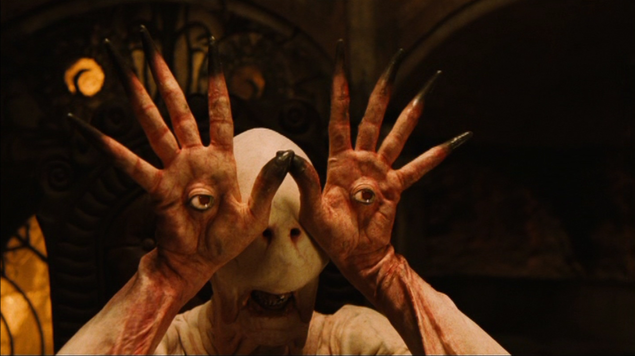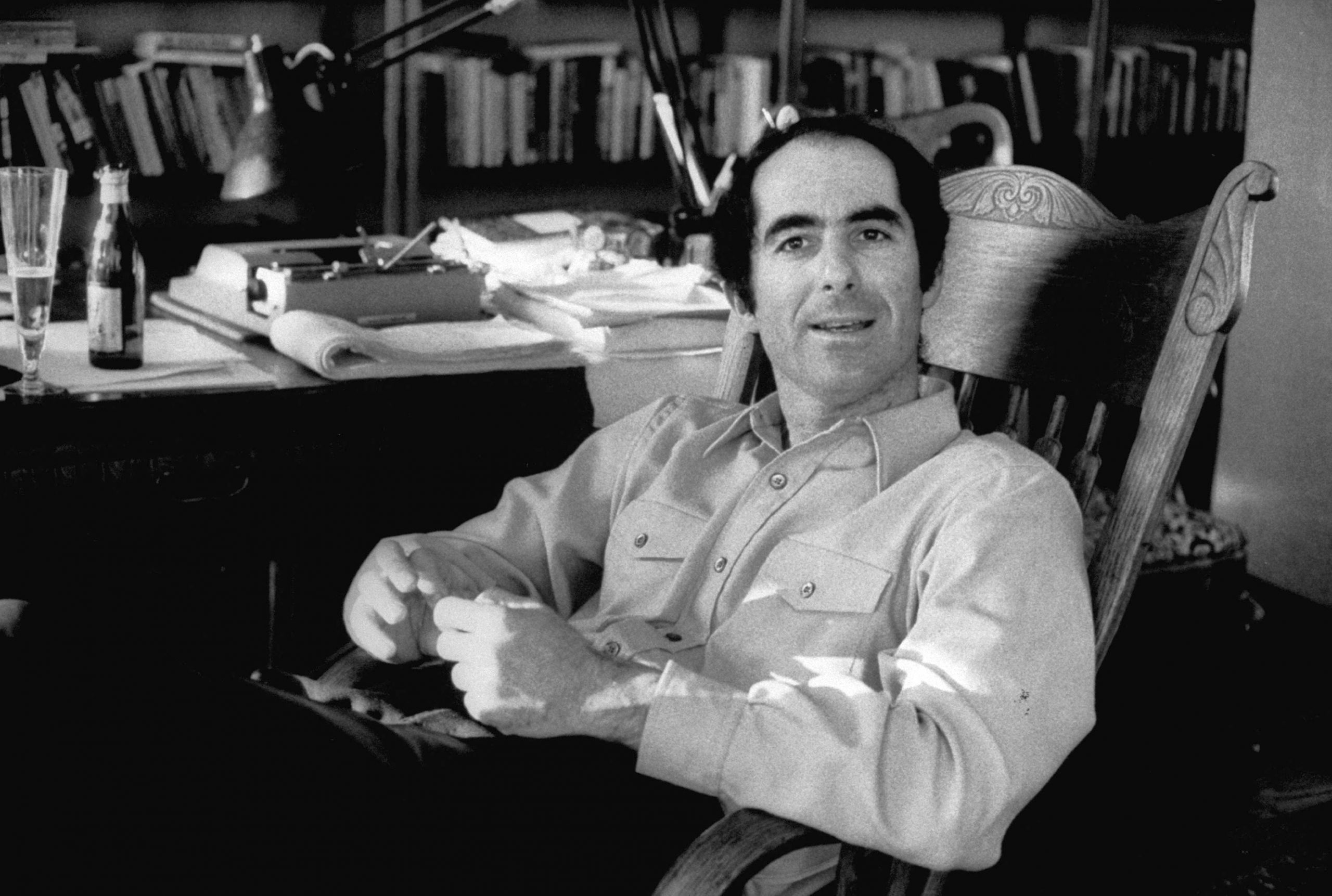حول مفهوم السينما النظيفة: سينما بدون قبلات!

في عام 1997، شهدت السينما المصرية نقيضين من نوعية الأفلام المعروضة؛ فيلم تايتانيك Titanicمن إخراج الأمريكي جيمس كاميرون، والذي تحول إلى ظاهرة نجاح في العالم كله، وليس فقط في موطنه الأمريكي، لعدة أسباب، أكثرها ملائمة لفكرة هذا المقال هي قصة الحب الملتهبة بين البطلة الجميلة والبطل شديد الوسامة، والتي أخذت منحنى حسي وجنسي ربما لم يسبقها له أحد الإنتاجات الكبرى لهوليوود من قبل، على الرغم من الإطار المحافظ نسبياً الذي غلف تناول الفيلم للعلاقة والذي فرضته قوانين السوق التجارية. في مشهد خلده الكثيرون، إما بالسخرية أو بالإعجاب، تطلب البطلة ابنة السابعة عشر من حبيبها أن يرسمها عارية، بينما ترتدي قلادة من الياقوت الأزرق.
ربما لا يعلم كاميرون، أن هذا المشهد كان بمثابة أولى مراحل الاكتشاف عند المراهقات المصريات في ذلك الوقت، لما تعنيه أجسادهن، وعلاقتهن بالنمو، وتفتحها للحب والمشاعر وأيضاً الشهوة.
من المعلوم طبعاً، أن الفتاة المصرية غير مسموح لها باكتشاف جسدها، أو حتى التجريب على سبيل الوصول لما تفضله وما تنفر منه في عالم الجنس والاشتهاء، وكان تايتانيك بمثابة البوابة التي عبرت منها مراهقات هذا الوقت نحو المرايا في بيوتهن، حيث تحاول كل واحدة منهن تأمل نفسها وجسدها، ومقارنته بجسد روز.
على صعيد آخر، شهدت السينما المصرية في نفس العام، العرض الأول لفيلم سيؤسس لموجة سينمائية جديدة تخترق عصب الفن المصري فتنخر فيه بالسوس. إنها السينما النظيفة، وهي –طبقاً للتعريف الدارج والذي دأب نجومها ونجماتها على ترديده في جميع المقابلات واللقاءات والمانشيتات الصحفية- سينما تناسب جميع أفراد الأسرة، سينما خالية من القبلات ومشاهد التعري، سينما تحض على الفضيلة ومكارم الأخلاق، سينما بلا كوميديا أبيحة على غرار أفلام كيفن سميث وسيث روجان، سينما الإيفيه، والبطل الذكر، والبطلة الجميلة التي لا يغيب دورها عن أن تكون محبوبة أو مخطوفة أو مجروحة، وغالباً، الفتاة القبيحة التي يسخر منها البطل طوال الوقت، ويتحاشى الزواج منها رغم ملاحقتها له، وسينما صديق البطل الذي يقل عنه وسامة وأحياناً ذكاء والذي يرافق البطل فقط ليبدو البطل أكثر جمالاً ورجولة.
هذه السينما، لا يخشى فيها رب الأسرة الموظف البسيط من أن يأخذ بناته وزوجته لمشاهدة ما تنتجه. فمن واجبه –طبعاً- فرض رقابة على ما يشاهدن ويكتشفن، فمن منا لم يسمع جملة “أنا مارضاش مراتي أو بنتي تتفرج على ده” أو “افرض الفيلم فيه مشهد خارج ومراتي وبناتي قاعدين؟”

هذه السينما أيضاً سينما تجارية بحتة، لا مجال فيها للتجريب أو الفن، فهي صناعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وسجن وضع وراء قضبانه كثير من النجمات اللائي صعدن على قمة المجد بسببها، وأكثرن من تصريحات على غرار، “لا يمكن أن أمثل مشاهد تخدش حياء المشاهدين” أو “لا يمكن أن أرتدي مايوه أو ملابس تظهر مفاتني، حرصاً على مشاعر المشاهدين”.
هي السينما التي غازلت الطبقة الوسطى البرجوازية، بكل مظاهر تدينها الظاهري وغلوها في العبادات الدينية على حساب الأخلاقيات والروحانيات. هي السينما التي دفعت الأبطال دفعاً لتركيز كل طاقاتهم في حصاد الإيرادات، ونسيان أن ما صنع الجيل الذي يسبقهم وخلدهم في تاريخ وقلوب الجماهير -حتى أولئك الذين يكرهون العري والتعري- هي مسيرتهم الفنية وليس التجارية؛ فنجوم مثل محمود عبد العزيز ويحيى الفخراني وعادل إمام وأحمد زكي ونور الشريف ونجمات مثل يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي ونبيلة عبيد وشريهان، توجهوا بكل طاقاتهم للاستفادة من مخرجي الواقعية الجديدة التي بدأت مع مطلع الثمانينات أمثال خيري بشارة وعاطف الطيب ومحمد خان ورأفت الميهي وداوود عبد السيد، ومع هذا حافظوا على نجاحهم الجماهيري وظهورهم في أفلام تجارية قحة. لا أريد أن أنسى أحداً، لكنني كلما قارنت بين مسيرة نجمة مثل ليلى علوي الفنية، ونجمة واعدة كان من الممكن أن تتشكل وتتلون كيفما شاءت برحابة مثل منى زكي، أشعر بمزيج من الشفقة وأيضاً الدهشة؛ هل القبلات تجعل السينما حقاً متسخة؟
وماذا عن النكات العنصرية؟ السخرية من البشرة السمراء والتي حفل بها فيلم نظيف جداً مثل “صعيدي في الجامعة الأمريكية”؟ وماذا عن فيلم “إسماعيلية رايح جاي” ذاته والذي يتحرش فيه خالد النبوي بحنان ترك؟ مالذي يجعل مشهد التحرش أو محاولة الاغتصاب نظيفاً بينما القبلة فعل قذر؟
أبرز الأفلام
حسناً، فلنستعرض أبرز أفلام هذه السينما النظيفة ولنرى إذا كانت حقاً خالية من القذارة كما يزعم المدافعين عنها:
إسماعيلية رايح جاي: ماذا يمكن أن يقال عن هذا الفيلم سوى أنه فيلماً مسلياً؟ إنه أيضاً ناجح تجارياً لدرجة غير مسبوقة. حقق 15 مليون جنيه في وقت كانت السينما فيه في حالة من التردي تجارياً، وكمورد للدخل. وهو البذرة الأولى في نبتة موجة سينمائية جديدة، غيرت خارطة السينما المصرية فلم تعد كما كانت قبلها. حتى الآن مع موجة الانفتاح وظهور موجة جديدة وهي سينما البلطجي وأيضاً سينما المطرب الشعبي، وعودة بعض الأفلام ذات المستوى الفني العال، والتي أسس لها فيلم سهر الليالي عام 2003، مازالت للسينما النظيفة اليد العليا والكلمة المسموعة في سماء الفن المصري.
احتوى هذا الفيلم على بضعة مشاهد لا تجعله نظيفاً بأي شكل، يتصدرهما أخ البطل –بالطبع- الحقود المنحل الصايع باللغة الدارجة، في أحدهما، يحاول التحرش بحبيبة أخيه، وثانيهما، يتفحص ساقي امرأة جميلة أتت لتصلح سيارتها في ورشته. حتى الآن لم أفهم مالذي كان سيخدش حياء الأسرة المصرية المحافظة في قبلة بين البطلة –حنان ترك- والبطل –محمد فؤاد- بينما حياءها قد خدش بالفعل بمشهدي التحرش اللذين سبق ذكرهما؟
هل القبلة تخدش الحياء بينما التحرش والاغتصاب لا يخدشان؟ منطق غريب، سمعته من قبل بينما الممثلة صابرين تبرر لمذيعة ما أنها ترفض مشاهد الإغراء بعد ارتدائها الحجاب/الباروكة ولا ترفض مشاهد الاغتصاب! أي أن الممثلة ترفض أن تمثل مشهداً فيه امرأة ناضجة تقبل رجلاً بكامل إرادتها بينما تقبل أن يقبلها رجل عنوة بينما هي تقاومه وتدفعه وتحتمل إهاناته ومحاولاته في النيل منها غصباً عنها. هل هذه هي الرسالة التي يريد صناع السينما النظيفة أن يوصلوها لنا؟
المرأة مفعول به، قد تغتصب وتهان، لكنها أبداً لا تقبّل رجلاً بإرادتها. لو كان هذا صحيحاً فمنطق الطبقة الوسطى الملتوي عن الحلال والحرام، والمقبول والمكروه، في غاية الازدواجية والدونية.
لننتقل لفيلم آخر وهو فيلم مافيا: أحد أفلام الأكشن الذي ظهر أيضا عام 2002 ليكون أحد أهم إفرازات السينما النظيفة -فرع الأكشن وليس الكوميديا. في هذا الفيلم، ورغم نظرات البطلة الملتهبة للبطل، فإننا لا نراها تقبله ولا قبلة واحدة، بينما ينبري البطل في مشهد آخر بتقبيل عشيقته الأجنبية صوفيا، قبلات حارة بينما الكاميرا تقوم بالزووم إن على وجهيهما، لا ترى فيه الأسرة المصرية أي عري أو خدش للحياء، بل على العكس، يحطم الفيلم الإيرادات كالمعتاد وينال مباركة الأسرة المصرية الذرية nuclear familyالأصيلة بتحصيله إيرادات ما يقارب 13 مليون جنيه ونصف.

في مشهد حتمي، تقابل صوفيا الأجنبية المنحلة، مريم الطبيبة النفسية المصرية المحافظة، فتفتح صوفيا فمها لتخرج منه كل الكليشيهات والتنميطات عن الأجانب في ذهننا العربي. الأجنبية امرأة منحلة مستهترة، لا تحب بقوة وإنما تركض وراء المتعة والجنس فقط لا غير، تخبر الأجنبية المصرية بأنها لا تمانع مشاركتها في الحبيب، فقد سمعت أن في دين المصريين للرجل حق الزواج مرة واثنين وأربعة. هنا تنطلق مريم في خطبة عصماء دفاعاً عن مفهوم تعدد الزوجات في الدين الإسلامي وعن كرامتها أيضاً، فهي لا تقبل أن يشاركها أحد في حبيبها، بينما تبتسم لها صوفيا كالبلهاء!
إذا فالذكر المصري رابح من البداية للنهاية، عندما ينحرف ويخون بلده، تحبه الأجنبيات الفاتنات، وعندما ينصلح حاله، يجد ابنة بلده المحافظة ملك يمينه، وفي انتظاره عندما يصبح مواطناً صالحاً.
شورت وفانلة وكاب: الفيلم الذي وصفه مخرجه بأنه فيلم سياحي، صنع خصيصاً من أجل الدعاية لشرم الشيخ والغردقة، ولذا يمكن أن يغفر له المشاهد حبكته الضعيفة نوعاً والكليشيهات التي يزخر بها، لكن المشاهد وقتها لم يهتم سوى بقصة الحب الملتهبة بين الشخصية التي تلعبها اللبنانية نور والمصري أحمد السقا.
طبعاً لم تكن هناك سوى فتاة لبنانية ترضى أن ترتدي المايوه البيكيني وتظهر به في الفيلم، فنجماتنا المصريات رفعن شعار “لا لخدش الحياء” واكتفين بارتداء الفساتين والجينز، ربما على استحياء أيضاً. لكن ورغم جمال نور والمناظر الطبيعية الساحرة، وقصة الحب التي تؤجج المشاعر بين الصعلوك المصري والأميرة اللبنانية، ظلت الشاشة نظيفة من القبلات.
قبلات ممنوعة
أي قصة حب هذه التي تخلو من القبلات؟ هل ينسى أحد قبلة فاتن حمامة الحارة لعمر الشريف في فيلم “صراع في الوادي”؟ أم سعاد حسني بينما يقبلها شكري سرحان في “السفيرة عزيزة”. بل أن النجمات المحافظات أيام السينما الكلاسيكية المصرية أمثال ماجدة وسميرة أحمد وفاتن حمامة وزيزي البدراوي ونجاة، لهن قبلة مشتعلة في فيلم أو أكثر من اللاتي قمن فيهم بدور البطولة.
في حوار أجري معها مؤخراً، قالت الفنانة سلوى خطاب أن السينما المصرية “باظت من ساعة ما بطلوا البوس”. فتحت عليها أبواب جهنم، وانهالت عليها التعليقات ما بين ساخر ومستهزئ ومهاجم ومندد، بدا ربما أن سلوى تكلمت بأريحيتها المعتادة وخرج تعليقها عفوياً، وإن كان هجوم السوشيال ميديا وبرامج التوك شو عليه قد حملّه أكثر مما يجب. لا ننسى أيضاً أن المذيعة بدا عليها الارتباك التام وهي تفاجأ بتعليق سلوى خطاب، بل وانبرت تدعي أن فاتن حمامة أكثر من قدمت الرومانسية على الشاشة لم “تنشغل بمسألة البوس”، مما يضرب نظرية سلوى في مقتل، والتي استرسلت قائلة “أن المجتمع كله باظ لما السينما ما بقاش فيها بوس” لأن الناس كانت تتعلم الحب والرومانسية من الشاشة، والآن أصبحت الشاشة لا تنقل سوى البلطجة والرقص المبتذل والكوميديا الغارقة في مستنقع الإيفيه…
آه، والرومانسية؛ فقط بدون “بوس”.
هل يتخيل أحد كيف سيكون المشهد الذي ترتدي فيه صباح فستان الانتقام الأبيض وتغني لعبد الحليم “لأ” دون قبلة؟ وهل يمكن تخيل “خلي بالك من زوزو” دون قبلات سعاد حسني وحسين فهمي؟ ومالذي يمكن أن يكون خدش حياء المصريين في قبلات شادية وصلاح ذو الفقار على مدار تاريخهما الفني؟
في فيلمين نظيفين للغاية تفصل بينهما سنة إنتاجية -2004 و 2005-، الباشا تلميذ وزكي شان، يبدو واضحاً أن مشهد التحرش أو محاولة الاغتصاب قد باتت بديلاً للقبلة. يبدو أن صناع الفيلم باتوا في مأزق صعب بسبب خلو الفيلم من أي مشهد يحرك مشاعر المشاهدين، وربما هو تكرار لتيمة معينة وهي الصراع الكلاسيكي بين بطل الفيلم المغوار –أو أحياناً طيب القلب، الساذج- والوغد الوسيم/اللزج والبطلة الجميلة. المثلث الكلاسيكي للصراع الانساني، والذي يعود بنا للانسان الحجري القديم، المثلث الوحشي بين رجلين وامرأة في المنتصف، وعادة لا يكون المثلث أصيلاً متشابكاً كأفلام مثل Les Enfants du Paradis لمارسيل كارني- 1945، أو Sabrina لبيلي وايلدر- 1954، أو Jules et Jim لفرانسوا تروفو- 1962، فقط هناك فتاة وفتى يحبان بعضهما البعض، وهناك العزول، ممثلاً في زميل أو صديق للبطلة، وغريم لدود للبطل في نفس الوقت –محمد رجب في “الباشا تلميذ” وأمير كرارة في “زكي شان”- وهناك لحظة يشعر فيها الغريم أنه هزم، فبدلاً من الانسحاب بشياكة، يحاول اغتصاب البطلة، مستغلاً تواجدهما بمفردهما في منطقة نائية – البحر في الفيلم الأول، وشقة الغريم في الفيلم الثاني- وكعادة الأفلام المصرية تكون مقاومتها له سلبية بالصراخ والبكاء، ضاربة عرض الحائط بأبسط قواعد البناء الدرامي التي يجب محاكاة الحياة الحقيقية فيها، فلا تحاول حتى ضربه أو مقابلة عنفه بعنف مماثل.

مشهد الاغتصاب أو التحرش في أفلام السينما النظيفة هو امتداد لمسيرة تهميش المرأة في السينما المصرية، بل وتسليعها، فمشاهد التحرش في الفيلمين السابقين ليس لها أي مبرر درامي سوى إظهار رجولة وشهامة وأصالة البطل ودناءة وسفالة الغريم. ماذا عن شخصية البطلة؟ مالذي قد يحدثه فيها أمر جلل كهذا؟ أي صراع درامي قد يتولد من محاولة رجل كانت تعتبره قريباً أو حبيباً أو زميلاً أن يفرض نفسه عليها جنسياً؟ لا شيء!
في الكتابة الأمريكية؛ توصف هذه المشاهد للاغتصاب والتحرش غير المبرر بال gratuitous rape. هناك الكثير من الأمثلة في السينما المصرية لمشاهد الاغتصاب المبرر والذي عليه يقوم البناء الدرامي أو يخلق الصراع. نذكر مثلاً فيلم “المغتصبون” لسعيد مرزوق و”الكرنك” لعلي بدرخان و”الشيطان يعظ” لأشرف فهمي و”ليلة سقوط بغداد” لمحمد أمين. لكن السينما النظيفة والتي جعلت من نظافتها شعلة تضيء بها طريق الفن المصري، لم يكلف صناعها أنفسهم بمحاولة إيجاد مبرر درامي لمثل هذه المشاهد.
تناقض
الغريب، أن الأسرة المصرية التي شدت رحالها للسينما أواخر التسعينات، لم تقف أمام تكرار هذه المشاهد كثيراً. لم تعتبرها خروجاً على الذوق العام ولا خدشاً للحياء. بل على العكس، أكثر من مرة سمعت أمهات ينصحن صديقاتهن بمشاهدة فيلم “كذا وكذا” مع بناتهن اللاتي لا تتعدى أعمارهن العاشرة والاثني عشر، دون أن يفكرن فيما قد يدور في ذهن البنت بينما هي ترى نفس الممثلة يتم التحرش بها واغتصابها مراراً وتكراراً في أكثر من فيلم، فقط لتظهر في المشهد التالي بكامل زينتها دون الالتفات لما حدث، في محاولة لتسطيح وتهميش انتهاك المرأة على الشاشة، وكل هذا لأجل عيون حياء الأسرة المصرية.
في عام 2005، شهدت السينما المصرية انفجار ماسورة السينما النظيفة، بدأ عدد النجمات اللاتي يمثلن للفن وليس للقولبة آخذاً في التقلص، حتى فنانة موهوبة مثل حنان ترك؛ خرجت من عباءة يوسف شاهين لتتنافس هي وزميلتها منى زكي على دور البطلة في الأفلام النظيفة الذكورية. وانضمت لعباءة النظافة فنانة موهوبة مثل منة شلبي، ظهرت للأضواء بفيلم “الساحر” رائعة رضوان الكاشف عن عالم المهمشين، والذي يعد من أفضل الأفلام المصرية الحديثة اكتشافاً لعالم الجنسانية والمراهقة. في “الساحر”، تكتشف نور معالم جسدها، تتحسس طريقها نحو الجنس والنضج وعالم الرجال المغلق. تبدأ هرمونات الأنوثة في التحكم في رؤيتها للعالم، ورغبتها في سبر غور المجهول، الممثل في حازم، الشاب الغني، بعد أن ملت اكتشاف شبقها على يد حمودة؛ حبيبها وابن حتتها.
قابل “الساحر” عاصفة من الهجوم حينما عرض عام 2001، ونزل الهجوم كله على رأس المسكينة منة، فهي الطرف الأضعف؛ الفنانة، والتي يتصدر باسمها العمل، وتصبح متحملة لكل تبعات نجاحه أو فشله، وهي أيضاً، في نظر الجماهير و –للأسف- بعض النقاد والصحفيين الفتاة المنحلة التي خرجت على الآداب العامة وأذت مشاعر الشباب المكبوت جنسياً، في أداءها لدور نور؛ كتلة النار والشبق المتحركة، والتي حتى يجد أبوها –قام بدوره الفنان محمود عبد العزيز- نفسه عاجزاً أمام جمالها وفتنتها اللذان يجذبان الانتباه حيثما ذهبت، فلا يجد مناصاً من حبسها خوفاً عليها من الناس ومن شبقها.
ربما تكون الأفلام التي تتمحور حول الجنسانية قد اندثرت، لكن عملاً سينمائياً مأخوذاً عن نص أدبي وهو الفيل الأزرق لمروان حامد، قد بدأ عرضه في السينمات المصرية عام 2014، وبدا مبشراً بالنجاح وبكسر التابوهات التي قررتها السينما النظيفة جداً. لكن يبدو أن مغازلة صناع الفيلم للجمهور المحافظ، وهي الأجيال الصغيرة من مراهقين وشباب، تربوا ونشأوا على السينما النظيفة وتشكل وعيهم الفني والاجتماعي على مفاهيمها لما هو مقبول وما هو مذموم، أجبرت صناع الفيلم على تقليل جرعة الجنس في الرواية حتى تلائم الجمهور المحافظ. في الرواية شخصية من شخصياتها المحورية، مايا، هي رمز للغواية مكتوب بإسقاط عبراني واضح، فمايا الشبقة المثيرة تهدي عشيقها يحيى التفاحة المحرمة –حبة الفيل الأزرق- وتجعله يدخل تجربة يعبر بها الحد الفاصل بين الممنوع والمقبول –أكل الثمرة المحرمة والطرد من الجنة.
في الفيلم تتحول مايا لعروة في جاكتة البطل، شخصية جانبية هامشية للغاية، وكل ما تمثله مبرر درامي كي يبتلع البطل حبة الفيل الأرزق وتتكشف له الحجب. الجنس والغواية والشهوة، كانوا من أعمدة البناء التي عليها صعدت دراما رواية “الفيل الأزرق” المشوقة. لكن الفيلم انتزع جوهر الرواية وأعلى من قيمة المؤثرات البصرية والجرافيكس على حساب المضمون الجريء –لحد كبير- الذي تميزت به الرواية، فكانت العلاقة الجنسية بين مايا ويحيى علاقة نظيفة كالعادة، خالية من القبلات أو المشاهد الحسية التي من المفترض أن يبرزها الفيلم. الغريب أن حتى كاتب السيناريو، وهو مؤلف الرواية أحمد مراد، لم يتضرر من أن يفعل هذا بروايته نفسها، ولم يسبب له إزعاجاً أن يتغير مضمون الرواية ويصبح فيلما تجارياً بحتاً، مع تجاهل شطر كبير من علاقة يحيى بنفسه وبالنساء في حياته. أما العلاقة الملتبسة السادو/ مازوخية بين شريف وزوجته، فتم الإشارة إليها على استحياء وكأنما يخشون الخوض في مياه مستنقع الجنس العكر، بكل ما تحويه من أسرار يخافون على مشاعر الجماهير العريضة منها.
مع تحفظي على موقف إحسان عبد القدوس من المرأة، والذي أرى عدم مناصرته لها رغم جرأته في تناول العلاقة بينها وبين الرجل؛ إلا أنني تخيلت لو قمنا بإعادة تحويل نص روايته “أنف وثلاثة عيون” للشاشة الفضية بروح العصر، وانتزعنا كل ما قد يجنسن الفيلم بصلة، فيصبح ما لدينا جنين مشوه، ملائم لمتطلبات السوق السينمائي النظيف والأسرة المصرية النظيفة.
تجارب وأبحاث
هل جرب أحد أن يبحث مرة عن اسم ممثلة مصرية على موقع اليوتيوب؟
جرب أن تكتب اسماً عشوائياً، وراقب ما قد يظهر في ال search bar. ستكون المقترحات كالآتي:
منى زكي ساخنة
منى زكي رقص
منى زكي اغراء
ماذا لو جربنا فنانة من زمن الفن المصري الكلاسيكي مثل شويكار؟
سنجد الآتي:
شويكار للكبار فقط
شويكار وفؤاد المهندس ساخن
شويكار ومحمود عبد العزيز ساخن
ماذا لو اخترنا ممثلة اشتهرت بأدوارها التليفزيونية ولم تكن بعيدة عن صورة الفنانة المحافظة التي نادراً ما تكسر القواعد وتتمرد مثل تيسير فهمي:
تيسير فهمي ساخنة
تيسير فهمي بالمايوه
تيسير فهمي اغراء
تيسير فهمي 18+
هناك أكثر من كارثة، أولها اعتبار أي من مشاهد شويكار وفؤاد المهندس سوياً مشاهد إغراء. تلك القبلات البريئة التي انطوت معظمها على اسكتشات مضحكة أصبحت تمثل إغراء لجيل تربى على السينما المدعوكة بالصابون!
المفجع في الأمر هو عندما تبحث عن اسم فنانة وقورة اشتهرت بأداء أدوار الأم مثل أمينة رزق فتجد أكثر الكلمات تردداً عنها “رقص أمينة رزق”، أو في حالة القديرة سناء جميل “سخونة سناء جميل” و”سناء جميل إغراء”.
تحول عقل المشاهد العربي إلى ماخور حينما يتعلق الأمر بالممثلات، لم يسلم منه نجمات كبيرات أو صغيرات، اشتهرن بأدوار الإغراء أو الأمومة، نجمات تليفزيون أو نجمات سينما.
أن يتدافع مرتادي اليوتيوب للبحث عن تيسير فهمي وهي ترتدي المايوه، فهذه كارثة. في وقت من الأوقات كانت أمهات وجدات هذه الأجيال العظيمة ترتدين المايوه على شواطئ سان ستيفانو والمنتزة ورأس البر وجمصة، وليس فقط في الشواطئ المغلقة أو ال compounds التي لا يرتادها سوى الصفوة. ومن الغريب أيضاً أن نكتشف أن السينما النظيفة لم تهذب أخلاق المجتمع كما زعم المروجون لها وصانعوها، بل أنها ساعدت على تسليع الممثل والممثلة. الممثل كونه ذكر الألفا الرابح، والذي ينبغي عليه أن يحمل فيلماً بأكمله على كتفيه ليتصدر المشهد ويأخذ في تكرار نفسه الفيلم تلو الآخر –راقب محمد هنيدي، أحمد حلمي، أحمد مكي، أحمد السقا، كريم عبد العزيز على مدار مسيرتهم الفنية- أما الممثلة فيتم تسليعها على أنه جسد أحسن بتغطيته، يصفق له الجمهور ويهلل طالما سار على الطريق المستقيم ويلهث وراء كل ما يستطيعون الوصول إليه منه إذا تجرأ مرة وأظهر أكثر مما ينبغي –من أكثر هذه الأمثلة المحزنة، منى زكي، والتي حاولت التمرد عن طريق دورها في فيلم “احكي يا شهرزاد” ليسري نصر الله فقط ليخاصمها الجمهور وتفقد عرش التربع على قمة النجومية.
دفاع عن النظافة!
في ندوة ما، تحدثت نجمة عرفت بالإغراء؛ غادة عبد الرازق، عن كون جيلها أفضل من جيل فنانات الزمن الجميل، فهن جيل رفض ارتداء المايوه وقمصان النوم الساتان والملابس الداخلية. غادة والتي يهاجمها الجميع نظراً لما قدمته من مشاهد جريئة، مشاهد بالمايوه في فيلم “زي الهوا” ومشاهد مثلية في فيلم “حين ميسرة” لخالد يوسف ومشاهد حميمية في فيلمي “الريس عمر حرب” و”كلمني شكراً”، تدافع عن السينما النظيفة وتدعي أنها وجيلها من الفنانات هن من أسسن لها. الحقيقة موقف مثل هذا يدعو للتساؤل بل للذهول، لكن مع قليل من التدقيق، لا يتهم المرء غادة بالشيزوفرينيا، غادة هي جزء من جيل تعلم أن يحب السينما الحقيقية ويخشاها، سواء كان هذا الجيل عاملاً فيها مثل غادة، أو متلقياً لها مثل أولئك الذين يكتبون اسم غادة على اليوتيوب مقروناً ب “ساخنة” أو “سكس” أو “18+”
آه بالمناسبة، ما إن يكتب المرء اسم غادة عبد الرازق على اليوتيوب، تظهر النتائج التالية:
غادة عبد الرازق ساخن جداً
غادة عبد الرازق 18+
غادة عبد الرازق وسمية الخشاب ساخن
هناك نتائج أخرى أتحفظ على نشرها في هذا المقال.
لا ألوم غادة على تأدية مشاهد موظفة درامياً، لكنني ألومها وهي فنانة جريئة صنفت أولاً وأخيراً على أنها فنانة إغراء على أن تذم في جيل فنانات عظيمات، مثلن ولم يضعن اعتبارات سخيفة عن السينما في أذهانهن، ولم يصنفن أنفسهن نظيفات أو قذرات طبقاً لمصطلحات تربوية بعيدة كل البعد عن صناعة السينما كفن أو حتى كتجارة.
في النهاية، يبقى السؤال؛ هل سينتصر الفن؟ مع تدفق الدماء الجديدة في السينما المصرية، وظهور مخرجين واعدين أمثال هاني خليفة وأحمد عبد الله وآيتن أمين وعمرو سلامة وخالد الحجر ونادين خان وخالد الحلفاوي، نتعشم أن تبدأ السينما في الخروج من سينما المصطلحات إلى سماء التجريب والذاتية والاكتشاف. خاصة وأن هناك موجة مضادة لجماهير خرجت مع التطور التكنولوجي وعصر السماوات المفتوحة لتنجب جيلاً من عشاق السينما الحقيقية، واسعي الثقافة السينمائية والإطلاع على كل ما تجود به السينما العالمية المغايرة للنور. صحيح أننا لن نمحو أثر الصندوق الأخلاقي الضيق الذي حبست فيه السينما المصرية نفسها بإدعائها الفضيلة، لكننا سنحاول على الأقل صنع ثقوب في هذا الصندوق؛ أو لنقل، خدش بطانته السميكة، فيظهر على السطح جيل من الفنانين والفنانات المتمردين والمتمردات على معايير بالية تمت صياغتها لتفكيك بنية شعب عاش حياته السابقة عاشقاً للفن مقدساً له وتبديله بشعب آخر يجد في سخرية رجل ملتحي تافه من قامة عالية مثل أم كلثوم، مثاراً للإعجاب.