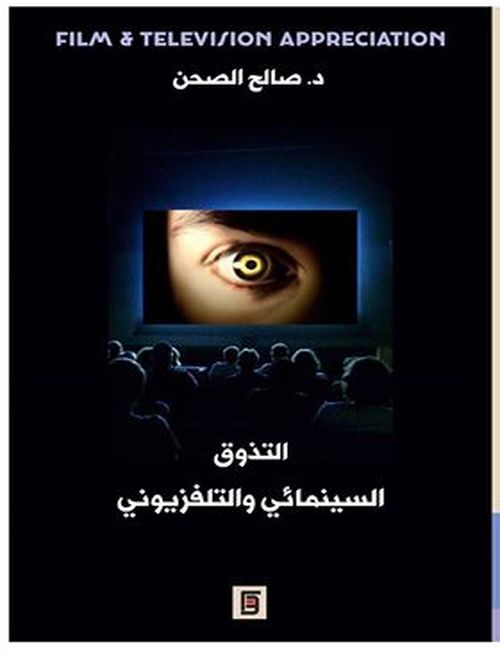“الصورة السينمائية”: سحر مارلين فى مواجهة العالم الإفتراضى!
 سعيد شيمي مع الناقدة ماجدة موريس
سعيد شيمي مع الناقدة ماجدة موريس
تطالعك على غلاف هذا الكتاب فاتنة السينما الألمانية والهوليوودية مارلين ديتريش، وهى تتطلع الى أعلى، سحر الأبيض والأسود يجعلها كما لو كانت عرّافة قادمة مباشرة من مسرحية إغريقية، فى عينيها من الأسئلة أكثر مما تعرف من الإجابات، فى الصورة ثقة وقلق، وكأنها السينما نفسها، بين ماض راسخ ومؤثر، ومستقبل يحكمه الجديد كل يوم.
الكتاب هو أحدث إصدارات مدير التصوير المصرى القدير والباحث السينمائى الدءوب سعيد شيمى، وهو يبدو كما تعودنا أقرب الى المرجع الضخم (446 صفحة).
العنوان وحده جدير برسالة أكاديمية معتبرة :”الصورة السينمائية من السينما الصامتة الى الرقمية”، الكتاب صدر عن أكثر السلاسل السينمائية المصرية رصانة وأهمية، فهو العدد 72 من سلسلة “آفاق السينما” التى تصدر عن هيئة قصور الثقافة. أما الموضوع فهو سرد متعمق وتفصيلى لتاريخ الصورة السينمائية، ليس بوصفها كادرات ثابتة فى شريط متصل، ولكن باعتبارها مرآة عكست ولاتزال تعكس إبداعات الفن جنباً الى جنب مع انتصارات العلم، براعة هذا السفر الكبير فى أنه إذ يستعرض تاريخ الصورة السينمائية، فإنه يستعرض رحلة الإنسان فى ابتكار الطرق والأساليب والأجهزة التى تجعله قادراً على تسجيل اللحظة، والإمساك بالزمن، وتحويل الفانى الى خالد، حتى لو كان ذلك الى حين.
سأعود حتما الى نظرة مارلين ديتريتش، ولكن دعنى أحدثك فى البداية عن إسهامات عاشق السينما سعيد شيمى العملية والنظرية، الذي ارتبط اسمه أولاً بعدد معتبر من الآفلام الوثائقية الهامة (منها مثلا أبطال من مصر للمخرج الراحل أحمد راشد وفيما بعد فيلم الصباح للراحل سامى السلامونى)، وارتبط إنجازه اللافت فى عالم السينما الروائية بتيار الواقعية الجديدة، وتحديداً الأفلام الهامة لكل من عاطف الطيب ورفيق عمره محمد خان ( ضربة شمس، الحريف، طائر على الطريق، سواق الأوتوبيس، الحب فوق هضبة الهرم، ملف فى الآداب)، وارتبط أيضاً بريادته فى تصوير عدة أفلام تدور أبرز مشاهدها تحت الماء ( من حجيم تحت الماء الى جزيرة الشيطان والطريق الى إيلات).
منهج واضح
ولكن إسهاماته فى مجال تقديم الدراسات عن فن التصوير السينمائى والخدع السينمائية لا تقل أهمية واستحقاقاً للمتابعة، يكفى أن نشير الى بعض العناوين فقط: “التصوير السينمائى تحت الماء”، “تاريخ التصوير السينمائى فى مصر من 1897 الى 1996″، أفلامى مع عاطف الطيب”، “الخدع والمؤثرات فى الفيلم المصرى _ جزءان”، “اتجاهات الإبداع فى الصورة السينمائية المصرية”، “تجربتى مع الصورة السينمائية _ جزءان”، “سحر الألوان من اللوحة الى الشاشة”.
رغم تعدد العناوين، إلا أن ما يجمع بينها أكبر بكثير من كونها تتعلق بفن التصوير السينمائى، إنه بالأساس ذلك المنهج الواضح الذى يمزج بسلاسة بين السرد التاريخى والأسس النظرية والتجربة العملية معاً، فكأنها مراجع هامة ترضى المتخصص والهاوى، تشبع فضول المستكشف، وتقدم المعلومات الوفيرة للدارس والمحترف، وليس لدينا فى المكتبة السينمائية العربية إلا أقل القليل من الكتب التى نجحت فى تحقيق هذه المعادلة الصعبة.
أما الصفة الثانية فى كتابات سعيد شيمى فهى تأكيدها المتواصل على أن التصوير السينمائى ليس عنصراً يعمل فى فراغ، إنه جزء من عناصر الفيلم السينمائى، الصورة السينمائية لها وظيفتها المحددة ارتباطاً بالدراما، المسألة ليست إضاءة المنظر مثل “فرح العمدة”، ولا تقديم كادرات جميلة والسلام، ولكن نجاح الصورة السينمائية يتصل عضوياً بقدرتها على التعبير عن أجواء السيناريو، وبقدرتها على ضخ الحياة فى شريط السينما، لتتحول الأطياف والأشباح على الشاشة الى أحاسيس متجسدة، ومشاعر وعواطف وأفكار، عن طريق التكوين واللون والحركة وأحجام اللقطات والمؤثرات البصرية.
ثالثاً: تاريخ التصوير السينمائى فى كتب سعيد شيمى ليس منفصلاً عن تاريخ المجتمعات وتطورها، ولا عن تاريخ كل الفنون، كما أنه جزء اساسى من تطور فنون وعلوم السينما نفسها، لا تصف المؤلفات ما سجلته شرائط الأفلام من خلال الكاميرا، ولكنها تقوم بتفكيكه وتحليله ووضعه فى سياقى الزمانى والإنسانى، هنا أهمية مضاعفة لمنهج الكتابة، وإلا تحولت الكتابة عن الصورة السينمائية الى منهج تعليمى لحرفة من الحرف وكفى، الحرفة وتفاصيلها فى تلك الدراسات ليست غاية، ولكنها وسيلة للوصول الى الدرجة الأعلى وهى الفن.
كتاب “الصورة السينمائية من السينما الصامتة الى الرقمية” يحتذى أيضاً نفس المنهج، رغم أن القفزات هائلة بين كاميرات فجر السينما وآلات العرض والعدسات فى عصر لوميير، وتلك الأجهزة والكاميرات الأسطورية الطائرة والهائمة فى عصر التكنولوجيا الرقمية، ورغم انحياز سعيد شيمى الصريح الى عصر السينما الرقمية القادم دون التغاضى عن إنجازات عصر السيليولويد العظيمة التى يحللها بالتفصيل، إلا أن المعنى الأهم الذى يرسخ فى ذهنك، وكما يقول بعض مديرى التصوير الكبار فى نهاية الكتاب، هو أن كل المعدات والأجهزة ، قديماً وحديثاً، ليست فى النهاية سوى “باليتة” ألوان يستخدمها الفنان، يقولون :”التكنولوجيا لا تصنع فناً وإنما الفنان هو الذى يصنع الفن”، “الفن لا يخرج من الكمبيوتر أو الكاميرا الرقمية أكثر مما يخرج من أنبوبة زيت الرسم”، “التكنيك لا يحل محل الأفكار والأسلوب لايحل محل المحتوى ” .. إلخ
دعونى أضيف، وقد امتلأت دهشة بالإستعراض المذهل الذى قطعته رحلة الصورة السينمائية، إن هذه السهولة وتلك الإمكانيات الهائلة التى يسّرتها الثورة الرقمية فى صناعة الأفلام تبدو مأزقاً حقيقياً لأى فنان، ذلك أن الفن اختيار وتوظيف للإمكانيات، وليس مجرد لعبة بصرية عشوائية، يكفى ان نشاهد الاستخدام الكارثى لما يطلق عليه sky cam فى الأفلام المصرية الجديدة حتى نفهم خطورة هذه السهولة، هذا الجهاز العملاق الذى يحمل الكاميرا كرافعة أسطورية الى ارتفاعات هائلة، وتلك الكاميرا التى يحركها مدير التصوير ويشاهد صورتها كيفما شاء وفى كل الإتجاهات وهو جالس فى مكانه، تحولت الى لعبة بصرية مزعجة، شئ أقرب الى مراجيح مولد النبى، ولكن على شاشة بيضاء.
الفيلم والحلم
قام المؤلف بتقسيم كتابه الى أربعة أبواب تحكى قصة الصورة السينمائية من الفيلم الى الحلم الرقمى الذى أصبح واقعاً مكتسحاً، فى الباب الأول نبدأ الحكاية من أولها، تلك الأسس البصرية التى لولاها ما كانت السينما، خاصية ثبات الرؤية، دور علماء البصريات الأوائل، القواعد التى اكتشفها الحسن ابن الهيثم، السينما كخدعة لا تتحرك فيها الصورة فى الواقع، ولكن يتوالى عرض الكادرات بسرعة معينة، فتدركها العين متحركة، إسهامات إديسون صاحب أول استديو للتصوير السينمائى فى التاريخ، العرض الأول فى باريس للأخوين لوميير الذى يؤرخ به لمولد السينما، ورغم أن هذا العرض كان مقابل تذاكر، إلا أن الأخوين لوميير لم يستطيعا تصديق وجود أى مستقبل اقتصادى لهذا الإختراع.
فى الباب الأول إسهامات جورج ميلييس، أفلامه الخيالية، اكتشاف لغة الصورة وإمكانيات الحركة والخدع، نشأة هوليوود ومشكلات بدائية وضعف حساسية الأفلام مما استلزم المبالغة فى دهن وجوه الممثلين والممثلات باللون الأبيض، مولد التعبيرية الألمانية وأفلامها الهامة، نهج التصوير الكلاسيكى فى الأفلام الأمريكية، بزوغ نظام النجوم فى الدانمرك أولا ثم وصوله الى هوليوود.
الباب الثانى يستعرض بالتفصيل سنوات النضوج: ظهور الصوت الذى سجن الكاميرات فى حجرات خاصة حتى لايُسمع صوتها، كما أنه حدد حركتها حتى لايتم اكتشاف الميكروفونات الضخمة، ولكن الفن سيتحايل مرة أخرى من أجل تحرير الصورة: سيتم تطوير الكرين لخدمة السينما الإستعراضية، سيظهر كاتم صوت للكاميرا بدلاً من الحجرات الكبيرة، سيولد الفيلم الوثائقى وسينما الحقيقة والجرائد السينمائية التى تسجل الحروب، ستظهر الواقعية الإيطالية من وسط الأنقاض، وبرغم ضعف الإمكانيات وغياب الأستديوهات، يظهر التليفزيون فترد السينما بإمكانيات استخدام الألوان والسينما المجسمة والسينما سكوب فى الخمسينات، تصبح الكاميرا الحرة محوراً للموجة الجديدة فى فرنسا التى تؤثر فى سينما العالم كله، يستمر التطوير بظهور عدسات الزووم فى بداية عقد الخمسينات كعدسة تستخدم فى الأفلام الإخبارية، تظهر الكاميرا السينمائية العاكسة، تنجح تجارب التصوير تحت الماء، نصل الى التصوير فائق السرعة فى الأبحاث العلمية.

فى الباب الثالث الذى يحمل عنوان سنوات الإستنارة يستعرض المؤلف اكتشافات إمكانيات الألوان، والتجارب التى قدمتها سينما أوربا الشرقية وجنوب شرق آسيا، ظهور التليفزيون الملون وكاميرا الفيديو وابتكار الفيديو المساعد لكاميرا السينما الذى أتاح للمخرج أن يشاهد الصورة أثناء تصويرها، لولا هذا الإبتكار ما أتيح استخدام الكاميرا الملتصقة بجسد المصور (steady cam)، أو الكاميرا التي تحملها رافعة هائلة (sky cam)، أو حتى الكاميرات التى تقوم بالتصوير من الطائرات، بل إن هناك اليوم طائرات صغيرة يمكن تحريكها عن بعد حاملة كاميرات صغيرة، مما يعطى إمكانيات اسطورية للتصوير فى كل الإتجاهات والإرتفاعات.
وفى الباب الرابع يرصد المؤلف سنوات التغيير، الدخول الى عصر الصورة الرقمية التى أتاحت بناء عالم افتراضى كامل باستخدام البرامج المختلفة مما أتاح تصوير فيلم مثل “300” المذهل فى استوديو صغير، ثورة كاملة فى التكلفة وإمكانيات الخدع البصرية، وحرية لا حدود لها فى تجسيد أكثر الأحلام جموحاً، ظهرت الكاميرات الرقمية التى تحسنت نتيجتها لتقترب صورتها من جودة الفيلم السينمائى، بدأ ترميم الأفلام رقمياً بجودة مدهشة، ظهر مخرجو دوجما 95 الذين اعتمدوا على التصوير بالكاميرات الرقمية، ظل مع ذلك بعض المخرجين يرفضون الإستغناء عن التصوير مباشرة على الفيلم السينمائى، قال ستيفن سبيلبرج بكل وضوح :”الفنون تحاكى شيئاً ما بداخلنا، سأصور كل أفلامى على الأفلام السينمائية حتى إغلاق آخرمعمل سينمائى”.
العلم والفن
بناء الكتاب بهذه الطريقة المتماسكة لا يضع العلم فى مواجهة الفن، القضية محسومة تماماً، التكنولوجيا والعلم أداة لخدمة فن الصورة السينمائية وصنّاعها الكبار من المصورين والمخرجين، ستجد دوماً الإشارة التفصيلية للإنجاز الفنى مستفيداً من الإنجاز التقنى، لا معنى للعدسات دون وجود مخرج مثل جريفيث استطاع أن يستفيد منها، وتمكن من الإستفادة من إمكانيات المنظر الكبير، لم يكن ممكناً أن يتطور الكرين أو التصوير تحت الماء دون مواهب استثنائية مثل فريد استير وجنجر روجرز واستير ويليامز، ما كان يمكن أن يكون للصورة السينمائية هذه القدرة التعبيرية الخارقة فى مشهد سلالم الأوديسا الشهير بفيلم “البارجة بوتومكين” لولا عبقرية سيرجى إيزنشتين، واكتشافه لعالم المونتاج الساحر، ما كان يمكن أن تكون الصورة السينمائية فى الأفلام العظيمة بمثل هذا الثراء لولا المرجعيات التشكيلية واللونية التى اعتمد عليها مخرجين كبار مثل أنطونيونى وكوبريك وكيروساوا وكيشلوفسكى وفيللنى وبرجمان وبارادجانوف وليلوش وشادى عبد السلام وتاركوفسكى.
يظل هدف التطور دائماً أن تُصنع أفلام كبيرة وعظيمة يمتلئ الكتاب بتحليل أمثلة لها مثل “أوديسا الفضاء 2001″ و”صرخات وهمسات” و”أحلام” و”ساتيركون” و”المومياء” و”تكبير الصورة” و” أندريه روبلييف”، هناك كذلك وقفة طويلة مع تجارب كبار مديرى التصوير مثل الإيطالى فيتوريو استورارو (الملتزم والتانجو الأخير فى باريس وسفر الرؤيا الآن)، والسويدى سفن نيكفست (أفلام برجمان)، والأمريكى جوردون ويليس ( الأب الروحى بجزءيه الأول والثانى).
يعطى سعيد شيمى هذه الإنجازات الفيلمية حقها شرحاً وتحليلاً، وخصوصاً فيما يتعلق بخلق الجو والمعنى الدرامى للألوان، ولكنه يعود للتأكيد على أن المستقبل للصورة الرقمية وليست الفيلمية، فى الحقيقة لا يخلو فيلم الآن من هذا التدخل الرقمى فى مراحل عملياته أو إنتاجه، ومن المستحيل إنتاج الأفلام الخيالية بدون التكنولوجيا الرقمية.
تبدو مارلين ديتريتش وكأنها تنظر بعين الى سحر الفيلم، وبعين أخرى الى أعاجيب التكنولوجيا الرقمية، ربما يكون ذلك تفسيراً آخر للغلاف البديع للكتاب بعد الإنتهاء من قراءته، أظن أن الفنان سيستفيد من الصورة الرقمية بشرط أن تكون فى مستوى ما يحققه له الفيلم القديم، زادت حساسية الفيلم فمنح ذلك المصورين القدرة على محاكاة اللوحات العظيمة عن الأحداث التاريخية، لو حققت الصورة الرقمية حلم المصور ستكتسح الميدان، أما لو كان المبرر مجرد خفض التكاليف، فإن كثيرين لن ينحازوا الى الصورة الرقمية.
ستظل صورة مارلين بالأبيض والأسود تتحدى الصورة الرقمية القادمة، وستظل كتب سعيد شيمى عنواناً للدراسة السينمائية الجادة، ودليلا على العشق، وبرهاناً على أن الصورة مرآة للحياة بكل ما فيها، لو كانت لدينا فضائيات لها علاقة بالأفلام وبالسينما حقاً، لخصصت برنامجاً يقدم فيه المصور الكبير حصاد دراساته مدعومة بالأفلام والمشاهد، ولكنهم يتاجرون فقط فى الصور والأفلام، دون أن يقرأوا شيئاً عنها، ودون أن يفهموا معنى نظرة مارلين.