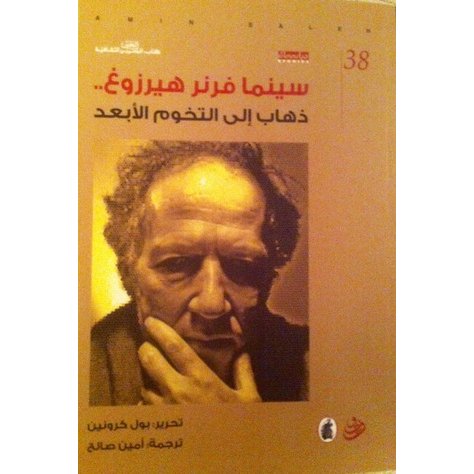هوامش على دفتر النقد.. ما بين الشهد والدموع

لا أستطيع إغفال دور التليفزيون فى ترسيخ معنى كلمة “نقد” فى عقل صبى صغير فى مرحلة التكوين فى السبعينات والثمانينات من القرن العشرين . كان هناك مثلا برنامج بعنوان “جولة الفنون” تقدمه المذيعة مديحة كمال متخصصٌ فى متابعة معارض الفن التشكيلى الجديدة، وكان يستضيف دائماً أحد النقاد المتخصصين الكبار للشرح والتعليق، من طبقة كمال جويلى والراحل الكبير بدر الدين أبو غازى.
بالتأكيد لم أكن استوعب التفاصيل، ولكنى ارتبطتُ كثيراً باللوحات والتماثيل والألوان، وكلها عناصر هامة فى فن قراءة الأفلام والصور.
كان هناك أيضاً برنامج عن الموسيقى الكلاسيكية بعنوان “صوت الموسيقى” تقدمه السيدة سمحة الخولى، وبرنامج ثالث بعنوان “فن الباليه” يقدّم مختارات من الباليهات الشهيرة، وبرنامج رابع بعنوان “تياترو” عن المسرح من إعداد الراحل جلال العشرى ومن تقديم منى جبر، أذكر أن البرنامج الأخير كان يستضيف ناقداً ليتحدث عن مسرحية كل اسبوع مع تحليل عناصر العرض فى وجود مخرجه أو أحد أبطاله.
مرة أخرى لا أزعم أننى كنت أستوعب كل ما يقال، ولكنك تستطيع أن تقول أن مفهوم ودور الناقد تبلور فى ذهنى الى حد ما: إنه الشخص الذى يقوم بتحليل العمل الفنى والحكم على مستواه بناء على قواعد محددة لم أكن أعرف شيئا عنها بعد.
لم تكن هذه البرامج متخصصة فى تلك الفنون فقط، ولكنها كانت أيضا فى الفن الذى ارتبطت به: السينما.كان ذلك من خلال برنامجين هما الأشهر فى مجال الثقافة السينمائية: “نادى السينما” على القناة الأولى من تقديم درية شرف الدين، وبرنامج “اوسكار” على القناة الثانية من تقديم سناء منصور، وكان وراء البرنامجين إعدادا واختيارا، أحد رواد الثقافة السينمائية وهو يوسف شريف رزق الله الذى ساهم أيضا فى إعداد وتقديم برنامج هام آخر بعنوان “نجوم وأفلام” بالمشاركة مع الناقد الراحل سامى السلامونى .
استضافة النقاد
هذه البرامج كانت تستضيف “نقاداً ” يتحدثون عن الفيلم المعروض، أوتقدّم خلاصة رأى النقاد فى الفيلم مع لفت الأنظار الى عناصر تميزه الفنى، وأسباب فوز الفيلم بجائزة فى هذا العنصر أو ذاك.
البرنامج الأخير مثلاً كان يختار مخرجاً ويناقش معه أعماله، ويتولى السؤال ناقد مثل السلامونى أو يوسف شريف رزق الله، وأحيانا كان يتم تحليل بعض المشاهد لقطة لقطة.
ياإلهى ، كم كان رائعاً هذا البرنامج الذى كنت أنتظره لأكتشف السينما من خلال زوايا أكثر عمقاً. ما زلت أذكر حلقة يوسف شاهين التى ظهرت فيها الرائعة الراحلة مارى كوينى، والمدهش العظيم محمود المليجى الذى قدّم مع شاهين _ وبدون إعداد، مجموعة من مشاهد الأداء المذهلة والمتنوعة بنفس جملة الحوار.
ما زلت أذكر أن السلامونى اصطحب شاهين لتصوير إحدى محاضراته فى معهد السينما. مازلت أتذكر أيضا أن الناقد الراحل كان هو ضيف برنامج “نادى السينما” عند عرض التحفة السينمائية “كل هذا الجاز” للمخرج بوب فوس، ولا انسى أن السلامونى أيّد حذف التليفزيون لبعض المشاهد التى لا تصلح للعرض المنزلى، وهو أمر لم أستوعبه إلا بعد أن شاهدت الفيلم كاملاً فيما بعد.
لا أنسى كذلك ضيوفاً مميزين جداً للبرنامج كانوا يقومون بتشريح الأفلام وعناصرها عنصراً عنصراً مثل الدكتور سمير سيف . أذكر أننى سمعت مصطلح “المدرسة الوحشية” لأول مرة فى حياتى من سمير سيف وهو يحلل أحد أفلام روبرت ألدريتش فى برنامج “نادى السينما “.
تقريباً كل نقاد السينما فى السبعينيات والثمانينيات تعرفت عليهم من خلال هذه البرامج التى كانت تقدم ما يقترب من “الدراسات النقدية المصورة”. لا أنسى أيضاً برنامجاً أحدث زمنياً كان يحمل اسم “وقائع مصرية ” ويتناول شخصيات فنية استثنائية مثل الراحل على اسماعيل المؤلف والموزع الموسيقى الفذ، وعبد العزيز فهمى مدير التصوير المصرى العالمى ومصور فيلم “المومياء”، وشادى عبد السلام المخرج ومهندس الديكور ومصمم الأزياء العظيم.
كان برنامجاً تقف خلفه عين ناقدة مثقفة. ليست هناك أسئلة على غرار:”وأين ترعرعت سيدتى؟ “، ولكنها أسئلة عن الدراما والصورة وحركة الكاميرا والإضاءة وفن الممثل مع الشرح على المشاهد بالإعادة والتكرار وكأننا أمام “كورس فى التذوق السينمائى”.
كانت برامج صنعت بحب وعشق وهواية حقيقية، ولا أعتقد أبداً أننى استفدتُ من عشرات الكتب عن فن السينما التى قرأتها فيما بعد مثلما استفدت من متابعة هذه البرامج الرائعة التى يستحق أصحابها أعظم تكريم لأنهم نقلوا معاهد السينما ونواديها الى المنازل قبل عصر الفيديو والكمبيوتر.
أحلامي في السينما
أصبحت أحلامى تدور حول السينما والأفلام رغم أننى لم أكن دخلت وقتها سوى عدداً محدوداً من دور العرض، ولكنى لم أكن أعرف بالضبط ماذا أريد من السينما. فى البداية قمتُ بتجربة غريبة وهى الكتابة. كنت مفتوناً فى تلك الأيام بالحلقات التليفزيونية “هيتشكوك يقدّم ..” بلحنها المميز، وكنتُ مُعجباً بالطريقة التى يختم بها المخرج الكبير الحلقة، وعبارة “good night” التى كان يرددها باللكنة الإنجليزية الرصينة. شاهدتُ يوماً إحدى الحلقات. أعجبتنى، فكتبتُ قصة الحلقة وأعطيتها عنواناً هو “مأساة هارى هولمان” .
لم أكن أعرف أننى قمت بتحويل سيناريو مصوّر الى قصة سينمائية. فى مرحلة تالية، أحببت أن أكون مخرجاً. بهرتنى هيئة المخرج والعالم الرائع المسمى الأستديو الذى يتحكم فيه. الصورة الأكثر رسوخاً وحميمية عن هذا العالم كانت فى فيلم “اسماعيل ياسين فى الطيران” حيث المخرج (يوسف شاهين) يدير تصوير أحد مشاهد الحركة التى ينفذها الدوبلير البائس (اسماعيل ياسين).
أعجبتنى جداً الآلة العملاقة التى ترفع الكاميرا الى أعلى (عرفتُ فيما بعد أن اسمها الكرين ). قمتُ بتحويل شماعة للمناشف الى ما يشبه العربة التى تحمل الكاميرا (الدوللى).
أعجبنى أن المخرج الذى يجلس على مقعد يحمل اسمه هو إمبراطور المكان. كانت هناك أيضاً شخصية لمخرج سينمائى يقوم بدوره محمد سلطان فى فيلم أحببته كثيراً فى طفولتى هو “عائلة زيزى”، ولا زلت أذكر أنه أخرج رقصة للراقصة سهيرزكى .
كانت الأحلام هائمة بين الكتابة والإخراج، ولم يعد كافياً أن أكتفى بالثقافة البصرية السمعية بمتابعة الأفلام والبرامج، ولكن كان لابد من القراءة المنظّمة. لحسن الحظ أننى بدأت بقراءة كتابين فتحا شهيتى للقراءة بنهم وبلا حدود. الكتاب الأول من تأليف الناقد الراحل سعد الدين توفيق وعنوانه ” صلاح أبو سيف فنان الشعب”، وموضوعه استعراض تاريخى ونقدى لأفلام المخرج الكبير، والكتاب الثانى من تأليف الناقد هاشم النحاس وعنوانه “يوميات فيلم”، وهو متابعة لخطوات تصوير وإنتاج فيلم “القاهرة 30” بكل العمليات الفنية من الأستديو الى غرفة المونتاج، كما كان هناك ملحق إضافى عن صدى الفيلم فى عيون النقاد (نقاد سينمائيون ونقاد للأدب أيضاً بل وبعض الكتّاب والأدباء مثل الراحل يوسف إدريس والراحل مصطفى محمود).
الدرس الأول
كان الدرس الأول الذى تعلمته من الكتابين أن صناعة الأفلام عملية شاقة جداً، وأن هناك ثلاثة مصانع كبرى يخرج منها الفيلم: ورق السيناريو، والأستديو أو مكان التصوير عموماً، وحجرة المونتاج. من تلك اللحظة بدأت فى القراءة ليس فيما يتعلق بتفاصيل العملية السينمائية، ولكن فى كل مجالات الثقافة وخاصة الفنون المختلفة (موسيقى، مسرح، فن تشكيلى )، ومع الإنفتاح على المراكز الثقافية فى القاهرة أصبحتُ مطالباً بالقراءة فى كل المجالات تقريبا، وبسبب الأفلام عدت الى الأدب وعلم النفس والسياسة وعلم الإجتماع والفلسفة والتاريخ والجغرافيا.
بدا الأمر كما لو أن باب السينما ومشاهدة الأفلام هو باب الحياة نفسها. تدريجياً اختلفت نظرتى للأفلام بعد أن عرفت معنى “الفيلم الفنى” الذى يقدّم ما هو أبعد من التسلية، ومع تنوع المشاهدة والإنفتاح على نوعيات مختلفة من الأساليب والمدارس السينمائية أصبحتْ الحاجة أساسية للتحليل الدقيق للأفلام، وهنا بدأت القراءة المنظّمة لكل كتابات نقاد السبعينات والثمانينات والتسعينات بلا استثناء. اشتريت الكتب، واقتنيت أعداد ومجلدات نشرة نادى سينما القاهرة من سور الأزبكية العظيم، وقد وجدت بها دراسات رصينة ومعتبرة لأفلام شاهدتها وأخرى لم أشاهدها فقررت أن ابحث عنها.
تراكمت الأفلام والقراءات فأصبح هناك رصيد من المقارنات. نمت “ذائقة ما” فى المشاهدة وفى إبداء الرأى حول الأفلام. لم أكن أترك فيلما دون “دردشة” مع الأصدقاء حول عناصره وتحليلها. عرفتُ الندوات المتخصصة التى تُناقش فيها أفلام الكبار من مبدعى الفن السابع. لم أكن قد حددت حتى تلك اللحظة أننى سأكتب فى السينما. كانت كل الملاحظات التى أسجّلها لنفسى فى نوتة صغيرة أو فى أجندة كبيرة.
كنت أريد أن أعرف لماذا يبدو هذا الفيلم رديئاً حتى لا أصنع مثله لو أتيحت لى مستقبلاً فرصة صناعة الأفلام. كانت أمامى دائما نصيحة الراحل محمد كريم لتلاميذه بأن يستفيدوا أولاً من الأفلام الرديئة فلا يصنعوا مثلها، وبسبب تلك النصيحة لم أكن أغضب أبداً إذا وقعت على فيلم ردئ. عندما طُلبت منى الكتابة الإحترافية عن الأفلام كنت جاهزاً بصورة أدهشتنى، فقد كنت متابعاً لكل الأفلام، ومتابعاً لمهرجان القاهرة وأفلامه، وكنت أكتب نقاطاً حول الفيلم الذى أشاهده، ثم أستكمل الحديث عنه على المقهى مع الأصدقاء.
المقال الأول
عندما كتبتُ المقال الأول المطلوب لفيلم اسمه “الرقص مع الشيطان” بطولة نور الشريف وإخراج علاء محجوب، بدا لى كما لو أننى أقوم بتفريغ شريط رأيى الشفهى فى الفيلم حتى ببعض مفرداته العامية . لظروف ما لم ينشر المقال لتكون بداية النشر مع فيلم أكثر أهمية هو “أرض الأحلام ” إخراج “داوود عبد السيد “، والذى ظلّ حتى هذه اللحظة الفيلم الأخير لفاتن حمامة، وأذكر أننى ذهبت الى سينما “طيبة” بمدينة نصر فى أطراف القاهرة لأن الفيلم رُفع بسرعة من دور عرض وسط البلد.
تعلّمت من كتابات كل النقاد الذين قرأت لهم ومن كل الأجيال. حتى أولئك الذين لم يعجبنى أسلوبهم أو منهجهم أو آراءهم استفدت منهم بألا أكتب مثلهم. بعد فترة من الثقافة البصرية عن طريق مشاهدة الأفلام من كل الأنواع وبكل اللغات ومن مختلف المدارس والمستويات، ومن القراءة لكل الإتجاهات وبكل الأساليب، أصبح فى ذهنى سؤالان لابد أن يجيب عنهما ناقد الأفلام هما: ماذا يقول العمل ؟ وكيف يقول؟ ، وعليه دائما أن يقول “حيثيات” هذا الرأى.
هناك دائما قواعد ولكنها ليست كل شئ. كان محمد عبد الوهاب الموسيقار العظيم يقول: “لاشئ يعلو فوق الجمال”. لو كانت المسألة مجرد قواعد صماء نطبقها دون وعى لما كان للتجارب المختلفة لكبار المخرجين أىّ قيمة فنية بينما هذه التجارب تحديداً هى التى ساهمت فى تطور فن السينما واختلاف النظرة لتأثيره.
هناك عنصر هام جداً اسمه “الذائقة الجمالية”، ولكن هذه الذائقة لا تعنى ألا تعرف القواعد ، كما أنها ثمرة مجهود شاق جداً سواء فى المشاهدة أو فى القراءة عن السينما وعن كل شئ تقريباً. كلما كان العمل أكثر جمالاً كلما احتجنا مجهوداً أكبر فى تذوقه وفى نقل تفصيلات هذا الجمال الى القارئ. قرأت يوما أن عبد الوهاب لم يستطع أن يسيطر على قدميه عندما استمع لأول مرة الى لحن سيد درويش البديع ” أنا المصرى كريم العنصرين”، لم يستطع أن يتحمل سطوة الجمال الذى استمع إليه ولم يستطع أيضاً أن يفسّره فأخذ يعدو بلا توقف وسط دهشة المارة.
الناقد لديه مشكلة: عليه أن يستمتع كمتفرج، ولكن عليه أيضاً أن يكون فى مستوى هذا الجمال الساحر، عليه أن يستوعبه، ثم يبذل مجهوداً موازياً لمجهود المبدع لكى يكتب مقالا جميلاً عن فيلم عظيم. الحقيقة أن متعة النقد، والشهد القليل الذى يوفره، وإحدى مباهجه القليلة هى أنه رغم مسؤولية أن تكون على مستوى الجمال، إلا أنك تستمتع مرتين: مرة بمشاهدة الفيلم الرائع، ومرة بالكتابة عنه بعد أن تشاهده من جديد على شاشة الذهن.
الفيلم الجميل
الفيلم الجميل مثل المرأة الجميلة “تزيدك حُسناً كلما زدتها نظراً”. ولكن على الناقد أن يتحمل “الكثير من الأعراض الجانبية ” لمهنته، لا بل وبعض الدموع أيضاً، لأن الروائع فى كل فن قليلة ومعدودة، والنسبة العظمى للأفلام العادية والرديئة. هنا تتحول المباهج الى معاناة حقيقية، وتتحول متعة المشاهدة والكتابة الى عذاب مزدوج: مرة بمشاهدة فيلم ردئ، ومرة باستعادة خبرة مؤلمة بالكتابة عنه.
كتبتُ أكثر من مرة أن أمتع شئ أن تكتب عن فيلم رائع أعجبك لدرجة أن القلم ينطلق فرحاً على الورق، وأصعب شئ أن تكتب عن فيلم ردئ لأنك ستكون مضطراً ساعتها أن تسرد كتاب السينما من صفحته الأولى، ثم تناقش بديهيات معروفة، بالإضافة الى استعراض “حماقات” شاهدتها وتريد أن تنساها.
كررتُ فى كثير من مقالاتى أن الفيلم العظيم فرصة رائعة لكى تكتب مقالاً نقدياً عظيماً، أما الفيلم الردئ فأقصى ما يسمح به أن تكتب مقالا ساخراً جيداً جزاءً وفاقاً لسخرية صنّاع الفيلم من الجمهور وعدم اتقان صنعتهم أو مهنتهم. الفيلم الردئ مأزق للمتفرج مثلما هومأزق للناقد المطلوب منه أن يكتب مقالاً مقروءاً عن فيلم لا يوجد فيه ما يستحق لا القراءة ولا الكتابة، ومع ذلك لابد أن تكتب لأنك (كناقد) لا تشاهد الأفلام لحسابك الشخصى أو لمتعتك الذاتية، ولكنك تشاهد الأفلام لحساب القارئ. يقول طه حسين العظيم إن الناقد هو “مستشار” القارئ. نحن والمبدعون نقدم أعمالنا الى القارئ، وبالتالى ليس صحيحاً ما هو شائع من أن النقاد يكتبون لكى يستفيد النجوم من نصائحهم، بل إن المؤرخ والناقد الفرنسى جورج سادول ينصح الناقد بألا تكون له علاقة أصلاً بالمبدع، ويطلب منه حرفياً أن يسكن فى مدينة أخرى بعيدة التماساً لحرية الرأى والكتابة.
ثمرة النقد
لا يتعامل القارئ إلا مع ثمرة النقد وهو المقال المكتوب دون أن يتعرف على كيفية الوصول الى هذه الثمرة، فإذا كان المقال النقدى يتضمن حُكماً مبنياً على “قواعد وحيثيات” لمستوى فيلم معين، فإن هذا الحكم هو المرحلة الرابعة والأخيرة فى عملية قراءة الأفلام، لدينا قبل الحكم ثلاثة عناصر مركّبة ومتداخلة لابد أن يتناولها المقال النقدى: العنصر الأول هو عرض العمل الفنى. لا يعنى ذلك إطلاقاً أن تحكى قصة الفيلم وكأنك تسرد أدق تفصيلاته، ولكنه يعنى أن تعرض الفيلم من خلال وجهة نظرك، ومن خلال زاوية الرؤية التى اخترتها للحديث. يعنى مثلا : لو كنت تتحدث عن فيلم “شخصيات” فلا محل هنا لسرد حدوتة لا وجود لها أصلاً.
المهم فى هذه الحالة أن تحلًل الشخصيات ومدى ارتباطها بمغزى الفيلم أو معناه. عرض الفيلم يحتاج الى التكثيف والإختزال لأنك تخاطب به قارئاً من اثنين: إما أن يكون قد شاهد الفيلم فلا حاجة به إذن لأن تكرر له ما رآه، وإما أن يكون لم يشاهد الفيلم، وبالتالى قد تسرف فى التفاصيل فتحرقه عليه فيما أنت تود أن تدعوه لمشاهدة الفيلم.
لا حلّ سوى أن تعرض الفيلم بشكل مكثف من خلال زاوية الرؤية التى اخترتها لمقالك. أى أنك تعيد بناء الفيلم فى ضوء المقال ورؤيته وليس العكس أبداً. أما العنصر الثانى للمقال النقدى فهو التحليل والفك والتركيب. الناقد يقوم تقريباً بعكس ما يقوم به المبدع، فإذا كان صنّاع الفيلم يقومون بالبناء ومزج العناصر، فإن الناقد يقوم بتحليل العمل الى عناصره التى تكوّن منها بهدف اكتشاف الطريقة التى تعمل بها هذه العناصر بتكامل وانسجام (فى الأفلام الجيدة)، أوالطريقة “لاتعمل” بها هذه العناصر (فى الأفلام الرديئة).
دور الناقد
الفيلم مثل الآلة العملاقة المكوّنة من تروس كثيرة لو اختل منها أحد التروس لما دارت الآلة. دور الناقد (والتشبيه بالطبع لتبسيط الفكرة) هو الكشف عن دور كل ترس فى العمل، واكتشاف مواطن الخلل عندما يضطرب عمل هذه الآلة. أردت من هذا التشبيه أن أنقل لك مدى صعوبة التفكيك، وخصوصا فى تلك الأفلام الخادعة التى تجد فيها اتقاناً فى التنفيذ ولكنك تكتشف (لو تأملت قليلاً ) أن بناء الفيلم وعناصره الداخلية بها الكثير من الإضطراب.
أذكر أننى حضرتُ فى أحد الأعياد حفلة العاشرة والنصف صباحاً لفيلم “الوعد” الذى كتبه وحيد حامد وأخرجه محمد ياسين. كان الفيلم شديد الإبهار فى تنفيذه (أداء الممثلين، أماكن التصوير، الموسيقى، الصورة، مشاهد بأكملها مكتوبة بشكل جيد). رغم ذلك أحسست اعتمادا على الذائقة الناتجة عن مشاهدة الكثير من الأفلام أن هناك حلقة مفقودة وكأن مؤشراً داخلياً يتحرك بقوة ويقول لى: “هناك شئ خطأ.. هذه عمارة شاهقة جميلة بها خلل فى الأساس”.
شعرت بحيرة كبيرة، ولم يكن هناك حل سوى أن أشاهد الحفلة التالية فى نفس قاعة العرض. عدتُ الى نفس المقعد فى حفلة الواحدة والنصف. إذا كانت المشاهدة الأولى قد ركّزتْ على عناصر التنفيذ المبهرة، فقد قررتُ التركيز هذه المرة على علاقات الشخصيات ومسار الدراما لأكتشف الخلل الخطير فى سيناريو “الوعد” وهو أنه عبارة عن أربعة أفلام شبه منفصلة، ورغم أن كل فيلم متقن التنفيذ إلا أنه لا توجد وحدة تربط هذه الأجزاء. أى ان الآلة تبدو من بعيد وكأنها تعمل بشكل متسق بينما إذا اقتربت ستكتشف أن كل جزء منها يعمل جيداً ولكن بشكل مستقل.
لم يكن ممكناً الوصول الى هذه النتيجة لولا عنصر التحليل الدقيق لأهم عناصر الفيلم وهو السيناريو، ولو لم أصل الى هذه النتيجة لشاهدت “الوعد” للمرة الثالثة أو الرابعة حتى أكتشف المشكلة بشكل أطمئن إليه.
يبقى العنصر الثالث وهو عصب أى ناقد نضج. أتحدث هنا عن “المقارنة” التى تضع الفيلم فى سياق الأفلام المشابهة لنوعه، أو فى إطار مسيرة مبدعيه. لولا المقارنة ما استطعنا أن نحدد بدقة مستوى الفيلم أو درجة الجهد المبذول فيه. أنت مثلا يمكن أن تقبل فيلماً مثل “الطاووس” كعمل أول من مخرج مجتهد يكتشف أفلام التشويق ويريد أن يساهم فيها، ولكن الفيلم نفسه يتحول الى عمل متواضع من الدرجة الثالثة إذا كان من إخراج كمال الشيخ رائد التشويق لأن “مقارنة” أى فيلم من أفلامه الأولى (الأبيض والأسود) بفيلم “الطاووس” تجعل منه عملاً رديئاً.
الذائقة النقدية
الحقيقة أن “الذائقة النقدية” نفسها ليست فى الحقيقة إلا وليدة المقارنة بتراكم المشاهدة. لو افترضنا جدلاً أن شخصاً شاهد فيلماً ولم يشاهد غيره على الإطلاق. فى هذه الحالة فإن فن السينما كله لن يكون سوى هذا الفيلم. كلنا مررنا بهذه المرحلة فى طفولتنا لدرجة أننا كنا نعتقد أنه لا يوجد ممثلون فى الكون إلا هؤلاء الذين شاهدناهم فى هذا الفيلم الأول، ولكن مع مشاهدة أفلام جديدة تنشأ لدينا “القدرة على المقارنة” وتولد معها القدرة على إصدار الأحكام فنقول مثلا إن “أحمد السقا” أكثر اقناعا فى “أفلام الأكشن” من فريد شوقى. من هنا تأتى أهمية أن يشاهد الناقد أعداداً كبيرة من الأفلام، لأن ذلك سيزيد قدرته على المقارنة والحكم الأقرب الى الموضوعية.
حصاد هذا المزيج من العناصر الثلاثة ينتهى بنا الى الحكم على مستوى الفيلم ، والحكم مرتبط بهذه الحيثيات المتوافرة. قد تشاهد مثلا فيلماً تنبهر به وتحلّله وتقارنه بغيره من الأفلام التى شاهدتها. تمر سنوات وتكتشف أن هذا الفيلم منقول بالمشهد والحرف والتقطيع من فيلم أجنبى.
فى هذه الحالة سيتغير الحكم مع ظهور حيثيات جديدة. هذا ما أقصده من أن الحكم مرتبط باجتهاد الناقد فى “لحظة كتابة النقد” وليس حكماً أبدياً سرمدياً.
هناك بعد ذلك النقطة الأخيرة وهى الكتابة التى ترتبط بزاوية الرؤية التى يدور حولها المقال. مع الخبرة سيكون من السهل أن تكتب لو وصلت الى زاوية الرؤية أو مفتاح الفيلم (مثال: كتبتُ مرة مقالا عن فيلم “الناصر صلاح الدين” باعتباره فيلماً سياسياً صريحاً رغم أنه يُقرأ كثيرا على أنه فيلم تاريخى أو دينى.. كانت كل حيثيات وشواهد وتحليل عناصر الفيلم تدور حول هذا المفتاح ولا تتجاوزه أو تستطرد بعيداً عنه).
تجربة
لابد ان أذكر لك أيضاً أننى خُضْتُ تجربة شديدة الصعوبة بكتابة مقالين أسبوعياً عن نفس الفيلم: أحدهما مقال طويل فى جريدة يومية، والثانى مقال أقرب الى العمود المكثف فى مجلة أسبوعية. لم تكن الصعوبة فى المساحة ولا فى محاولة الإضافة والإختلاف ولكن أيضا فى تغيير الأسلوب وزاوية التناول بل والخاتمة مع المحافظة على جوهر الرأى، وكانت الصعوبة الأكبر فى المقال الصغير وليست فى المقال الكبير.
خُضْتُ أيضاً تجربة الكتابة لمطبوعة سينمائية متخصصة هى “السينما الجديدة” الصادرة عن جمعية نقاد السينما المصريين. فى هذه الحالة لم أكن مضطراً لشرح المصطلحات السينمائية أو الفنية، ولكنى حاولت دوماً أن أكون فى كل ما أكتب سهلاً واضحاً لا أتردد فى تكرار الشرح والتفسير كصديق يجلس مع المتفرج بعد مشاهدة الفيلم. لا أترك حكماً دون أن أدلل عليه بالأمثلة والشواهد من الفيلم وليس من خارجه.
لا أتردد أبداً فى استخدام لفظ عامى أراه أكثر وصولا للقارئ من لفظ فصيح مهجور، فى الافلام الرديئة تنطلق حاسة السخرية الى مداها الأقصى. لقد آمنتُ دوماً أن أسوأ نقد هو الذى لا يفسر الفيلم، ولكنه يجعله أكثر غموضاً. فى كل الأحوال، لابد من العناية بكل عناصر المقال كالعنوان وبناء الفقرات بحيث تتناول كل فقرة فكرة محددة، مع ضبط بناء المقال بأكمله بدون استطراد أو إيجاز مخلّ.
لا أكتب ابداً أثناء مشاهدة الفيلم فى دار العرض، ولكنى أنتهز فرصة الإستراحة لتسجيل بعض العناصر التى تشكل فيما بعد حوالى 80% من جسد المقال. بدون مفتاح المقال أو هذه العناصر لا يمكن أبداً أن أكتب أى مقال، أما المفتاح نفسه فيمكن أن أصل إليه بعد المشاهدة أو أثناءها، بل قد يقفز الى الذهن أحيانا عنوان المقال ومفتاحه معا، وقد أكتب العنوان بعد أن أفرغ تماما من الكتابة. ولكنى أكتب فى كل الحالات بحرية شديدة وكأننى أقوم بتعويض التوتر الناشئ فى الفترة من انتهاء المشاهدة الى الكتابة، وفى كل الحالات لا أخجل من الحماس للفيلم الجيد ولا أشعر بالذنب من الهجوم العنيف الساخر على الفيلم الردئ.
انحياز
أما الأفلام التى أنحاز لها وأشجعها فهى إما أفلام فنية تقّدم تجارب مختلفة “ناضجة” و”أصيلة”.. أو الأفلام التجارية جيدة الصنع التى تدور فى فلك النوع ولكن بدرجة عالية من الإتقان، وقد كررتُ فى أكثر من مقال أننا أحببنا السينما من هذه النوعية التجارية المتقنة، ولولاها ما انتقلنا الى درجة تذوق الأفلام الفنية.
لو شاهدت فيلم “جنجر وفريد” لفيللينى أو “اليوم السادس” ليوسف شاهين لعلمت أن اثنين من مبدعى الأفلام الفنية فى العالم وفى مصر لم يرتبطا بالسينما إلا من خلال النماذج المتقنة من أفلام الأنواع. تقريباً لم أجد مشاهداً يبدأ تذوق السينما بالأفلام الفنية، وإنما لابد أن يحب السينما ويرتبط بها من خلال أعمال أكثر بساطة وأقل تعقيدا فى البناء. أظن أيضاً أن متفرج الفيلم التجارى جيد الصنع هو مشاهد افتراضى قادم للفيلم الفنى بحثاً عن المزيد من المتعة والإكتشاف.
كتبتُ مقالات كثيرة عن أفلام مصرية وعربية وأجنبية بعضها أقرب الى الدراسة. لا أعرف فيم أصبت وفيم أخطأت، ولكنى اجتهدت ما وسعنى الإجتهاد، ولم أفقد أبدا متعة ولا بهجة دخول السينما لمشاهدة الأفلام لدرجة أننى لا أستطيع الكتابة حتى اليوم عن أى فيلم من خلال شاشة كمبيوتر مثلاً. حاولتُ دائماً أن أجعل الناس تحب السينما.
لم أشعر أبداً أن السينما مدينة لى بل أنا المدين لها لأنها فتحت أمامى بوابة الحياة كلها. لم أنس ابداً أننى ذلك الطفل الصغير الذى دخل الى الشاشة البيضاء، والذى ظل يحكى لزملائه عن السعادة التى شعر بها ، ويحرضهم على أن يخوضوا مثله تجربة المشاهدة والإستمتاع.
تغيرتْ المواقع واتسعتْ التجربة وزادتْ الخبرات، ولكن شيئاً واحداً لم يتغير أبداً وهو صوت “ندّاهة الأفلام ” التى تطاردنى فى أى وقت، فأترك كل شئ لكى أعود من جديد الى قاعة مظلمة تقودنى الى داخل عالمى الساحر وبيتى الجميل الذى لا أرتضى عنه بديلاً رغم دورات الشهد والدموع : الشاشة البيضاء.