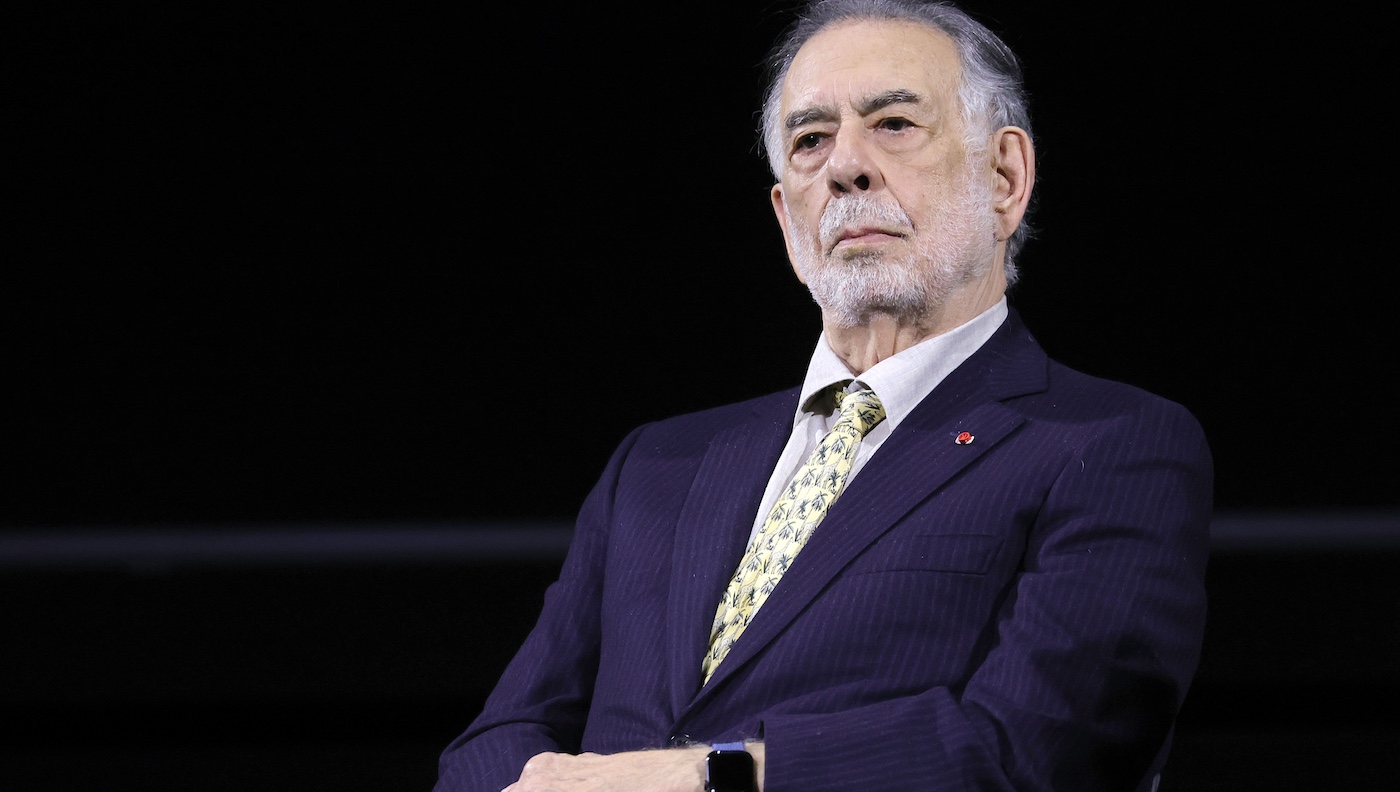“مولود في غزة”.. سردية الحرب بلسان الطفولة المعذبة

نهى غنام- فلسطين
يستهل الفيلم الوثائقي “مولود في غزة” للمخرج الإسباني هيرنان زين انتاج عام 2014، لقطته الافتتاحية بأمواج البحر التي ترتطم بالكاميرا، وتتداخل مع الموسيقى المؤثرة لتشكلان أهم بنيتين للخطاب السردي في الفيلم (الصورة والصوت)، ثم سرعان ما يدخل الطفل محمد الى كادر الصورة ويبدأ برواية قصته وسط مكب النفايات الذي يعتاش منه إيذاناً ببدء مجموعة أخرى من قصص الأطفال، فيما تأخذ الكاميرا وضعية التصوير البطيء slow motion التي لعبت دوراً مهماً في إحداث التغيير على تقليدية الفيلم الوثائقي، وقدمت صورة مختلفة تحقق عنصر الجذب بالبطء وليس السرعة كما هو متعارف عليه.
ولعل التشابه المعتاد في أحداث المراحل التاريخية لغزة الذي يربط بين العدوان الاسرائيلي على القطاع في العام 2014، ضمن ما أطلق عليه الاحتلال عملية الجرف الصامد، والإبادة الدائرة حالياً بحق أبناء القطاع هو ما يرجعنا الى الفيلم ويدفع بنا لتحليله.
فقد تجرعت غزة مرارة الحروب والحصار عبر تاريخها، وقدمت من الخسارات المادية والبشرية ما استدعى توثيق حالة هذه المدينة الصابرة، عبر سلسلة من الأفلام الوثائقية التي عرضت بواقعية ما يجري في هذه البقعة الصغيرة دون أدنى تشويه للحقيقة أو لبنية الفيلم الوثائقي، والمفارقة ان مخرجي تلك الأفلام ينتمون لمختلف دول العالم وعبروا عن القضية الفلسطينية بصورة تكاد تكون أكثر حرفية وإبداع من المخرجين العرب.
استمرت حرب 2014 التي أسمتها المقاومة العصف المأكول لمدة 50 يوماً، استشهد فيها 551 طفلا، وقد تصاعدت أحداثها بسبب قيام مستوطنين بتعذيب وإحراق الطفل المقدسي محمد أبو خضير، جرى بعده قصف متبادل بين إسرائيل والمقاومة، وقد انتهت الحرب دون أن يحقق الاحتلال هدفه المعلن من العملية، وهو وقف اطلاق الصواريخ من غزة، غير أنه مارس اقسى أنواع العنف والترهيب ضد الأطفال الأبرياء الذين فقدوا خلال العدوان براءتهم وأجزاء من أجسادهم وأفراد عائلاتهم، فتجدهم في الشهادات على المجازر وفقد الأحبة رجالاً أشداء يكسبون رزقهم بعرقهم وقادرين في الوقت نفسه على مواجهة الكاميرا بأريحية لسرد قصصهم التي لم يعشها غيرهم.

لم يسرد الأطفال حكاياتهم فقط، انما سردوا قصص متعلقة بكل مظاهر الحياة من حولهم، والتي اثرت عليها الحرب، فأخرجوا أنات الأيتام والمصابين والمرضى والنازحين الذين بقوا بلا مأوى أو مصدر للرزق، في حين مال أغلبهم صوب البحر لممارسة حرفة الصيد التي أنقذت الغزي من مآزق استمرارية دخوله وخروجه من الحروب.
وقد سلط الفيلم الضوء على كل تجربة بصورة فردية، لخصوصية الحكايات التي مر بها الأطفال ونتج عنها سوء الظروف التي عاشوها، ولم يتعارض ذلك مع حديثهم عن طموحاتهم وامنياتهم ورغبتهم في التنفيس وممارسة نشاطات الحياة بشكل طبيعي.
استمرت وتيرة النسق السردي التتابعي للمشاهد لمجموعة من قصص الأطفال الذين واجهوا ويلات الحرب ولمست حياتهم، بل قلبتها بشكل مباشر، ثم تحول السرد الى النسق الشخصي باستخدام عناصره الفنية القائمة على التجارب الشخصية الحقيقية للفرد التي وثقها الأطفال الذين تحدث كل واحد منهم عن قصته بصورة واقعية، فيما تبعته الكاميرا لتوثق ما يسرد على لسانه بكل مصداقية.
صنع كل طفل من المتحدثين حالة خاصة بسرد تجربته، ولعل إدارة المخرج للكاميرا وتكاتف باقي العناصر الفنية هو ما أظهر القصص التي تروي فظائع الحروب بهذه الجاذبية وبهذا القدر من التعاطف، وقد عرضت تجارب الأطفال العديد من القضايا المتعلقة بآثار الحرب، منها التسرب المدرسي للعمل وإعالة الأسرة، وتدمير المنشآت الزراعية والصناعية التي تعد مصدراً للرزق، ومشاكل النزوح وعلاج المرضى الذين يعانون من السرطان، بالإضافة الى الأطفال الذين بقيت شظايا الاحتلال في أجسادهم شاهدة على جريمة قصفهم وهم يلعبون على الشاطئ، وقد تعرض بعضهم لتشوهات خلقية أثرت على نمط حياته، وكشف حجم التعامل مع هذه الحالات كفاءة الكادر الطبي في مستشفيات وغزة وقدرته على مواجهة الظروف القاسية، ليس بعيداً عن ذلك تفاقم حالات اليتم وارتفاع نسبة الأطفال الذين يعيلون أسر بأكملها، والتزايد الملحوظ في الاضطرابات النفسية لديهم.
تم التركيز على اللغة الفنية للفيلم من خلال أحجام وزوايا وحركات الكاميرا، بالإضافة الى الخفة والذكاء في المونتاج، فاستخدم المخرج اللقطة المتوسطة عند الحديث مع الشخصيات على مستوى النظر للتمكن من التركيز على اللغة الجسدية أثناء حديثهم، وانتقل من خلالها الى اللقطة الواسعة التي هدفت الى تصوير رحابة المكان وحجم الدمار الذي ألّم به، مقابل عرض الشخصيات كجزء من القصة العامة التي اتسمت بالحزن والمعاناة ببساطة الواقعية وتلقائيتها ودون أي تكلف من الساردين.
فيما أبدع في توظيف اللقطة من زاوية منخفضة لإظهار مدى جلد وقوة الطفل الذي يقف على أنقاض منزله المدمر كلياً، يفصل معاناته ويسرد أمله بالقادم رغم فداحة الخسارة التي تعرض لها جراء العدوان، كما تحركت الكاميرا الى الامام والخلف بطريقة خلقت نوع من الحيوية الجاذبة ومهدت للدخول الى المكان.

وتم استخدام الخطوط بحرفية في تكوين الصورة الواقعية لقصة الفيلم، فعلى الرغم من الدمار الذي حل بالبيوت الا أن التركيز على أفقية النوافذ الثابتة في الجدران المهشمة، وفوضوية الأسياخ الحديدية النافرة من الإسمنت المدمر، عبرت عن حدة الموقف وبلاغة حجمه الحقيقي.
لعبت المؤثرات الصوتية دوراً مهماً في التعريف بهوية المكان وعكس الشعور العام به، وعززت من التعاطف مع القصة، وأبرز هذه المؤثرات أصوات الأجواء العامة للبحر والهواء وصخب الأطفال وهم يلعبون بالإضافة الى أصوات القصف.
وعلى الرغم من ان الموسيقى لعبت دوراً محورياً في بداية الفيلم، الا أنها تراجعت لصالح السرد الصوتي في منتصفه، وترك المجال لصوت الشخصيات، التي حرص المخرج على الموازنة في ظهورها كما وازن في عرض مظاهر الحياة كصيد السمك والسباحة واللعب في الحدائق العامة مقابل مشاهد الدمار المرعبة التي تسببت بها الحرب.
يعتبر تقديم المعلومة وتفسيرها بمجموعة من الوسائط الفنية داخل الفيلم هدفاً رئيسياً من أهداف الفيلم الوثائقي، وقد شكلت الأرقام محور هذه المعلومات وتم عرضها بطريقة تقطيع ذكية لم تجرح العين أثناء عرضها بين القصص المختلفة، لقد رفعت الحرب نسبة البطالة في غزة الى 45 بالمئة، وحولت 80 بالمئة من سكان غزة الى عاطلين عن العمل ومحتاجين للمساعدات، فيما أجبرت 42 ألف أسرة تعتاش من الزراعة على ترك مزارعها فصحرت بذلك 42 ألف دونم من هذه الأراضي، وقد ترتب على ذلك العديد من المشاكل والمعاناة فيما بعد.
اختتم الفيلم كما بدأ بلقطة من البحر، ولكن المختلف أن محمد الذي جمع (الزبالة) في البداية سبح فيه ولاطم أمواجه بحرفية سباح ماهر، لقد بدا الطفل الرجل وكأنه يواجه قدره أثناء السباحة، حاله حال مدينته الحزينة التي لم تفلت من الحرب على مدار تاريخها لكنها تعيش ومتمسكة بالحياة، كانت هذه الرسالة النهائية للفيلم، ولكن قبلها صورت الكاميرا بحركتها البطيئة مجموعة من الأطفال الضاحكين الذين يركضون باتجاهها وكأنهم يخرجون من الشاشة لإعطاء المتفرج حضناً ودرساً بالحياة، ويتأخر أصغرهم وأكثرهم ضحكاً وحيوية في لقطة ذكية خرج فيها من كادر الصورة ببطء وأمل.