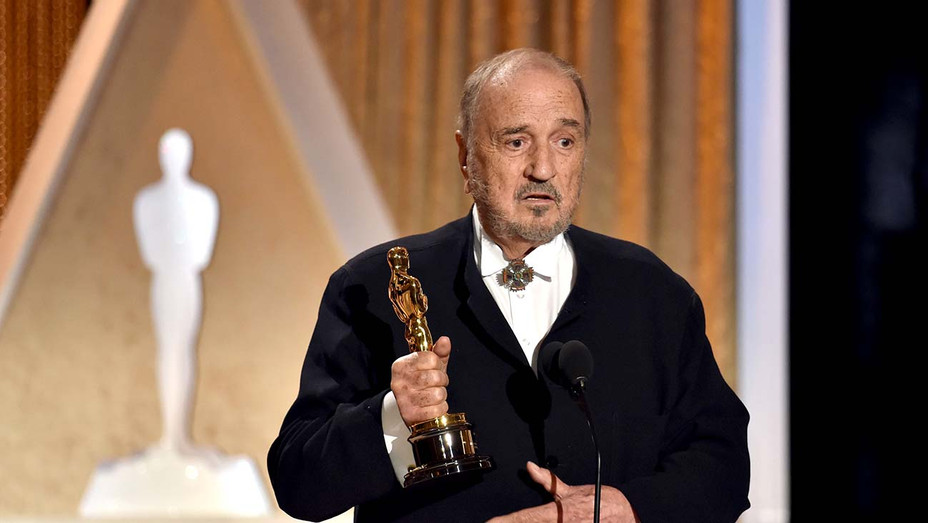ملامح المشوار السينمائي عند المخرج محمد خان

مساء الثامن عشر من فبراير 1980 في إحدى قاعات العرض بوسط القاهرة، الجمهور يدخل القاعة لمشاهدة فيلم جديد للنجم نور الشريف بعنوان “ضربة شمس”، يبدو من الأفيشات أنه سيكون عملا مثيرا من النوعية التجارية، فوجه نور يظهر على الأفيش في وضع تأهب ممسكا بكاميرا غريبة الشكل، داخل عدستها الممثلة نورا تكتم صرختها، ووراءه ليلى فوزي تصوب فوهة مسدسها للمشاهد، بينما ينطلق في أسفل الأفيش قطار سريع ودراجة بخارية وسيارة. لا يوجد ما هو أكثر إيحاءا بالأكشن والمطاردات الممتعة، لكن المفاجأة الحقيقية هي أن الفيلم سيحمل مفاجآت أكبر بكثير من التوقعات.
التترات تبدأ على كادر غير واضح المعالم، مساحة بيضاء يحتوي يمينها على حركة تشعرك للحظة أنها منتظمة، لكنك تتراجع عن هذا الشعور عندما تجد أن سرعتها تختلف من ثانية لأخرى، ومع اقتراب التتر من نهايته، تبدأ الصورة في التحول للوضوح تدريجيا، لتكشف عن حقيقة اللقطة التي لم ندركها في البداية، فهي لقطة مصورة من شباك مرتفع لأحد شوارع وسط القاهرة المزدحمة، والحركة على يمين الكادر هي الأمواج المتتالية من السيارات، المزدحة بعشوائية هارمونية، تتحول أحيانا لفوضى كارثية وأحيانا أخرى لصورة مثالية للنظام. القطع الأول للقطة خارجية تأسيسية توضح لنا هوية المكان: شقة صغيرة أشبه بالاستوديو تطل على المدينة، قبل أن تدخل اللقطة الثالثة مباشرة إلى داخل الشقة، وإلى صلب المفاجأة.
أمام المرآة تقف نورا، فتاة جميلة في نهاية العشرينيات، تقوم بارتداء بلوزتها أمام حبيبها شمس بصورة لا يمكن أن تعني إلا أنهما قد فرغا لتوهما من ممارسة الجنس، تنظر في مرآة بجوارها لوحة لامرأة عارية تؤكد نفس المعلومة، يبدو من اختيارها لملابسها أنها فتاة عملية على طراز نهاية السبعينيات، من جيل الباحثات عن الاستقلال والمتأثرات بثورة أوروبا الثقافية ـ وربما الجنسية ـ بينما ينشغل شمس عنها بتنظيف عدسات الكاميرا التي تبدو أهم عنده مما سواها. ديكور المكان المحيط يكرس لنفس ما تقوله ملابس الفتاة: الحرية الحداثية، ولكن الحديث الذي تبدأه سلوى ويتابعه شمس على مضض يقول العكس تماما. فالفتاة المتحررة التي مارست الجنس لتوها في ستوديو بوهيمي الطابع تتحدث كأي فتاة مصرية عن متاعب تبرير العودة المتأخرة للمنزل، وتسعى لانتزاع قرار من حبيبها بأن يكون أكثر تقليدية، أن يفتح ستوديو كمصور كلاسيكي، أن يترك مهنة مصور الصحافة بمتاعبها وعدم استقرارها، والسطر الخفي هو بالطبع: أن يأخذ خطوة أكثر جدية في مسار علاقتهما، حتى يقوم شمس بخطوة تنهي كل شيء، عندما يجذبها نحو السرير ليقبلها قبلة حارة تنهي الحوار برمته.
بعد الحديث ينطلق شمس بدراجته البخارية ووراءه حبيبته، التي تطلب منه بيع الدراجة وشراء سيارة، مرددة أكثر جملة ذكرتها المقالات النقدية التي كتبت عن الفيلم، بأنها ترغب في أن تكون بجواره وليس خلفه. الكثيرون فسروا الأمر بأنه يحمل مجازا لفظيا لرغبتها في الحرية، وهو أمر يحمل قدرا من الصحة، لكن إذا لم نعزل الجملة عن سياق الحديث الذي بدأ في المشهد السابق، فهو تعبير أيضا عن رغبة سلوى في حياة أقل غرابة، حياة تركب فيها سيارة مغلقة بجوار زوج، بدلا من ركوب دراجة بخارية خلف حبيب مندفع يتحرك بالدراجة كما لو كان فارسا يمتطي جوادا غير مروض. يتركها لتبدأ حياتها اليومية بينما ينطلق هو بدراجته ليلتقي صدفة بزميله في العمل، الصحفي رب الأسرة الطيب المنشغل بشراء ملابس جديدة بصحبة زوجته وأطفاله الثلاثة.
التتابع السابق الذي لا يشغل على الشاشة أكثر من عشر دقائق لم يقم فقط برسم شخصيتي شمس وسلوى للمشاهد بحذق وبلاغة سردية مثيرة للإعجاب، ولكنه حمل بداخله بذور مشروع سينمائي كامل، ورسم الخطوط الأولية لملامح مشروع فني لمخرج كان ظهوره طفرة حقيقية في تاريخ السينما المصرية، وهو أسلوب سيتستمر طويلا ويأخذ في التبلور واكتساب الخبرات وخوض التجارب ليصنع عالما كاملا اسمه سينما محمد خان. هذا العالم المبهر في تفاصيله، والممتد لأكثر من ثلاثة عقود، هو ما سنحاول إلقاء نظرة عليه في هذه الدراسة انطلاقا مما تحمله تتابعات بداية العمل الأول من دلالات أسلوبية وموضوعية، بكل ما يحمله هذا من تأكيد على وعي صانع الأفلام الذي أدرك من اللحظة الأولى أنه ملزم بتقديم الجديد، فرسم مسارا وانطلق فيه بلا توقف، حتى تمكن من صناعة نموذجا خاصا بالسينما “الخانية”، وهو مصطلح صار مستخدما سواء في وصف أعمال المخرج الكبير أو أي عمل يقترب في أسلوبه منها، وأصبحت دلالته مفهومة في ذهن من يسمعه، بما لم يكن ليحدث أبدا مالم يمتلك محمد خان هذا القدر من الخصوصية والتفرد.
فكيف حملت تتابعات البداية في ضربة شمس الملامح الأولى للسينما الخانية؟ دعونا نتعرف على هذه الملامح الفريدة.
أولا: الشغف
محمد خان عاشق أصيل للسينما، شغوف بها، عاش أعوام طويلة قبل احترافها هاويا لها، يتابع كافة أشكالها وأنواعها، ويتنقل بين قاعات العرض في القاهرة ولندن، حتى جاءت اللحظة التي قرر فيها أن يتحول هذا الشغف إلى إبداع. ولأن خان ليس شخصا عاديا بل هو عاشق ومفكر، فإن شغفه ووعيه كان لابد وأن يكونا الذراعين المحركين لمشروعه، وللكثير من شخصياته كذلك. ومثلما قال الأديب الألماني توماس مان إن “اللامبالاة وحدها تكون حرة. ما هو مميز لا يكون حراً أبدا، إنه مدموغ بختمه الخاص، مشروط ومكبّل”، فإن هذا الوصف يمكن تطبيقه بدقة على محمد خان وسينماه، فقد كان هو مكبّلا بصدقه وإبداعه وشغفه بالسينما ورغبته في التغيير عبرها، وهي تقريبا نفس السمات التي ميزت أبطال عالمه، ومنهم بالطبع بطله الأول شمس.
شمس هو الآخر مكبل بموهبته وشغفه، بعشقه للتصوير وانتزاع اللحظة وتجميدها في صورة فوتوغرافية (وهل السينما إلا فعل نفس الشيء على صور متتابعة؟)، وهو شغف يمنعه من أن يكون مجرد آخر مثل الآخرين، ويجعل ولعه بكاميرته وعدساته أكبر حتى من خشيته على حياته وحياة من حوله، فهو لا ينتمي إلا لذاته، ولا تحركه سوى هذه القوة الداخلية التي قد تتعارض في كثير من الأحيان مع المنطق الذي يعيش الآخرون وفقا له، والذي تحاول حبيبته أن تجعله يتسرب إليه ولو قليلا. شمس مثله مثل فارس بطل “طائر على الطريق”، الشغوف بحريته وتحليقه خارج السرب، فهو ليس مجرد سائق بيجو آخر، ومحركه الرئيسي ليس كسب الرزق، بل هو هذا الدافع الداخلي الذي يحركه لينطلق بسيارته كالطائر ويناطح الإقطاعي القاسي ويدخل قصة حب محكوم عليها بالفشل، فقط ليرضي هذا الشغف الداخلي الذي يستحيل السيطرة عليه ولو كان الثمن هو حياته نفسها.
بإمكانك استخلاص العديد والعديد من الأمثلة على كون الشغف عاملا محركا لشخصيات عالم محمد خان، والذي يكون أحيانا مفهوما كوله الضابط هشام في “زوجة رجل مهم” بالسلطة بصورة قادته في النهاية للجنون والانتحار، وأحيانا غير مفهوم كهذه النزعة المدمرة للذات المسيطرة على حياة فارس “الحريف”، والتي تجعله غير قادر على الظهور بصورة سوية في كافة المهام المطلوب منه تأديتها، فهو نصف أب ونصف عامل ونصف لاعب، ليس لأنه لا يمتلك الأسباب الكافية للنجاح، ولكن لأن هناك قوة داخلية تمنعه من أن ينجح بالفعل.
الشغف بالسينما جعل محمد خان ينتقل من حياة مستقرة في لندن ليأتي ويغامر في القاهرة، ويواجه كل تحديات المشوار حتى يصبح واحدا من أهم المخرجين في تاريخ السينما العربية، والشغف هو ما دفع شمس لخوض مغامرة تقول كل الحسابات المنطقية أن عليه الابتعاد عنها، والشغف هو هذا الدافع الحاضر دائما في نفوس أبطال السينمال الخانية، محركا لهم ودافعا إياهم نحو مصائرهم المختلفة، تماما كما دفع صانعهم لبدء مشوار طويل وصعب.

لقطة من فيلم “ضربة شمس”
ثانيا: الفروسية
إذا كانت هناك قيمة واحدة يمكن أن نقول أنها الأبرز في مشروع محمد خان السينمائي فستكون بلا جدال هي الفروسية، بل يمكن أن نقول أنها القيمة الأكثر انطباقا على شخصه وتجربته مع الحياة. فالفروسية كما عرفها التاريخ العربي كمصطلح والتاريخ بأكمله كحالة تقول على سمتين أساسيتين، الأولى هي الفارس المؤمن بفكرة أو قضية أو نسق حياة، والمستعد للدفاع عن إيمانه لأبعد الحدود والتضحية من أجله حتى ولو بدت قضيته خاسرة أو وقف الجميع في وجهها، والثانية هي امتلاك هذا الفارس لقدرات خاصة ومواهب تميزه عن الآخرين وتخلق منه أسطورة تعيش في الأذهان. وما تجربة خان إلا انعكاسا لهذه الحالة؟
فهو لا يحمل الجنسية المصرية إلى يومنا هذا، لكنه أكثر مصرية من ملايين يحملون الاعتراف الرسمي، يعرف مصر بتفاصيلها ويذوب فيها عشقا ويعبر عنها كما لا يمكن لغيره أن يفعل. وهو هاو لم يدرس السينما في المعهد الذي يمنح دارسه جواز المرور الذي يجعل طريقه أسهل كثيرا ممن أتى من خارجه، ولكنه شق طريقه ممتشقا سيف موهبته حتى بلغ مكانته في قلوب عشاق السينما في كل مكان. فروسية خان تتمثل أيضا في نوعية السينما التي اختارها، فهي سينما بعيدة عن الذوق الاعتيادي للمشاهد المصري، سينما لا تستخف به ولا تداعب عقلة بحبكة مباشرة أو تدعم القيم الساذجة التي اعتادت الأفلام أن تدعمها، سينما كانت مهددة في كل لحظة من مشوار صانعها بالفشل، وبأن يكون الفيلم الذي يصنعه هو فيلمه الأخير، لكنه تمكن أن يستكمل المسيرة فيلما بعد فيلم، متلاعبا بكل السبل الممكنة حتى لا يتنازل أو يقدم عملا لا يؤمن به، حتى توج فيلم فروسيته بأكثر المشاهد تحريكا لمشاعر أي عاشق للسينما: مخرج قدير صاحب فيلموجرافيا مخيفة للكبار قبل الصغار، يصور فيلما روائيا طويلا بكاميرا ديجيتال صغيرة مثل التي يستخدمها شباب الصنّاع، ليكرس بفيلمه “كليفتي” للفكرة في وقت كان الجميع يتأففون منها، ويعطي درسا بليغا ورسالة واضحة بأن الاستمرار في الإبداع هو الأمل والغاية، وأن الروح الشابة المستعدة لتجربة الجديد لا ترتبط بالسن ولكن ترتبط في حالة خان بالفروسية، فالفارس لا يستسلم ولا تكسره الرياح ولو انحنى لها قليلا، ليخرج منها أكثر قوة وقدرة على العطاء.
نفس الفروسية تلمحها في شخصيات السينما الخانية، ولا يوجد دليلا أوضح من لعب شخصيته المفضلة التي تحمل اسم فارس لدور البطولة في ثلاثة من أروع أفلامه “طائر على الطريق” و”الحريف” و”فارس المدينة”. هذه الشخصية التي تطورت عبر الزمن لتتجلي في صورتها الأوضح في “فارس المدينة” تحمل داخلها تصور محمد خان الخاص عن الفروسية، ففارس بطل حر، يعيش خارج الأطر المحفوظة ولا يحركه سوى دوافعه وشغفه للحياة، ولكنه وعلى العكس مما قد يبدو عليه لأول وهلة، ليس عدميا أو لا أخلاقي، إنه فقط لا يؤمن بمنظومة القيم والأخلاق الدارجة، ويستبدلها بمنظومة قيم خاصة يطبقها بإيمان كامل، وهو مستعد للدفاع عن قيمه هذه حتى النهاية، ومهما كلفه هذا من ثمن.
ففارس “طائر على الطريق” يقيم علاقات جنسية غير شرعية، لكنه ينهيها فورا عندما يعلم أن طرفها سيدة متزوجة، فهو أنبل من أن يفعل ذلك (وهو الموقف الذي يغيره لاحقا من أجل موقف أكثر اتساقا مع فروسيته هو الانتصار على الإقطاعي الديكتاتور الذي وقع في غرام زوجته)، وفي الحالتين لا يهم فارس كثيرا تعقيدات الشرعية الأخلاقية العامة للأمر، ولا يهمه كثيرا رأي الناس فيه، فهو صاحب منطقه الخاص الذي يخض فقط لشروطه، تماما مثل فارس “فارس المدينة” الذي صنع ثروته بطرق عديدة معظمها مخالف للقانون، لكنه لا يفر بثروته مثل الكثيرين، بل يصمم على امتصاص حياته وممتلكاته لآخر قطرة، فقط ليلتزم بعهد قطعه على نفسه، وأمثاله لا يحنثون بوعودهم، وكيف يمكنه أن يفعل ذلك واسمه ـ شديد الدلالة ـ هو فارس حسن الهلالي؟
لن تحتاج لكثير من الجهد لتلمح نفس الفروسية مبكرا في شخصية شمس بطل أول أفلام خانه، فهو مثله مثل صانع الفيلم: فنان موهوب ومغامر، يندفع حتى النهاية للانتصار لما يحبه ويتقنه ويؤمن به، حتى لو كان التحدي يبدو عسيرا أو مخيفا لمن سواه، فهم ليسوا ببساطة ليسوا فرسانا مثله!
ولأن الارتباط الأول لفظيا ودلاليا للفارس في ذهن الجميع هو ارتباطه بفرسه، الأداة التي يمتطيها ويتنقل بها والتي اشتقت كلمة “فارس” من تطويعه لها، فإن هذا الارتباط يتجلي في كل أفلام محمد خان تقريبا بصورته المعاصرة. فأبطال خان يمتلكون علاقة خاصة بمركباتهم، ولمشاهد تجولهم في الشوارع وانطلاقهم بها حضور دائم في السينما الخانية. الأمر الذي ظهر مبكرا جدا في علاقة شمس بدراجته البخارية التي يتحرك بها كالفارس طوال مغامرته، والذي امتد ليصير البطل طائرا على الطريق بسيارة أجرة، أو شابا مغامرا يخوض رحلة غير متوقعة بسيارته الفارهة في “مشوار عمر”، أو فارس حقيقي يركب جوادا عربيا في “الغرقانة”، أو حريف شوارع مغمور يجد نشوة حرم منها طويلا في جولة بسيارة صديقه الذي تنازل ليصعد، أو حتى في فتاتين متواضعتي الحياة والأحلام يركبان مترو الأنفاق يوميا ليكون فرسهما الذي يخوضان به مغامرة الحياة في مدينة قاسية كالقاهرة.

لقطة من فيلم “طائر على الطريق”
ثالثا: عشق المدينة
يقول الأديب البريطاني لورنس داريل في عمله الأشهر “رباعية الأسكندرية” أن المدينة تصير عالما عندما يحب المرء أحد سكانها. فما بالك لو كانت هذه المدينة هي القاهرة؟ وما بالك لو كان هذا المحب هو محمد خان؟ وما بالك لو لم يكن قد أحب أحد سكانها، بل أحب سكانها جميعهم، بطباعهم الحسنة والسيئة، بشهامتهم وقسوتهم وخستهم أحيانا؟
للقاهرة في سينما خان مكانة خاصة، فهي مدينة طفولته وصباه وشبابه، التي تصعلك بشوارعها وتسلسل إلى قاعات السينما فيها، والتي تعلم في مسالكها أنه إذا أراد أن يكون مبدعا حقيقيا، فعليه أن يجمع بين رهافة العاشق الباريسي وكياسة السيد البريطاني ومهارة وحذق النصاب القاهري خفيف الظل، الذي يتحايل على الدنيا ليضمن وجوده، ويتلاعب بالآخرين دون أن يكرههم، ويمتص الحياة حتى آخر قطرة فيها، عليه ببساطة أن يصير “كليفتي” يسرق الكحل من العين دون أن يدميها، ويسرق اللقطة من الشارع فتظهر جماله دون أن تخفي عيوبه، ليعبر بها عن تعقد هذا الشارع غريب الأطوار الذي يمكن تقتل فيه الناس بعض ويبيعون فيه العرض، لكنه يحول “البوسة” فيه إلى فضيحة كما تقول قصيدة أمينة جاهين التي حولها فيلم “الحريف” لأيقونة.
وفي مقاله عن فيلم “ضربة شمس” كتب الناقد الراحل الكبير سامي السلاموني واصفا القاهرة وصفا لا ينسى بأنها مدينة تكره التصوير، وهي وصف صار حقيقة يدركها الجميع في عصرنا هذا، الذي صارت الجميع فيه يمتلكون كاميرات، لكنهم يعانون الأمرين من أجل التقاط ولو صورة فوتوغرافية في أحد شوارع عاصمة الألف مئذنة والألف ألف حلم. السلاموني كتب وقتها عن الإنجاز الذي حققه محمد خان بصحبة صديقه ورفيق صباه مدير التصوير الكبير سعيد شيمي عندما خرجا بالكاميرا ليصورا معظم أحداث الفيلم في شوارع العاصمة، متنقلين مع شمس من حي لحي ومن شارع لمترو أنفاق، ليقدما في فيلمهما الأول توثيقا بصريا لم يتمكن أحد من تحقيقه قبلهما.
ولكن الإنجاز الحقيقي في المشروع الفني لخان ليس مجرد “الخروج بالكاميرا للشارع” أو “توثيق المدينة بصريا”، فالأمر أعقد من ذلك بكثير، فالخروج مجرد فعل مادي، والتوثيق قيمة تاريخية، والأهم من الاثنين هو كيفية صياغتهما داخل الأفلام، فالمخرج ليس مجرد مؤرخ أو موّثق، ولكنه صانع عوالم مادته الخام هي المشاعر المتمثلة في بشر من لحم ودم، هؤلاء البشر يعيشون داخل المدينة، وبالتالي تصبح علاقتها بها متبادلة، فهي خلفهم وأمامهم، العيش فيها هو ماضي الشخصية وأحد مكوناتها النفسية والسلوكية والاجتماعية، وهو أيضا حاضرها ومستقبلها، فالشخصية الخانية باحثة دائما عن الطريقة المثالية للتعايش في سلام نفسي داخل المدينة، سواء كان هذا التوازن المنشود مهنيا أو عاطفيا أو من أي نوع آخر، لكن هدفه في النهاية هو التوائم دون تنازل، لا عن فروسية الشخصية أو شغفها من جهة، ولا على مدينتها من جهة أخرى، وباستثناء مداعبة رقيقة تشبه عتاب المحبين وجهها خان للقاهرة في “خرج ولم يعد”، لم يدر بخلد أي من شخصيات السينما الخانية أن تترك مدينتها إلا للضرورة القصوى، فترك القاهرة لدى خان هو “الغياب” بعينه، والذي يجعل صاحبه ينفصل عن عالمه، تماما كالأزمة التي عاشها شاكر بطل “عودة مواطن” عندما عاد لأشقاءه فاكتشف أنه لم يكن غائبا عنهم جسديا فقط، بل ومعنويا، فمن يترك قاهرة خان يكاد يكون ميتا (لاحظ ما يعتقده الجميع عن وفاة عطية في خرج ولم يعد)، تنقطع أواصر صلته بالجذور، ولا يذكره أحد حتى المقربين إليه.
وربما يبدو غريبا لدى البعض أن تتضمن قائمة أعمال مخرج يعشق القاهرة بهذا الوله فيلما يهاجمها مثل “خرج ولم يعد”، والذي يجد بطله عطية السعادة والسكينة والحب في قرية بدائية هادئة، بعكس حياته الصعبة والمعقدة والمهددة يوميا في مسكنه الأصلي بالقاهرة، ولكن الأمر كما قلنا لا يعدو كونه عتاب المحب المدرك لواقع مدينته، فهو لا يعشقها لأنها الأجمل، لكنه يعلم جيدا أنها مليئة بالتناقضات والمصاعب والعيوب التي قد تكون هائلة إذا ما قورنت بمدن أخرى، ولكنها تمتلك هذا الوهج الذي يصعب الفكاك منه، والذي يجعل سكانها يحولون هذه المتاعب المستحيلة إلى مجرد تفاصيل هامشية في حياة يومية صاخبة. وهو ما جعلني أفكر كثيرا وأمارس هوايتي في تخيل الأحداث التي ستقع بعد نهاية الأفلام التي أحبها، فكنت في كل مرة لا أستطيع أن أمنع نفسي من الاعتقاد في أن قرار عطية بهجران القاهرة ليس نهائيا، وأن مثلما اتخذه في لحظة ليقرر القفز من السيارة ليعود للقرية، فسيأتي عليه يوم يقرر فيه أن يقفز مجددا ليعود لموطنه الأصلى، ولكن هذه المرة ليس ليطارد حلمه الوظيفي الساذج، بل لأنه ككل قاهري، يترك جزءا منه بالمدينة عندما يغادرها، تماما مثل خان الذي غادرها في فيلمين أو ثلاثة، ليعود في كل مرة مجددا إلى مدينته التي لم يقدمها مخرج على الشاشة مثلما قدمها هو.
رابعا: قيمة المكان
ارتباط الشخصيات الدرامية في سينما خان لم يكن له فقط تأثيرا إيجابيا على دراما أفلامه فقط، ولكنه كان مدخلا لصياغة جديدة في الدراما المصرية بشكل عام، يكون المكان فيها عنصر مهم ومؤثر. فالسينما المصرية الكلاسيكية عاشت عقودا تدور الغالبية العظمى من أفلامها في مكان غير محدد، فنعرف أن هذا هو منزل الشخصية الفلانية، ونعرف مستواه الاجتماعي، لكننا قليلا جدا ما نعرف موقعه أو الحي الذي يوجد فيه، ولو عرفناه فهي مجرد معلومة عابرة لا قيمة لها، ولو كانت لها قيمة وتوظيف درامي فلن يخرج هذا التوظيف عن شكلين دراميين: الأول هو الاستخدام النمطي للأحياء حسب مستواها الاجتماعي، فسكان الأحياء الراقية أثرياء وقاطني الأحياء الشعبية فقراء، والثاني هو أن يكون المكان نفسه هو البطل أو المعروف بدراما المكان.
محمد خان اتخذ خطوة أبعد بكثير من النموذجين السابقين، فالمكان في سينماه ليس مجرد أمر عارض قد يذكر أو لا يذكر، وهو ليس مجرد تعبير سطحي عن مستوى اجتماعي، وبالطبع لا يقدم خان دراما مكان كلاسيكية. المكان في السينما الخانية عنصر فاعل، يرتبط بالشخصيات ويؤثر فيها وتؤثر فيه، وذلك بناءا على وعي صانع الفيلم بالمدينة أولا وبنمط الحياة داخل كل حي من أحياءها ثانيا، والاستوديو البوهيمي الذي يعيش فيه شمس هو مكان تم اختياره بعناية، فشاب باحث عن الحرية مثله لابد وأن يعبر مسكنه عنه وعن حياته، لا سيما ونحن نعرف في أول مشهد نراه فيه أنه قد باع شقة عائلته وانتقل لهذا المكان. ومن البديهي أن يبحث شخص مثله عن مسكن في منطقة لا يضيق عليه أحد الخناق فيها ويراقب زيارات حبيبته له، ويجب أن تكون قريبة من مناطق عمله كمصور صحفي، وفي نفس الوقت لا يسمح دخل وظيفته بأن يكون هذا المكان مثلا في حي كالزمالك يتوفر فيه أول شرطين، وبالتالي فإن عمارات وسط البلد هي الاختيار الأنسب له، وهي أمور لا تقال صراحة لكنها تعطي الدراما صدقا وارتباطا بواقع الحياة كان أحد إنجازات جيل الثمانينات بشكل عام ومحمد خان بشكل خاص.
قس على ما سبق تأثير المكان على كل الشخصيات الخانية، فاستوديو شمس يختلف كليا في دلالاته وتأثيره عن حجرة السطح التي يعيش فيها فارس الحريف (والتي قد تكون فوق نفس العمارة كما سنرى لاحقا)، وكلاهما يختلف تماما عن منزل حلوان المملوك لعائلة شاكر في “عودة مواطن”، وعن شقة مصر الجديدة التي يعيش فيها يحيى بطل الفيلم الذي يحمل اسم الشقة نفسها (ولاحظ دلالة الأمر). كل مكان خاص بأبطاله، يجعل المشاهد يندمج تلقائيا معهم ويشعر بأنه هؤلاء أشخاص يعيشون بالفعل في هذه الأحياء، وليسوا مجرد ممثلين يؤدون حكايات تدور في الفراغ.
قمة الإبداع في توظيف هذا العنصر سنجدها في “أحلام هند وكاميليا”، والذي تدور أحداثه في حي مصر الجديدة أيضا، ولكن ليس في شققها الفخمة أو سياراتها، بل في العالم الخاص بالشخصيات: السلالم الخلفية ومترو الحي الشهير الذي لم يعد يركبه سوى الفقراء والموظفين، بل أننا لا نرى البطلتين وهما الخادمتين داخل المنازل التي تعملان فيها إلا مرات محدودة جدا، ترتبط في كل مرة بحس تسلل من يتواجد في مكان ليس ملكا له، فحتى نفس الحي الذي يقدمه المخرج أكثر من مرة، ينظر له في كل مرة بعين الشخصيات وليس بعين الزائر أو الموّثق، لينقل عالم أبطاله الفعلي للشاشة بكافة تفاصيله بل والمشاعر المسيطرة عليه بصورة غير مسبوقة، وهو لُبّ الوصف الذي أطلق على أعماله وأعمال جيله (الواقعية الجديدة)، فهو يقدم الواقع، ولكن بأسلوبه البعيد تماما عن ميلودرامات الاستوديو التي سيطرت على نسبة لا بأس بها من الموجة الأولى للواقعية في السينما المصرية.
خامسا: الوعي بمأزق الأنثى
نعود من جديد للتفسير المتسرع لعبارة سلوى الشهيرة “عاوز أقعد جنبك.. مش وراك”، والذي أجزم الكثيرون بثقة أحسدهم عليها أنها توضح تحرر الفتاة وسعي صانع الفيلم لتكريس فكرة المساواة بين الجنسين. والحقيقة أن العبارة بارعة الصياغة تحمل داخلها بالفعل إذا ما تم تناولها بشكل مجرد بعيدا عن سياقها هذا المعنى ذا الصبغة “الحقوقية”، وتبدو العبارة صالحة لأن تستخدم كشعار نسوي عابر للزمن، ولكن المواقف الحقوقية دائما ما تكون أحادية الموقف، وسينما محمد خان أبعد ما تكون عن الأحادية أو التبسيط، بل إن قوتها الفكرية الأساسية تنبع من إمساكها بزخم الحياة وتفاصيلها وتناقضاتها، لهذا فإن علينا أن نعيد النظر لموقف سلوى، والذي يحمل ككل ما في فيلم خان الأول، بذورا للاتجاهات التي سنراها بوضوح لاحقا خلال مشروعه السينمائي.
فأزمة المرأة في المجتمع المصري لا يمكن تلخيصها في وجود تفرقة بين الذكور والإناث، ولا يمكن اختزالها في فتاة ترغب في الجلوس بجوار حبيبها بدلا من أن تجلس وراءه. المرأة في مصر تعيش واقع أعقد من ذلك بكثير، واقع يتاح لها فيه المساواة بل والتفوق على الرجل في بعض الأصعدة، بينما تسلب حتى من حق التفكير في أن تكون ندا له بأصعدة أخرى، تماما مثل سلوى، التي تملك بداخلها بذرة التمرد والمطالبة بالحرية، والتي تتضح من شخصيتها التي نفهم أبعادها تباعا، ومن علاقتها المفتوحة بحبيبها التي نراها من اللحظة الأولى بصورة صادمة لثوابت المجتمع، ولكنها في نفس اللحظة محاطة بالكثير من الضغوط: تحكم أسرتها التي تصل لمواعيد عودتها للمنزل، نظرة العالم المحيط لها، والأهم هو الثقافة التي تشربتها منذ الصغر، والتي تجعلها وإن كانت تحب فنانا بوهيميا وتؤمن بموهبته وتخالف قواعد المجتمع معه، إلا أنها لا تزال محتفظة بالرغبة في الحصول على حياة مقاربة لحياة بني جنسها من الفتيات المصريات، حياة أقل جنونا وأكثر أمانا، حياة لا يعد الجلوس بجوار الزوج فيها دليلا على المساواة، بل على محاولة للجمع بين حسنيين: الحب الحر والحد الأدنى من الأمان المجتمعي.

لقطة من فيلم “الحريف”
هذا الوعي بمأزق الأنثى هو أحد العناصر الكثيرة التي لم تجعل “ضربة شمس” مجرد فيلم أكشن جماهيري آخر، ولكنه عمل أكثر عمقا وارتباطا بالواقع بما يفوق مئات الأفلام التي تسرد حكايات دراما اجتماعية يظن من لا يعلم أنها واقعية تطرح قضايا اجتماعية، ولكنها في الحقيقة تتعامل مع هذه القضايا باستقطاب صارخ، ينطبق عليه ما قاله المخرج السوفيتي الكبير أندري تاركوفسكي عن هذه النوعية من الأفلام، عندما قال وكأنه يصف سينما محمد خان “تفسير ذلك هو أن نمط الحياة شعري أكثر مما هو ممثل أو مصور أحيانا من قبل المدافعين بعزم عن الطبيعية. الكثير مع ذلك، يبقى في أفكارنا وقلوبنا كاقتراحات غير متحققة. عوضا عن محاولة الإمساك بالفوارق الدقيقة التي لا تكاد تدرك، فإن أغلب الأفلام الواقعية البسيطة، لا تتجاهل هذه الفوارق فحسب إنما تصر على استخدام صور حادة وصارخة ومبالغ فيها، والتي في أفضل الأحوال يمكنها فقط أن تجعل الصورة تبدو بعيدة الاحتمال”. ومن بين كل مخرجي السينما المصرية، خان هو أحد أفضل من أمسك بهذه الفوارق الدقيقة التي لا تكاد ترى، لا سيما فيما يتعلق بصورة المرأة في أفلامه.
فالمرأة في سينما خان ليست امبراطورة مسيطرة وليست مظلومة مستضعفة، إنها مزيج من كل هذا وأكثر، إنها إنسان يعيش سياقا معقدا يغير موقف العالم منه في كل لحظة عن سابقتها. من نفس المنطلق يمكننا إعادة النظر للكثير من الشخصيات النسائية في أفلام المخرج الكبير من زاوية مختلفة، فعلى سبيل المثال يمكن إعادة تقييم موقفنا من منى بطلة “زوجة رجل مهم”، والتي يراها البعض ضحية لزوج مهووس بالسلطة وضعها في قائمة ممتلكاته دون التفكير في مشاعرها. ولكن إذا أعدنا مشاهدة الفيلم دون أحكام مسبقة، فسنجد أن هشام على الأقل في المراحل الأولى من علاقته بمنى، كان بالفعل زوجا محبا مخلصا يتمنى السعادة لزوجته، بينما كانت هي مراهقة حالمة بالحب، مستعدة لأن تقع في حب شاب يشع ذكورة وسطوة مثل هذا الضابط الشاب. مأزق منى لا يمكن تلخيصه في اعتبارها ضحية، لكنه هو الاخر يقع في نفس مساحة الفوارق الدقيقة التي حولتها من مراهقة تستجيب بسعادة لرغبة ضابط وسيم في الزواج منها، إلى سيدة بالغة تعاني من حرمان عاطفي سببه تحول نفس الضابط بحكم حياته الجديدة إلى شخص أكثر تجبرا، يؤمن أن لديه دائما ما هو أهم من اهتمامات زوجته ورغباتها.
يمكنك بنفس القياس أن تنظر لكل شخصيات خان الأنثوية، وعلى رأسها نوال البطلة الوحيدة التي صدر خان فيلمها “موعد على العشاء” بإهداء موجه لها شخصيا، فهي نموذج مثالي آخر لفهم المخرج الكبير لمأزق الأنثى، فهي امرأة ظلمها كل من حولها، ظلمها الثري الذي أراد الزواج منها فاغتصبها لتقبل رغما عن أنفها، وظلمتها والدتها عندما دعمت هذه الزيجة وسعدت بها، ولكنها رغم تعاستها تبدو قوية، نبيلة، غير مستعدة للاستجابة لدعوات صديقاتها اللاتي يحاولون تبرير خيانتهم لأزواجهم ويدعونها أن تحذو حذوهم. لاحظ هنا أن المحيطين بنوال هم ذكر وحيد والعديد من النساء، فهي وإن كانت ضحية لسلطوية ذكورية واقتصادية إلا أن العدد الأكبر من المشاركين في قمعها ودفعها للخطأ من النساء، بل ونساء يفترض أن يكن أقرب المقربات لها: أمها وصديقاتها، وهي الخيارات التي تؤكد من جديد على تعقد السياق الاجتماعي، وصعوبة التعامل مع مأزق المرأة بمعزل عن المرأة نفسها.
فوزية “موعد على العشاء”، نجاح “مشوار عمر”، هند “أحلام هند وكاميليا”، وردة “الغرقانة”، وغيرهن من نساء عوالم خان، كلهن صور متعددة لاستيعاب المخرج الكبير ومن تعاون معهم من كتاب سيناريو موهوبين لما أوضحناه من تعقد لمأزق الأنثى المصرية، والذي يصعب تخليصه أو وصفه أو الدفاع عنه بأي موقف “حقوقي” يرى الأمور بالأبيض والأسود، فالمرأة في عالم خان لا تبحث عن حقوقها، ولكنها تدافع عن مساحتها من الحياة، وتخوض صراعات مع نفسها ومع العالم المحيط للتمسك بهذه المساحة مهما كانت العوائق التي تلاقيها، وهو موقف لا يمكن أن يتبناه مخرج يرى العالم من بعيد، ولكنه بحاجة لمبدع حقيقي، معجون بالمجتمع ومشكلاته وتفاصيله، قادر على نقل هذه التناقضات للشاشة، ولم يوجد من تنطبق عليه مثل هذه الشروط أكثر من محمد خان.
سادسا: التشبع بسينما العالم
من بين أجيال السينما المصرية المتعاقبة، يمكن اعتبار جيل الثمانينيات أول جيل “مثقف سينمائيا” حسب التعريف المعاصر للكلمة، لعدة أسباب بعضها يتعلق بالزمن نفسه، حيث نشأ هذا الجيل في خضم الحراك السينمائي الأضخم في تاريخ الصناعة المصرية، وشب مع أوج نشاط المراكز الثقافية وجمعيات ونوادي السينما، التي قدمت لشباب الموهوبين نوافذ للإطلاع على سينما مختلفة كان من العسير جدا الانفتاح عليها طبقا لمقاييس هذا العصر. أسباب أخرى بعيدة عن الزمن تتعلق بأبناء الجيل أنفسهم وعلى رأسهم محمد خان، الذي كان ولا يزال “سينيفل” حقيقي، عاشق للأفلام يتنقل لمشاهدتها من مكان لمكان ومن بلد لآخر، على النقيض تماما من نسبة كبيرة من كبار مخرجينا الذين انقطعت صلتهم بالسينما العالمية ـ وربما المصرية ـ منذ أعوام طويلة. أضف إلى ما سبق سفر خان للدراسة في مدرسة لندن الدولية للفيلم، التي كانت وقتها تدعى مدرسة تقنيات الفيلم وقت أن كانت مدرسة السينما الوحيدة في بريطانيا، ليتسع نطاق مشاهداته أكثر وأكثر، ويصبح بحق واحد من أغزر المطلعين على سينما العالم، قبل حتى أن يبدأ في صناعة الأفلام.
هذا التشبع الهائل بمختلف أنواع السينما، والذي يبدأ من الأفلام التجارية المسلية وحتى أكثر أشكال الأفلام تجريدا وصعوبة في التلقي، كان لا بد وأن يظهر تأثيره في أفلام محمد خان، لا سيما الأعمال الأولى منها التي سبقت التكوين التدريجي لأسلوب السينما الخانية، والتي صارت لاحقا مدرسة مستقلة بذاتها تتشبه بها الأعمال ولا تتشبه هي بغيرها. وفيلم “ضربة شمس” هو واحد من أكثر الأفلام التي كتب النقاد عن تأثرها بمشاهدات المخرج الكبير، وتحديدا بفيلم الإيطالي ميكل أنجلو أنطونيوني الشهير “تكبير” أو “Blow-Up”، والذي كتب الكثيرون يصفون ضربة شمس بالتأثر به خاصة وأن بطله هو الآخر مصور شغوف بحبس الحقيقة داخل الصورة الفوتوغرافية.

من فيلم “زوجة رجل مهم”
شهرة الوصف الذي ردده نقاد المرحلة وانتقل منهم للأجيال التالية جعل الأمر يسير بالنسبة لجيل كاتب هذه السطور بصورة عكسية، فشاهدنا أفلام محمد خان في صبانا وتعلقنا بها وعشقناها، ثم قرأنا ما كُتب عنها فتعرفنا من خلالها على أنطونيوني وشاهدنا فيلمه البديع. ربما كان لاختلاف ترتيب المشاهدة دورا في الأمر، ولكني لم أر هذا التأثر الواضح الذي أشار له الجميع، ووجدت أن التشابه بين الشخصيات هو تشابه أولي جدا يمكن أن ينطبق على عشرات الأفلام، وإن دل على شيء فإنما يدل على “إشارة” من خان لفيلم يحبه، لا تصل إلى درجة النقل أو التأثر.
أما التأثر الحقيقي بسينما العالم والذي يمكن أن تلمحه في الدقائق الأولى من “ضربة شمس”، هو في رأيي تأثر شكلي وموضوعي بسينما المخرج الفرنسي الشهير جان لوك جودار، أحد الآباء المؤسسين للموجة الجديدة في السينما الفرنسية، وبالتحديد بفيلمه الأول الأيقوني “حتى آخر نفس” أو “A Bout de Souffle”. وأقول أنه تأثر شكلي لارتباطه ببعض الخيارات في بناء الشخصية وطريقة تنفيذ المشاهد واختيار إيقاع تتابعها، وتأثر موضوعي لأنه مثلما كان فيلم جودار بمثابة ثورة في السينما الفرنسية، فقد لعب فيلم خان والأفلام التالية نفس الدور في السينما المصرية والعربية.
التأثر الشكلي هنا بعيد كل البعد عن فكرة النقل أو الاقتباس، ولكنه مرتبط بالرغبة في تقديم سينما جديدة في كل عناصرها، تتخلص من تراث كلاسيكي يجبر صناع الأفلام على التفكير بطريقة معينة، ليبدأ وضع قواعد حديثة تواكب روح العصر، وتتعرف أكثر على طبيعة الوسيط السينمائي، والذي ظل عقودا طويلة حبيسا في مساحة وسطى بين المسرح والأدب والحكي الشعبي تقلل كثيرا من الخيارات المتاحة أمام المخرج. والمشهد الافتتاحي بين شمس وسلوى بحواره الديناميكي الطويل، والذي يتنقل بسرعة وذكاء بين الخاص والعام، بين علاقة الحبيبين وحلم البطل الفني، دون أن يفقد المشاد للحظة متعته البصرية، واكتشافه في كل لقطة للجديد من تفاصيل المكان والعلاقة بين الحبيبين، هو مشهد يقترب كثيرا من روح مشهد شهير في الفيلم الفرنسي يتحدث فيه البطل جان بول بلوموندو مع البطلة جين سيبيرج في الغرفة البوهيمية التي تسكن فيها.
الحوار في مشهد افتتاح ضربة شمس ـ وهو التفصيلة المسرحية ـ يستخدم بكثرة، ولكنها مدعمة بديناميكية وحراك داخلي مستمر، يصاحبه التنويع البصري الذي تحدثنا عنه، والذي يقوم البطلان خلال معظمه بأفعال لا علاقة لها بما يقولانه لبعضهما البعض، ليخلق هذا كله ناتجا كليا يؤسس لشكل حداثي من استغلال كل عناصر المشهد: التكوين والميزانسين والحوار والقطع المونتاجي والديكور والملابس، في خلق زخم بصري يجعل القيمة الكلية للمشهد تفوق حاصل جمع كل عناصره على حدة، وتقوم بالطبع بسرد مالم يمكن أن يُفهَم لو تمت قراءة المشهد مكتوبا. ببساطة: يؤسس المشهد للوحدة البنائية شديدة التكثيف من حيث الجانب البصري والانفعالي، وهي هذا الذي سنصفه لاحقا بـ “المشهد الخاني” الذي سيتواجد باستمرار في كل أعمال المخرج اللاحقة.
وعلى مدار مسيرته الممتدة لم تتوقف أبدا علاقة التفاعل الخلاق بين ما يصنعه محمد خان وما يراه من سينما عالمية، بصورة جعلته دائما راغبا في تجربة الجديد، وخوض مساحات إخراجية أبعد من الاكتفاء بالاعتماد على ما أتقنه بالفعل، مساحات يحاول أن يواكب فيها السينما العالمية التي لا يتوقف يوما عن متابعة جديدها، ولكن بحس مصري خالص، وبصمة خاصة تطفو على السطح مهما كانت نوعية العمل الذي يصنعه أو طريقة تنفيذه.
سابعا: تناغم المشروع
نتحرك قليلا من المشاهد الأولى لفيلم “ضربة شمس”، لنقف عند لحظة عابرة أتت على بعد دقائق معدودة من تتابعات البداية، يقوم فيها البطل وصديقه مراد بقراءة صفحة الحوادث في الجريدة، ليتوقفا للحظات عند خبر غريب، يروي حكاية زوجة قامت بقتل زوجها بالسم. مجرد نظرة عابرة على العنوان لا يتوقف عندها كثيرا من يشاهد الفيلم، ولكن هذه اللحظة تتحول على يد محمد خان بعد أعوام محدودة إلى فيلم كامل، عندما يروي حكاية الزوجة التي أصبحت بطلته المحببة نوال، الجميلة سعاد حسني، والتي دست السم في طبق المسقعة لتأكل مع طليقها المتجبر الذي قتل زوجها الثاني، منفذة فعلتها بمنتهى الهدوء وبلا أي انفعال، فكما يقولون: الانتقام طبق يفضل أن يقدم باردا.
هذه التفصيلة العابرة في عمل خان الأول تكشف عن ميزة في مشروعه الفني ربما لم يتمتع بها مخرج قبله أو بعده، وهي بعد النظر وامتلاك رؤية واضحة لملامح الخطوات التالية، ولا أقول للخطوات نفسها، فمن الصعب تصور أن خان كان يمتلك يقينا وقت تصوير فيلمه الأول أنه سيعود ويقدم حكاية الزوجة القاتلة لاحقا، لكن الأمر يقوم على الوعي، وعي المبدع بصورة مشروعه وشكل العالم الذي يدور فيه ونوعية الشخصيات التي يحب أن يروي حكاياتها في أفلامه، فلقطة الجريدة كانت أشبه بالملاحظات التي يدونها الكاتب في هوامشه، والتي قد يعود لها لاحقا فيحولها لعمل إبداعي، أو يفقد اهتمامه بها فتظل في مكانها السليم: ملحوظة جانبية تمتلك قيمة تتعلق بسياق العمل الذي وضعت على هامشه، تماما كما تخبرنا تفصيلة الجريدة شيئا ما حول طبيعة العالم الذي يعيش شمس فيه.
هذه السمة الأسلوبية وثيقة الارتباط بما ذكرناه من قبل عن أهمية المكان كعنصر فاعل في سينما خان، ويزيد عليها هنا عنصر آخر هو الزمان. ففي معظم أفلام المرحلة الأولى من مشروعه السينمائي والتي امتدت منذ أن قدم فيلمه الأول وحتى أنتج وأخرج “فارس المدينة”، احتفظ محمد خان بدرجة مذهلة من تناغم المكان والزمان، فمثلما تعيش الشخصيات في أماكن واضحة لها سمات وخصائص تؤثر في شكل حياة من يعيشون فيها، فإنهم يعيشون أيضا في زمان شديد الوضوح هو قاهرة الثمانينيات، قاهرة ما بعد ترسيخ الانفتاح التي كرس خان عقدا وبعض العقد من مشوارع في رصدها وتفكيكها وتحليلها، ومحاولات إلقاء نظرات من زوايا مختلفة عن طبيعتها وصورة الحياة فيها.
فشمس الذي قرأ في الجريدة حكاية نوال، من الوارد جدا أن يكون الاستوديو الذي يعيش فيه موجودا بنفس البناية التي يسكن فارس الحريف في غرفة فوق سطحها، ومحطة مترو حلوان التي انتهت فيها مغامرته لا تبعد كثيرا عن منزل عائلة شكري في عودة مواطن، وعندما خرج المهندس أحمد بطل الثأر وزوجته من قاعة السينما قبل تعرضهما للحادث، قد يكونا قد مرا أمام متجر المجوهرات الذي يملكه والد عمر في مشوار عمر، فعلى الرغم من تعدد الشخصيات والحكايات والحبكات الدرامية في أفلام محمد خان، إلا أن “وحدة الهمّ” جعلتها تشكل لوحة وحدة بناءها الأولية هي الشخصية الصادقة التي تحمل أفكار ومشاعر مخرج مهموم بالإنسان في وطنه، يحاول في كل مرة تقديم صفحة جديدة في كتابه تحليله لما يحدث في هذا الوطن، ورصد ما يخوضه الإنسان المصري ليعيش حياة يشعر فيها بأنه أكثر إنسانية رغم كل ما يحيط به من عوائق.
تناغم العالم والزمان والمكان تجلى في فيلم “فارس المدينة” بصورة غير مسبوقة، لم يقم مخرج على مدار تاريخ السينما المصرية بالإقدام عليها قبل خان أو بعده، وذلك عندما اختار المخرج الكبير أن ينهي المرحلة الأولى من مشروعه الإبداعي بعمل يسرد مصير شخصيات أفلامه السابقة. وسر إبهار هذا الفيلم ليس في جمعه لهذه المصائر، ولكن لكونه فيلما مستقلا بذاته، يمكن لمن لم يشاهد أي فيلم سابق لمحمد خان أن يشاهده ليجد عملا متكامل العناصر، يروي حكاية غير مألوفة عن رجل أعمال انفتاحي لا يزال متمسكا بأخلاقيات الفرسان، يخوض معركته الأخيرة بعالم الأعمال في ظروف هي الأسوأ على الإطلاق لكل من على شاكلته، وفي مرحلة فاصلة حولت من شكل النظام المالي للمجتمع برمته، وكانت أبرز دليلا على تفكك البناء المجتمعي للعقد الماضي (وهو أمر لم يبخل خان على التأكيد عليه أكثر من مرة في أفلامه السابقة).
نفس هذا العمل المستقل بذاته يمكن أن يرى فيه المشاهد الخبير بعوالم محمد خان المزيد من المتعة، عبر رصد شخصيات الأفلام الماضية التي تعاود الظهور خلال مغامرة فارس حسن الهلالي، لتؤكد نفس الفرضية التي ذكرناها بأن هذه الشخصيات ترتبط بزمانها ومكانها لدرجة تجعل من الوارد جدا أن تتواجد في حيز اجتماعي واحد، تماما كما قرأ شمس قبل أكثر من 13 عاما خبر عن فعلة نوال. فارس يلتقي خلال مشواره بعمر بطل مشوار عمر الذي تخلى عن انطلاقه السابق ليعمل ويستقر بمحل والده، بينما نعرف أن العاهرة نجاح التي تعرف عليها عمر خلال مشواره تربطها الآن علاقة بفارس، وأن أحلام إبنة هند التي كانت ثمرة مغامرتهما في أحلام هند وكاميليا انتهى بها الحال مثل والدتها خادمة في منزل دلال طليقة فارس، والتي نعرف من اسمها واسم ابنها بكر أنه هو نفسه فارس بطل الحريف، بينما نعرف عندما يقابل شاكر بطل عودة مواطن في المطار قبل أن يهرب للمرة الثالثة من وطنه، أن فارس يمثل أيضا أحد تجليات بطل طائر على الطريق، بالرغم من أننا شاهدناه يموت في نهاية الفيلم، وكأن موته كان موتا رمزيا، وأنه حتى لو مات هذا الفارس، فهناك مثله العديد من الفرسان.
هذا التناغم والترابط يؤكد على ما تتمتع سينما محمد خان من بعد اجتماعي عميق، لا يقل في الأهمية عن البعد الفني للأفلام، ويؤكد أن أفلام المخرج الكبير وإن كانت قد خضعت لعدد هائل من التحليلات والدراسات الفنية والإسلوبية، فهي لا تزال بحاجة لمن ينظر إليها من مفهوم اجتماعي، ويقوم من خلالها بفهم طبيعة العالم الذي دارت فيه: عالم قاهرة الثمانينيات وأوائل التسعينيات، بكل ما فيه من زخم اجتماعي وإنساني، ومعايير مختلفة وحياة لم تعد كما كانت عليه، وعجلة تتسارع في الاتجاه الخاطئ لم يكن من الممكن أن تسفر عن شيء سوى ما انتهى عليه حال فارس حسن الهلالي.
ثامنا: زخم شريط الصوت
من بين الإضافات المتعددة التي قدمتها سينما محمد خان لصناعة الفيلم في مصر، يمكنني اختيار جهوده في تطوير استخدام شريط الصوت لتوصف بالطفرة الحقيقية، خاصة وأن الشق المتعلق بشريط الصوت في الأفلام كان ـ ولا يزال ـ واحدا من الجوانب المهملة في الصناعة، والتي يتعامل معها قدر كبير من صناع الأفلام باعتبارها أمرا تقنيا يغيب عنه الحس الإبداعي، وهو بالقطع تعامل خاطئ مع عنصر صار العالم كله يشهد بقيمته وقدرته على تغيير قيمة الفيلم كاملا بالسلب أو الإيجاب.
ومن الدقائق الأولى لأول أفلام خان يمكن للمهتم أن يدرك بوضوح أنه بصدد التعامل مع مخرج يعرف جيدا قيمة عنصر الصوت في الفيلم، ويعتبره أداة إبداعية عالية القيمة، لا يمكن استخدامها على سبيل العادة أو لمجرد ملء المساحات وتغطية مشكلات الصورة، وهو ما يمكن لمسه من ابتعاده الكامل عن الأخطاء المعتادة في أعمال المخرجين الأولى، من الإفراط في استخدام الموسيقى التصويرية وسوء توظيف المؤثرات الصوتية، بل على العكس تماما يمكن اعتبار شريط الصوت في ضربة شمس نموذجا مثاليا يمكن أن يوجه صناع الأفلام المبتدئين من خلاله لكيفية التعامل مع العناصر الصوتية بدقة، والاختيار بينها بعناية تخدم دراما الفيلم وتعلي من قيمته.
تترات الفيلم تنزل على خبطات إيقاعية غير معتادة، هي الجملة المختزلة التي وضعها الموسيقار كمال بكير واختارها خان لتكون موسيقى الفيلم التصويرية، مبتعدا بذلك عن أي اختيار تقليدي لموسيقى حماسية أو ميلودرامية، الجملة الإيقاعية تتماشى في الحس العشوائي المسيطر عليها مع عشوائية الحركة داخل الكادر الذي تحدثنا عنه من قبل. تنتهي الخبطات بنهاية التتر ووضح صورة الشارع ليتصاعد صوت صخب الشارع نفسه، وهو الصوت الذي يستمر مصاحبا لمشهد شمس وسلوى مشبعا المشاهد من اللحظة الأولى بطبيعة المكان ـ بل والعالم ـ الذي تعيش به الشخصيات، وهو ما يدعمه صوت عدسة الزووم التي يرى شمس من خلالها حبيبته، وكأننا نبدأ في هذه اللحظة في متابعة الحياة مثلة: من عدسة الكاميرا.
الحوار يبدأ بذكاءه وديناميكيته وصوت الشارع في خلفيته، حتى تتم القبلة ليتصاعد صوت الشارع مجددا مصحوبا بصوت دراجة شمس البخارية، واللذان يختلطان بحوار البطلين حتى جملة سلوى الشهيرة “نفسي أقعد جنبك…”، لتتصاعد بعدها موسيقى حماسية أشبه بنفير تقديم البطل والتمهيد للمغامرة، لا تستمر الموسيقى لأكثر من ثوان لتقوم بدورها، ومن ثم تنتهي بمجرد توصيل شمس لسلوى، لنعود مجددا لصخب الشارع وصوت مزلقان المترو، لنقضي عشر دقائق بلا أي موسيقى، يذهب شمس خلالها لنادي البلياردو، ويتم خلالها تضخيم كل أصوات المكان: اصطدام كرات البلياردو/ صوت قرص التليفون/ قلب صفحات الجريدة، وكلها أمور تشترك مع الصورة في إشعار المشاهد بأن أمرا خطيرا يتم تدبيره حاليا.
الصورة تستمر بلا موسيقى بينما ينطلق شمس بدراجته متجها إلى الزفاف الذي ستنطلق منه المغامرة، وبمجرد وصوله هناك، ومع حركة الكاميرا الهادئة لاستكشاف المكان من الخارج، وصعودها لتبين السيارة التي تجلس القاتلة الصامتة ليلى فوزي خلف عجلة قيادتها، تبدأ موسيقى راقصة ناعمة تردد لحن سيد مكاوي: يا صلاة الزين.. يا صلاة الزين، وقبل أن يدرك المشاهد أنها بداية الموسيقى التي ترقص عليها الراقصة في الفرح، يكون قد وقع في شباك الفيلم كليا، ولم يعد مستعدا للاهتمام بأي شيء سوى متابعة ما يراه أمامه على الشاشة.
ما سبق لا يمكن أن يكون قد تم على سبيل المصادفة، ولو تم إعطاء نفس اللقطات التي صورها خان نفسه لمخرج آخر ليصيغها على طاولة المونتاج، لا يمكن تصور خروجه بنفس النتيجة من إثراء الصورة بالصوت، لأنها بصمة خاصة ستستمر طوال مشوار المخرج الكبير، بصمة تجعلنا قادرين بسهولة على تذكر عشرات المشاهد التي لعب فيها الصوت دور البطل، تجعلنا نذكر صوت ماكينة السينما في افتتاحية “زوجة رجل مهم” يليه عذوبة عبد الحليم حافظ يغني أهواك لتنزل معها دموع منى المراهقة، لننتقل لنفس الكوبليه بعد مرور أعوام ونرى منى وقد كبرت تستمع بحب للراديو وتهرع لشراء شريط كاسيت جديد ليراها الضابط هشام ويسأل عنها، بينما تعود هي مسرعة لتكمل تسجيل الحفلة مسجلة تعليقها الصوتي “المنيا.. عبد الحليم.. حفلة شم النسيم”.. لتنهي به واحد من أكثر تتابعات البداية عذوبة ورقة في تاريخ السينما المصرية.
تُقبض قلوبنا عندما نتذكر تداخل أصوات عقارب الساعات في مشهد انتظار نوال لحبيبها حتى أتاها خبر مقتله في “موعد على العشاء”، ونتذكر لهاث فارس الذي يغطي شريط الصوت عندما يخوض الحريف مباراته الأخيرة والأكثر أهمية في حياته كلها، وننبهر عندما نتذكر المقابلة الصوتية بين “هذه ليست أمريكا” دافيد بوي الصادرة من سيارة عمر و”الدنيا ربيع” سعاد حسني الآتية من راديو محطة البنزين الحقيرة في “مشوار عمر”. الكثير والكثير من التفاصيل والتراكيب الصوتية المبدعة والغير متوقعة التي يفاجئ محمد خان جمهوره بها في كل فيلم، والتي جعلته ومنذ اللحظات الأولى أحد أكثر مخرجي مصر وعيا بهذه الأداة المهملة المسماة شريط الصوت.
تاسعا: الانتصار للروح الشابة
عندما بدأ محمد خان تصوير فيله الأول ضربة شمس كان عمره 36 عاما، وعندما عرض الفيلم تجاريا كان عمره 38 عاما، بما يفوق بطل الفيلم ومخرجه بفارق السنوات الأربع التي تفصل بينهما، فقد كان نور الشريف وقتها لا يتجاوز الرابعة والثلاثين (حسب تاريخ ميلاده المعلن)، وقتها وبرغم الفارق العمري كان كل ما كُتب عن الفيلم تقريبا يشير لتعاون النجم “الكبير” مع المخرج “الشاب”، وهو توصيف صحيح سينمائيا بالرغم من تعارضه مع القواعد اللغوية، فبناءا على حسابات الجماهيرية ومعايير عمر الممثل، كان نور وقتها في قمة نجوميته وبداية نضجه بينما كان خان بالفعل يدخل أعتاب السن الذي برزت فيه موهبة النسبة الأكبر من مخرجي العالم، ولكن هذا الوصف الذي كان صحيحا بمعايير “نسبية” وقتها، أخذ مع مرور الأعوام يترسخ أكثر فأكثر، ويظهر أن الأمر لا يقتصر على النسبية السينمائية، ولكنه أمر يرتبط بشخصية محمد خان نفسه، ونوعية السينما التي يقدمها والأشخاص الذي يفضل التعامل معهم فنيا.
ففيلم ضربة شمس لم يكن انطلاقة لروح شابة في السينما المصرية فقط لأن مخرجه يقدم فيلمه الأول وهو في مرحلة “الشباب الإخراجي”، وإلا كان تأثيره سيتشابه مع العديد من الأعمال الأولى التي تنطبق عليها نفس الشروط. ولكنه كان علامة فارقة لأنه مثّل بالفعل روحا سينمائية شابة، لا تقتصر على المخرج الشاب والبطل الشاب والمصور الشاب والمونتيرة الشابة، ولكن الأهم كان امتلاكه لهذه الروح الخلاقة الراغبة في تغيير العالم، بتقديم أفلام جديدة ومختلفة، لا تقوم بثورة لمجرد الثورة على ما سبق، بل تهضمه وتستوعبه بوعي يفوق عمر صناعها، ثم تخرج بإبداعها الجديد المناسب لروح العصر، مع تلازم هذه الروح العصرية مع عمق اجتماعي وفكري يرى هو الآخر العالم من منظور جديد أكثر شبابا وقدرة على الحلم بعالم تجعله السينما أفضل وأكثر جمالا وبهجة.
هذه الروح لم تتوقف عند فيلم خان الأول أو الثاني أو العاشر، ولكنها استمرت معه باستمرار مشواره الممتد لأكثر من عشرين فيلما روائيا طويلا، فظل طوال هذه الأعوام الأكثر قدرة على استيعاب المدخلات الجديدة للصناعة، ليس فقط على صعيد الأفكار والمعالجات التي تتحرك وتتطور باستمرار، ولكن أيضا على صعيد طاقم العمل الذي يتعاون معه، والذي يجتمع فيه فكرتي الراحة النفسية للعمل مع بعض الفنانين الذين تتماس مساحاتهم الإبداعية مع عوالم خان من جهة، وإدخال عناصر جديدة شابة للمنظومة لتطعمها بروح تتحرك دائما للأمام من جهة أخرى. كتاب سيناريو ومصورين وممثلين وغيرها من الفرص التي منحها خان تباعا لجيل تلو الآخر ليدخلوا لصناعة السينما المصرية من الباب الواسع.
في نفس الوقت لم تتوقف الأفلام نفسها عن الانتصار لهذه الروح الشابة، المحبة للحياة والراغبة في انتزاع الوجود من العالم برغم كل الصعوبات، ومن يشاهد هموم فتيات القرن الواحد والعشرين وكبتهن وإحباطهن مجسدا في ياسمين وجومانا بطلتي “بنات وسط البلد”، أو علاقة الحب الديناميكية بين شاب يؤمن بأنه خبير بالحياة وفتاة رومانسية تصدم لأول مرة بالمدينة بفيلم “شقة مصر الجديدة”، سيعرف أنه أمام صانع أفلام خارج حسابات السن، لم يركن لأسمه الشاهق كي يتعامل مع الفن بأستاذية مدعاة، بل ظل حتى يومنا هذا صاحب روح شابة، لا تتوقف عن التجريب ومحاولة فهم العالم والتعامل معه بأحدث أدواته، لذلك لم يكن من الغريب قياسا على شخصية المخرج الكبير، أن يكون من أوائل من أقدموا على توظيف التقنيات الحديثة في سينماه عندما صور فيلم “كليفتي” بكاميرا ديجيتال كما روينا من قبل. وها هو خان في لحظة كتابة هذه السطور، يعكف على الانتهاء من فيلمه الجديد “فتاة المصنع”، تعاونا مع منتج شاب ومؤلفة شابة ومصور شاب وممثلين شباب، يقفون حوله لينهلوا من خبرته، ويندهشوا من قدرته الدائمة على أن يكون أكثر منهم شبابا وحماسا واشتعالا ورغبة في تغيير الكون.
إنه محمد خان.. صانع الأحلام، عاشق القاهرة ومحللها المحب، وأستاذ السينما وتلميذها النجيب، الفارس الذي تحدى الجميع بموهبته، ورسخ في أفلامه للنبل والنقاء في زمن ندر فيه الفرسان، الأكثر اقترابا من النفس البشرية بزخمها ومشاعرها والتناقضات التي تملأها، والشغوف الذي تدفعه قوته الداخلية دائما نحو المزيد والمزيد. إنه محمد خان الذي عشقنا أفلامه صغارا، ثم كبرنا لندرك قيمتها وقيمة صانعها، ثم عرفناه لنجده أكثر منّا شبابا وإيجابية وطاقة لا تنضب. إنه.. محمد خان.