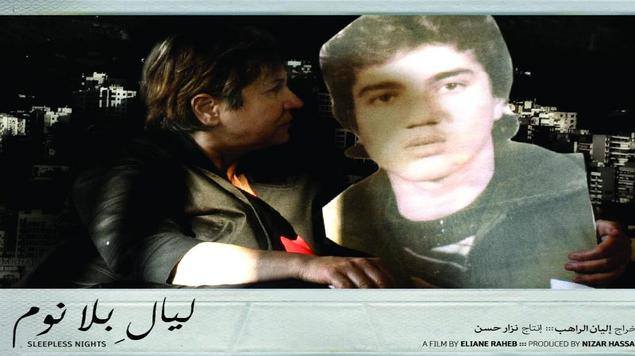“ما هتفت لغيرها”: زمن الحلم الفردي والحلم الجماعي

لعل أهم ملامح فيلم “ما هتفت لغيرها” وهو من نوع الفيلم غير الخيالي، أي انه يمزج بين التسجيلي والوثائقي والروائي، أنه أولا يعكس التجربة الشخصية لمخرجه وصانعه وهو الناقد والمخرج اللبناني محمد سويد، وهو بهذا المعنى يعد أحد أفلام “السيرة الذاتية.
وثانيا: يعكس الفيلم بوضوح هواجس مثقف كان مسيسا حتى النخاع في الماضي، حين ارتبط بحركة اليسار من جهة، وبحركة فتح الفلسطينية من جهة أخرى، مزواجا بين الأفكار الأممية، والأفكار المتعلقة بالتحرر الوطني، وهي مزواجة لها مبرراتها فقد كان خطاب الثور ة الفلسطينية في تلك الفترة من أواخر الستينيات حتى منتصف السبعينيات، خطابا يمزج بين الأفكار اليسارية والوطنية. وكان الانضمام لحركة “علمانية” مهربا من التيار الطائفي الجارف الذي كان سائدا في الساحة اللبنانية، وغن كان الفيلم لا يهتم كثيرا بهذه النقطة. ولكنه بهذا المعنى فيلم مثقف تبدو نكهة الثقافة والتفلسف فيه عالية، وأحيانا تلتبس الأمور بعض الشيء بسبب الطموح الكبير من جانب المخرج لكي يروي كل شيء في سياق فني مبتكر.
وثالثا: بسبب زحام الأفكار والمواد والمعلومات، وتدفق المقاربات والمقارنات والشهادات، يبدو الفيلم أحيانا – من الناحية الأيديولوجية- شديد التشوش، خاصة بالنسبة للمشاهد غير المطلع تماما على التناقضات في الواقع السياسي اللبناني: فالقومي هو الوطني، واليساري يناصر صدام حسين القومي البعثي، والأممية لا معنى لها في سياق ينشد الذوبان في “العروبة”، والعلماني يمكن أن يكون شيعيا أيضا، وبالتالي يمكن أن ينشأ حزب الله من داخل جناح من أجنحة حركة فتح كما يروي لنا المعلق في الفيلم، وحركة فتح ترتبط في الوقت نفسه بحركات التحرر الشيوعية في فيتنام.
والسؤال الكبير الذي يطرحه الفيلم: هل نجحت بيروت في تجنب مصير هانوي، ولماذا فشلت بالمقابل، لت تصبح مثل دبي وهونج كونج؟
“حيث يكون قلبك يكون كنزك”.. بهذه المقولة المتكررة يفتتح فيلم “ما هتفت لغيرها”. وعنوان الفيلم هو حد الأناشيد الذائعة لحركة فتح في الستينيات، فيالبداية نجد أنفسنا أمام ضابط فيتنامي في ميدان كبير في هانوي. الضابط يتخذ وضعا للتصوير.. وهذه اللقطة تحديدا ستعود لتتكرر كثيرا باختلاف الضباط والجنود، ثم حديث عن أبو داود، حيث يروي حاتم حاتم تجربته في فتح ولكن على لسان المخرج دلالة على العلاقة المباشرة بين المخرج وشخصية حاتم المعادلة له في شبابه البكر.
البطل يفترض أنه يتعقب تجربته الشخصية في مجال السياسة في محاولة لفهم كيف حدث ما حدث ولماذا لم تصبح بيروت هانوي أو سايجون، ولماذا ايضا لم تصبح معجزة النهضة الاقتصادية، ويتناول علاقته بالسيمنا، ولعه المبكر بها، ورغبته في الولوج إلى عالمها. لكنه يبدو كما لو كان يتعقب تجربة والده. والحقيقة أن التليق الذي يرد في الفيلم على لسان الراوي مكتوب بجاذبية واقتصاد وجمال بدون أي تكلف، وهو جزء من سحر الفيلم وجماله ويساهم في شد المتفرج إلى المتابعة.
أنت تسمع في هذا الفيلم الكثير من الشخصيات التي تروي علاقتها بالمكان.. ببيروت ثم بدبي، أما فيتنام فلا صو هناك في الصورة، فقط لقطات هادئة أقرب إلى الصور الخيالية التي تمليء بالابتسامات والإيماءات الرقيقة دون أي تعليق.
محاور الفيلم الأساسية: بيروت، دبي، هانوي، والشخصيات الأساسية: لبناني مقعد بسبب اصابته في الحرب في دكان لبيع الدراجات والمخلفات في بيروت كان أحد المناضلين السابقين في السبعينيات، ورجل أعمال هندي الأصل في دبي يشرح ويتكلم ويعقد المقارنات، ومدير نادي السيارات في بيروت، وكاتب هو عادل عبد الصمد .. يتوقف عند وصفه القديم للبنان بأنه “بلد امبريالي وأنه هانوي العرب”.
وهناك أيضا امرأة إيرانية فرت من بلادها بعد الثورة الإسلامية تتحدث عبر الفيلم إلا أنها تفاجئنا حينما تصف وجه الخميني بأنه “جميل وروحاني”.
في هذا المزيج الذي يخضع لطريقة في البناء تعتمد على الانتقالات الحرة، والمقابلات، واللقطات المأخوذة من الأرشيف، وعلى الموسيقى واستخدام الوثائق المصورة لأغاني وأناشيد الثورة الفلسطينية (حركة فتح تحديدا)، مع أغنيات شهيرة (لبيك ياعلم العروبة وغيرها) تكمن ملامح عمل شديد الطموح: أساسه فكرة البحث المعذب عن حقيقة الذات، من خلال وجود الفرد في الماضي وسط الواقع الموضوعي.. ودائما، في طيات الفيلم، هناك العلاقة الحميمية مع السينما وعالمها، رغم ابتعادها عن الواقع، ربما تجسد السينما لبطلنا “البطولة” التي كان ينشدها في الواقع.
هناك من يقول لك إنهم “اغتالوا صدام حسين”، وهناك حديث عن أبو داود ودوره البارز الملهم للشباب في تلك الفترة، ثم صور من جنازته، وهناك أبو الحسن هانوي تلك الشخصية الأسطورية التي كانت شديدة الصلة والحماس لفتح ثم قطعت العلاقة معها وذهبت للعيش في جنوب لبنان.
فيلم محمد سويد فيلم معذب، بالبحث الشاق عن الحقيقة، حقيقة النفس وحقيقة الوطن، لن يمكنك الإمساك بكل ما فيه تماما، فهو يربكك بانتقالاته العديدة، ومقارناته التي تبدو ساخرة أيضا، سخرية من الحالة اللبنانية بأسرها، تلك الحالة التي تجعل لبنان يظل “رهينة” وسط الفرقاء في الداخل والخارج، وهو لذلك يدفع الثمن دائما، ولذا لم يكن من الممكن ان تصبح بيروت مثل دبي، أو دبي مثل بيروت. رجل الأعمال الهندي في دبي يعزو الأمر إلى ان “بيروت مدينة كبرى في لبنان.. بينما دبي مدينة صغيرة.. بيروت تعاني من مشاكل العواصم المكتظة” ولا يبدو أنه سيصل قط إلى لب الحقيقة.. لطن الصور التي يدخلها المخرج على خلفية صامتة تظهر دبي عامرة، وبيروت مدمرة.
هناك دائما استرجاع ما للحرب الأهلية، لأجواء القلق والتوتر والصراع المسلح، واستدعاء لزمن الكفاح ولو من خلال الأغاني وشريط الصوت المنسوج ببراعة كبيرة في الفيلم.
ربما يعاني الفيلم من بعض التكرار والإطالة، وربما كان يمكن ضبط الإيقاع أكثر إذا ما خفف المخرج أو تخفف من بعض المقابلات وجعلها اكثر تركيزا. لكن التجربة بشكل عام، ممتعة بصريا وصوتيا، وتجعلنا نخرج وفي أذهاننا عشرات الأسئلة عن الماضي الذي كان، كيف كنا وكيف أصبحنا، ما الذي ينتظزنا في المستقبل، هل كانت التضحيات تستحق أن نخوضها، وما النتيجة القائمة حاليا، من الذي جنى “النصر” بالمعنى المادي المباشر.. هل انتصرت بيروت، هل أصبحت سايجون.. هل تتمتع بهدوء ورونق فيتنام التي أصبحت الآن “مزارا سياحيا” كما نرى في الفيلم، أم أنها فشلت فقط في أن تصبح “دبي”!