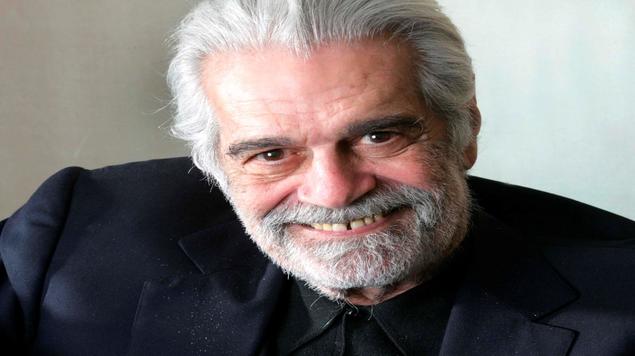قيس الزبيدي ردا على مقال أمير العمري: عن المونتاج ومصطلح اللغة السينمائية

كتب الناقد أمير العمري في صحيفة العرب بتاريخ الجمعة 2019/07/05 مقالة– حوالي 1000 – كلمة حول كتابي الجديد “دراسات في بنية الوسيط السينمائي – حوالي 270 صفحة – ” تحت عنوان: “إعادة قراءة تاريخ تطور نظريات السينما ” وينهي المقالة: كتاب قيس الزبيدي كنز نظري دون شك.
مقال أمير العمري عبر هذا الرابط
لكنه يرى في الوقت نفسه إن الكتاب يطرح الكثير من الأفكار التي تستحق بدورها أن تقام حولها الندوات لمناقشتها في سياق النقد بهدف “غربلة” الكثير من المفاهيم السائدة العتيقة، وفض الاشتباك مع النظريات الغربية المتشابهة التي بدأت تظهر منذ الستينيات، وربما تكون رغم مساهماتها المشهودة، قد أربكت أيضا التعامل النظري مع “الوسيط السينمائي”.
ومع اعتزازي بهذا التقويم لكتابي خاصة من قبل كاتب وناقد سينمائي يحتل موقعا متميزا في مشهد النقد السينمائي العربي، إلا أنني كنت أتمنى لو ان العمري كتب مقالة طويلة تستعرض ما يسميه ” الكنز النظري” في “عين على السينما” فهو الموقع الثقافي السينمائي الأنسب للمقالات والدراسات الطويلة، على العكس من صحيفة يومية، تلزم كتابها بكتابة مقالات قصيرة.
وسأحاول في دراستي هذه أن أعرض بشكل مفصل مسألتين أشار إليهما العمري:
الأولى تتعلق بنظرية اندريه بازان، والثانية تتعلق بمصطلح لغة السينما:
1- اندريه بازان
«إن جوهر الفوتوغرافيا يحيا في فن السينما». سيغفريد كراكاور.
يفضل العمري، كونه من المؤمنين بدور النقد، إنه كان عليّ أقدم “نقدا“لنظرية بازان، التي تقلل كثيرا من شأن المونتاج؟
لقد عرضت لنظرية بازان في سياقها التاريخي الى جانب نظريات عديدة لمنظري سينما كبار، فبازان على عكس الشكلانيين، الذين وجدوا – حسب إيزنشتين– في “ميزان سين” الصورة، أي المونتاج قلب الفيلم السينمائي، فإن بازان وجد في “ميزان سين، المكان، جوهر الفيلم الواقعي أي بما سمي بعدئذ المشهد/ اللقطة وهو ما يعني اللقطات المستمرة الطويلة، التي حققت ³المونتاج داخل الصورة بفضل آلة التصوير واستخدام عدسات عمق الميدان. وميز تطور لغة السينما بوجود تيارين متعارضين:
التيار الأول: المخرجون الذين آمنوا بالصورة، وينطلقون من الطبيعة السينماتوغرافية للوسيط السينمائي.
التيار الثاني: المخرجون الذين آمنوا بالواقع، وينطلقون من الطبيعة الفوتوغرافية للوسيط السينمائي
علينا أن نتوقف، أولاً، عند خصيصة الصورة السينمائية. صحيح أنها امتداد للصورة الفوتوغرافية، لكن كيف حصل هذا الامتداد؟ بما أن هذه الصورة الفوتوغرافية هي استاتيكية ثابتة، فهي صورة مغلقة ترتد معالمها وسماتها الشكلية، وترتد خطوط معانيها إلى داخل مقطعها (إطارها) الخاص، وخصيصة الصورة السينمائية، أنها لا تظهر الخط الذي تنتهي عنده الصورة ويرتد منه إلى الداخل، إنما أيضاً الخط الذي تبدأ منه وتتجه نحو مقطع صورة أخرى، هو نفسه ذات خاصية مماثلة، مغلقة ومفتوحة في نفس الوقت، وهكذا.. وحينما تشكل مجموعة من تكوينات الصور مشهداً أو مقطعا حراً – سكوينس– فان المشهد أو السكوينس يكون، بدلالته، مغلقا ومفتوحا في نفس الوقت أيضا.
يكتب أندريه بازان عن عمق وضوح أبعاد الصورة in focusفي المشهد الواحد، المونتاج الداخلي، عبر استمرارية الزمن في اللقطة الواحدة، وجد لمفاهيمه هذه أولا شرعية، كان مثال لها ناصع فيلم التسجيلي “نانوك الشمال” 1923لفلاهيرتي ، الذي إمتدح بازان لقطته الطويلة، التى تصور نانوك يصارع الفقمة من خلال فتحة فى الجليد وبين أن مالا يمكن تقبله هو ألا يظهر لنا فى اللقطة نفسها الصياد والحفرة والفقمة، فلو تم تفتيت اللقطة عن طريق المونتاج إلى لقطات متجزئة في مشهد لتغيرّت طبيعتها الواقعية. كذلك وجد بازان شرعية لنظريته في أفلام الواقعيين الجدد في إيطاليا وعند مخرجين أمريكيين مثل أورسون ويلز– المواطن كين– ووليام وايلر أفضل سنوات حياتنا.
انشغل أرسون ويلز، قبل أن يبدأ تصوير فيلمه، بالتعرف على التقنية المستخدمة في استوديوهاتR.K.O، وأخذ يشاهد ويتعرف على أساليب وتقنيات التعبير في أفلام فريتز لانغ ورينيه كلير وفرانك كابرا وكينغ فيدور، وبشكل رئيسي في أفلام جون فورد، الذي اعترف به ويلز معلماً له باستمرار.
واستطاع ويلز في النتيجة أن يصنع، بشكل عبقري، ترسانة مليئة بإمكانات تعبير فنية، وضعت قواعد جديدة في السرد السينمائي والمونتاجي: طرق مونتاج مكثفة، وتكوينات صور تعبيرية قوية وبنية درامية، لا ترتبط أحداثها في تعاقب زمني. ولعل الإنجاز الكبير، الذي وقف عنده النقد وما يزال، هو ابتكار المونتاج الداخلي: أي استمرار زمن المشهد في لقطة طويلة واحدة، عبر استخدام عدسة ذات زاوية منفرجة: عدسة ذات بعد بؤري قصير، تساعد في الحصول على تفاصيل حادة الوضوح في عمق ميدان الصورة، كما تستطيع، في نفس الوقت، تصوير الأشخاص بالعلاقة مع الوسط المحيط بهم بذات الوضوح. ويعود الفضل في تحقيق ذلك إلى غريغ تولاند، مصور الفيلم العظيم، كما يراه ويلز، ويؤكده تاريخ السينما.
إن أهمية فيلم “المواطن كين” 1941لا يمكن تقديرها، لأن عمق الميدان أتاح لأورسون ويلز أن يكمل الواقع في استمراريته البصرية، ولأنه يتيح عرض كل المشهد في لقطة واحدة، تبقى فيها الكاميرا ثابتة. وأصبحت التأثيرات الدرامية، التي كان يتيحها المونتاج في السابق، تنشا الآن عبر الممثلين، أثناء ما يغيرون مكانهم داخل اللقطة الواحدة، كما يتم تصويرها، بعبارة أخرى إن اللقطة/ المشهد Plansequenzعلى طريقة عمق الميدان التي يقوم بها المخرج المعاصر، لا تتخلى عن المونتاج، إنما تدمج المونتاج في تكويناته البصرية. وبهذا يسجل ظهور أرسون ويلز، بوضوح، بداية مرحلة جديدة في أفق المونتاج السينمائي، وإذا ما بحثنا عن سلف لأرسون ويلز فلن يكون سوى جان رينوار، الذي يعترف أيضاً: “كلما تقدمت في مهنتي، وجدت نفسي مضطراً لممارسة الإخراج عن طريق الذهاب بالكاميرا إلى عمق الصورة“. لكن فيلم ويلز ” المواطن كين ” يبدو من وجهة نظر بازان كأحسن مثال يؤكد قيام هذه الثورة فى اللغة السينمائية. فإن مشاهد كاملة من الفيلم تعالج فى لقطة واحدة بفضل توظيف أسلوب عمق المجال سواء فى المقدمة أو العمق، دون الحاجة إلى استخدام أساليب المونتاج المألوفة، ولم يعد عمق المجال depth of field وتقنيا depth of focus وباللغة الألمانية Schärfentiefeبدعة يبتدعها المصور مثل استخدام مرشحات الضوء ، أو هذا النوع أو ذاك من أساليب الإضاءة ، ولكنه – حسب بازان – “كسب أساسى فى الإخراج ,وتقدم جدلى فى تاريخ اللغة السينمائية ” .
وقد ساعد التوسع في استخدام تقنية هذه العدسة ذات الزاوية المنفرجة على الوصول لسلسلة من الإبتكارات التكنولوجية/ الفنية، دفعت بالفيلم الى الإقتراب أكثر نحو الواقع وقلبت توازن القيم فى الصورة. وسمحت بإستخدام التكوين فى عمق الصورة. وأصبح من الممكن تصوير مشاهد كاملة فى مكان واحد دون التضحية بالتفاصيل، إذ أن كل مسافة كانت تظهر بنفس الوضوح على الشاشة ومن ثم، فقد أمكن الجمع فى نفس الوقت بين لقطة قريبة فى المقدمة ولقطة عامة مأخوذة فى العمق في مونتاج داخلي، يبنى عالماً سينمائياً واقعياً ثلاثى الأبعاد مخترقاً السطح المستوى للشاشة.
جاء نقد الميزان سين البازاني بداية من غودار الذي ابتكر، باعتماده على نظرية بازان، التركيب الجدلي الأساس بين الـ “ميزان سين” والمونتاج، كوجهين مختلفين لنفس النشاط التعبيري، وبدأ بتعريف المونتاج كجزء من الـ “ميزان سين”وأعاد النظر بهذه العلاقة في مقالة “المونتاج – همي الجميل” (دفاتر السينما – كانون الأول 1956)، ورأى: “أن المونتاج هو فوق كل شيء جزء مكمّل للميزان سين، حيث يمكن فصلهما عن بعض فقط بكل مجازفة تماماً كما لو أن أحداً يحاول فصل الإيقاع عن اللحن. فما أن يسعى شخص ما إلى رؤية شيء في المكان، حتى يسعى آخر إلى رؤيته في الزمان“.
اتخذت وظائف المونتاج عبر تاريخ السينما طرقاً وأشكالاً عديدة لكنها في نهاية الأمر تحددت في مجموعتين:
* الأولى تنتمي إلى المونتاج الأفقي، التي تكمن طبيعته في سرد لقطات وفقاً لقانون التجاور عبر التعارض والتكامل.
* والثانية تنتمي إلى المونتاج العمودي الذي تكمن طبيعته في سرد لقطات وفقا لقانون التزامن.
المونتاج الأفقي
أنطلاقا من إن بمقدور لقطتين أن يأتلفا معاً، فلابد لهما، أولا أن يوجدا منفصلتين. لهذا اعتمد إيزنشتين في دراسته(المونتاج– 1938 ) على طريقة مونتاج تنظيم الصور، خطيا، في الزمان. وحاول أن يعيد النظر من جديد في مفهوم المونتاج سماها: ” تقابل /“Gegeuberstellung بين لقطتين/صورتين متجاورتين، ينتج عنهما معنى جديد غير موجود في أي “لقطة” منهما منفصلة وأوضحه على الشكل التالي: جزء (أ) من العناصر يتم اختيارها من موضوع يتطور إلى جزء (ب)المشتق من نفس المصدر ويولدان في “تقابل” ذلك التعميم الصُوري الذي يجسد بدوره مضمون الموضوع العام بشكل واضح. و“إذا ما تم تركيب أي (لقطتين)، فإنهما يتوحدان في تصور جديد، وينشأ من تقابلهما دلالة جديدة حتماً: أي أن جمع “لقطتين” لا يساوي حاصل جمعهما، بل هو، أكثر من ذلك، نتيجة جديدة نوعياً، تولّد “معنى ثالثا“.
من هنا فأن المونتاج الأفقي يحصل حينما تقيم وحدة اللقطات الصغرى التي تصور بشكل منفرد، لتدمج كوحدات في بنية سرد الحكاية وتقيم بينها علاقة خطية متتابعة: واحدة بعد الأخرى. ويتم تنظيم تتابع الصور في الزمن بشكل أفقي عبر تكثيف أو إطالة الزمن فنياً، وبالتالي يعد شرط ظهور الزمن الفني تجاوزاً للزمن الواقعي. وترتبط كل لقطة بغيرها خطياً/ أفقيا كما ترتبط اللقطة بنفسها: أي أن كل لقطة تجاور لقطة أخرى أو تقابل لقطة ثانية أو تكون كل لقطة ضد اللقطة التالية. وينتج في مثل هذا المبدأ التوليفي إدراك كل عنصر مونتاج تحت انطباع العنصر السابق: لقطات تتبع لقطات أو مشاهد تتبع مشاهد. ويتم التأثير السيكولوجي في هذه الحالة أيضا من تأثير اللقطة الأولى على الثانية أو من تأثير المشهد على المشهد الثاني وهكذا تنشأ الدلالة والمعاني عبر هذا التجاور. وينطبق هذا المبدأ على السكوينس: مشاهد أو لقطات تتابع ويلي بعضها البعض. ويتم التأثير النفسي عبر الصور التي يتم استقبالها تحت تأثير الصور المتتابعة.
يكشف يوري لوتمان بوضوح أن تتابع الأحداث في الواقع يتم في سيل مستمر غير متقطع، بينما تشكل الأحداث على الشاشة ما يشبه سلسلة من التكثيفات تتخللها مجموعة من الفراغات تملأ بأحداث هي حلقات اتصال. ونعود لنكتشف بأن الواقع السينمائي أو الحياة في السينما تختلف عن الحياة الواقعية في كونها تمثل سلسلة من (القطع المتجاورة). إذ بمقدورنا، انطلاقاً من أي شيء مرئي يمتلك في الواقع امتداداً مكانياً، أن نصوغه في السينما كسلسلة زمانية عن طريق تجزئته إلى لقطات.
فعالم السينما هو على الدوام جزء من عالم آخر، جزء من عالمنا المرئي ذي السيل المستمر ذاته لكن مضافاً إليه عنصر التجزئة (اللا- استمرارية). عالم مُصاغ إلى أجزاء متفرقة، عالم مجزأ إلى أحجام متقطعة، فالعالم الموضوعي يقابل برؤية فنية مشروطة بحقل الأشياء المرئية أما حقل الأشياء اللا مرئية في الواقع فيبقى خارج إطار هذه الرؤية. على هذا يحكم مبدأ التقطيع والتجزؤ العالم الفني، عالم الحياة الممثلة وهو مبدأ تقسيم أساسه صور متفرقة متقطعة تتميز بالتقطيع الإيقاعي القائم على أساس إعادة بناء، تكون اللقطة السينمائية خليته، وتفرض طبيعة اللقطة، كوحدة منفصلة، التجزئة والتقطيع والوزن في الزمان والمكان السينمائيين. ولا تقوم اللقطة، حتى في حال الاستغناء عن المونتاج، بإعادة عرض الواقع في تكامله أبداً، إنها تفتته، تجزئه وتقطعه وفق قانونية بصرية قائمة على القفزات، قانونية يحكمها مبدأ التجزئة (اللا استمرارية). هنا يأتي دور الحركة في تجاوز اللا- استمرارية. فالحركة التي جعلت من الصورة الفوتوغرافية لقطة هي ذاتها تجعل من عالم السينما عالماً قائماً على استمرارية فنية من نوع آخر. ويصبح التعاقب (الاستمرارية) بدل التجزئة (اللا استمرارية) ممكناً فقط بواسطة مبدأ الحركة الفني، حيث أن الاستمرارية في السينما قائمة أصلاً على التجزئة وتجاوز التجزئة إلى الاستمرارية الخاصة يتم فقط بواسطة الحركة.
المونتاج العمودي
تعود تظرية اندريه بازان المضادة للمونتاج الأفقي” عند إيزنشتين” إلى اكتشاف المونتاج الداخلي أو “التزامني“، وانتصر، بالتالي لأولئك المخرجين، لأنهم راهنوا على مرحلة بناء الفيلم الفنية أثناء التصوير، وليس في مرحلة المونتاج. من هنا يحصل المونتاج التزامني، الذي تمت تسميته المونتاج العمودي بأشكاله المختلفة، حينما يتم تنظيم الصور في المكان: أي، ترتبط اللقطة بنفسها ، وتتزامن داخلها لقطة أخرى في آن واحد، وينتج عن هذا التزامن استمرار المكان الذي يُبْنى فنياً بشكل عمودي: تزامن أكثر من صورة واحدة في لقطة واحدة ، تألف مشهدا واحدا ،حيث يجري حدثان يتزامنان في مكان واحد: يتطابق فيه الزمن الفني والزمن الواقعي. على عكس ما كان يحصل في المونتاج المتوازي، عند غرفث مثلا، الذي يجري فيه حدثان في زمن واحد لكن مكانين متباعدين.
ينظم المونتاج الصور في الزمن، أما الميزان سين، فينظم الصور في المكان. وكما هو معروف، فإن المكان لا ينفصل عن الزمان، وهما يشكلان وحدة لا تنفصم. غير أننا نعتقد، أن المكان يخضع للزمان في حالة المونتاج، أما في حالة الميزان سين، فيخضع الزمان للمكان.
ومع إن الصراع كان حاداً بين من يؤمنون بأوَّلية تركيب الصورة بوساطة “المونتاج” وبين من يؤمنون بأولوية احترام المكان الفيزيائي بوساطة “الميزانسين“. إلا إن تاريخ السينما يبيّن لنا، أن لا هذا التيار ولا ذاك، استطاع أن يستغني عن المونتاج. لأن المونتاج، ببساطة، هو قدر السينما.
وإن وظيفة المونتاج تعطي إمكانية التحكم في زمن السرد أي التحكم في طبيعة العلاقة بين الزمن الواقعي والزمن الفني، بيينما وظيفة الـ “ميزان سين” تتحكم في العلاقة الزمنية بين الزمنيين لصالح الزمن الواقعي على حساب الزمن الفني.
ختاما يمكن القول إنّ كلا المونتاجين في السينما: أي تكوين الصورة/ اللقطة الفيلمية المنفردة التي لا يكمن المعنى في الصورة ذاتها، بل تنشأ المعاني وفقا لقانون تجاور اللقطات، التي تتعارض وتتكامل في مشهد واحد: والـ “ميزان سين” الواقعي للقطة طويلة مستمرة / مشهد يكمن معناها في الموضوع المصور على حساب التأويل وللممثل على حساب المخرج ولا يكون فيها دور يذكر للمونتاج الأفقي كما أنّهما ليسا امتداداً آلياً لواحد منهما بل هما نتاج لتركيبهما المعقد وتناقضهما الجدلي.
2- مصطلح اللغة السينمائية
تعاني دراستي لمصطلح “اللغة السينمائية“ كما يرى العمري أيضا من مشكلة تنتج من مسألة “اعتبار الصور السينمائية مثل الكلمات، طبيعتها كعلامات، أي التعريف بشيء آخر أو بتعبير أفضل، إحلال شيء آخر بدله”. وهو ما يربك الموضوع كله ويردّنا إلى أن استخدام كلمة “لغة” هو استخدام مجازي، ولكن في سياق آخر مختلف. فالفيلم ليس من الممكن اعتباره ترجمة بالصورة للغة منطوقة لأننا في هذه الحالة سنتساءل: أي لغة؟ هل هي اللغة الإنكليزية أم الروسية أم الفرنسية أم اليابانية”؟
ليس المهم، لمن يبحث، التراجع عن مصطلح “لغة السينما“، حتى وان كان يستعمله مجازاً، المهم أن تتاح لنا فرصة الوقوف عند: “إشكالية” موجودة حقا ويجب علينا فهمها بعمق، خصوصا وان “الالتباس” يأتي من استعمال مصطلح “لغة” بينما الوسيط السينمائي، ليس، في واقع الحال، لغة جاهزة، لها قاموسها الخاص وقواعدها العامة ونحوها…
منذ بداية تاريخ السينما تمت مقارنة السينما باللغة الطبيعية وتبع ذلك الاعتقاد بأنها لغة تمتلك قواعدها ومونتاجها ونحوها. واستمر عدم الوضوح في عدد من تلك المفاهيم في إطار نظرية السينما، خصوصاً وان النظرية الكلاسيكية، لم تمتلك إلا معرفة قليلة بعلم اللغة، وكانت بالكاد تؤهلها لعقد مقاربة سليمة بين مفاهيم هذا العلم وتطبيقها.
نقرأ في كتاب بيتر والين “السيميولوجيا والسينما في لغة الفيلم“ ترجمة أمين صالح: “من الأيام الأولى للسينما كان هناك ميل مثابر، مع أنه مفهوم، لتضخيم أهمية التشابهات مع اللغة الشفهية. السبب الرئيسي لهذا كان الرغبة في تثبيت وضع السينما بوصفها فناً.(…) السينما هي بالفعل لغة، لكن لغة بلا نظام شفري. إنها لغة لأنها تملك نصوصاً. ثمة خطاب ذو معنى لكن بخلاف اللغة اللفظية، لا يمكن إحالة هذه اللغة إلى شفرة كائنة.“
ويبقى في هذه الحالة أن نرى أن هناك عدداً من مشاكل مركزية في فهمنا لنظرية السينما، لا يمكن حلها دون الرجوع إلى نظرية علم اللغة؟
كان الهولندي جان ماري بيترس Jan Marie Lambert Peters من أوائل السينميائيين، الذين بحثوا في هذه الإشكالية. وتقف دراسته الأولى التأسيسية “بنية اللغة السينمائية“التي نشرت عام 1961 على رأس قائمة البحوث الجديدة المهمة. ويبدأ بيترس بحثه بالسؤال التالي: “ماذا نريد أن نفهم من كلمة “لغة“؟ وإذا ما كنا نرى في لغة الكلام الظاهرة اللغوية الوحيدة. فعندها ستكون كل مناقشة حول طبيعة لغة السينما بدون أي معنى. أما إذا سلمّنا بوجود لغات أخرى إلى جانب لغة الكلام، وانطلقنا من مفهوم لغة عام جداً، فعندها يمكننا أيضاً أن نفكر بـلغة للسينما. وإذا ما توصلنا، بناء على ذلك، إلى الاستنتاج القائل بأن استعمال تعبير لغة سينمائية تم تفسيره، فنكون، بذلك، توصلنا بالتأكيد إلى نتيجة ناقصة. فالتسمية لغة لا تفصح في هذه الحالة عن شيء جديد حول طبيعة السينما. يمكننا أيضاً التفكير بلغة الكلام كموديل (Model) واكتشاف ميزتها الجوهرية ومن ثم تمحيص مدى وجود مثل هذه الميزة الجوهرية في السينما. ولا شك أن مثل هذا المنهج المقارن مثمر إلى حد ما، لأنه يوضح لنا الفرق بين لغة السينما ولغة الكلام ويظهر لنا أيضاً شيئاً ما حول البنية الذاتية للوسيط السينمائي.
استطاع الفرنسي أندريه مارتينيه André Martinet، وهو يقارن بين الكلام البشري وبين غيره من ألوان التخاطب، أن يبين أن الكلام البشري قادر وحده على “التمفصل المزدوج“وأكتشف أن مبدأ التمفصل المزدوج هو القانون الأساس من قوانين أي لغة طبيعية، فأساس كل خطاب لغوي يتميز بوحدتين: الفونيمات “phonèmes“، التي هي وحدات تمييزية أصغر يعبر عنها في الكتابة بالحروف الأبجدية وهي وحدات أولية للصوت غير دالة ، تنفرد بها كل لغة وتسمى اللغات الغربيّة تسمّى الأبجدية Alphabe:و في اللغة العربية حروف الأبجديّة هي 28 حرفا وحدات صوتية صغيرة لا تحمل أي معنى: تلخص أصواتها في : أبجد، هوز، حطي، كلمن، سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ.أما وحدة المورفيمات “morphème” وتعتبر وحدات التمفصل الأول وهي وحدات صوتية صغرى دالة تتألف بدورها من حروف الفونيمات المحدودة التي تنتج عدداً غير محدود من المورفيمات ، تساعد على التمييز بين المعاني ، ولا تنجز وظيفتها بفضل تفردها الصوتي وإنما بفضل تقابلها التبادلي ضمن نظام معين.هكذا يكون بقدرة الانسان غير المحدودة على استخدام الأصوات لإنتاج وإبداع المعاني المختلفة في شتّى السياقات.
يتيح اكتشاف مارتينيه الحاسم للتمفصل المزدوج تعريف اللغة، بحيث لا يمكن اعتبار أية وسيلة اتصال أخرى، لا تمتلك هذا القانون الأساس بمنزلة اللغة. ومن هنا أيضاً يأتي، مثلاً، تأكيد اللساني الفرنسي جورج مونان Georges Mounin بناء على إن اللسان المتمفصل ، يقبل التقطيع والتمفصل وهي الصفة التي عدّها من أهم مميزات الألسن الطبيعية البشرية إذ به تتفرد وتتميز عن باقي الأنظمة الأخرى. وأكد بالتالي على إن “التمفصل المزدوج هو ما يُميز اللسان البشري وما هو لغوي خالص في تعابير الإنسان معاً، وهو مشترك بين اللغات كافة. وخارج التمفصل المزدوج لا توجد لغة قط، ولا يوجد شيء يتعلق بعلم اللغة“.
وفي ستينيات وسبعينيات القرن الماضي بينت السيميائيات، إنه لا يمكن العثور في الفيلم ، على أي بنى تشبه بنية الأشكال اللغوية. وكان أن توقفت الدراسات المقارنة الحديثة عند هذه المسألة طويلاً، وتوصلت إلى نتيجة: إن اللقطة لا تشابه الكلمة والمشهد لا يشابه الجملة، لأن الفيلم أصلاً لا يمتلك، مثل اللغة، نظاماً خاصاً، يجعل منه لغة. فالكلمات هي رموز اصطلاحية ينوب فيها الدال عن المدلول على أساس المواضعة، أما الصور فهي علامات أيقونيه، تقوم نفسها على أساس المشابهة، فكما تملك الكلمة علاقة غير مباشرة بما تدل عليه، تملك الصورة علاقة أيقونية مباشرة بما تدل عليه وتصوره: أي إن الكلمة، وحدة لغوية، علامة، وظيفتها إحلال شيء بدل شيء آخر، فهي دال ينفصل عن مدلوله: الكلمة تساوي الشيء. أما الصورة، فهي علامة بصرية، تتشابه فيها العلاقة بين الشيء ومظهره، ويتطابق فيها الدال مع المدلول: أي إن العلامة هنا هي مظهر الشيء ذاته: العلامة تشبه مظهر الشيء. وتكمن قوة اللغة في استعمال علامات يتباين فيها الدال والمدلول، بينما قوة الفيلم تكمن في استعمال علامات يتشابه فيها الدال والمدلول: صورة القط تشبه القط فعلا، بينما لا يشبه القط في شيء العنصر الصوتي/قط/أو العنصر المكتوب قط.
وبدأ النقاش حول بنية لغة السينما وبنية اللغة الطبيعية وذلك انطلاقا من هذه الإشكالية، إن صح التعبير، في أول ندوة حول سيميائية الفيلم في مهرجان بيزارو عام 1965 شارك فيها امبرتو إيكو وبيير باولو بازوليني والفرنسي كريستيان ميتز.
وذهب من جهتة بازوليني الى ان لغة السينما ليست بحاجة الى تمفصل اللغة المزدوج لان لها تمفصلها المزدوج الخاص الذي لا يتناسب مع تمفصل اللغة؟
وتتكون وحدتها الدنيا من مختلف الاشياء الواقعية التي يتضمنها مشهد ما. وان الوحدات الدنيا هي صور الواقع يسميها من وجهة نظر لغوية Kinemeوذلك قياسا على فونيمات وتدخل هذه الوحدات في تركيب وحدة اكبر هي المشهد وتعادل “morphème” اللغة الطبيعية ووجد ايكو محاولة بازوليني في تقطيع لغة السينما الى وحدات يوظف مفهوما للواقع لا يمكن ان يرضى به الجميع، لان ما تنقله السينما من افعال يدخل عالم العلامات. وبالتالي يتفق معه على انه ليس من الضروري ان تنبني كودات السينما اي شفراتها على نموذج تمفصل اللغة المزدوج . كما انه ميز ايضا بين الشفرة الفيلمية والسينمائية لان السينمائية تشفر عملية نقل الواقع بوساطة الاجهزة السينمائية في حين تشفر الاولى الفيلمية التواصل وفقا لمستوى قواعد محددة من قواعد السرد مع الاخذ بنظر الاعتبار ان الفيلمي والسينمائي يستند بعضهما على بعض مثلما تستند شفرة الاسلوب البلاغي على شفرة اللساني. بحيث أصبحت فكرة الايقونية في مجال الادراك البصري نقطة البداية في افق اعادة نظر أيكو في الوقائع البصرية.
بدوره تناول كريستيان ميتز امكانية قيام مقاربة سيميائية للفيلم بوجود “مادة أوليه غير قابلة للتحليل والاختزال في وحدات منفصلة. ويعني بهذه المادة الصورة، اي شئ مماثل للواقع لا صلة له بمواضعات اللغة الطبيعية، التي تتأسس على قوة“التمفصل المزدوج“: فلكي يتم استخدام اللغة، على المرء أن يكون قادراً على فهم أصواتها ومعانيها، وكلاً من دالِّها ومدلولها. إلا أن هذا لا ينطبق على السينما. التي هي منفصلة ومتميزة عن باقي اللغات وتتميز بعلامتها ذات الدائرة القصيرة، التي يكون فيها الدال والمدلول هما الشيء نفسه تقريباً: فما نراه هو ما نتوصل إليه.
على اساس من هذه المفاهيم فقد قدمت دراسة مصطلح ” اللغة السينمائية في “عين على السينما” على أنها مقدمة نظرية أولى للنقاش؟
ورغم أن النقاد العرب، ما زالوا يستخدمونه حتى اليوم، دونما أي شعور بالحرج. فنحن نرى مثلا ناقداً بارزاً كعلي أبو شادي، الذي عنوّن كتابه “الفيلم السينمائي” والذي سبق وصدر في طبعته الاولى عن الثقافة الجماهيرية في العام 1989، لكنه حينما اعاد إصداره عن مكتبة الاسرة في العام 1996 واعاد إصداره في دمشق في سلسلة الفن السابع 114 في العام 2006- غير عنوانه إلى “لغة السينما“، التي يعرّفها: حرفة الفنان السينمائي و“ووسيلته لتحقيق رؤيته وتوضيح موقفه بشأنها، شأن اللغة التي يستخدمها الكاتب وفق القواعد والأساليب البلاغية والنحوية“.
كما إن مخرجاً كبيراً كصلاح أبو سيف أكد، أثناء ما كان يشرح لطلاب المونتاج والإخراج في السنة الثالثة في أكاديمية الفنون بالقاهرة، “علينا فهم السينما كـــ لغة ذات ابجدية واضحة ومحددة، شأنها في ذلك شان جميع اللغات الحية كـاللغة العربية وما تتضمنه من قواعد للنحو والصرف (…) وكلما اتقنا قواعد اللغة كلما استطعنا التعبير عن مرادنا بأبسط وأدق الألفاظ بحيث يفهم حديثنا كل من يستمع إليه. ونتيجة لذلك يرى إن اللغة السينمائية تتألف ابجديتها من ثمانية حروف: خمسة منها تخص الصورة وثلاثة تخص الصوت. ويسمي أبو سيف لطلابه هذه الحروف الخمسة كالتالي: الديكور والممثل والاكسسوار الثابت والمتحرك والاضاءة“!
يبقى أن من يعتقد إن تقسيم المشهد إلى لقطات بأحجام مختلفة واستعمال الشاريو أو الزوم والبانوراما أوالتصوير بكاميرا واحدة واعتماد مواقع تصوير عديدة واستخدام طرق مونتاج مختلفة الخ… يخوله باستعمال هذا المفهوم، فليس علينا سوى أن نبين إن ذلك يشكل للسينمائي “كودات” حيادية، ليس لها، في الأصل، دوال جاهزة، ترتبط بمدلولات قاموسية، فالفيلمي المنجز يسبق الفيلم، وما هو سينمائي ينتج من الفيلم ويأتي مصدره من علامات مبتكرة تتآلف في الفيلم كخطاب.
عرّفت السيميائية اللغة والفيلم باعتبارهما ينتميان، من جهة، إلى نظم الاتصال، ويختلفان، من جهة أخرى، في أن اللغة، أية لغة، تملك نظام لغة، أما الفيلم، الذي تجمعه مع اللغة أشياء كثيرة مشتركة، فليس له نظام لغة. ولعل هذه المقارنة توضح ما عناه كريستيان ميتز، حينما اعتبر الفيلم لسانا بدون لغة، أو حينما عقب على ذلك امبيرتو ايكو، وعدالفيلم بمنزلة كلام لا يستند على لغة.
يعرض كريستيان ميتز مراحل ثلاثة لتاريخ النظرية، جرى فيها تسليط الضوء على الفيلم، وتأسس، نتيجة لذلك، ما سُمي نظرية الفيلم أو نظرية السينما، ويعني الشئ ذاته، وتمت فيها معرفة ما هو فيلمي أو ما هو سينماتوغرافي. وكانت تلك الأبحاث الانتقائية والتركيبية متألقة، في بعض الأحيان، رغم إنها لم تستعمل منهجاً معرفيا بعينه، بشكل كامل، بل استعملت مناهج عديدة. وفي مرحلة ثالثة، كانت متوقعة، كان على كل منهج من هذه المناهج، وهو يرتبط بغيره ويتداخل، أن تختفي أشكاله الحاضرة، وأن يتخلص تركيب نظرية السينما، فعلاً، من انتقائيته ويراجع مدى صحة تقديراته المختلفة ومعرفة مستواها التجريدي الخاص. ويبدو إننا في الوقت الحاضر، نجد أنفسنا في المرحلة الثانية، التي هي – حسب ميتز – “مصح شفاء” لا مفر منه، وعلينا بالتالي أن نتعرف على تعددية المناهج الضرورية.إن سيكولوجية الفيلم وسيميائيته لم تكن موجودة في الماضي، وربما لن توجد في المستقبل، لكن علينا اليوم أن نرعاها، لأن الوصول إلى خلاصة حقيقية، لن يتحقق بالإملاء، إنمايتحقق، في النهاية، عن طريق الأبحاث الوفيرة“.
يؤكد كريستيان ميتز على إن الفيلم: “يروي لنا قصصاً مترابطة، ويقول لنا أشياء كثيرة، تقولها أيضا اللغة المنطوقة، لكنه يقولها بطريقة أخرى. إن الذهاب إلى السينما يعني رؤية هذه القصص“.بمعنى آخر: “ليس لان السينما لغة تستطيع أن تروي لنا قصصا جميلة، إنما لأنها روت لنا هذه القصص أصبحت، بذلك، لغة“. على الفيلم أن يقول شيئا وله أن يقوله، لكن دون أن يلتزم بشعور معالجة الصور ككلمات وتنظيمها وفقا لقواعد نحو لغوي مشابه. أن حظ الفيلم في قدرته على التفريج والتعبير عنمعنى، ليس وفقا لأفكار مسبقة أو مستعارة، إنما عبر تنظيم عناصره في الزمان والمكان. يستنتج ميتز: “الكاتب يستعمل اللغة، أما السينمائي فإنه يبتكرها“.
وقد وضع ميتز أمامنا جوابين، الأول الذي تبيّنه “الواقعة” التاريخية، وهو أن السينما تطورت، بالدرجة الأولى، إلى سينما سردية تروي حكايات. والثاني يتعلق بتتابع الصور واقترابه، كمعنى، من العبارة الملفوظة، مما قاد إلى اعتبار اللقطة المنفردة كعبارة سردية صغرى. ولربما دفعته مقارنة كهذه إلى التوضيح: “بأننا نفهم الفيلم ليس بسبب من فهمنا المُسبق لنظامه، إنما على العكس من ذلك، فنحن، لأننا نفهم الفيلم، نقترب من فهم نظامه. فالسينما لم ترو لنا قصصا جميلة لأنها لغة، بل لأنها روت لنا مثل هذه القصص والحكايات أصبحت كما اللغة“. ويستنتج ميتز: “السينما فن حين تصبح لغة”.
يسمح لنا التشابه في مستوى التركيب الأفقي ومستوى الاختيار العمودي في فنون خاصة مثل الرسم والسينما، أن نعتبر هذه الفنون مادة للسيميوتيك، أي كأنظمة مبنية وفقا لنموذج اللغة. وإذ يجد لوتمان اللغة الطبيعية كموديل نموذج للعالم أولي، فانه يجد أشكال التعبير في الفن وسائط موديل من نوع آخر ثانوي. وهو يعتبر اللغة “نظام تنمذج أولي” في التعبير، وبما أن وعي الإنسان هو وعي لغوي، فإنه يمكن اعتبار وسائل التعبير الأخرى الأدبية والفنية “نظام تنمذج ثانوي” في التعبير، وقلما يستطيع نظام التنمذج الثانوي، وهو يبتكر لغته في التعبير، الاستغناء عنالنظام الأولي.
إن التحليل الذي يقدمه لوتمان ويصل انطلاقاً منه إلى نظام موديل الفن كلغة “تعبير” ثانية بالعلاقة مع اللغة الأولى، يساعد إلى حد كبير على فهم الإشكالية التي واجهت وتواجه العديدين. فهو يسمي هذه اللغة الثانية “نظام تنمذج ثانوي” يضع بيد المختصين مصطلحاً يعينهم على إزالة الالتباس، الذي يحيط بالإشكالية المطروحة، الناتجة من عدم الوضوح العام.
وختاما أحب أشير إلى إن العمري وأنا كنا نعتقد انها المرة الأولى في البحث العربي السينمائي النظري يثار فيها موضوع دراسة “مصطلح اللغة السينمائية“في “عين على السينما” وإن هناك مجموعة من النقاد والباحثين السينمائيين، تشاور معهم وأبدوا استعدادهم للمساهمة في نقاش الدراسة وإن العمري بين للجميع بأنه سينشر كافة الدراسات الحوارية في كتاب!
تعقيب من أمير العمري:
كان هذا الموضوع قد طرح من قبل بالفعل- ليس في موقع “عين على السينما” بل في مدونتي الشخصية “حياة في السينما” قبل سنوات، وساهم في النقاش بعض النقاد ولكن المادة التي توفرت لي لم تكن تكفي لانتاج ولو ربع كتاب لذلك لم يصدر كتاب في الموضوع. أما مقالي الذي نشر في “العرب” فلم يكن الهدف منه مناقشة كل ما جاء في الكتاب وهو كثير، بل لفت الأنظار الى أهميته وأهمية ما يطرحه من أفكار، ودفع الآخرين الى اقتنائه وقرائته والتوقف أمام بعض النقاط وطرح التساؤلات بشأنها بدلا من اللجوء، كما يفعل غالبية من يقدمون عروض الكتب، بتلخيص محتويات كتاب الزبيدي في آلاف الكلمات كبير. والمهم أن المقال نجح في أن “يستفز” الزبيدي لكتابة هذا المقال التفصيلي الجميل الذي يسط الضوء من خلاله على بعض ما جاء في الكتاب ويشرح مداخله الى ما توصل إليه من خلاصات. لكن يجب الاشارة أيضا الى أن الزبيدي نقل فقرات كاملة من كتابه في مجال مناقشة مسألة “لغة السينما” لتوضيح جوانب الموضوع كما يراها هو وأتفق أنها في حاجة بالفعل الى مزيد من المناقشة والتفصيل.