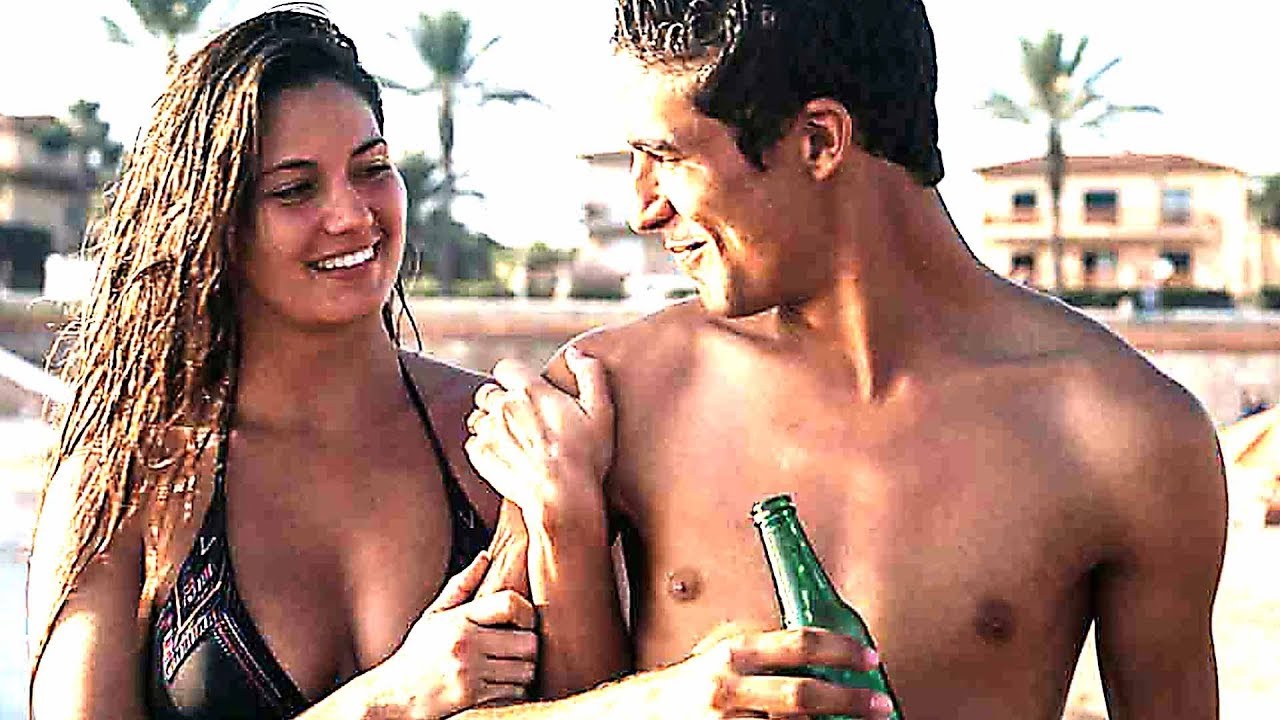في محبة السينما

السينما فن ساحر، فن له جاذبية استثنائية، وهو على الأرجح من ضمن التعابير الفنية الأكثر تأثيرا على المتخيل الإنساني والأكثر تدخلا في حياة المواطنين عبر القارات وفي مختلف المراحل التاريخية الحديثة. وقد حظيت الظاهرة السينمائية، ومازالت تحظى، باهتمام شرائح مجتمعية متباينة إذ يختلف تلقي الأفلام ما بين استهلاك بسيط يروم تزجية الوقت والتسلية وبين نمط من التلقي يسائل المنتوجات الفيلمية ويدقق في تفاصيلها ويربط بينها وبين تطور مجتمع ما وطبيعة احتياجاته في مرحلة تاريخية محددة. وهذا النمط الثاني هو الذي ينبني على اهتمام يمزج بين البعدين العاطفي والمعقلن في تعلقه بالسينما، وهو ما يسمى لدى المتخصصين بـ”محبة السينما” أو “السينيفيليا Cinephilia”. فما هي “أعراض” محبة السينما هاته؟ وما هي أشكال تمظهراتها؟
في البدء يكون الانجذاب نحو عروض سينمائية متباينة في محتوياتها واقتراحاتها الجمالية، ليتولد بعد ذلك الإستمتاع بأجواء القاعات وما توفره من غفلية وغموض وإمكانية الإنكفاء على الذات، ثم تأتي مرحلة تشبه الإدمان حينما تتحول مشاهدة فيلم إلى طقس ضروري لا يمكن الإستغناء عنه. و قد نحصر تمظهرات محبة السينما في الإقبال المنتظم على مشاهدة الأفلام على اختلاف سجلاتها ومدارسها، يلي ذلك التدخلات الشفاهية التي تلي عروضا سينمائية حيث يتم إبداء الرأي الفوري حول ما شوهد على شاشة العرض فتكون هنالك إمكانية تدافع الأفكار وتقاسمها، ليأتي بعد ذلك العبور إلى النقد المكتوب للتعبير عن وجهة نظر تعلن عن منطلقاتها واختياراتها الفكرية والجمالية، وجهة نظر تلتقي في بنيتها مع الخطاب السينمائي ومع حركة الكاميرا حينما تركز على عناصر من الفيلم دون أخرى تبعا لحساسية الناقد أو المنظر ورؤيته للعالم، كما أنها تعيد بناء موضوعها وتمنحه دلالات جديدة كما يفعل التوضيب مع المواد المصورة، أي أن محبو السينما لا يكتفون بالإستهلاك، بل يعمدون إلى تحليل المنتوجات الفيلمية وإصدار الأحكام ورصد الإنتظارات والتوقعات والتفاعلات التي تتولد لدى المتلقين والتي قد تتقارب بين أفراد مجموعة اجتماعية ما، فتشكل جزءا من المشترك ومن الرصيد الذي يشكل لحمة تقرب بين أفراد تلك المجموعة وتجعل استجاباتهم تتشابه تجاه ظاهرة ثقافية أو فنية.
وبالرغم من أنه يمكن الجزم بأن ظاهرة محبة السينما قد رأت النور بالتوازي مع عرض الأفلام الأولى للأخوين لوميير، إلا أنها أسست لتصورها النظري في أربعينيات القرن الماضي حينما انتصرت لسينما المؤلف والسينما ذات الأبعاد الجمالية والفكرية مقابل سينما تجارية ترضخ لرغبات الجمهور وتسعى إلى أن توفر له فرجة سهلة.
وفي العاصمة الفرنسية باريس تحديدا ومع أجواء نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأت تتشكل حركة النوادي السينمائية ترافقها بعض الكتابات الخجولة، وتم الترويج لشعار يقول: “من يحب الحياة.. يذهب إلى السينما”، لتظهر بعد ذلك مجلتي “دفاتر السينماLes cahiers du cinema ” و”بوزيتيف Positif” اللتين دافعتا عن طروحات نقدية مغايرة وانتصرتا للتجريب والمغامرة، كما أنهما أسستا لما عرف في السينما الفرنسية بالموجة الجديدة. ومن اللافت للإنتباه أن العديد من الكتاب الذين جربوا مهاراتهم النقدية والتنظيرية في هاتين المجلتين انتقلوا إلى مرحلة الإبداع وإنجاز أفلام لقت حفاوة خاصة كما هي حالة فرانسوا تروفو F.Truffaut وجان لوك كودارJ.L.Godart وإيريك رومرE.Romher وغيرهم.
ويتعلق الأمر بمجموعة من الشباب العصاميين الذين تشربوا حب الفن السابع في النوادي السينما ومقاهي الحي اللاتيني ومدرجات جامعة السربون وعبر السجالات والنقاشات الصاخبة التي غالبا ما كانت تستحضر رؤى فنية وتصورات سياسية مترابطة، ليمزجوا محبة السينما برؤية نقدية وشغف واشتباك مع العالم . وبالتدريج، انتشرت أفكارهم التي كانت تبدو في البدء غريبة، وبدأت تؤثر في الجمهور الواسع، كما أن العديد من المهرجانات العالمية خصصت جوائز يمنحها النقاد وبرمجت بعض الفقرات التي لم تخف مساندتها للتجريب والبحث الجمالي.
إن محبة السينما ، باعتبارها ظاهرة عابرة للمجتمعات وللثقافات، تعني، ضمن ما تعنيه، القدرة على الإختيار واعتماد معايير للتمييز، وهي لا تتردد في الحث على النظر إلى السينما باعتبارها شكلا تعبيريا قائم الذات وليس فقط مادة دسمة للسجالات الصاخبة، كما أنها ترتبط بالمواقف الفكرية المتقدمة خاصة في بلدان العالم الثالث التي برزت فيها هذه الحركة في الجامعات وفي بعض النوادي الطليعية كما كان الأمر ببعض العواصم العربية التي عرفت في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي ما يمكن تسميته بالعصر الذهبي للحركة السينيفيلية بنقاشاتها وصخبها، بل إن هنالك العديد من المخرجين العرب الذي تخرجوا من “معطف” هذه الحركة التي ساهمت في مد صلات ذكية ومنتجة بين السينما والمجتمع، وفي جعل المتلقين يتوجهون نحو الأفلام لينصتوا إلى توتراتها وصمتها، والتأكيد على أن الفرجة السينمائية هي من مستلزمات مجتمع حداثي أو مجتمع يطمح إلى أن يصبح كذلك.
كما أنها جعلت، بمعنى من المعاني، النقاد ومحبو السينما يقومون بدور الوساطة بين الإنتاجات السينمائية وبين من يفترض فيهم أنهم قد شاهدوها أو عليهم مشاهدتها أو إعادة مشاهدتها.
ولكي يقوم محب السينما بدور الوساطة بشكل جيد وفعال من المفترض فيه أن يكون قد استمتع بما شاهد، وأن يكون قد تفاعل مع ما عرض أمامه ليحاول بعد ذلك نقل ذلك الإحساس بالمتعة إلى الآخرين ليحاول إدهاشهم بخلاصاته وبفكه لشفرات العمل حتى يبرهن على أن ما كل المقاربات تتشابه وما كل الأعمال الفنية تتشابه كما يريد أن يوهمنا بذلك نقد شكلاني بارد.
أما السياق الآخر الذي تتدخل فيه محبة السينما بشكل أساسي فهو سياق المهرجانات السينمائية التي يتميز كل واحد منها بخطه التحريري ويتمايز ببرمجته التي توجه وتؤطر وتدافع ضمنيا عن توجهات فنية بعينها، دون أن نغفل قاعات العرض التجريبية التي تقترح أفلاما قد توصف بالنخبوية، أفلاما تحاور المستقبل وتتميز بجرأتها الجمالية والفكرية وتكون بمثابة مختبر فني تعمل المجلات المتخصصة والندوات لاحقا على التعريف بخلاصاته والترويج لها وتقريبها من الجمهور الواسع.
ولا يمكن تصور حركة ثقافية وفنية مؤثرة تتمحور حول السينما باعتبارها فنا حداثيا ودائم التطور دون وجود خزانات سينمائية تحفظ الأرشيف السينمائي لبلد ما وتحفظ ذاكرة صوره وترمم الأفلام التي تستوجب الترميم ، لأن من لا يعرف من أين أتى لا يستطيع أن يحدد الوجهة التي يقصدها، ولأن محبة السينما هي مشاهدة ونقد واكتشاف وإعادة اكتشاف للإبداعات السينمائية على اختلاف مصادرها.
وقد عرفت الحركة السينيفيلية عبر العالم عدة تحولات إذ كان المشرفون على النوادي السينمائية والمجلات المتخصصة والمهرجانت الفنية يدبرون بإبداع ومشقة ندرة الأفلام، فأصبحوا الآن مطالبين بتدبير وفرة يصعب أحيانا التحكم فيها. وأصبح للحركة السينيفيلة تحديات ورهانات جديدة مثل التفكير في وضعية السينما مع غزو المؤثرات الخاصة و مع تعملق بعض القنوات التلفزية مثل نيتفليكس، و التفكير في أشكال جديدة للتكيف مع معطى موضوعي وهو أن الفرجة السينمائية قد أصبحت، في بعد من أبعادها، ذات طابع فردي وذلك بفعل تقوي ظاهرة اختفاء قاعات السينما وتراجع عدد مرتاديها، واستهلاك شرائح كبيرة من المهتمين للأفلام عبر شبكة الأنترنيت أو القنوات الفضائية المتخصصة أو حتى الهواتف الذكية.
ويبقى الهدف الرئيس للحركة السينيفيلية هو المساهمة في فرض الإعتراف بالسينما بين المثقفين والمتخصصين باعتبارها شكلا فنيا وتعبيرا ثقافيا له قوته وضرورته لكونه يفتح أفق انتظار المتلقين على تجربة جمالية مغايرة لتلك التي يفتحها الأدب أو التشكيل مثلا.
وتطمح هذه الحركة إلى مرافقة الدهشة و النظرة الجديدة التي تولدهما الإنتاجات السينمائية الطليعية والقبض على التحولات المذهلة التي تعرفها الظاهرة السينمائية، كما أنها تعمل على التأسيس لتاريخ مغاير للمشاهدة وفن النظر.
- – .