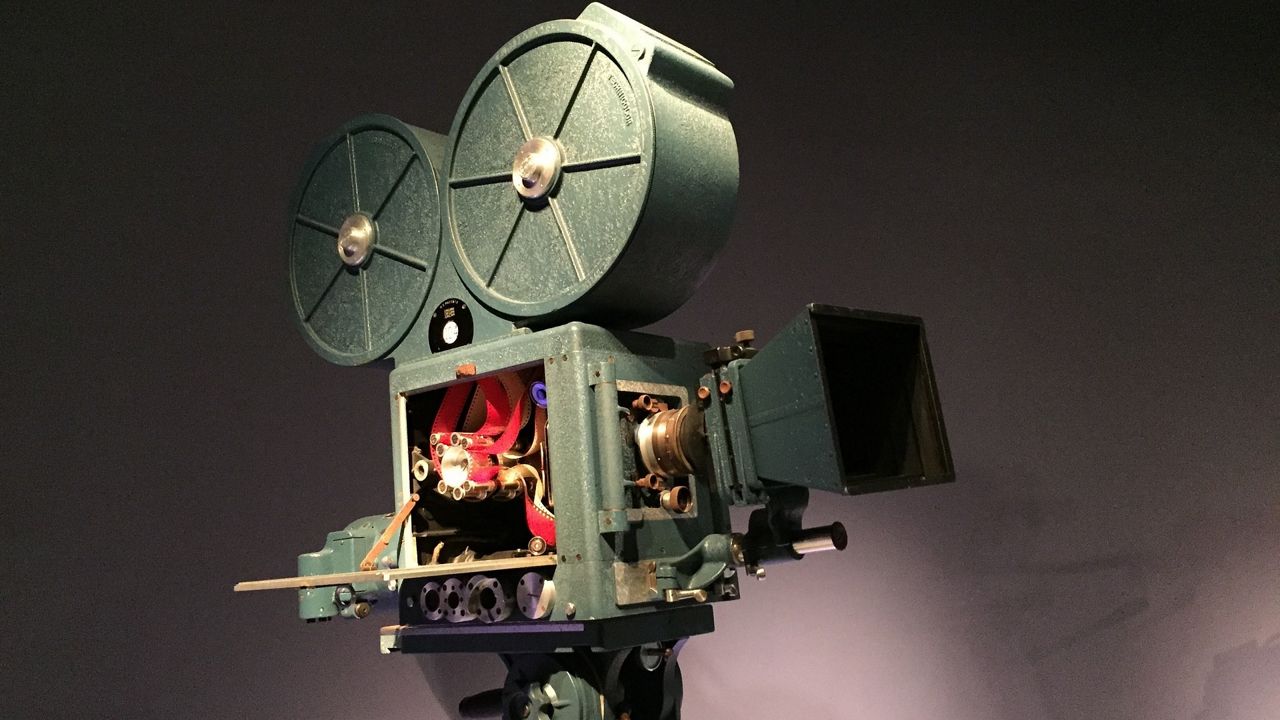“في المنزل” للمغربية كريمة السعيدي

مبارك حسني
القاعدة ليست صائبة مئة في المئة، لكنها مؤكدة في الكثير من الأعمال السينمائية، ومفادها أن كل فيلم قوي في تأثيره العاطفي، لا يكون كذلك إلا لو كان مخرجه مسكونا حتى النخاع بموضوعه، أي بصّوره الموجودة في الذهن قبل أن يعبر عنها على الشاشة بفعل الضوء الخلفي لآلة العرض. وينطبق هذا الأمر بشكل كبير على فيلم “في المنزل” للمخرجة المغربية المقيمة في بلجيكا، كريمة السعيدي.
حيوات بالقرب من الموت
ولأنها متمكنة من الأدوات التقنية، كخِريجة من معهد الإنساس ببروكسيل في مجال السيناريو وتحليل الافلام، ثم كومنتيرة، فقد وظفت معرفتها وخبرتها بفضل ما “يسكنها” لتبدع فيلما حنينياً وحميمياً، وضعت فيه الكثير من أحاسيسها العميقة، وليس أفضل من سرد حكاية عائلتها التي تكفلت والدتها بمصيرها، من أفراح والعديد من المآسي، لمدة خمسين سنة. هذه الوالدة التي تركت مدينتها الأصلية، طنجة، في اتجاه بلجيكا رفقة زوجها، بلا سلاح سوى براءة أولى وسليقة الأمومة، وما تفرضه من علاقات مع الأبناء. فكل شيء يدور في المنزل، كما يدل على ذلك العنوان.
نقطة قوة الفيلم هي جرأة المخرجة في سرد حياة خمسة عقود ببعثها قسرا في ذهن هذه الأم، لكن بعد أن أصابها داء النسيان، الزهايمر، وقرب الموت. فهي في حالة صراع ضد ما لا تُضمن نتائجه أصلا، أي بعث حياة ممتدة ومتعرجة من بين ثنايا الذاكرة التي لم تعد سوى شيء هلامي بلا وجود حقيقي.
حدث هذا أولا بالحوار المُسَجل مع الأم في الغرفة بالمستشفى، وبالتصوير بواسطة كاميرا الهاتف في بداية الأمر، تحت إحساس مستعجل وُجدتْ المخرجة مدفوعة إليه ولو للإمساك بما قد يندثر بالكامل وتستحيل استعادته.

ثانيا، بالتصوير المُلتقط لألبوم العائلة بصوره الجامدة في زمنيتها الخاصة، وهي الوحيدة التي بإمكانها أن تُنَقِّط مراحل السنوات الماضية، حيث يتم السؤال والخوض في محتواها وعن الأشخاص الموجودين فيها، والتعليق عليها كعملية لازمة لوضع كلمات على صمتها.
وثالثا وأخيرا، بتوضيب الكل في شريط سينمائي، وهو العمل الذي استغرق تسعة أشهر بالتمام والكمال، موزعة على سنة. والشريط هو نتاج هذا التوضيب المُحكم (المونتاج). وهكذا يتشكل الفيلم من صوت خلفي وتوارد لصور وفيديوهات، في علاقة مع حاضر المخرجة التي تحزن لمرض الوالدة، والتي تود أن تعرف كيف جرى ما جرى، ولماذا صار مآل حياة مليئة بالأحداث إلى هذه النقطة التي بلا عودة.
هو فيلم حميمي، كما قلنا، لأنه مرتبط بمخرجته طولا وعرضا. هو الفيلم/ السؤال الكبير الذي ستنطق فيه حياة أمها، وبالتالي حياتها هي بالذات. فهذه الأخيرة هي الأصل الذي نبتت منه الفكرة، والأم هي الفرع الذي يحمل الكثير منها، فكًوَّنه تكوينا. هي تجربة، لا من أجل لس الخلاص من ألم أو ذنب، بل لغاية واحدة هي الفهم، بالبرهنة عن طريق الصُّور الخالصة، إن جاز التعبير. وهو عين ما باحت به المخرجة في تعليق أولي في الشريط.
أين المنزل؟
كل شيء يبدأ من حيث المنطلق الأول، أي من الطفولة، فتسأل البنت أمها عن المنزل الذي كانت تقطنه قبل الرحيل، فلا تتذكر. لكن الكاميرا تعوض ذلك، فتنتقل إلى طنجة مباشرة، لتدخل في أزقة حيها العتيق المعلق، وتتموج مع منعرجاتها، فكأنها تخوض في منعرجات ذاكرة بلا لون، ذاكرة ضبابية. ثم تعود إلى بروكسيل، في تقابل عنوانه الهجرة. فهذه الهجرة حملت معها الوطن الأصل، في وطن آخر مختلف بالكامل. فداخل المنزل ظلت العادات مغربية، وحين نلتقي صُورا توثق لعُرس على سبيل المثال، نسمع أهازيج وأغانٍ شعبية معروفة. أمام أعين الطفلة/ المخرجة التي تنقل لنا في لقطة من اللقطات حفل إحياء ذكرى وطنية بلجيكية يقف فيها أطفال بلجيكيون من شتى الأعراق أمام نصب الجندي المجهول.
في حقيقة الامر، المنزل هو تلك الشقة “المغربية” الصغيرة حيث حدث كل شيء بتأثير مما يحدث في الخارج. وكمثال على ذلك حكاية موت “جمال” شقيق المخرجة، إثر نشوب صراع أدى إلى سقوطه مغمى عنه، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو ما يحدث كثيرا في أوساط المهاجرين العرب في الغرب، في أحيائهم السكنية. لن نرى أثر الحزن على وجه الأم بطبيعة الحال، لكن المخرجة تمنحنا صورة للعائلة مجتمعة بكامل أفرادها.
مثال ثان، خروج البنت من منزل العائلة، لتعيش وحدها كأي بنت “غربية”. هنا أيضا، لن نحصل على أثر ذلك على الأم. فهي غائبة، هي التي كانت قوية الإرادة وصاحبة اختيارات جريئة قبل الانحدار المرضي الحاسم. وكذلك لن نعرف مدى أثر علاقاتها مع الرجال الذين عرفتهم، والذين ذكرهم الفيلم من خلال الصورة والتعليق، بلا نفاق ولا مداراة، ودون أي نزعة أخلاقية متعالية.
ما قل ودل

في هذه الأمثلة، نكون كمن تعرف على عناوين حلقات في حياة امرأة غير قادرة على منح التفاصيل، فتتكفل المخرجة يإيجادها. لكن، ولأنها تجهلها هي بدورها في مجملها، تُعوض ذلك بإبداع سينمائي يقوم مقام ذلك، فنكتفي به ولا نشعر بنقص أو تعسف، لأنه يحقق المراد، أي يؤثر في عاطفتنا في العمق.
إنها “التوليفة” المعروفة التي تجسد “ما قل ودل” مُعطاة سينمائيا. وهو ما يحصل عبر اختيار زوايا التقاط معينة، ومساقط نور محددة، وألوان تحيل على الذي راح، على الماضي المثقل بالحنين والشجن.
وللتمكن من الوصول إلى هذه النتيجة، يلعب سلم اللقطات دورا حاسما، الشئ الذي تمنحنا إياه اللقطات الكبيرة للوجوه، التي تم ضبط وقت إيرادها في سيل اللقطات الأخرى، بكل ما تنبئ عنه من مشاعر دقيقة وفاعلة.
ثم هناك الاستعارات المجازية التي تقوم مقام التوضيح والتفسير والتوصيل، كمرادفات تكمل المعنى على غرار الثوب الأبيض الذي لا يفتأ يعود من حين لآخر طيلة مسار الفيلم، كستار يُفتح ليظهر حقيقة يتوجب معرفتها، كحاجز يخفي شيئا ما توخيا للحشمة (الزهايمر ودنو الموت المحتم يفرض ذلك)، أو حين يلتقي بثوب الكفن ومرأى قبر الأم في اللقطات الأخيرة.
الخلاصة أن المخرجة كريمة السعيدي أتت فعلا سينمائياً ليس سهلا، فعل يتناول “ثيمة” موت من خلال وجود بقايا ذاكرة. وهو مما يَسُرُّ المشاهد رغم جديته القوية.
الفيديو