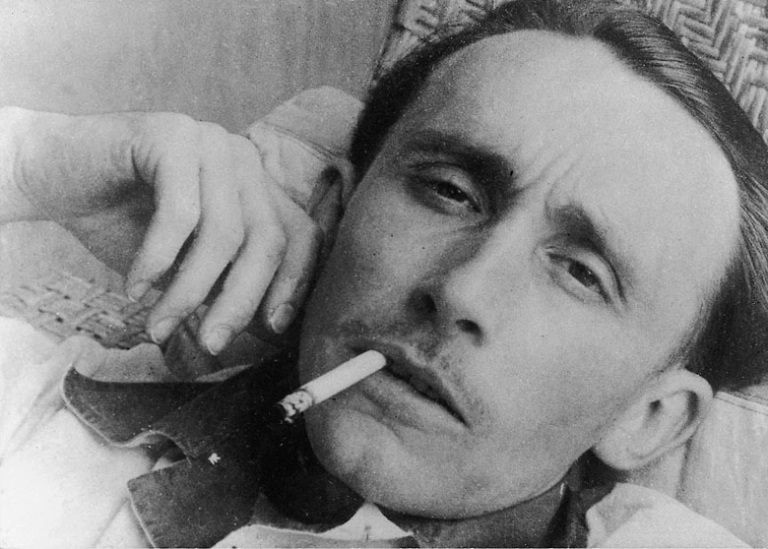فيلم “الست”.. من دائرة النقد إلى “الحراسة الثقافية”

د. ماهر عبد المحسن
لا تقتصر مهمة الناقد السينمائي على تحليل عناصر العمل الفني من سيناريو وتمثيل وتصوير وموسيقى وإخراج.. إلخ، لكن يحدث أحياناً أن يجد الناقد نفسه مضطرا إلى الخروج عن السياق الجمالي برمته والحديث عن ظروف إنتاج العمل، وتناول سياقاته الاجتماعية والسياسية والثقافية للوقوف على الرسائل المضمرة التي يمكن أن يحملها بداخله.
يحدث ذلك، غالبا، في الأفلام التاريخية، وتلك التي تتناول حياة الشخصيات العامة، ذات الأهمية في الفن أو السياسية، والتي تتمتع بمكانة خاصة في وجدان الجمهور.
ينطبق هذا المعنى على كوكب الشرق أم كلثوم، التي تناولت السينما، مؤخرًا، قصة حياتها في فيلم “الست” الذي أخرجه مروان حامد وكتب السيناريو له أحمد مراد وقامت ببطولته منى زكي. وبالرغم من أن الفيلم لم يمض على تاريخ عرضه سوى أيام قلائل إلا إنه أثار جدلاً واسعاً بين النقاد والجمهور، وكشف عن انقسام حاد في الوعي وطريقة في التفكير تحتاج إلى مراجعة. فالفيلم، في الحقيقة، لم يكن مرآة تعكس حياة أم كلثوم الخارجية بقدر ما كان مرآة تعكس حياتنا، نحن، الداخلية!
وبهذا المعنى، لا يحتاج الفيلم، في لحظتنا الراهنة، إلى مقاربة جمالية تكشف عن العناصر الإبداعية في العمل، لكن يحتاج أكثر إلى تحليل ثقافي وتاريخي، ورؤية فلسفية تجيب عن السؤال الأهم: كيف يفكر المصريون؟ وهو سؤال يستدعي البحث في الدوافع النفسية والعقلية التي تحدد مواقفهم إزاء قضايا الفن والسياسة والمجتمع.
الجدل حول الفيلم بوصفه سباقًا على الرمز القومي

منذ عرض البرومو الترويجي لفيلم “الست”، لم يتوقف الجدل حوله، لا قبل نزوله إلى دور العرض ولا بعده. ومع مرور الأيام، بدا واضحًا أن ما يجري يتجاوز بكثير حدود الاختلاف حول عمل سينمائي، ليتحوّل إلى سجال ثقافي حاد، يكشف عن طريقة تفكير المصريين في الفن، والرمز، والذاكرة، وحدود المسموح والممنوع في إعادة تمثيل الماضي.
فيلم “الست” لم يُستقبل بوصفه نصًا فنيًا قابلاً للنقد، بل بوصفه حدثًا مقلقًا، كأنه اقتحم منطقة محظورة في الوعي الجمعي. ومن هنا، فإن أهمية الجدل لا تكمن في الفيلم ذاته، بل في الخطابات التي أنتجها: في المقالات، والمنشورات، والتعليقات، والانفعالات المتوترة التي كشفت عن بنية أعمق من مجرد رأي مؤيد أو معارض.
وفقًا لمنظور ميشيل فوكو، لا يمكن فهم أي ظاهرة ثقافية بمعزل عن نظام الخطاب الذي تنتج داخله.
واللافت في الجدل حول فيلم “الست” أن الأسئلة التي طُرحت لم تكن فنية في المقام الأول، بل سلطوية ورمزية: هل يجوز أصلًا تجسيد أم كلثوم؟ من يملك حق تمثيلها؟ وأي صورة لها يجب أن تبقى ثابتة؟.هكذا، لم يعد الفيلم موضوع النقاش، بل مشروعيته ذاتها.
ومنذ هذه اللحظة، خرج الجدل من دائرة النقد إلى دائرة الحراسة الثقافية، حيث يُنظر إلى الرمز لا بوصفه تاريخًا، بل بوصفه ملكية معنوية يجب حمايتها من التأويل.
أم كلثوم: كيف صُنِع الرمز القومي؟
لفهم حساسية الجدل، لا بد من العودة إلى الخلف قليلًا.
أم كلثوم لم تصبح رمزًا قوميًّا تلقائيًا، بل جرى إنتاجها رمزيًا داخل سياق الدولة الوطنية، خصوصًا في لحظة صعود دولة يوليو، حيث تضافرت الإذاعة، والإعلام، والحفلات الجماهيرية، والخطاب القومي، لتقديمها بوصفها صوت الأمة.
وفقًا لتحليل ستيوارت هول، فإن الهوية القومية لا تُكتشف، بل تُبنى عبر التمثيل. وهكذا، جرى تثبيت صورة معينة لأم كلثوم: صوت متعالٍ، حضور شبه أسطوري، رمز يتجاوز الفرد إلى الجماعة، ويُنزَع عنه الكثير من تفاصيله الإنسانية لصالح صورة جامعة.
هذه الصورة لم تُلغِ أم كلثوم كفنانة، لكنها جمّدت إحدى لحظاتها، وقدّمتها بوصفها الحقيقة النهائية.
مع تراجع الخطاب القومي الكلاسيكي، لم تتحرّر أم كلثوم من الحراسة، بل انتقلت هذه الحراسة من الدولة إلى الجمهور. أصبحت “الست” ملكًا وجدانيًا عامًا، لكن هذه الملكية لم تسمح بإعادة القراءة، بل عزّزت منطق المنع: هذا لا يليق بها، هذا يشوّه صورتها، هذا لا يشبهها.
هنا نرى ما وصفه فوكو بتداول السلطة: فالخطاب الذي كان رسميًا صار شعبيًا، لكنه احتفظ بنفس آليات الإقصاء، وكأن الرمز لا يعيش إلا إذا بقي ثابتًا، منزّهًا عن الزمن.

كثير من الاعتراضات على الفيلم انطلقت من فكرة أن منى زكي “لا تشبه أم كلثوم”، وكأن هناك أصلًا نقيًا محفوظًا في الذاكرة، وأي انحراف عنه يُعد تشويهًا. لكن التفكيك، كما يعلّمنا جاك دريدا، يفضح هذا الوهم. فـ”الأصل” لا يُعرف إلا عبر النسخ، والحضور لا يتحقق إلا من خلال الاختلاف.
أم كلثوم التي نعتقد أننا نعرفها ليست كيانًا خالصًا، بل بناءً مركّبًا من تسجيلات منتقاة، وصور مُعدّة، وسرديات صاغها الإعلام والحنين. الفيلم لا يهدم الأصل، لأنه ببساطة لا يوجد أصل خارج التمثيل.
لم يكن الهجوم موجّهًا إلى الفيلم فقط، بل إلى منى زكي بوصفها جسدًا: ملامحها، صوتها، حضورها الفيزيقي. وهنا يتقاطع الجدل مع تحليلات النقد النسوي الثقافي، التي تبيّن كيف يُسمح للمرأة أن تكون رمزًا، بشرط أن تُنزَع عنها إنسانيتها.
الرمز الأنثوي المقبول هو: قوي، أسطوري، منزّه عن الجسد والتاريخ الشخصي. أما السينما، بطبيعتها، فتعيد الرمز إلى الجسد والزمن والضعف. ومن هنا تنبع الصدمة.
وسائل التواصل: حين يتحوّل النقد إلى استقطاب
لا يمكن إغفال دور وسائل التواصل الاجتماعي في تضخيم الجدل. فهذه المنصات لا تكافئ التفكير المركّب، بل تغذّي الانفعال والثنائيات الحادة: مع أو ضد، وطني أو خائن، مدافع عن التراث أو مدمّر له.
في هذا المناخ، يختفي النقاش، ويحلّ محله الأداء الأخلاقي، حيث يصبح الرأي وسيلة لإثبات الانتماء لا للفهم.
فيلم “الست”، في جوهره، ليس أكثر من حلقة جديدة في سباق طويل على امتلاك أم كلثوم رمزيًا: الدولة صنعت الرمز، الجمهور ورثه، وحرسه، السوق أعاد تدويره، والسينما حاولت إعادة سرده.

وبهذا المعنى، الصدام لم يقع لأن الفيلم سيئ أو جيد، بل لأنه حرّك الرمز بعد أن اعتدنا سكونه.
ربما لا يكون فيلم “الست” علامة فارقة في تاريخ السينما، لكن الجدل الذي أثاره علامة فارقة في تاريخ وعينا الثقافي. لقد كشف خوفنا من التأويل، وقلقنا من إعادة النظر في رموزنا، وميلنا إلى تحويل الفن إلى محكمة، لا إلى مساحة تفكير.
لم يكن السؤال الحقيقي: هل نجحت منى زكي في تجسيد أم كلثوم؟ بل: هل نتحمّل فكرة أن الرمز القومي كائن حيّ، لا تمثال؟ في هذا المعنى، لم يكن الجدل مبالغًا فيه بقدر ما كان كاشفًا. لقد ظننا أننا نحاكم فيلمًا، لكننا – في الحقيقة – كنا ننظر إلى أنفسنا.