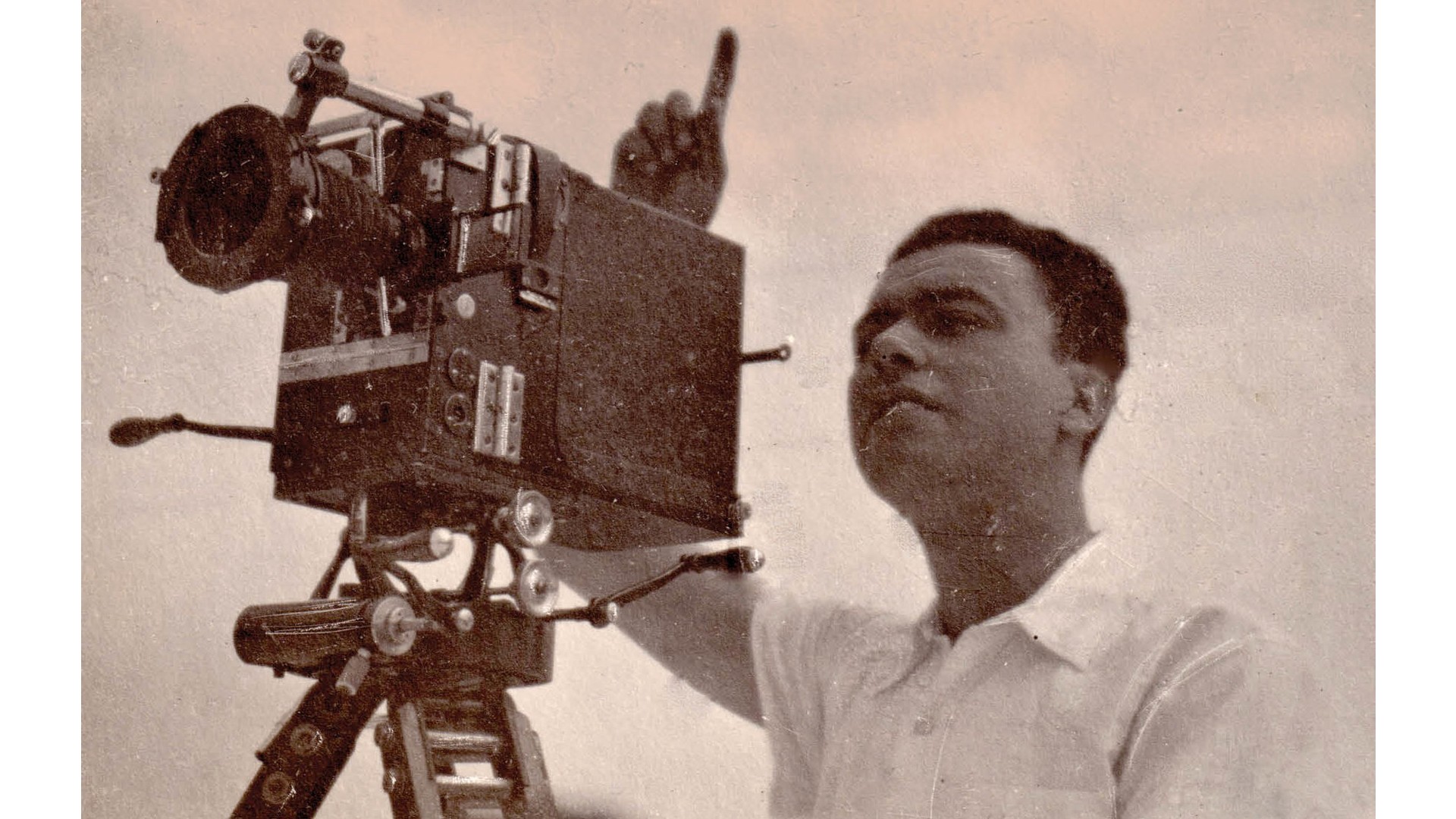سينما المستقبل وفوبيا الوباء الذي اجتاح العالم

انقضى عصر دور العرض الكبيرة الأنيقة التي كانت تشعرك بأن السينما لا تقل عن المسرح بتقاليده العريقة، بشاشاتها الضخمة، وما يسبق العرض من موسيقى قد تكون مكتوبة خصيصا لكي تسبق عرض الفيلم، خاصة لو كان من نوع الأفلام التاريخية الكبيرة المُبهرة مثل “لورانس العرب” و“بن هور” و“نابليون” وغيرها، وستائرها المشغولة بدقة التي تجعلك تشعر عندما تتمّ إزاحتها، بأنك توشك أن تدلف إلى عالم سحري شديد الخصوصية والسحر والرونق.
بعد ذلك أصبح البديل هو الجلوس داخل عُلب ضيقة خانقة ذات أسقف منخفضة تكتم الأنفاس، فوق مقاعد مرصوصة في صفوف مُتقاربة ضيقة حيث لا يُمكنك أن تمدّ ساقيك بشكل مريح، بل تظل تكافح لكي لا تصاب بالتيبّس العضلي، وربما تعاني أيضا – كما كان يحدث كثيرا معي – من قلة ذوق الكثير من أفراد الجمهور الذين قد يلقي بهم حظك السيء في طريقك أو بالأحرى، إلى جوارك أو وراءك مباشرة، والذين لا يتوقّفون عن فتح أجهزة هواتفهم المحمولة والتطلّع إلى ما يصلهم من رسائل أو الردّ عليها وأحيانا إجراء الاتصالات الصوتية بكل ما يُسبّبه هذا من مضايقات.
هذه “العُلب” الضيقة الخانقة تعرض الأفلام على شاشات صغيرة، وقد لا تتّسع أحيانا لأكثر من 30 أو 40 مقعدا، فدور السينما مُتعدّدة القاعات أو المجمّعات السينمائية التي تحتوي عادة على 8 قاعات أو أكثر، تريد أن تعرض أكثر من فيلم في أكثر من قاعة في نفس الوقت.
ومن هناك، لا تُحقّق خسائر كبيرة إذا عرضت فيلما واحدا في قاعة كبيرة، خاصة لو كان الفيلم من الأفلام “الفنية” التي لا يذهب لمشاهدتها عادة سوى المُغرمين بهذا النوع “المثقّف” من الأفلام، وخاصة لو كانت ممّا يطلقون عليه في الغرب “الأفلام الأجنبية”، أي غير الناطقة بلغة البلد الذي تعيش فيه. وفي حالتي الشخصية ولكوني أقيم في العاصمة البريطانية لندن، فالأفلام الأجنبية هنا هي غير الناطقة بالإنجليزية، أي تلك التي يتعيّن عليك متابعتها من خلال الترجمة المطبوعة لحواراتها على الشريط السينمائي نفسه.
كنت قد شاهدت مثلا، فيلم “الصمت” لمارتن سكورسيزي، في قاعة تقع تحت الأرض، لا يتجاوز عدد مقاعدها 30 مقعدا. ولذلك كان إحساسي دائما عندما أضطرّ إلى مشاهدة الأفلام “الفنية” في مثل هذه القاعات الصغيرة الخانقة أن تجربة مشاهدة الأفلام في قاعات السينما اقتربت كثيرا من مُشاهدة التلفزيون في البيت. أقصد من حيث مساحة الشاشة، فمع تضاؤل مساحة شاشة القاعة السينمائية كبرت مساحة شاشة أجهزة التلفزيون الحديث.
أما جهاز العرض المنزلي فقد تفوّق على شاشة التلفزيون، وأصبح يمنحك مشاهدة سينمائية داخل قاعة خاصة، حيث لا يُمكنك أن تشكو من قلّة ذوق بعض أفراد الجمهور، ولا ارتفاع أصواتهم أو رنين هواتفهم المحمولة أو الضوء الذي يُحرّف انتباهك الصادر من شاشات تلك الهواتف اللعينة التي أصبحت في أيدي الجميع. وهو على أيّ حال، حلّ وسط جيد بين السينما والتلفزيون.
وأنواع أجهزة العرض المنزلي كثيرة وتتراوح أسعارها بين بضعة جنيهات إلى آلاف الجنيهات، والعبرة بالطبع بمستوى نقاء الصورة وعُمر مصباح الجهاز أيضا، فهو لا يعيش إلى الأبد بل له عُمر افتراضي ينتهي بعده ويتعيّن استبداله.

صحيح أن هذا النوع من المُشاهدة المنزلية يحرمنا من التقليد السينمائي الذي كان يميّز السينما، أي مُشاهدة الأفلام مع الجمهور في طقس جماعي مُشترك، والإحساس بمشاعر الآخرين من حولك. ولكن ماذا يُمكنك أن تفعل وقد أصبحت محاصرا في عصر كورونا، وذلك التشكّك المُخيف في بعضنا البعض.
في فبراير الماضي كُنت أحضر مهرجان برلين السينمائي، وتصادف جلوسي إلى جوار صحافية ألمانية. وقبل العرض ولكوني قادما من الطقس البارد في الخارج أفلتت مني “سعلة” خفيفة مُقتضبة. فما كان من السيدة الجالسة بجواري سوى أن تطلّعت إليّ في حدة وقالت “هل يمكنك أن تضع يدك فوق فمك عندما تسعل من فضلك؟”.
استغربت كثيرا قولها هذا وكان ردّي المباشر عليها “ولكني فعلت. وهو ما أفعله دائما. لكنك لم تكوني تنظرين إليّ.. أليس كذلك؟”. ارتبكت المرأة وأخذت تبحث دون جدوى في حقيبتها التي وضعتها على الأرض، عن كمّامة ثم ابتسمت وقالت إنها نسيت أن تحضر الكمّامات معها.
الغريب في الأمر أنّني ظللت طوال عرض الفيلم لأكثر من ساعتين، دون أن تفاجئني الرغبة في السعال على الإطلاق، فقد كان السعال الأول مجرد “تسليك” أكثر منه سعالا. أما السيدة الألمانية فقد سعلت ستّ مرات. وكُنت في كل مرة لا أنسى أن أتطلّع إليها لأتأكّد من أنها وضعت يدها على فمها. فقد أصبح القلق ينتابني. ألم أقل إن السينما المنزلية أفضل كثيرا في الوقت الحالي على الأقل!
يجب أن أعترف بأن تغطية الفم باليد أو بمنديل ورقي مثلا، عند العطس أو السعال، ليست من العادات العربية الأصيلة، ربما لأن المجتمعات العربية أكثر حميمية، وأقل شعورا بالفردية، وأكثر ميلا للتحرّر من القيود بسبب كثرة القيود “الرسمية” المفروضة على الجميع لسبب أو من دون أيّ سبب.
لكني لا أنسى مشهدا جرى أمام عيني داخل مصعد محطة من محطات مترو الأنفاق في لندن عندما وصلت إليها للإقامة فيها في منتصف الثمانينات. ازدحم المصعد بالصاعدين من تحت الأرض. داخل زحام المصعد كان شاب عربي يقف بالقرب من عجوز إنجليزي بدا كأنه خرج لتوّه من أحد أفلام الثلاثينات، وكان يرتدي معطفا من وبر الجمل، ويحمل مظلة في يده، ويرتدي قبعة، أي أنه كان إنجليزيا كلاسيكيا. وأفلت من الشاب العربي سعال خشن من دون أن يُغطّي فمه بيده. فرمقه العجوز الإنجليزي “شزرا”، كما يقولون، وخاطبه بلهجة توبيخ واضحة “يجب أن تستشير طبيبا!”.
أودّ فقط أن أختم هذا المقال بالقول إن الفائدة الوحيدة من “حالة الحصار” الناتجة عن انتشار وباء كورونا، دفعتني لمُشاهدة الكثير من كلاسيكيات السينما العالمية، وإعادة مشاهدة بعض الأفلام التي تركت بصماتها بقوة على ذاكرتي. وقد شاهدت للمرة الثالثة فيلم “الأيرلندي” لسكورسيزي، واكتشفت فيه أشياء كثيرة كانت قد فاتتني عندما شاهدته للمرة الأولى على شاشة كبيرة في ختام مهرجان لندن السينمائي في أكتوبر الماضي.
وتيقّنت أن ممّا يجعل هذا الفيلم عملا شديد الرونق والسحر والقوّة والتأثير، تلك “الكيمياء” المُدهشة التي تجمع بين أداء أبطاله الثلاثة روبرت دي نيرو وجو بيشي وآل باتشينو.
لا أعرف متى تُعيد السينمات فتح أبوابها مُجدّدا بعد أن ينقضي الوباء. لكن نصيحتي: لا تنس أن تضع يدك على فمك عندما تسعل داخل السينما، وإلاّ تعرّضت للتوبيخ!