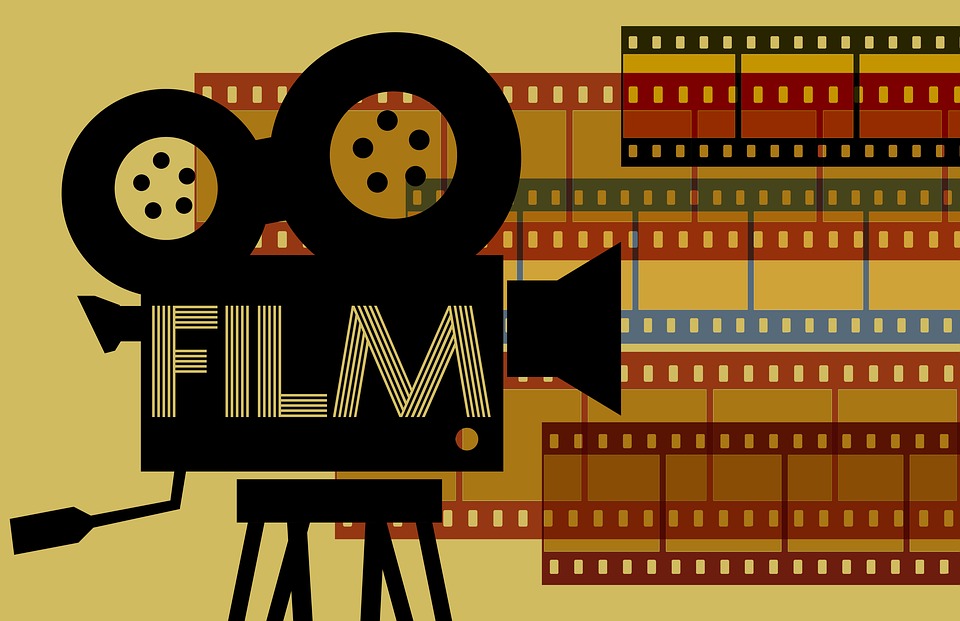حوار مع تساي مينغ ليانغ: ألا تشعر بأن السينما تحرّرت؟

ترجمة: أمين صالح
أجرى الحوار نيك بنكرتون، ونشر في Reverse Shot، 17 أبريل 2015:
– قبل عرض فيلمك “كلاب ضالة” (2013)، صرّحت بأنه قد يكون الأخير الذي يُعرض في الصالات السينمائية التقليدية، حيث أصبحت الجاليريهات والمتاحف أكثر ملاءمة لعرض تلك النوعية من الأعمال التي صرت تحقّقها. ما الذي قاد إلى احساسك بهذه الطريقة؟ هل حدث شيء ما جعلك تغيّر نظرتك؟
* من وجهة نظري، رحيل السينما عن الصالة السينمائية جزء من تقدّم طبيعي للأشياء، تماماً مثلما يفلت الفن المعاصر من الجاليري. إذا إيرادات شباك التذاكر لها أي ارتباط بالقيمة الجوهرية والحقيقية للفيلم، فإن كل آخر مخرج في العالم سوف يعطي تلك الإيرادات تصديقاً واعتماداً. من جهة أخرى، فيما لا تتوفر لأفلامي إمكانية مالية في هذا الاقتصاد، فإن السؤال، بالنسبة لي، يصبح: كيف يمكنني أن أبرهن على قيمة أفلامي؟ لماذا أستمر في تحقيق الأفلام؟ لمن أصنع الأفلام؟
في العام 2000، بعد أن حققت فيلمي الخامس “كم الساعة هناك؟”، وبفضل شريكي الفرنسي الشفوق والرقيق، المنتج برونو، أتيحت لي فرصة البدء في تمويل وتوزيع أفلامي الخاصة. في ذلك الوقت، كانت لأفلامي سمعة سيئة ضمن محيط الصالات في تايوان، ولم يرغب أحد في عرض أفلامي. ذات مرّة، أقنعت صاحب صالة صغيرة تسع 100 مقعداً بأن استأجر الصالة لمدة أسبوعين، أعرض فيها فيلمي. قبل أسبوع من العرض، انتقلت مع الممثلين إلى الشوارع لبيع التذاكر. لدهشتي، استطعنا بيع أكثر من 300 تذكرة، علماً بأن لا أحد في تايوان يرغب في مشاهدة أفلامي.
هكذا أمضيت عشر سنوات وأنا أبيع التذاكر الخاصة بأفلامي. إيرادات الشباك لم تكن خارقة، لكن أيضاً لم تكن كارثية.
في العام 2009 عُرض فيلمي “وجه”، المموّل من قِبل متحف اللوفر، في المسرح القومي بتايوان. المسؤولون في الدائرة الثقافية رحّبوا بحرارة بحضور مدير متحف اللوفر عرْض الفيلم، وهناك سأله أحدهم: “لماذا اخترتم تمويل فيلم تساي؟ هنا، نحن لا نفهم أبداً ما تريد أفلامه أن تقوله”. الرد كان موجزاً وخفيّ المعنى، لكنه رائع، إذ قال: “الكثيرون لا يستطيعون فهم لوحات بيكاسو، لكن هذا اللغز هو الذي يغري بالبحث والدراسة والاستنطاق المحكم”.
تأملت هذا الرد وتساءلت: بوسع المرء الذهاب إلى الجاليري لتأمل ودراسة أعمال بيكاسو الغامضة، لكن إلى أين يذهب الراغب في تأمل ودراسة فيلم غامض؟ هل الإجابة ستكون: صالة السينما، حيث النطاق المحدود من العروض عادةً لا يمثّل إلا هوليوود؟
أفلامي مصنوعة بغرض فني، إذن لماذا لا تُعرض في محيط الجاليري؟ ألا يمكن للمرء دراسة الأفلام في الجاليري أيضاً؟
– قلتَ عن “كلاب ضالة” أنه الفيلم الذي لا بداية له ولا نهاية.. هل من المهم بالنسبة لك أن يشاهَد من الافتتاح حتى الختام، أم تعتقد بإمكانية أن يشاهده الجمهور كما يشاء، من حيث البدء أو الانتهاء؟
* كيف يدخل المرء في حياة لا بداية لها ولا نهاية؟ في الواقع، لا أظن أن الإجابة مهمة. هذا عائد إليك.
حين نناقش مسائل تتعلق بالجمهور، نميل إلى إحلال أنفسنا محل الجماهير. الجمهور هو كل فرد منا، ولا أحد منا. أنت لا تستطيع أن تمثّل إلا نفسك، أنا نفسي، وهو نفسه. في الواقع، لا يمكن أن يكون هناك “جمهور جمعي”. الجمهور هو شخص واحد لأن المرء لا يستطيع أن يمثّل بصدق إلا نفسه.
في العام الماضي، في فيينا، عرضت عملاً مسرحياً بعنوان “راهب من سلالة تانغ الحاكمة”. واحد من الجمهور قال لي أنه شاهد العرض ثلاث مرات، وفي كل مرّة اختار أن يجلس في موضع مختلف، وشعر بأنه يشاهد مسرحية مختلفة تماماً.
هناك أيضاً الكثير من حالات الانسحاب من العرض استنكاراً، من متفرجين شاهد كل منهم عرضاً مختلفاً أيضاً. بعض النقاد كتبوا عن هذه الانسحابات قائلين أنهم شعروا بأنها جزء من الأداء، من العرض. على نحو غريب، كل أعمالي، كما يبدو، تثير هذا النوع من ردود الفعل المتناقضة. ربما هذا ليس غريباً على الإطلاق.

– هل هناك فيلم لك أثار استجابات عنيفة ضدك من الجمهور أو الصحافة أو كليهما؟
* في 2012، عُرض فيلمي “السائر” على اليوتيوب. في غضون شهر، حصل الرابط على مشاهدة تقدّر بأكثر من أربعة ملايين مشاهدة، ومع هذا، وجدت على الانترنت طناً من التعليقات العنيفة.
بالطبع، فيلمي The Wayward Cloud كان الصراع الأصعب ضد الرقابة التايوانية. لقد تعرّض للمنع تقريباً، أو لإعادة المونتاج على نحو مكثّف، لأن الناس زعموا أنه فيلم فاحش. لكن لأنه حاز على جائزة مهرجان برلين الفضية، فقد سمحوا لي بعرضه. بل أن مدرّساً أحضر فصلاً من الطلاب، الذين كانوا في سن 18 سنة، لمشاهدة الفيلم.
– هل ستكون هناك أفلام أخرى في سلسلة فيلم “السائر”؟ ما هي التحديات التي فرضتها هذه السلسلة؟
* أحب تصوير فعل المشي، لأنه لا يقتضي إعداداً وتحضيراً. مجرد قليل من المكياج للممثل، ورداء الراهب الأحمر. كنا نذهب إلى الموقع الذي اخترته ونبدأ في التصوير. هذا يشبه عمل الرسام عندما يذهب خارجاً لرسم منظر طبيعي. هل سمعت قط عن رسام يخطط أو يضع تصوّراً لأي شيء قبل خروجه لرسم طبيعة صامتة؟ إنه يرسم ما يجده وما يراه. ولأن العالم مليء بالعجائب، فإن بوسع الفنان أن يجد دوماً موضوعاته التي لا تنفد. لماذا يجب أن أقلق، واتحدى نفسي طوال الوقت؟
– عندما كتبت سيناريو فيلمك الدرامي الأول “ثوار إله النيون”، هل كنت تستمد مادتك من مرحلة شبابك؟
* قبل أن أشرع في إخراج أفلامي السينمائية، عملت لبضع سنوات في التلفزيون. في تلك الفترة، عروض التلفزيون كانت جميعها من النوع الخيالي الهروبي، الحافل بفنون القتال، أو من النوع الميلودرامي، أو الدراما التاريخية عن الحرب العالمية الثانية والغزو الياباني.
في ذلك الحين، تم تكليفي بكتابة سيناريوهات تتضمّن واقعية اجتماعية. في العام 1991، صورت مسلسلاً مصغّراً عن محكومين شباب. أثناء ذلك عثرت بالصدفة على لي كانغ شينغ في الشارع. وقد انجذبت إلى عائلته، ببنيتها التايوانية الكلاسيكية، وإلى والده القادم من البر الرئيسي بالصين، وأمه التايوانية، والبيت التايواني.. إضافة إلى انتهاكه للقانون، جو الغموض الذي يحيط به، ضجره، صمته، بطئه، طريقته في التدخين. كل هذا جعلني أتذكّر أبي الصارم، الذي نادراً ما تحدّث إليّ طيلة فترة نشوئي. بعد انتهائي من تصوير “ثوار إله النيون”، توفى أبي. كم تمنيت لو أنه شاهد فيلماً من إخراجي. كم تمنيت لو استطعت فهمه، لو كنت قريباً منه، لو عانقته. إنه كما لو أسقطت هذا التوق والحنين على عوالم أفلامي، وخصوصاً شخصية شاو كانغ بكثافة متزايدة. تدريجياً، حياتنا الواقعية معاً صارت تعكس وتجسد عوالم الأفلام. لي كانغ عانى من مرض غريب بعد الانتهاء من تصوير الفيلم. عنقه صار ملتوياً.
– تبدو مهتماً بالأماكن العامة التي فيها يمكن للغرباء الوحيدين التقاطع على نحو سريع الزوال: الأسواق، محلات بيع الفيديو، الصالات السينمائية. هل ترى أن هذه الأماكن تختفي، أم أن الناس يتوارون عنها ويختفون؟ إلى أي مدى تعتقد أن الإنترنت قد غيّر محاولة البحث بارتباك عن صلةٍ أو علاقةٍ كما تصورها أفلامك؟ هل فكرت في محاولة إظهار تغيّر هذه الطقوس في أفلامك؟
* أظن أن الخلق والحياة لا يمكن فصمهما، ووراء نطاق هذا لا يوجد شيء آخر. إذا لم يكن صانع الفيلم مروّجاً لبضاعة، فإن عمله جوهرياً هو انعكاس للحياة من خلال منظوره النفسي والروحي الفريد. أحب ارتياد الأسواق التقليدية الشعبية لأن الخضروات التي يبيعها المزارعون طازجة ولذيذة المذاق أكثر. فضلاً عن ذلك، التجربة تتضمن نكهة الحياة الأعمق. حين كنت صبياً، اعتدت الذهاب مع جدتي إلى سوق تقع على مقربة من برج الساعة. في ذاكرتي، ذلك البرج كان يبدو هائل الحجم. بعد فترة، عندما اختفت السوق، بدا البرج صغيراً. وكلما مررت بمحاذاة ذلك البرج، شعرت بالأسى. أحياناً يكون الواقع مثيراً للكآبة إلى حد أنك بالكاد تستطيع مواجهته. وتلك الصالات السينمائية المختفية، من ذكريات طفولتي. حين بدأت أجول العالم، أدركت أن من الممكن العثور عليها في كل مكان، في حالات متساوية من التهدّم والخراب، والعديد منها أضحت مواقع يزورها الناس. أحب ارتياد هذه الأماكن. وأجد مشقة في وصف الشعور الذي ينتابني في هذه الأماكن. المسارات النموذجية ليست جزءاً من عالمي، أو من أفلامي، وبلا ريب ليست جزءاً من أحلامي.
– منذ وقت مبكر، كما نرى في “وداعاً نزل التنين”، في 2003، كنت مهتماً بالتحوّل في ثقافة ارتياد الصالات السينمائية العامة عند جيلك الشاب، ونظرتك تلك اصبحت نبوئية. هل كان لديك إحساس أن الأفلام، المصنوعة في ذلك الحين، سوف تتعرّض، من بعض النواحي، لخطر الاختفاء؟ إن كان الأمر كذلك، ما الذي أعطاك هذا الإحساس؟

* مع “وداعاً نزل التنين”، كنت قادراً على توجيه تحية تقدير إلى فيلم كينغ هوْ الكلاسيكي “نزل التنين”، والذي، بعد أربعين سنة، لم يبزّه فيلم من النوعية ذاتها، وهذه الحقيقة ملأتني رهبةً. الفيلم أسر مخيلتي منذ أن كنت في الحادية عشرة من عمري. دعونا ننظر إلى الوراء، إلى مخرجي العالم الرائعين: تروفو، جودار، لوي مال، رومر، بريسون من فرنسا. فلليني، بازوليني، فيسكونتي من إيطاليا. فاسبندر، هيرزوغ، وآخرون من السينما الجديدة في ألمانيا. أوزو، ناروسي، ميزوجوشي، كوروساوا من السينما اليابانية في فترة ما بعد الحرب العالمية. أورسون ويلز، جون فورد، هتشكوك من أميركا. بل حتى لو ابتعدنا أكثر نحو الماضي، إلى معلمي السينما الصامتة: شارلي شابلن، مورناو، دراير. الآن بوسعنا أن نزور تلك الأفلام، من جديد، بحرية أكبر، ودائماً أشعر بالدهشة والذهول إزاء الاكتشافات الجديدة التي أجدها في تلك الأفلام في كل مشاهدة، وأنا حابس أنفاسي في اندماج. تلك الأفلام هي جوهر السينما العظيمة.
في كل مرّة أسافر بالطائرة في رحلة طويلة، أتفحص مئات القنوات المتوفرة من أجل الترفيه عن الركاب. غير أني أتخلى عن فكرة المشاهدة. مع ذلك، حين ألمح بطرف عيني المجاورين لي وهم في حالة ابتهاج غامر بينما يتفرجون على أحدث أفلام الوحوش والأشباح الصادرة من هوليوود وبوليوود وأوروبا، والمعروضة على شاشاتهم الصغيرة، فإنني أرغب أيضاً في معرفة ما يجري.
– هل يمكنك التحدث عن بعض الأفلام التي كان لها تأثيراً حيوياً وأساسياً عليك في فترة المراهقة أو الشباب؟ وكيف انعكست هذه الذكريات على أعمالك؟
* ربما تعود بي الذاكرة وأنا في سن الثالثة. كان فيلماً صينياً من إنتاج 1959، عن سمكة نهرية تتحوّل إلى امرأة جميلة. الألوان كانت زاهية، كما لو مرسومة أمام عينيّ. أيضاً سلبت لبّي أفلام بوليوود ذات الموضوعات الخارقة للطبيعة.
– مشهد لي كانغ وهو يلتهم الرأس المصنوع من الكُرُنب في “كلاب ضالة”، إضافة إلى اللقطة الختامية في الفيلم، يشبه انهيار المرأة في نهاية فيلمك “يحيا الحب”، في ما يتصل بعرض المعاناة المتواصلة، طويلة الأمد. لماذا هو مهم النظر، طويلاً وبعينين لا تطرفان، إلى الألم؟
* طبعاً لم تكن لدي أي فكرة، قبل الشروع في التصوير، عن أمد اللقطة وكم سيكون طولها.. هكذا الحال مع كل اللقطات في أفلامي. كل ما كنت أعرفه أن على “لي” أن يلتهم ويجهز على الرأس المصنوع من الكرنب. بأي طريقة أو حالة أو عاطفة.. لا أدري، لم أكن على يقين، لأنني لست مؤدياً. أنا مجرد راصد، أنتظر شيئاً لكي يحدث. كان بإمكاني فحسب أن أثق بأن “لي” سوف يلتهم الكرنب كله. هو في السادسة والأربعين من العمر، ونحن نعيش معاً، بالتالي صرت أعرف تماماً كل حالاته الذهنية المتعددة، وأمزجته المتقلبة.
أذكر أننا حين كنا نصوّر فيلم “النهر”، اقتضى مشهد ما أن يبكي “لي”، غير أنه لم يستطع البكاء. كان وقتذاك في منتصف العشرين من العمر. صفعته على وجهه مرتين، مع ذلك لم تسل دموعه. أما في “كم الساعة هناك” فقد بكى بسهولة لأن والده كان قد فارق الحياة آنذاك.

– شارك في تصوير فيلمك “كلاب ضالة” ثلاثة مصورين، وهو أمر غير عادي ونادر. ما الذي استلزم ذلك؟ هل استخدمت ثلاثة مدراء تصوير مختلفين لحالات مختلفة؟
* كل شخص يعرف لياو بن جونغ، الذي عمل معي مصوراً منذ فيلمي الأول. عرفت أنه موهوب منذ البداية. هو دائماً يعرف ما أريد، وكاميرته دائماً في الموضع الصحيح والمناسب. سونغ وين شونغ هو أيضاً مصور ماهر جداً، وأنا معجب كثيراً بحساسيته تجاه الإضاءة والأجواء. لقد علّمني كيف أستخدم الإضاءة. توفى أثناء عمله معي في الفيلم. لذلك استعنت بتلميذه لو كوينغ شين.
– هل اتبعت استراتيجية بصرية معيّنة في تصوير “كلاب ضالة”؟ كنت مفتوناً بالعمق الاستثنائي للصور.
* كنت أبتغي من كل لقطة أن تكون مثل لوحة تشكيلية، وكان الضوء بمثابة الصبغ، المادة الملونة.
– أرغب في معرفة المزيد عن الشقة ذات الجدران السوداء، الرطبة، التي تقطن فيها المرأة. ذلك يبدو أشبه بقطعة فنية.
* ذلك كان بيتاً عثرنا عليه صدفةً أثناء بحثنا عن المواقع. لقد تعرّض للتدمير والخراب بسبب حريق ما. وأظن أن هناك نزاع على ملكية المكان لأن الدور الأول تم ترميمه كاملاً، بينما الطابق الأعلى ظل مهجوراً، محروقاً، مسْوداً. كان مذهلاً منظر تلك الجدران المسْودّة وما تظهره من منظر جميل وغامض. عندما قررت جعل البيت الموقع الرئيس، برزت المشاكل للعيان. أي نوع من الأثاث ينبغي أن نستخدمه في هذا الموقع؟ لهذا السبب يبدو الفيلم وكأنه فيلم عن الأشباح. لا شيء يبدو واقعياً. بل يبدو أشبه بصور من الذاكرة. لكن ذاكرة من؟ الشخصيات، أم ذاكرة البيت؟
– لي كانغ يمثّل شخصية من يحل محل لوحة الإعلانات، مروّجاً لمشروع عقاري.. كيف ترى هذه الشخصية؟
* الاعلان البشري صار منظراً مألوفاً واعتيادياً في كل مكان. هم أشبه بأعمدة الكهرياء، بالأشجار، بالجدران على جانب الشارع. لا أحد يلاحظ حضورهم. وهم لا يلاحظون بعضهم بعضاً. إننا نعيش في مرحلة انعدام الحضور.
في الواقع، ليس هناك حضوراً “حقيقياً” في سينما اليوم أيضاً. الأفلام يتم إنتاجها، استهلاكها، إعادة إنتاجها، ثم تختفي.
– في حالة معاكسة لمسار المهنة المعتاد، نجدك في السنوات الأخيرة تركّز على تحقيق الأفلام القصيرة.. ما السبب؟ وما هي امتيازات شكل أو بنية الفيلم القصير؟
* ما هو الفيلم القصير؟ ما هو الفيلم الطويل؟ بعد “وجه” مرت أربع سنوات حتى حققت “كلاب ضالة”. الكثيرون ظنوا أني اعتزلت العمل السينمائي، لكنني في الحقيقة لم أتوقف أبداً. فرص عديدة أتاحت نفسها لي. وقد أخرجت أفلاماً متباينة الطول والمدّة، مستخدماً أشكالاً وبنى وتقنيات مختلفة، وكذلك أشكال عرض مختلفة، من الصالة السينمائية إلى الجاليري. في أزمنة كهذه، ألا تشعر بأن السينما تحررت؟