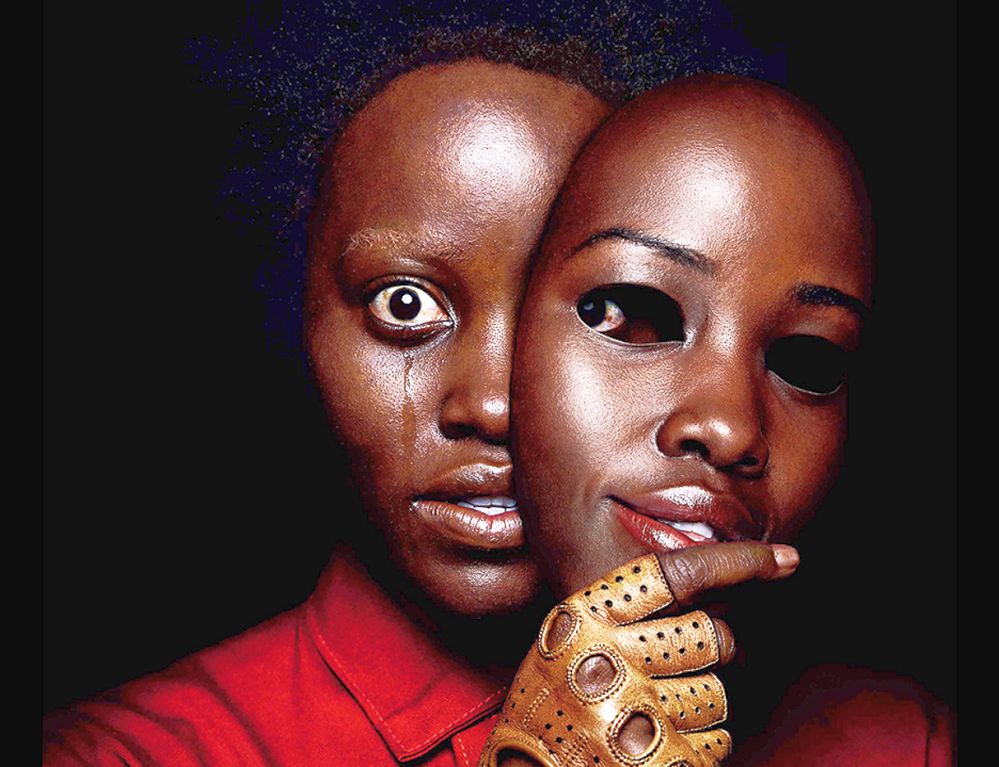تشظي الواقع: تأملات في الفيلم البريطاني القصير “تشخيص”

شهاب بديوي
يُدرك صُنّاع الأفلام القصيرة أن أصعب ما يواجهونه، ليس ضيق الوقت بحد ذاته، بل كيفية قول الكثير بأقل مساحة ممكنة من السرد والصورة. فكثير من هذه الأعمال، رغم قصر مدتها، تقع في فخ الملل أو الترهل السردي، على عكس بعض الأفلام الطويلة التي قد يتجاوز زمنها الساعتين وتظل مشدودة بانسياب درامي متين. يكمن السر، إذًا، في اختيار فكرة تلائم طبيعة الفيلم القصير وفي القدرة على معالجتها بتركيز ودقة، دون اعتبار هذا الفن محطة عابرة نحو الفيلم الروائي الطويل. إن للفيلم القصير لغته الخاصة، لغة مكثفة عالية الحساسية، تتطلب من المبدع وعيًا حادًا بالاقتصاد السردي والإيقاع البصري.
في هذا الإطار، يبرز فيلم “تشخيص” Diagnosis للمخرجة البريطانية إيفا رايلي بوصفه نموذجًا على قدرة الفيلم القصير على ابتكار عوالم كاملة رغم المساحة المحدودة. فالفيلم ينطلق من فكرة طازجة نابعة من عالم “المحاكاة الطبية”، حيث يجسد ممثلون أدوار مرضى لتدريب الأطباء الشباب على التعامل مع الحالات المختلفة. البطلة «سالي» – شابة مخطوبة حديثًا – تعمل في هذا المجال بمهارة لافتة، فتبرع في تقمص الشخصيات حتى تكاد تذوب فيها. غير أن هذه الموهبة، بدل أن تكون ميزة مطلقة، تتحول إلى عبء ثقيل حين تتسرب حدود التمثيل إلى حياتها الخاصة، فتجد نفسها عاجزة عن التمييز بين ما هو حقيقي وما هو محض أداء.
منذ اللحظة الأولى، يضعنا الفيلم تشخيص” في قلب مشهد مؤثر: امرأة شابة تنهار بعد تلقيها خبرًا صادمًا من طبيبها. يُخيل للمشاهد أنّه على وشك متابعة حكاية مأساوية عن المرض والفقدان، فنندفع تلقائيًا للتعاطف معها، قبل أن نفاجأ بانكشاف الحقيقة؛ كل ما رأيناه لم يكن سوى تمرين تمثيلي تؤديه فتاة جميلة ضمن برنامج تدريبي في إحدى الجامعات. هذه الصدمة المبكرة ليست مجرد حيلة درامية، بل تأسيس واعٍ لسؤال الفيلم المركزي: أين تقف الحقيقة حين تتسرب إليها خيوط التمثيل؟ وكيف يمكن للوهم أن يطل برأسه من بين تفاصيل حياتنا اليومية حتى نغدو أسرى له؟
ما يجعل الفيلم استثنائيًا ليس فقط أصالته الفكرية، بل أيضًا طريقة معالجته البصرية والدرامية. المخرجة البريطانية إيفا رايلي استطاعت أن تستلهم من عالم المحاكاة الطبية مادة سينمائية خام، ثم صاغتها بلغة شاعرية متماسكة. اختارت أن تبني الحكاية على إيقاع مشدود، يتدرج من اللحظة الصادمة الأولى إلى الكشف التدريجي عن مأزق البطلة النفسي، من دون أن تقع في فخ التفسير الزائد أو المبالغة في الرموز. كان لافتًا كيف استفاد الفيلم من تقنيات المونتاج لتكثيف مشاعر التوتر والارتباك، فجاء الإيقاع مضبوطًا بدقة، يمنح القصة توهجًا خاصًا، ويجعل مدته القصيرة كافية لإيصال كل ما يريد قوله.
أما الأداء التمثيلي، فكان عنصرًا حاسمًا في نجاح العمل. الممثلة شارلوت سبنسر جسدت شخصية «سالي» بحساسية عالية، متنقلة بسلاسة بين لحظات القوة والهشاشة، وبين الوعي والضياع. استطاعت أن تمنح الشخصية أبعادًا إنسانية عميقة، بحيث يظل المشاهد مأخوذًا بتفاصيلها حتى بعد انتهاء الفيلم. كانت نظراتها، صمتها، وتوتر جسدها أدوات صادقة تنقل صراعًا داخليًا معقدًا، صراعًا بين الرغبة في الإتقان المهني والخوف من فقدان الذات وسط لعبة التقمص.

من زاوية أخرى، يُعيد الفيلم طرح تساؤلات حول الحدود المتشابكة بين الفن والحياة، بين الكذب المحترف الذي يستدعيه التمثيل والحقيقة العارية التي قد تتسلل إلى الأداء من دون وعي. إن قدرة «سالي» على إقناع الآخرين في دورها التدريبي، والتي تُعد مهارة مهنية مطلوبة، تنقلب في عمقها إلى اختبار أخلاقي ونفسي: هل يمكن للمرء أن يتقمص دورًا حتى يبتلعه؟ وهل ثمة ثمن يدفعه الفنان حين يترك لخياله حرية الانصهار مع الواقع؟
لقد قدّم “تشخيص” درسًا عمليًا في معنى أن يكون الفيلم القصير أكثر من مجرد تجربة عابرة. هو برهان على أن قوة الحكاية لا تقاس بالدقائق بل بمدى قدرتها على النفاذ إلى وعي المتلقي وترك أثر عاطفي وفكري يتجاوز زمن العرض. فالفيلم، على قصره، يفتح الباب لنقاشات حول هوية الممثل وعلاقته بدوره، حول الحدود الأخلاقية في مجالات التدريب والمحاكاة، وحول هشاشة النفس البشرية أمام الإيهام.
إن نجاح العمل لا يقتصر على السيناريو والإخراج والأداء، بل يمتد إلى حساسية اختيار الفكرة ذاتها. فالدخول إلى عالم المحاكاة الطبية – ذلك المجال شبه المجهول للجمهور – منح الفيلم طزاجة وفرادة، وأتاح له فرصة استكشاف علاقة غامضة بين المعرفة والتمثيل، بين العلم والفن، بين الصدق والوهم. كما أنّ عرضه على منصة Vimeo ومروره في مهرجانات مثل MedFest Egypt جعلاه يصل إلى جمهور مهتم بقصص تتقاطع فيها قضايا الطب، النفس، والفن، وهو ما يثري الحوار حول استخدام السينما القصيرة في تناول موضوعات غير تقليدية.
“تشخيص” دعوة للتأمل في المسافة الفاصلة – أو بالأحرى المتداخلة – بين ما نعيشه وما نتخيله، بين الحقيقة والوهم، بين الذات والأدوار التي نرتديها في مسرح الحياة اليومية. عمل كهذا يذكّرنا بأن السينما، مهما قصرت مدتها، قادرة على أن تكون مرآة حادة تكشف هشاشتنا وتضيء زوايا لم نكن نراها من قبل.