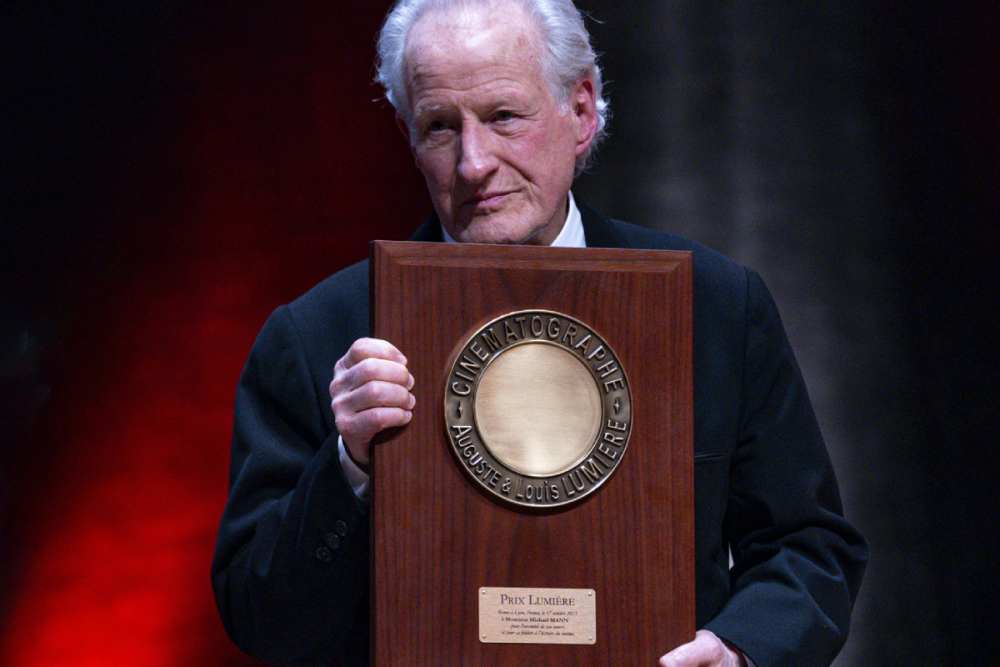السينما الفلسطينية في زمن الإبادة

فادي أبو نعمة
افتتاحية العدد 113 من “حواس السينما”- مايو ٢٠٢٥
بينما نكتب هذه الكلمات، نشعر بعجز اللغة في مواجهة الإبادة. ومع ذلك، نتناول هذا الملف كمحاولة للاستجابة لضرورة لحظتنا الراهنة – لحظةٌ تجلّت فيها الأشهر العشرون الماضية ليس فقط كلحظة عنف غير مسبوق، بل كحملة محو ممنهجة.
تعجز الكلمات عن وصف الأهوال التي يكابدها الفلسطينيون يوميًا في غزة وسائر أنحاء فلسطين. ومع ذلك، تبقى الكلمات سلاحًا لا غنى عنه في مواجهة هذا المحو. وكما يقول الشاعر الغزاوي الراحل رفعت العرير، الذي اغتيل في غارة جوية إسرائيلية في ديسمبر ٢٠٢٣: “إذا كان لا بد لي من الموت، فليكن أملًا – فلتكن حكاية”.1
لم يتراجع الفلسطينيون في مقاومتهم. بالتزامن مع حلفائهم حول العالم، سخّروا “قوة” الكلمات، من شهادات الناجين إلى لوائح الاتهام الجنائية لمحكمة العدل الدولية، ومن هتافات الاحتجاج التي ترددت أصداؤها من اليمن إلى جنوب إفريقيا وقاعات الجامعات الأمريكية.
لقد صاغت هذه الأصوات لغة جديدة للتضامن العالمي تعارض بصوت عالٍ تدمير الشعوب باسم المشروع الاستعماري الاستيطاني. وكما أوضح محمد الكرد بشكل مؤثر، فقد ضغطت وسائل الإعلام الغربية السائدة على الفلسطينيين للتكيف مع أدوار الضحايا المثاليين، مما يسمح بما يسميه “سياسة الجاذبية” كنموذج مهيمن للعمل. ومع ذلك، بمجرد أن نبتعد عن عالم الشارع الرئيسي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وغيرها من الدول الداعمة للإبادة الجماعية، تصبح مجموعة مختلفة تمامًا من العلاقات واضحة. من احتجاج مغني الراب الأيرلنديين “نيكاب” في مهرجان كوتشيلا، إلى عمال الموانئ اليونانيين الذين يعترضون شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، ومن حركات مثل “عمال السينما من أجل فلسطين” إلى مخيمات الطلاب المطالبة بسحب الاستثمارات، يرفض جميع هؤلاء الفاعلين علنًا شرعية مناشدات القوى المهيمن.
بمطالبتهم بالعدالة التي توقف الفظائع وتحاسب مرتكبيها، فإنهم لا محالة يُخرجون الغرب وعواصمه الاستعمارية السابقة من مركزية مركزية. لقد تجسدت هذه الممارسات الملتزمة سياسيًا في أماكن عديدة حول العالم. إنها ترسم جغرافيات معقدة، وتجمع بين استراتيجيات مقاومة متنوعة تُعيد تشكيل الوعي والعمل الجماعي. وبإحياء صور قديمة، تُولد تصورات جديدة للتحرر الفلسطيني.
يُسلط هذا الملف الضوء على مساهمة السينما وثقافة السينما في هذا التحول التاريخي المحوري في وضعنا العالمي الحالي. ومع ذلك، لا يمكن للكلمات ولا الصور أن تصمد أمام وابل الأسلحة والطائرات المسيرة والقنابل. ولا يمكنها منع الخسائر المستمرة في الأرواح. في حين أن التعذيب والأهوال التي تمارسها دولة الفصل العنصري الصهيونية، من خلال آلياتها المتعددة في مشروعها الاستعماري الاستيطاني، مستمرة منذ نكبة عام ١٩٤٨ على الأقل، فإن حجم العنف الذي اندلع خلال العامين الماضيين غير مسبوق.
في مواجهة هذه الفظائع، دعت الحاجة المُلحة إلى اتخاذ إجراء ما. ويلوح في الأفق سؤالٌ جوهريٌّ حول فاعلية وجدوى الإجراءات التي لا تُغير الوضع على الأرض بشكل مباشر في غزة وفلسطين، وكذلك في لبنان واليمن وسوريا الآن. ولاحظت الباحثة الناقدة في القانون والنظرية برينا بهاندار، “أن فكرة أن اتخاذ إجراء سياسي (وقانوني) من شأنه أن يجعل المرء يشعر بالأمل في إمكانية تغيير المسار – لا سيما فيما يتعلق بالعنف المميت المكثف – قد تم تحديها من خلال الأداء الوقح للإفلات من العقاب من قبل السياسيين والجنود والمواطنين الإسرائيليين”.2
في تحرير هذا الملف، وبينما نكتب هذه الكلمات، لا نتظاهر بتقديم إجابات، ولا نحمل أوهامًا حول تأثير فعلنا. ومع ذلك، ما يمكننا فعله هو إضافة أصواتنا إلى الجوقة التي خلقت ما يسميه الكاتب والمُخطط الحضري مهدي صباغ “تدفقات الأفكار التحررية التي تأتي من تحت على الرغم من الجغرافيات الاستعمارية الاستيطانية”.3
من خلال جمع سبع مقالات ومقابلتين، نبرز أفكارًا وممارسات متنوعة – والأهم من ذلك – جغرافيات ساهمت في دعم التضامن الذي تشكل حول السينما الفلسطينية.
ليست بادرتنا بالضرورة ذات معنى، بل هي بادرة في متناول أيدينا: فعل نادر ملموس وفي حدود إمكانياتنا. يقدم الملف المعروض أمامكم روايات عن كيفية ابتكار صانعي الأفلام والأعمال الثقافية السينمائية لأشكال جديدة من ممارساتهم من خلال المشاركة الملتزمة في النضال الفلسطيني من أجل التحرير.
إن تركيز هذه الممارسة الملتزمة يُعزز ويُسلط الضوء على الأهمية التي وجدها الفلسطينيون والعاملون في مجال الثقافة السينمائية في جميع أنحاء العالم في السينما.
في مقابلة أجريناها مع علا سلامة، المديرة التنفيذية لـ”فيلم لاب فلسطين” ومقرها رام الله، لاحظت: “تم بث الإبادة الجماعية على الهواء مباشرة – لم تتطلب أي تفسير. ومع ذلك، فإن للسينما غرضًا مميزًا. بينما قد تتلاشى التقارير الإخبارية من الذاكرة، فإن الأفلام تبقى. ولهذا السبب نتعامل مع السينما كسلاح مقاومة وأداة للإنقاذ”.
خُصَّص القسم الثالث من هذا العدد للمقالات التي تُركِّز على الماضي كمكانٍ للإمكانات الثورية وأرشيفٍ للمستقبل الجذري. تُنقِّب دراسة أ. ك. لطيف لفيلم “فلسطين، فيتنام أخرى” (1972) في الشبكات الثلاثية القارات التي جسَّدها الفيلم، كاشفةً كيف تبلور التضامن العالمي الثالثي من خلال الإنتاج السينمائي والتوزيع والتجريب الجمالي – وهو إرثٌ يُستعاد الآن من خلال الحفظ الرقمي.
وتُشيد مقالة كلير بيغبي بالمخرج العراقي قيس الزبيدي (1939-2024)، مُسلِّطةً الضوء على التزامه الدائم بالسينما الفلسطينية، ومُبيِّنةً كيف وثَّقت أعماله المُبتكرة المنفى الفلسطيني في الوقت الذي قاومت فيه المحو الصهيوني من خلال التعاون الدولي.
وأخيرًا، يتناول تحليل سوجا صوافطة وإيما بن عيون لفيلم “هنا وهناك” (1976) العلاقة المتوترة بين السينما والتمثيل التاريخي، مجادلين بأن نهج غودار وميلفيل “الجدلي الفوقي” يكشف عن إخفاقات السينما، بينما يُصرّ على قدرتها السياسية على سد الفجوات الزمنية والجغرافية.
تُبرز هذه المقالات، مجتمعةً، كيف أن آثار الماضي المجزأة لا تزال تُشكّل وتُشكّل من خلال نضال فلسطين المستمر ضد الإمبريالية والإبادة الثقافية. نجد منظورًا تاريخيًا أساسيًا للتفكير في العنف الاستعماري الاستيطاني الصهيوني عبر تاريخه الطويل، وفهم مختلف جوانب مقاومته.

نحن نتفق مع ناصر أبو رحمة في تأطيره – الذي يشاركه فيه العديد من الباحثين والناشطين – بأن “الاندفاع نحو حملة إبادة جماعية محمومة في غزة لا يمكن فهمه إلا إذا تم تحليله في القوس التاريخي الكامل للصراع على فلسطين الذي يصل إلى نقطة التحول الحالية”.6
لا تكشف هذه النظرة التاريخية الموسعة فقط عن الاستمرارية الوحشية للمحو الاستعماري و”اعتماد الصهيونية المطلق على الرعاية الإمبريالية”.7 بل أنها تُبرز الخيط المتصل للصمود الفلسطيني الذي استمر عبر الأجيال. وبينما نشهد على هذا التاريخ، فإننا نشارك أبو رحمة تفاؤله، إن صح التعبير، في اقتناعه بأن المأزق التأسيسي للصهيونية قد وصل إلى نهايته.
توضح المقالات في هذا القسم كيف وثّقت السينما الفلسطينية، ولا تزال، هذا الصراع التاريخي، كما تناضل بنشاط ضد محوه، محولةً شظايا الأرشيف إلى أدوات للتحرير.
من المهم أن نلاحظ كيف أن نسيان المنظور التاريخي أكثر من مجرد ضرر، وقد كان حاضرًا بأشكال مختلفة عديدة داخل فلسطين تحديدًا. لقد كانت هذه بلا شك استراتيجيةً متعمدةً للاستعمار الاستيطاني. ويشهد على ذلك التعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٩٤. وقد أثارت سياسات الكتب المدرسية، كما وضعها أول مركز للمناهج الدراسية أنشأته السلطة الفلسطينية عند توقيع اتفاقيات أوسلو مع إسرائيل، جدلًا كبيرًا.8
ونظرًا لخطورة الاستعمار الإسرائيلي وتغلغله في جميع جوانب الحياة الفلسطينية، فليس من المستغرب أن يصبح تعليم الفلسطينيين بؤرةً للصراع الأيديولوجي بسبب هذا الاستقلال المحدود. ومع ذلك، بينما يُوفر فحص بناء الكتب المدرسية للذات والتاريخ والأمة غالبًا مصدرًا للتعبير عن نضالات مختلفة، يُحذر باحثون في مجال التعليم الفلسطيني من أن المناهج الدراسية تنطوي أيضًا على خطر “احتمالية سنّ “حاضر استعماري” قد يُفرغ عملية إنهاء الاستعمار من جوهرها”.9
على سبيل المثال، تكشف نظرة سريعة على كتب التاريخ المدرسية للمرحلتين الابتدائية والثانوية أن سردية الحركة الوطنية الفلسطينية بين احتلال الضفة الغربية وغزة عام 1967 واندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 قد حُذفت تمامًا. وهذا، بالطبع، يتماشى مع السياسات العامة التي تنتهجها السلطة الفلسطينية في تحويل مفهومها للنضال من حركة تحرر وطني إلى مشروع بناء دولة، على أمل النجاح في مفاوضاتها مع إسرائيل.
يُحدد هذا النهج مُسبقًا إسكات الطبيعة النضالية في هذا الوقت، ويتجاهل تأثيرات شبكات التضامن العابرة للحدود الوطنية، فضلًا عن المقاومة المسلحة التي تقوم بها الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية. إن اللجوء إلى السينما يساعد في مواجهة هذه العملية.10
منذ الجهود الأولى للفلسطينيين للسيطرة على استقلالهم السياسي والثقافي، شكّلت السينما شاهدًا وسلاحًا. ويعود هذا التقليد إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث ساهمت سينما التضامن العابرة للحدود في دمج السرديات الفلسطينية في النضالات العالمية المناهضة للإمبريالية، وكما توضح نادية يعقوب في كتابها “السينما الفلسطينية في أيام الثورة”، كانت الأفلام الفلسطينية في سبعينيات القرن العشرين “جزءًا من خلق رؤية فلسطينية استمرت حتى يومنا هذا”، ولم تكن مجرد مساعي فنية بل “تمثيلات للتجربة الفلسطينية [التي] ساهمت في اختلاق الثورة الفلسطينية من خلال جعلها مرئية للمشاركين فيها وحلفائها كثورة”.11
سعت هذه الأعمال، التي غالبًا ما تم إنتاجها في ظل ظروف “هشاشة غير عادية”، إلى صياغة هوية جماعية، وتوثيق النزوح والمقاومة، وإسقاط السرديات الفلسطينية على شاشات عالمية، لمواجهة “لعنة الرؤية”.12
كما تلاحظ كاي ديكنسون، فإن السينما من هذه الفترة والفكر الذي رافقها، والمعتقدات التي غزتها في قلب الممارسة السياسية الثورية، لا تزال “تحمل دروسًا حيوية في كيفية عمل سينما التحرير”.13
ويؤكد هذا الملف على القوة الدائمة للسينما كموقع للخيال السياسي والمرونة الثقافية من خلال الانخراط في هذه المسارات التاريخية والمعاصرة. وعلى غرار أبو رحمة، يُشير آدم هنية إلى ضرورة وجود منظور جيوسياسي يضع إسرائيل والمشروع الصهيوني ليس كظاهرتين معزولتين أو استثنائيتين، بل كامتداد لمشاريع استعمارية غربية أوسع نطاقًا.14
ويجادل بأن الخطاب السائد حول التنمية في فلسطين “يطمس، وبالتالي يُعزز، حقيقة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي” من خلال فصل التدخلات الاقتصادية والاجتماعية عن هياكل السلطة التي تدعمه.15
ويعكس هذا التعتيم الأنماط التاريخية للحكم الاستعماري، حيث عملت الحوكمة التكنوقراطية والسياسات النيوليبرالية لفترة طويلة على “إخفاء” علاقات القوة مع تعزيز التبعية.16
ويعمل منطق التعتيم نفسه في المجال الثقافي، حيث لا تُعادل الرؤية التحرير، تُوسّع هيلغا طويل- سوري نطاق نقدها ليشمل مجال الإعلام.17
فبينما تُضخّم عولمة القضية الفلسطينية بروزها، تُجادل بأنها “جعلت القضايا بعيدةً ومُجرّدة”، مُجرّدةً جوهرها المُناهض للاستعمار في أطرٍ غير مُسيّسة لحقوق الإنسان أو التضامن الرمزي. وكما تُلاحظ، فإن هذه العملية “تُفرغ القضية نفسها من معناها”، مُختزلةً الفلسطينيين إلى “متفرّجين” بينما تُسيطر الأجندات الأيديولوجية المُتنافسة على نضالهم.18
ونجد هذا المنظور ذا صلة، إذ يكشف كيف تعمل البنى الاقتصادية والخطابية على تقويض الفاعلية الفلسطينية، سواءً من خلال أطر التنمية النيوليبرالية أو من خلال تسليع التضامن.
في أوقاتنا العصيبة، اخترنا من خلال هذا العدد، التركيز على أولئك الذين لا يُعتبر التضامن بالنسبة لهم لفتة رمزية، وأولئك الذين يرفضون محو أطر الاستعمار الاستيطاني. وبينما نقف مذهولين من فشل العالم في وقف المذبحة – ناكرين حتى أبسط حقوق الفلسطينيين في التدخل المسلح – فإننا نرفض التخلي عن قوة الصورة وثقافة السينما كأدوات للمقاومة. قوة سعى الكثيرون إلى تسخيرها خلال فترات عصيبة من التاريخ، وبالأخص الفلسطينيون أنفسهم.
الهوامش
1. رفعت العرير، “إذا كان لا بد لي من الموت: شعر ونثر” (نيويورك: دار نشر أو آر، 2024)، ص 28.
2. برينا بهاندار، “الإفلات من العقاب في زمن الإبادة الجماعية”، الفلسفة الراديكالية، العدد 217 (شتاء 2024): الصفحات 3-9.
3. مهدي صباغ، “مقدمة: تجديد التضامن”، في كتاب “حدودهم، عالمنا: بناء تضامنات جديدة مع فلسطين” (شيكاغو: دار نشر هاي ماركت، 2024)، ص 11.
٤. انظر “بعد غزة، أنت شخص آخر”: حوار مع علا سلامة من فيلم لاب في هذا الملف.
٥. خديجة حباشنة، فرسان السينما: قصة وحدة أفلام فلسطين، ترجمة نادين فتالة (شام: بالجريف ماكميلان، ٢٠٢٤).
٦. ناصر أبو رحمة، “منسجمون مع عصرهم”، فلسفة راديكالية، العدد ٢١٦ (صيف ٢٠٢٤)، ص ١٣.
٧. المرجع نفسه، ص ٢٠.
٨. ناثان ج. براون، “فلسطين: الصراع الخفي حول المنهج الخفي”، في كتاب “البدائل المتعددة: آراء الآخرين في كتب الشرق الأوسط المدرسية”، تحرير. إيلي بوديه وسميرة عليان (شام: بالجريف ماكميلان، ٢٠١٨)، ص ٤٥-٦٨.
٩. أندريه إلياس مزاوي، “أي فلسطين يجب أن نُدرّس؟” التوقيعات، والمخطوطات، والصراعات على الكتب المدرسية،” دراسات في الفلسفة والتربية، ٣٠، العدد ٢ (٢٠١١): ص ١٧٠.
. تُقدّم عزة الحسن سردًا قويًا لكيفية تأثير نهب الأرشيفات الفلسطينية للصور على علاقة المجتمع الفلسطيني بالثقافة البصرية. انظر عزة الحسن، الحياة الآخرة للصور الفلسطينية: البقايا البصرية وأرشيف الاختفاء (شام: بالجريف ماكميلان، ٢٠٢٤).
١١. نادية يعقوب، السينما الفلسطينية في أيام الثورة (أوستن: مطبعة جامعة تكساس، ٢٠١٨).
١٢. المرجع نفسه، ص ٢.