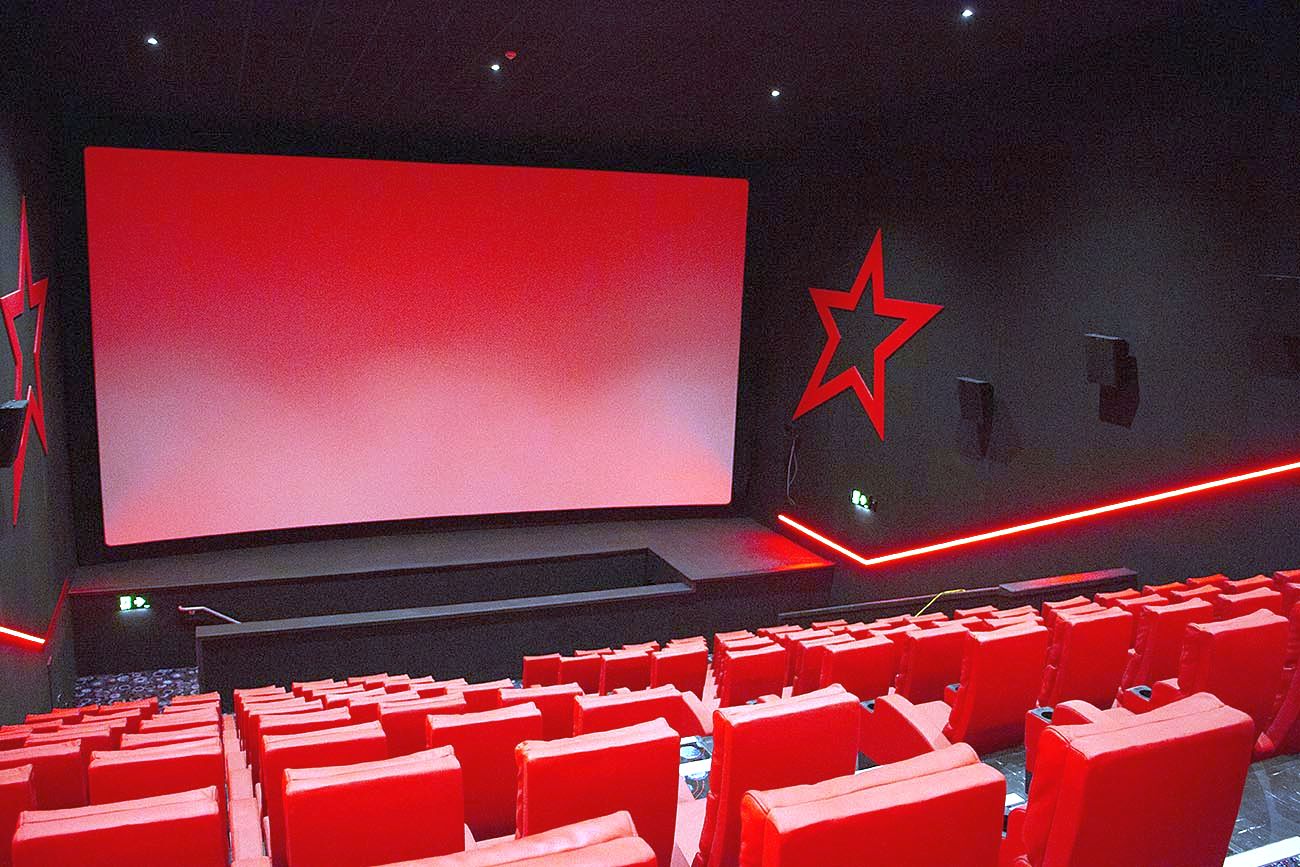قبطان “السيد سعيد” يُحرِّض على التمرد

مازن حلمي *
يمكن أن يصنع عملٌ فنىّ واحد فنانًا كبيرًا، فيما لا تترك عشرات الأعمال لآخرين أثرًا يُذكر. الأمثلة كثيرة في مختلف مجالات الإبداع. وخير شاهد على ذلك في السينما المصرية، حالة المخرج “السيد سعيد” بفيلمه الوحيد “القبطان”. “سعيد” واحدٌ من القديسين الذين أثروا الحياة السينمائية على المستويين النظري، والتطبيقي، بل الحياة الثقافية عامة، فهو متعدد المواهب، والملكات الإبداعية، متنوع العطاء مثلما يُمثّل طاقة إنسانية كبيرة.
وُلد السيد سعيد عام 1939 بمدينة بورسعيد، وبدأ حياته الفنية ككاتب بمجموعته القصصية “الموجة” بالتقاسم مع الكاتب “محمود بقشيش”، فأثنى عليها كبار النقاد مثل “محمود أمين العالم”، لكن سعيدًا كان مسحورًا بالفن؛ أراد أن يدخل جميع أبوابه، فتعلّم الموسيقى وقراءة وكتابة النوتة الموسيقية، كما أتقن العزف على بعض الآلات الموسيقية إلى جانب ولعه برسم الوجوه و”الاسكتشات”، إلى أن التقى معشوقه: فن السينما.

جاء السيد سعيد إلى القاهرة، ليلتحق بكلية الحقوق إلا أنه تركها، والتحق بمعهد السينما، وسرعان ما انخرط في المناخ الثقافي والسياسي في تلك الفترة، فانضم إلى تنظيمات يسارية شيوعية مثل “حدتو”، وتعرض لتجربة الاعتقال. هذه التجربة الحياتية والثقافية أثقلت وعيه الفكري، والسياسي، والاجتماعي وهو ما سيعبر عنه لاحقًا في كتاباته وسينماه.
ترك “السيد سعيد” إرثًا ثقافيًا نوعيًا: الفيلم الروائي القصير “الشاهد والقضية” عام 1975، والفيلم الروائي الطويل “القبطان” عام 1997، ومسلسلين تلفزيونيين هما “رحلة إلى الشمس” عام 1981، و”بحيرة التمساح” عام 1995، وفيلمًا تسجيليًا وثائقيًا هو “تعظيم سلام” 2011، وهو لم يُعرض حتى الآن، بالإضافة إلى كتابين، الأول “واحد من البنائين” عن مهندس الديكور “أنسى أبو سيف”، والثاني “المشاغب” عن المخرج الراحل “محمد كامل القليوبي”، إلى جانب جهده التنظيري من خلال عشرات الدراسات، والأبحاث، والمقالات عن قضايا السينما وهمومها منشورة في مجلات، وجرائد، وحلقات بحثية.
القبطان.. أيقونة سيد سعيد
يظل فيلمه الروائي الطويل “القبطان” علامة في تاريخ السينما المصرية بشخصيته الأسطورية، وأجوائه، ولغته السينمائية الجديدة كليًا عن السرد البصري المعتاد. ويمكن القول إنه فتح مسارًا جديدًا للسينما. إنه قصيدة شعرية غنائية تقترب من التصوف والشعر والميتافيزيقا، رغم أنه غائص في الهم العام. يتأرجح بين الذاتي والموضوعي، الواقعي والأسطوري، الماضي والحاضر.

لا قصة للفيلم نستطيع الإمساك بخيطها العريض أو نختصرها في جملة. يُعبِّر الفيلم عن مضمونه بلغة سينمائية خالصة قاطعًا جذوره العالقة بعالم الأدب القائم على الحكي، والاستطراد، والحوار. ويدور الفيلم حول شخصية تُدعى القبطان “محمود عبد العزيز” تعشق الوطن والحياة بطريقة خاصة، تظهر وتختفي، تحيا ولا تموت، إنه شخصية رمزية وحقيقية في آن واحد. ثمة خيوط درامية أخرى لكنها تبدأ وتنتهي في عالم ذلك القبطان العجيب.
وجوه القبطان
في المشاهد الأولى يُوهمنا “سعيد” أننا أمام شخصية زوربا اليوناني برقصة التانجو، وأجواء البحر، أو موضوعة الشخص الأكثر خبرة بالحياة والناس في مقابل آخر أكثر براءة، لكننا نجد شخصية مصرية صميمة قريبة من الأساطير الشعبية وعالم “سيد سعيد” ذاته. هذه الشخصية لها أبعاد ووجوه عدة:
أولًا: الوجه الإنساني المحب للبشر الشبيه بالمسيح في رحمته وقدرته على إتيان المعجزات، فهو ينقذ طفلًا فلسطينًا من الكوليرا، يعطف على فتاة الشارع وجيدة “وفاء صادق”، ويساعد الشباب الثلاثة (الملواني – المحمدي – كمال الأرستقراطي) الواقعين في غرام وجيدة على معرفة طريقهم في الحياة. كما يتجلى ملمح البطل الأسطوري في معرفته أسرار وماضي الشخصيات الأخرى.
ثانيًا: وجه القبطان النضالي الثائر وهو الأكثر سطوعًا وبروزًا في تكوينه، يقوم بدور المثقف العضوي والتنويري لمجموعات الصيادين عن طريق نقل أحداث العالم إليهم كحرب فرنسا في فيتنام، وكيفية هزيمة الفيتناميين للفرنسيين رغم الفارق الحضاري بينهما، يُسقط ذلك على جُند الإنجليز المًحتَل وشعب مصر، فضلًا عن اتخاذه من الشباب خلية مقاومة ضد الإنجليز وامتدادا له في المستقبل. تأتى مقاومته للحِكْمدار “أحمد توفيق” أشبه بلعبة القط والفأر من حيث الظهور والاختفاء. هنا يؤكد المخرج على دور السينما التوعوي والتحريضي في نفوس المتفرجين، ودوره كفنان ملتزم يُحرِّض على الثورة، وثورة الجمال.

ثالثًا: وجه عاشق الحياة من خلال الرقص والغناء، وتعدّد علاقاته النسائية بين وجيدة، والعاهرة، وصاحبة الحانة، والفتاة اليونانية. لكن تلك العلاقات لم تظهر كفاية، فنسخة العرض حُذف منها نصف ساعة تكثيفًا للفيلم، بالتالي كانت هناك خيوط سردية مبتورة، وانتقالات مفاجئة في الأحداث مثل علاقته بالفتاة اليونانية “هيلينا” التي أضحت طيفًا وخيالًا أكثر منها علاقة حقيقية، وزواج “وجيدة” من الحكمدار دون مقدمات درامية. يمكن التغاضي عن هذه الملاحظة لأن السرد فوق الواقعي يتبع منطق الشعر، والأسطورة.ِ
المقاومة بالفن
تحضر الموسيقى والغناء بديلًا عن الحكي الدرامي، فالحدث يُعبَّر عنه غناءً. الانشغال هنا بالجانب الروحي أكثر من بالتسلسل المنطقي العقلي. المخرج مثل المتصوفة والشعراء يعبر عن أحاسيسه ومواقفه بالإشارة، والرمز، والايحاء. يُدخل السينما منطقة التصوف والوجدان العرفاني؛ ليحقق سينما التصوف إن صح التعبير. ولا ننسى عبارة النِفّري الافتتاحية “إنما أحدثك فترى، فإن رأيت فلا حديث”.
طوال الفيلم نفهم ضمنيًا أن القبطان يحارب السلطة ويمهد للثورة، لكن بالغناء بدلًا من السلاح. مشاهد حلقات الغناء المتكررة بين القبطان وأصدقائه وبينه والصيادين إن كانت تعنى الاحتفال بالحياة، وإضفاء لون من البهجة والمرح، إلا أنها لا تعنى في العمق سوى المقاومة والنضال ضد الغازي الإنجليزي، والسلطة الفاسدة الممثلة في الحكمدار.
وظاهر الصورة السينمائية غير باطنها، وما حادثة اغتيال القائد الإنجليزي بيد الملواني غير نتيجة جهاد مسلح خفى. تلك ضروب للغة وأحوال المتصوفة، فضلاً عن الاحتفاء بالمذياع، ليس كآلة تجلب المتعة، إنما كأحد مشاعل الثورة وجسر للمعرفة. بهذه الشذرات والإيحاءات والغناء المتواصل يصنع “سعيد” عالمًا سينمائياً صوفيًا، مع فارق أن الصوفيين يذوبون عشقًا في الخالق، فيما هو يفنى في حب الوطن.
الشعر مرآة العالم
عندما تغيب الحكاية الفيلمية يتجلى حضور الشعر في البناء السردي، يأخذ أشكالًا عدة مثل الصورة الغنية بالتفاصيل المكتنزة بطاقة إيحائية هائلة، وحضور البحر اللافت ليس كخلفية طبيعية، بل بالمعنى الميتافيزيقي. هذا الصفاء الذي تبثه اللغة السينمائية الرقيقة إلى جانب موسيقى شعرية تستخدم كبديل للحوار تمس مشاعر المتفرج، وتعبر عما لا يمكن للكلام العادي البوح به.

إن شخصية الفيلم الرئيسة ذات وجه أسطوري؛ لذا كان الأسلوب الأجدر على استيعابها هو السرد الشعرى، فمن المشاهد المعبرة الشاعرية مشهد الشجار بين الملواني والمحمدي حيث لجأ إلى التعبير بالأقدام وضرب العصى من طرف أصدقاء المحمدي كناية عن تصاعد الخناق والعنف المرتقب.
يقتحم القبطان أماكن الأرستقراطية بلا اعتداد للمنطق؛ لأنه يتبع درب الشعر، ويحطم منطقية الحكاية، وتناميها المألوف؛ كي يمدنا بحالة شعورية من البهجة والفرح والتمرد.
رحل “السيد سعيد” عام 2019، فيما يواصل قبطانه الإبحار في ذاكرة السينما مواجهًا العاصفة.
________
* شاعر وناقد