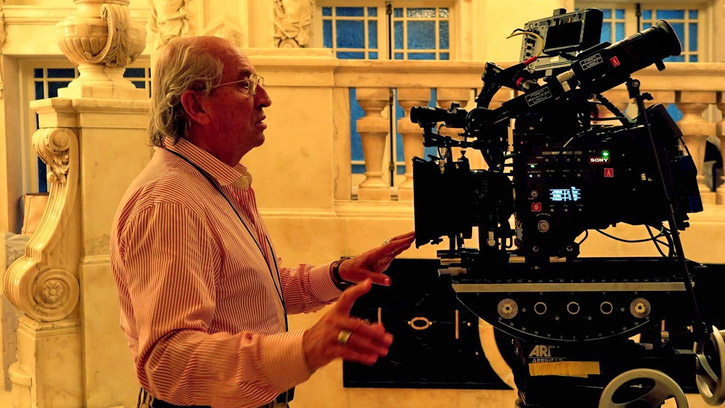أوبنهايمر ونولان ومصائر بروميثيوس الكافكية

محمد فاروق- مصر
أعطى بروميثيوس النار للبشر فعاقبته الآلهة بأن كبّلته إلى حجر
هكذا افتتح كريستوفر نولان فيلمه الثاني عشر Oppenheimer في أول مرة ينتقي فيها المخرج البريطاني-الأمريكي افتتاحية نصّية لأحد أعماله، الاختيار ملائم للفيلم ولمادته الأصلية: پروميثيوس الأمريكي: انتصار ومأساة چ. روبرت أوپنهايمر، كتاب «كاي بيرد» و«مارتن ج. شيروين» الحائز على جائزة پوليتزر عام 2006.
يشير النص الافتتاحي كما يشير عنوان الكتاب إلى التشابه الّذي تفرضه حياة العالِم الأمريكي روبرت أوبنهايمر وتنصيبه أبًا للقنبلة الذرّية مع أسطورة پروميثيوس العملاق الّذي سرق النار من آلهة الأولمپ وأعطاها للبشر فعاقبه زيوس بأن كبّله إلى صخرة وسلّط عليه نسرًا ليلتهم كبده، وفي كل يوم يتجدد كبده مرة أخرى ليظلّ النسر يلتهمه إلى الأبد.
صحيحٌ أن هرقل قد أنقذ بروميثيوس كما تقول الأسطورة[1] وقتل النسر وكسر حلقة المعاناة السيزيفية، لكن تظل سوداوية المصير لمن تحدّى الآلهة، ومنح البشر المعرفة والقوّة هي ما ترنّ في الأذهان، حتى أن فرانز كافكا كتب قصةً قصيرة عن مصير پروميثيوس أو مصائره المحتملة[2]، فعلى منوال تفسيرات الكتاب المقدّس أو الشروح الأكاديمية التاريخية سرد كافكا أربع أساطير مختلفة تحمل أربعة مصائر متباينة للعملاق الأسطوري.
أما بروميثيوس الأمريكي أو روبرت أوبنهايمر، فيسرد نولان سيرته الذاتية في فيلمٍ دسمٍ وثقيل على مدار ساعاته الثلاث، وعلى واجهته الممثل كيليان ميرفي الّذي يعمل مع المخرج للمرة السادسة (نصف فيلموجرافيا المخرج بالتمام والكمال) ولكنها الأولى كممثل رئيسي، ليناقش الفيلم مصير الفيزيائي الأمريكي، ويصاحبه مصير فيلمٍ مرتقبٍ بشدة، ومصير مخرجٍ كبير خاضت مسيرته مؤخرًا تخبطًا وإثارةً للجدل.

وفقًا للأسطورة الأولى، فقد قُيّد إلى صخرة في جبال القوقاز لكشفه أسرار الآلهة للبشر، وأرسلت الآلهة نسورًا لتأكل كبده الّذي ظلّ يتجدّد إلى الأبد.
في نهاية في أسطورة كافكا الأولى، يلقى بروميثيوس معاناةً أبديةً، وما من هرقل لينقذه، إنها النسخة الأقسى والعقاب الأشد، فما اقترفه لا يُغتفر. سيطوف بالذهن عند السماع بأمر هذا الفيلم أن سردية نولان ستعمل على تبنّي كل ما يمكن تبنّيه لتغفر لأوپنهايمر ما التصق به تاريخيًا، قد تحمل هذه الفكرة شيئًا من الصحة، لكنّها ستستدعي عملية قاسية.
في أولى دقائق الفيلم نشاهد أوپنهايمر الشاب يحنق على معلّمه الّذي يورّطه في أعمال مختبرية تحرمه من حضور محاضرات الفيزيائي الشهير نيلز بور، فيحقن تفاحة بسم السيانيد ويتركها على طاولة معلّمه، يستبعد كتاب بروميثيوس الأمريكي على نحوٍ ما أن تكون التفاحة قد حُقنت سمًّا قاتلًا فعلًا[3]، وأن الأقرب هو أنّها احتوت على ما يسبّب المرض أو التلبّك لا أكثر، لكن نولان قرّر تبنّي النسخة القاسية السوداوية من الحكاية بلا أي تبرير أو تخفيف، صحيحٌ أنّ أوبنهايمر سيعود أدراجه في اللحظات الأخيرة قبل أن تقتل التفاحة أحدًا، وبالتالي ستوازن إنسانيته وشقاؤه قليلًا من دور حيّة سفر التكوين الّذي لعبه في الدقائق الأولى من عمر الفيلم، لكنّنا سنظل أمام جانبٍ من الحقيقة يسرده الفيلم يقول أن چ. روبرت أوپنهايمر قد حاول قتل شخصٍ قبل سنواتٍ طويلة من مشروع مانهاتن، أي أنّ الخطيئة متجذّرة فيه إلى حدٍ بعيد، تجذّر يسبب شرخًا صعب الالتئام في أي محاولة لطلب المغفرة.
نولان أيضًا مثل شخصيته لديه خطاياه الّتي تصيّدها له النقاد عبر سنوات صعوده ونجاحه، فتصميم الشخصيات وخلق أبعادها لم يكن من أهم مميزات الرجل، الشخصيات النسائية على وجه التحديد في أفلام نولان تعاني من تسطيح إن جاز التعبير، وهنا الشخصيتان النسائيتان «چين تاتلوك» (فلورنس پيو) و«كيت أوپنهايمر» (إيميلي بلانت) قد تكون من المبالغة اعتبراهما أفضل حالًا من الوقوع في هذا النقد، فالأولى هي عشيقة أوپنهايمر الشيوعية، والّتي تمثّل جانبًا مذنبًا من حياته يؤرقه عبر السنين، والثانية هي زوجته، وهي صاحبة إحدى أقوى الأداءات التمثيلية في الفيلم المكتظ بالأداءات القويّة، ولكن قد لا يسعف أداء «إيميلي بلانت» الكثير من مشكلة تطوّر شخصية «كيت» غير الواضح، وقد لا يستسيغ المشاهدون تمامًا تحوّلاتها من ضد زوجها إلى جانبه ثم إلى جانبه على نحوٍ أعنف منه نفسه، إنها أقرب لأن تكون ظلًا من أوپنهايمر أو أحد جوانب شخصيته عن كونها إنسانًا مستقلًا.
نقدٌ آخر طالما وُجّه لنولان وهو تناوله للنظريات العلمية بقراءة مجازية مبالغ فيها أحيانًا، إنه التناول الّذي جعله يخرج عبارة في Interstellar مثل «الحب هو الشيء الوحيد الّذي يتجاوز أبعاد المكان والزمان»، وهي عبارة نالت ما نالته من استهجان، هنا يعود نولان لقراءاته المجازية للنظريات العلمية، لكن في نسق أكثر فاعلية بكل تأكيد، مثل تشبيه سباق التسلّح الّذي استهلّه مشروع مانهاتن بالتفاعل المتسلسل الّذي عند نقطةٍ ما قد يتسبب في احتراق الغلاف الجوي ودمار العالم، فالتفاعل المتسلسل وإن لم يحدث بشكل فيزيائي مباشر يحدث على نحوٍ ما عبر سباق التسلّح الّذي ابتدأته البشرية والّذي سيؤدي نفس الغرض وسينتهي ذات النهاية.
تناولٌ مجازيٌ آخر للحقائق العلمية -وإن كان أضعف تأثيرًا- نجده عندما عنوَن الفيلم شقّيه في السرد (الملوّن الّذي يعرض منظور روبرت أوپنهايمر والأبيض والأسود الّذي يعرض منظور لويس ستروس في أحيان والمنظور الموضوعي بلا راوٍ في أحيانٍ أخرى) باسمي العمليتين الأساسيتين للتفاعل النووي: الانشطار والاندماج، وهو أمرٌ قد تكون دلالته بعيدة بعض الشيء إن كانت له دلالة بالفعل.
تناولٌ آخر لم يدسّه نولان صراحةً في حوار الفيلم وإنما أجبر المشاهدين على أن يتبنّوه بأنفسهم، حينما شرح أوپنهايمر لطالبه الوحيد في أولى محاضراته قائلًا أن ميكانيكا الكم هي عبارة عن تناقضات لكنها تعمل، وتترك العبارة سائر الفيلم للمشاهدين ليتبينوا أن ما ينطبق على ميكانيكا الكم ينطبق على أوبنهايمر ذاته ولا عجب في أنّه قد أُخذ بها، فهو نفسه كتلة من التناقضات، يدس التفاحة المسمومة ثم يسحبها، يبتكر السلاح النووي ثم يحزن لتلطخ يده بالدماء، يلقى بالكلمات الشامتة في اليابانيين بينما يعاني صراعًا داخليًا، إنها مجموعة من التناقضات، ولكنها على نحوٍ ما تعمل.
وفقًا للأسطورة الثانية ضغط پروميثيوس نفسه في الصخرة أعمق وأعمق، مدفوعًا بألم تمزيق المناقير، حتى صار متحدًا مع الصخرة.

تتميّز أسطورة كافكا الثانية عن الثلاثة الأخريات في أمرين، الأول على مستوى المضمون وهو أنّها تتخذ شكلًا صوفيًا إن جاز الوصف نراه متجسدًا في تعبيرٍ مثل «متحدًا مع الصخرة» وهو ما قد يشير إلى لونٍ من السلام والتقبل، والثاني على مستوى الشكل وهو ما يلحظه مؤرخ الآداب المجري «جيورجي كالمان» في معرض تحليله لقصة كافكا[4]، وهو اختلاف الأسطورة الثانية في انغلاق حبكتها، وفي امتلاكها سردًا تقليديًا من بدايةٍ ووسطٍ ونهايةٍ، فعلى الأقل هنا نحن نرى نهاية ونعرف ما جرى فيها.
بخصوص السرد في أوپنهايمر فهو أبعد ما يكون عن التقسيم الكلاسيكي، كعادته يلجأ نولان إلى لاخطّية شديدة التعرج، بلغت ذروتها (أو إحدى ذرواتها للدقة) في مشهد مقابلة أوپنهايمر مع الچنرال «بوريس باش» (كاسي أفليك) حين عرض مونتاچ المقابلة الحدث نفسه بالتوازي مع حوارين يدوران حول المقابلة في زمانين مختلفين، فسردٌ كهذا هو ما يراهن عليه نولان لإضفاء الإثارة على قصة سيرة ذاتية، إلى جانب بعض أدواته المعتادة مثل محاولة صنع التواءة هائلة في الحبكة، بالضبط ما فعله مع شخصية «لويس ستروس» (روبرت داوني چونيور) الّذي خلق لها -على غرار أفلام الغموض- لحظة تنوير تكشف نواياها الحقيقية وتبثّ حالة من الصدمة عند المتلقّي، غير أن هذا قد يأتي على حساب تركيز السيناريو على مبتغاه، لأن لحظة التنوير تلك تأتي مستبعدة الكثير من العناصر والرنجات الحمراء الّتي ألقاها السيناريو هنا وهناك لتفرض في النهاية على المشاهد بؤرة جديدة للأحداث، وهو ما قد يُرى أنّه لم يتم بالقدر الكافي من السلاسة، غير أن سرد نولان المتعرّج لا يزال يمكن اعتباره حاويًا قيمةً جماليةً في ذاته، حتى بمنأى عن كونه وسيلة فعّالة لخدمة القصة وحكيها، وربما هو ما تحتاجه بالفعل سيرةٌ ذاتيةٌ يلمّ بها الكثيرون ولا تسفر أهمية شخصيتها عن جودة سينمائية بالضرورة، لعلّ هذا ما يفسّر إعجاب كريستوفر نولان بفيلم دامين شازيل[5] First Man (2018) وإن اختلف أسلوب شازيل عن أسلوب نولان في إضفاء الجودة السينمائية على السيرة الذاتية المعروفة للكثيرين.
يستعير نولان كذلك أدواتٍ من أنواع سينمائية شتّى، فيقدّم تسلسلًا أشبه بتسلسلات الرعب القائمة على التخيّلات والهلاوس في واحدٍ من أجمل مشاهد الفيلم إن لم يكن أجملها وهو مشهد خطاب أوپنهايمر الاحتفالي حيث يرى العالِم الأمريكي المبتهجين بالقصف الذرّي من حوله وهم يذوبون في البياض النووي وتتناثر جلودهم كالأوراق، كما يستعير من أفلام الإثارة والتحقيقات تقنية ماكجيفن McGuffin، حينما يتحرك النصّ أو إحدى شخصياته في سبيل تفسير أمرٍ ما، هو هنا ما قاله أوپنهايمر لأينشتاين ولم يسمعه ستروس ليظنّ أنه تسبّب في تقليب العالِم الألماني عليه، إنها أشبه بروزبد المواطن كين الّذي يتضح في النهاية أنها لم تكن مربط الفرس، الاختلاف هنا أنّها تتضح أنها مربط فرس أكثر أهمية من تمحور ستروس حول ذاته، لا شك أن تقديمها على هذا المنوال في المشهد الأخير رفع من شأن نهاية الفيلم إلى حدٍ كبير.
وبخصوص تقبّل المصير عند بروميثيوس ، فقد سلك أوپنهايمر مسلك «الاتحاد مع الصخرة» في كثيرٍ من الأحيان، فبعد لعبه لدور الشيطان ابتغى لعب دور الشهيد، تمامًا كما فعل مع التفاحة في بداية الفيلم، فعندما يعرف بنبأ انتحار عشيقته نجده متقوقعًا ناحبًا تحت المطر، فتأتي زوجته لتصيح فيه بأن يتوقّف عن لعب دور الشهيد وأن يتحمل عواقب خطاياه، يستخدم نولان الخلفية العاطفية للشخصية كرمزٍ بيّن لخطايا أوپنهايمر التاريخية، كما يستخدم زوجته كما تطرّقنا- للتعبير عن جانبٍ غاضبٍ فيه يرفض الانصياع للعب دور الشهيد، وستعود ثنائية استسلام الزوج للمصير وغضب الزوجة المضاد لهذا الخنوع لتظهر مجدّدًا إبان جلسة التحقيق الّتي يخوضها أوپنهايمر في الخمسينيات لتجديد تصريحه الأمني، إنها جلسة تحقيق معنيّة بصلاته بالشيوعية ومرتبطة بجنون المكارثية الّذي أصاب أمريكا في ذلك العقد، لكن استخدامها في الفيلم كأشبه بمحاكمة تطهّر پروميثيوس من خطاياه التاريخية هو ثيمة لن تخطئها عين، إنها محاكمة أوپنهايمر على جرائم لم يُحاكم عليها.
وفقًا للأسطورة الثالثة فقد نُسيّت خيانته خلال آلاف السنين، نسيتها الآلهة، ونسيتها النسور، ونسيها بروميثيوس نفسه.يمنحنا كافكا ما يمكن أن نسميه نهايةً في الأسطورة الثالثة، ولكنها نهاية على قدرٍ من الإبهام والغموض، فإنها تتحدث عن النسيان دون أن تخبرنا ما يحدث بعد النسيان، كما أنّها تنسى أن بعض العواقب لا يمكن نسيانها، وأوپنهايمر يدري أن ما فعله لن يُنسى ولن يُطوى، تجلّى هذا بشكلٍ كبير في مشهد النهاية حينما أعلن لأينشتاين عن اعتقاده في أنّه قد بدأ تفاعلًا متسلسلًا لن ينخمد، وهو اعتقادٌ تؤكد عليه الصورة حينما ترسم نارًا تأكل غلاف الأرض الجوّي، تبتلعه موضعًا بعد موضع، ثم تظلم الشاشة تاركةً المشاهد يتابع التفاعل المتسلسل في حياته الحقيقية وفي عصره المجنون عبر التقارير الإخبارية.
نولان كذلك لا ينسى أفكاره المعتادة كما استقبلناها من أفلامه ولا يتخلّى عنها، فهو يرى الشرّ متأصلًا في الطبيعة البشرية، مثل شرّ د.مان في Interstellar المدفوع بغريزة البقاء، كما ينبذ أي مفاهيم ميتافيزيقية لها أن تُقهقر أهمية الإنسان خلفها، فكما رأيناه في Dunkirk قد جعل من الحرب كارثة لا يُبتغى فيها سوى النجاة، وبالتالي يتهمّش فيها دور العدو أو «الآخر».
وفيلموجرافيا نولان ككل ترفض التركيز على «الآخر» بالمعنى العميق للكلمة رفضًا باتًّا، فعندما قدّم خيالًا علميًا متمسرحًا في الفضاء لم نرَ وجودًا آخر أو مخلوقاتٍ فضائية، وعندما أخرج فيلمًا عن الحرب العالمية الثانية لم نشاهد دورًا دراميًا فعّالًا لآلة الشرّ النازية، وإذا دخل هذا المخرج مجال سينما الرعب في المستقبل فعلى الأغلب لن نجد في أعماله لا أشباحًا ولا كيانات ما وراء طبيعية، والتواءات حبكاته كما في Memento وInterstellar و Tenet كلها يمكن تلخيصها في عبارة واحدة «لا يوجد آخر، نحن من جلبنا أنفسنا إلى هنا»،
وفي فيلم “أوپنهايمر” لا يتغيّر الوضع، لا نرى اليابانيين لأن أوبنهايمر عند مرحلة القصف النووي قد تراجع إلى مرتبة المتلقي السلبي، تُلقى نصائحه بخصوص تفجير القنبلة على مسافة عالية جُزافًا، ويستمع إلى ما يحدث عبر الراديو كسائر المتابعين، لقد انفصل الصانع عن المصنوع، ومن الممكن أن تتوه المسؤولية الأخلاقية في شبكة معقدة من الأيادي والمؤسسات (على غرار نهج حنا أرندت في كتابها تفاهة الشرّ مثلًا) لكن تبنّى الفيلم رجوع المسؤولية المباشرة للقصف النووي إلى الرئيس «هاري ترومان» (جاري أولدمان) الذي سخر من أوپنهايمر بشأن تلطخ يده بالدماء، وهو تبنٍ مقبولٌ ووجيه إلى درجة كبيرة لأن ترومان بالفعل كان متحمسًا أعمى للهجوم النووي، وقد صرّح فيما بعد بأنه لو عاد به الزمن فسيفعلها مرة أخرى[6].

ربما يعد “أوپنهايمر” أكثر أفلام نولان تشاؤمية، فرؤيته المادية في أفلامه غالبًا ما تنجح في شق طريق النجاة، وهو قطعًا ما لم يحدث هنا، وإن رأى أحدٌ بأنّه ألقى لمحة من تطهّرٍ ذاتي يميّز الديمقراطية الأمريكية متمثلًا في رفض الكونجرس لتولي رجلٍ مثل ستروس منصب وزير التجارة، فلا يمكن غض الطرف عن ذكره أن هذا الدور قد لعبه أو اشترك فيه السيناتور چون ف. كينيدي، وبالطبع لا يغفل أحد ولا يغفل نولان ما سيحدث لكينيدي مستقبلًا، وتباعًا فإن التطهّر الذاتي ذاك مشكوكٌ فيه إلى حدٍ كبير في أفضل الأحوال.
وفقًا للأسطورة الرابعة فقد سئم الجميع هذا الشأن العبثي، سئمت الآلهة، وسئمت النسور، والتأم الجرح سائمًا.
والسأم كالنسيان، نهاية مبهمة وغامضة، ولكنه يختلف عنه في ارتباطه بالعبثية وانعدام المعنى، لكن من الصعب أن يتولّد انعدام المعنى إذا كانت عواقب الأمر لا تزال تلوّح بمعانيها أمامنا.
ربما خشي نولان السأم، وأن يتوه المعنى في شريطه السينمائي الطويل والمعقد إلى حد ما، ربما كانت تلك المشكلة الكبرى في فيلمه السابق Tenet حينما بلغ نقطةً استشرى فيها التعقيد- وإن كان نوعٌ آخر من التعقيد- حتى انفصل المتلقي عن العمل، ولمنع تلك المشكلة في أوبنهايمر لجأ المخرج إلى أداة التخلي عن الواقعية بأن يصيغ بين مشاهده صورًا سيريالية، وهي وسيلة بدأها الفيلم في مشهد التعري في غرفة التحقيق والذي شكّل جرسًا دق أمام المشاهدين موقظًا إيّاهم ومعلنًا أن الفيلم على أتم الاستعداد للخروج عن السرد البيوجرافي الواقعي، وأنه لن يجد غضاضة في دمج مَشاهده وإلقاء خطوطها الزمنية لتنبعج على بعضها مثلما سيرمي بعشيقة أوپنهايمر بين أحضانه في تلك الغرفة، في مشهدٍ أضفى بكل تأكيد غرائبية مهيبة وأجواءً شبيهة بالميثولوچيا على السرد البيروقراطي والسياسي البارد.
حيلة أخرى استغلها نولان لإضافة البريق على الفيلم، وهي استخدام ما توفر في يديه من نجوم، فحتى قبل المشاهدة لا يخفى على أحد ارتكاز الفيلم على وفرة زاخرة من النجوم، وفي الفيلم كانت تتعمّد الصورة أن تضع لحظات تقديم النجوم في إطارٍ برّاق، إذ ترصد الكاميرا باهتمام ذلك الرجل الذي انحنى ليلتقط القلم فتجده «رامي مالك»، أو تبدأ في تركيز بؤرتها على السيدة في خلفية الصورة لتبصر بعد انقشاع الضباب ملامح «إيميلي بلانت»، وتراقب في صمت ذاك الچنرال بالزيّ العسكري من خلف ظهره لتعرف بعدها أنّه «كاسي أفليك»، ولكن مصطلح النجوم في الفيلم لا يقتصر إطلاقًا على الممثلين، فالفيلم كقصة حقيقية وهامّة يضم في نصّه أسماءً لامعة على قدرٍ من الشعبية توازي شعبية الواقفين أمام الكاميرا، ونعني العلماء من أمثال ألبرت أينشتاين، من استغله الفيلم جيدًا في دور المعلم Mentor الذي يقف خارج سيل الأحداث ثم يظهر ليتبادل الكلمات مع أوپنهايمر فيبدو الأخير حينئذٍ كمن يتنفس الصعداء وسط معترك حياته الملتهب، ومثل علماء آخرين كنيلز بور وفيرتر هايزنبرج وكيرت جودل، أو سياسيين مثل چون ف. كينيدي، وكلهم اتّسمت لحظات ظهورهم أو ذكرهم باللُطف أو الاحتفاء، كما لم يكتفِ الفيلم بنجومه ونجوم قصته، بل سعى إلى خلق نجومه الخاصة بنفسه، مثل مشهد الخطاب الاحتفالي الذي قدّم لنا السرد بصيصًا منه في وقتٍ مبكّر من الفيلم عبر تقنية الـ Foreshadowing بعرضه لأقدام الجمهور وهي تدب على الأرض، مما أضاف على لحظة الظهور الفعليّ للمشهد نفسه هيبةً وفاعلية ملحوظة، أمرٌ مشابه هو ما حدث مع مشهد الانفجار النووي المنتظر، إذ جاء المشهد -الّذي انتظره المشاهدون وأعدّوه واجهة الفيلم الأساسية- طويلًا نسبيًا مقارنةً بما سبقه وبما تلاه من مشاهد يضمها مونتاچٌ سريع، فبدا كما لو وُضع داخل إطارٍ لامع، وكأنّه يتم الاحتفاء بنجمٍ جديد ومُنتظَر في فيلمٍ مليءٍ بالنجوم.
هكذا قدّم “أوپنهايمر” نفسه للجمهور السينمائي، مخرج مُهمّ وممثلون مهمّون، قصة مهمة عن شخصيات مهمة، يضع الفيلم نفسه في موضع نجومية توازي نجومية مخرجه وممثليه ومواضيعه، يتبنّى عبر ساعاته الثلاث قطاعًا عريضًا من التقنيات السينمائية في المونتاچ والتصوير والسرد، يتناول حوارات دسمة ومعضلات أخلاقية عويصة، يتغلّف بموسيقى تصويرية تفرض نفسها وبتجربة صوتية فريدة من نوعها، يترنّح أحيانًا كترنّح بطله لكنّه لا يطلب المغفرة، لأنه يدري أنه في المُجمل يقدّم تجربةً سينمائية ستحقّق في النهاية للمتلقي شعورًا بالرضا أكبر مما حقّقه أيّ جزءٍ من مجموع أجزائها.
هوامش
[1] Hesiod. Theogony. Lines 520-530.
[2] Franz Kafka. The Complete Stories. Prometheus.
[3] Kai Bird and Martin J. Sherwin. American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer. Chapter 3: I Am Having a Pretty Bad Time.
[4] Gyorgy C. Kalman. Kafka’s Prometheus. Published in Neohelicon XXXIV (2007)
[5] Variety. Directors on Directors: Filmmakers Praise Some of Their Favorite Movies of 2018.
[6] Harry S. Truman. A letter to Irv Kupcinet. Dated August 5th, 1963. Published in Harry S. Truman Presidential Library.