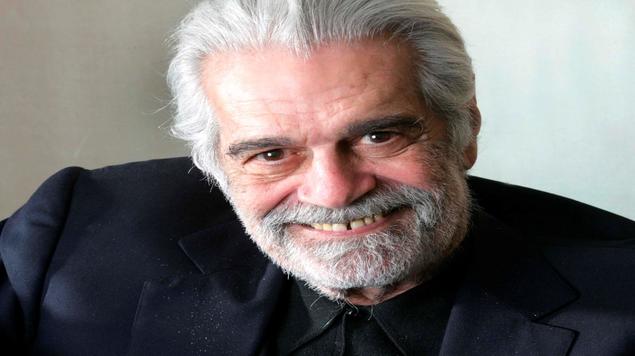نقاد السينما في الزمن الصعب: عن صبحي شفيق والتلاقي وزائر الفجر

في زمن آخر وعصر آخر، كنا نحلم، وكانت أحلامنا، أي أحلام أبناء جيلي جميعا، تتجه نحو التحديث والمجتمع الذي تصان فيه حقوق الفرد، وتضطلع الدولة فيه بمسؤولية الرقي بالإنسان، بتعليمه وتنمية ذوقه، وكان مبدأ “تكافؤ الفرص” مطروحا بقوة، ولو على صعيد نظري، وكان ممكنا بالتالي، أن تجد، من أسفل السلم الاجتماعي، من يطالب بنيل حقوقه، دون أن يخشى أن يقال له: ومن أنت أصلا، ومن الذي أرسلك؟
كانت فكرة الرقي بالذوق العام والذوق الفردي راسخة إلى حد ما، وربما تكون قد وُرثت عن عهود سابقة، فقد كان طبيعيا مثلا، أن تجدَ فرقا للموسيقى النحاسية تابعة للبلديات، تعزف بعد ظهر كل يوم جمعة، مقطوعات موسيقية كلاسيكية رفيعة المستوى. كان هذا طبعا قبل أن تطغى ثقافة “الدهماء” التي لم تؤد فقط إلى حرق دار الأوبرا العظيمة وإقامة “جراج” متعدد الطوابق مكانها لأصحاب السيارات الفارهة من “طبقة الأثرياء الجدد” في عصر الانفتاح الاقتصادي “السعيد جدا”، بل أصبحنا نرى أيضا كيف أصبحت دار “الأوبرا الجديدة” التي أقامها لنا اليابانيون في الجزيرة على سبيل الهدية “الرمزية”، تقدم أغاني نانسي عجرم ونوال الزغبي وغيرهما!
وكانت فكرة تغيير أذواق جمهور السينما، أو بالأحرى، تطوير هذه الأذواق، فكرة ملحة كثيرا على أجهزة الثقافة والإعلام في مصر، فقد كان الحديث لا يكف ليلا ونهارا، في الإذاعات المختلفة، عن”المثقف الملتزم”، وعن فكرة الالتزام في الفن والأدب، وكانت المناقشات كثيرا ما تتطرق أيضا إلى ما طرحه الفيلسوف الفرنسي الكبير جان بول سارتر حول معنى الالتزام، والمثقف الملتزم. وكان هناك بالطبع من يميلون إلى أن الالتزام يعني الخضوع للفلسفة أو “الأيديولوجية” السائدة التي تحكم توجهات السلطة. وكانت تتمثل في تلك الفترة، فما أطلق عليه فلاسفة العهد “الاشتراكية العربية”، ولم تكن كلمة “الناصرية” قد ظهرت بعد، بل وكان محظورا استخدامها أصلا في وجود عبد الناصر.
ومن قلب ذلك الزخم الثقافي ظهر جيل من نقاد السينما، كانوا يتطلعون إلى القيام بدور وثيق في تغيير السينما، وكانوا بالتالي قد التصقوا من البداية، بجيل جديد من السينمائيين الشباب الذين تخرجوا من معهد السينما بالقاهرة، وكانت التجارب السينمائية العالمية التي انتشرت في أوروبا وامريكا اللاتينية، تغويهم بفكرة التغيير، أي تغيير قوالب السينما السائدة، وهو ما أدى وقتها إلى عراك وجدال ثقافي شديد، بين شباب السينمائيين، وجيل المخرجين الراسخين الذي اعتبروا وقوف “مؤسسة السينما” الرسمية وراء مطالب السينمائيين الشباب، يمثل تهديدا لهم.
في تلك الفترة عقد وزير الثقافة ثروت عكاشة مؤتمرا عاما للسينمائيين في إطار سلسلة مؤتمرات المثقفين التي تبنتها الوزارة بعد هزيمة 1967 كنوع من المراجعة الفكرية الشاملة، وإتاحة الفرصة أمام جموع المثقفين للتعبير عن آرائهم فيما يجري في الوطن، وكيفية المساهمة بدور في الواقع.
وفي أحد تلك الاجتماعات الشهيرة التي نشرت فيما بعد في عدد من الكتب صدرت عن وزراة الثقافة، وقف المخرج الراحل حسن الإمام ينتقد بشدة سياسة الدولة في مجال الإنتاج السينمائي في مصر في إطار ما عرف بـ”تجربة القطاع العام في السينما”، ويشكو من قلة العمل، ومن أنه يعاني من الفاقة. ومن ضمن ما قاله حسن الإمام في ذلك الاجتماع الشهير إنه اضطر لبيع ساعة يده من أجل دفع مصاريف المدرسة الخاصة التي تتعلم فيها ابنته!
وكانت المفارقة بالطبع، أن عموم الناس في مصر في ذلك الوقت، بل وكبار المسؤولين في الدولة، كانوا يدخلون أبناءهم المدارس العامة، وكان من الأمور المعيبة أن يقول أحد إن ابناءه يتعلمون في المدارس الخاصة، فقد كانت تلك من سمات “التمايز الطبقي”. وكانت المدارس الخاصة وقتها، محدودة للغاية ولم تكن قد توسعت وتوغلت في المجتمع كما هي الآن.
المهم أن مجموعة نقاد السينما الذين جاءوا من المسرح والأدب والفلسفة والفن التشكيلي والسينما، أصبحوا يشكلون نوعا من “اللوبي” الخاص، الذي يعتبر نفسه، جزءا من حركة التغيير في السينما.
وقد كان الجيل الذي ظهر في الستينيات أسعد حالا من كل ما سبقه أو لحقه من أجيال، فقد كانت الدولة أكثر ترحيبا بالنقد السينمائي، وكانت بحكم مسؤوليتها عن السينما من خلال القطاع العام، ترحب بوجود ذراع أخرى، مثقفة، تتمثل في النقد ولجنة قراءة السيناريوهات، بل إن الدولة أنشأت معهدا خاصا للسيناريو في الستينيات، أغلقته فيما بعد واكتفت بوجود قسم لتدريس السيناريو في معهد السينما. وكان المعهد الأخير يستقدم أساتذة زائرين من كبار السينمائيين في العالم، للتدريس للطلاب. بل وجاء أيضا السينمائي الإيطالي الكبير، روبرتو روسيلليني، رائد الواقعية الجديدة في السينما، لكي يؤسس وحدة تجريبية للإنتاج السينمائي، وتوثقت علاقته مع شادي عبد السلام، وتحمس لتجربة إنتاج فيلم “المومياء” ولكن المناخ الفاسد المتشكك في الأجنبي بوجه عام، حتى يومنا هذا، والذي يعتمد دوما، نظرية المؤامرة، أدى إلى التشكيك في مهمة روسيلليني، والتساؤل عما يفعله في مصر، وعما يحصل عليه من أموال (بالعملة الصعبة)، وهي تجربة تولى وزير الثقافة الأسبق الدكتور ثروت عكاشة، تناولها تفصيلا بكل ملابساتها، في مذكراته التي نشرها في أواخر الثمانينيات. وقد حسمها لصالح روسيلليني العظيم.
وقد لحق أبناء جيلي بجانب من تراث جيل الستينيات، في الثقافة وفي السينما وفي النقد عموما، لكن التطورات الدرامية العنيفة التي تلاحقت في السبعينيات، ثم الجمود الذي أصاب المناخ الثقافي بعد ذلك، ربما حتى اليوم، نتيجة غياب “رؤية” سياسية واضحة، ومنهج في إدارة المجتمع، جعلنا بكل أسف، أمام خيار من اثنين: إما دخول “الحظيرة”، أو العيش في “المنفى” الاختياري!
صبحي شفيق
كان صبحي شفيق واحدا من نقاد جيل العمالقة، فقد بدأ ناقدا مثقفا شديد الإطلاع، وكان بحكم معرفته باللغة الفرنسية، ودراسته في باريس في زمن الموجة الجديدة في السينما خلال الخمسينيات، قد أصبح في وقت ما من أوائل الستينيات حتى أوائل السبعينيات، “نبي السينما الجديدة” في مصر.
كنا نستمع إليه عادة في “البرنامج الثاني”، وهي الإذاعة المخصصة للثقافة في مصر، وهو يصول ويجول في برنامج “ندوة المسرح والسينما” الذي كان يقدمه الإذاعي المثقف ابراهيم الصيرفي. وكان يحدثنا عن الموجة الجديدة الفرنسية، والواقعية الجديدة الإيطالية، وعن التيارات الجديدة في السينما، والعلاقة بين الأدب الجديد الذي كان أحد رواده وقتها آلان روب جرييه، وبين السينما الجديدة.
وكان صبحي شفيق أيضا يكتب في الملحق الثقافي في “الأهرام”، وكان يكتب فيه عمالقة الكتاب في مصر مثل الدكتور لويس عوض، توفيق الحكيم، نجيب محفوظ، حسين فوزي، زكي نجيب محمود، عائشة عبد الرحمن، يوسف إدريس، وغيرهم.
وعندما أصدرت وزارة الثقافة (في عهد الوزير ثروت عكاشة) مجلة “المسرح والسينما” عام 1968 كان صبحي شفيق أحد أعضاء هيئة تحرير قسم السينما فيها. وقد اطلعنا على كتاباته وترجماته ومنها أتذكر، دراسة حول بدايات الموجة الجديدة وأصول نظرية “الكاميرا- قلم”، و”المخرج- المؤلف” لألكسندر أستروك، المنظر والمخرج السينمائي الفرنسي الذي كتب عنه صبحي شفيق الكثير، وشرح نظريته بطريقة جذابة وممتعة، واعتبره الأب الروحي الحقيقي للموجة الجديدة الفرنسية.
وقد ترجم صبحي شفيق ونشر في هذه المجلة أيضا، سيناريو فيلم “عاشت حياتها” لجان لوك جودار، وقدم له تقديما مثيرا للانتباه. وكان يكتب عن مخرجي الموجة الجديدة، ويلفت النظر إلى أساليبهم وأعمالهم.
إلا أنني عندما تعرفت عن قرب على صبحي شفيق كان ذلك في عام 1973 قبل حرب أكتوبر، في أوج عصر الرئيس الراحل أنور السادات. وكان صبحي شفيق، الناقد الكبير، قد أراد على ما يبدو، أن يحقق نظريته الخاصة في السينما، وأن يسير على درب مخرجي “الموجة الجديدة”، الذين تحولوا من النقد إلى ممارسة الإخراج السينمائي، مثل جودار وتريفو وشابرول وريفيت، فأخرج فيلمه الروائي الطويل الأول (والأخير) “التلاقي” الذي شاهدته في نادي القاهرة للسينما في عصره الذهبي.
ولكني صدمت في الفيلم، فقد وجدته عملا شديد الاضطراب فكريا وفنيا، على الرغم من إعجابي بمخرجه كناقد ومثقف كبير. وكان الفيلم في رأيي وحسب رؤيتي في ذلك الوقت، يغرق في تصوير جوانب أخلاقية تتعلق بالعلاقات بين أفراد الشريحة المثقفة في الطبقة الوسطى، ولكن في سياق الأفكار التي كانت سائدة وقتذاك. وكان يدور حول ثنائيات، تمارس الخيانة والخيانة المضادة، بالمعنى الأخلاقي المحض، كرمز للسقوط. وكان صبحي يريد أن يقول لنا إن مجتمع الهزيمة قد تفكك وتدهور، أي أن هدفه من الفيلم كان تقديم إدانة سياسية لمجتمع الهزيمة، وخاصة للطبقة الوسطى وللمثقفين، الذين يرفعون الشعارات الكبرى إلا أنهم أسرى الأفكار الاقطاعية والمفاهيم القديمة. وكانت هذه كلها أفكارا عظيمة، لكن المشكلة كانت تكمن في طريقة معالجتها فنيا، وكانت تميل إلى استخدام نفس القوالب الميلودرامية القديمة. وقد كتبت مقالا متواضعا، ولكن شديد الهجاء للفيلم، نشر في نشرة نادي السينما، حين كنت في بداياتي الأولى ككاتب وناقد، أجرب حظي في النشر على نطاق محدود.

لقطة من فيلم “التلاقي”
وعلمت بعد ذلك أن صبحي شفيق ثار بعدما قرأ هذا المقال، وأخذ يتساءل: “من هو هذا، (وكنت أيامها مازلت طالبا في الجامعة)، إنه لم يفهم فيلمي”. وأخذ يحتج لدى المسؤولين عن إصدار النشرة وذهب إلى أحمد الحضري يشكو كيف يسمح لي بنشر هذا المقال. وقد علمت أيضا أن صبحي شفيق تصور وقتها أن هناك من أراد أن يكيد له من بين المشرفين على نشرة نادي السينما، عن طريق نشر هذا المقال، أو ربما “التحريض” على كتابته أيضا. وربما كان قد تصور أيضا أن المقال مقدمة تبرر منع الفيلم الذي وقع بالفعل، فقد واجه الفيلم رفضا من جانب القائمين على مؤسسة السينما، التي أنتجته.
كانت مجموعة من الشباب من هواة السينما، وكنت من بينهم، قد بدأت تظهر، وبدأنا ننشر مقالاتنا في نشرة النادي، ونكافح في سبيل نشر ما نستطيع دون أن يمسه “مقص الرقيب” الذي كان يتمثل وقتها في “اللجنة الثلاثية”، التي كان أعضاؤها يتغيرون من وقت إلى آخر، لكن لأن الفترة كانت مشحونة بالاضطراب والقلق والاحتقان السياسي، كان هناك تخوف من أن ُيتخذ بعض ما ينشر في تلك النشرة، مبررا لإغلاق النادي نفسه بدعوى أنه ضد نظام السادات، وكان السادات ومعاونوه، يتشككون في المثقفين عموما، خاصة بعد البيان الشهير الذي صدر عام 1972 ووقعه عدد من ألمع الأسماء في المجال الثقافي على رأسهم توفيق الحكيم وحسين فوزي وأحمد بهاء الدين، وأرسلوه إلى السادات، في مرحلة اللاسلم واللاحرب، وفي مناخ شهد اعتصامات الطلاب واحتجاجاتهم العنيفة ضد نظام بدا متراخيا لا يريد أن يواجه العدو الرابض في سيناء منذ نحو ست سنوات، تحت دعاوى وتبريرات مختلفة. وكانت نتيجة ذلك البيان طرد 111 صحفيا وكاتبا من أعمالهم.
جاء صبحي شفيق ذات مرة إلى مركز الثقافة السينمائية في شارع شريف حيث مقر “جمعية نقاد السينما المصريين”، التي كنت قد أنضممت إليها عام 1974، وكان صبحي على ما أتذكر أحد مؤسسيها، أي من “العشرة الكبار”. وكان من الواضح أنه منفعل بسبب الأصداء السلبية التي حققها عرض فيلمه، خاصة وقد صدر قرار بمنع عرضه. وقد رأيته منشغلا في مناقشة مع ناقد معروف، أخذ يكيل فيها الاتهامات للنقاد الشباب الصاعدين من أبناء جيلي، ويصفهم بأنهم أبناء البورجوازية الصغيرة الباحثين عن “تحقيق الذات” أو شيء من هذا القبيل، كما أطلق تعبيره الذي لا أنساه، عندما وصفنا بأننا “فريق الكشافة” في جمعية النقاد!
هذا التعبير الطريف الذي أضحكني كثيرا، سأعود بعد مرور أكثر من ربع قرن، لكي أذكر صبحي شفيق به كلما كنت ألتقي به ويدور بيننا حديث أو آخر، فقد كنت أتوقف وسط الحديث عادة وأقول له معابثا: فلتغفر لنا.. فلازلنا في فريق الكشافة!
وكان لصبحي تعبير آخر لا أنساه، قاله أمامي ذات مرة في جمعية النقاد في معرض مناقشة فيلم “زائر الفجر” وما حل به من منع، فصبحي، على العكس من جميع النقاد، لم يكن معجبا بالفيلم، ولم يجد فيه ما وجده معظمنا وقتذاك من جرأة وبراعة فكرية فنية، وفي معرض السخرية من الفيلم ومن المعجبين به، قال إن بطلتنا “الثورية” (أي بطلة الفيلم التي كانت تقوم بدورها الممثلة الراحلة ماجدة الخطيب) ماتت خوفا “من قطة” هاجمتها فوق سلم العمارة التي كانت تقيم بها، فكيف نريد تغيير المجتمع والدنيا وبطلتنا خافت من قطة فماتت!
كانت السخرية مريرة بالطبع، لأن المفترض أن الصحفية، بطلة الفيلم الثائرة على الواقع وما يحدث فيه من تجاوزات، قُتلت، بسبب موقفها السياسي، أو أن هذا على أي حال، محور أحداث الفيلم الذي يقوم على “التحقيق” في مقتل الصحفية نادية الشريف، وهل ماتت بنوبة قلبية أم بفعل فاعل.
كنا وقتها نشتعل بالثورة والغضب والرغبة في تغيير البلد والدنيا والعالم، مبهورين بفيلم يشير بإصبع الاتهام بصراحة وجرأة لم تطرح من قبل في السينما المصرية، إلى نظام فاسد وظالم. وجاء الفيلم الذي منع على الفور من العرض، لكي يقدم لنا نموذجا لبطلة ثورية هي التي سخر منها صبحي سخرية مريرة، ومن إعجابنا بها!
فيلم “زائر الفجر”
عرض فيلم “زائر الفجر” للمخرج الراحل ممدوح شكري في عرض أول قبل العرض التجاري العام في يناير 1973 في جمعية الفيلم ثم عرض في نادي القاهرة للسينما.
في الخارج، أي خارج جمعية الفيلم ونادي السينما، كانت الحركة الطلابية في قمة المواجهة مع نظام السادات. وقد ظهر فيلم “زائر الفجر” في تلك الأجواء، وكان يعبر أفضل ما يمكن، عنها، وفيه يصور ممدوح شكري ببراعة وحساسية خاصة، مجتمع الهزيمة من خلال دراما معقدة مدخلها هو التحقيق في مقتل صحفية شابة متمردة، كانت تحاول أن تفهم لماذا حدث ما حدث ومن المسؤول عما وصلت إليه البلاد من تدهور على مستوى البنية التحتية، وأصبحت أجهزة الأمن تلقي بوطأتها الثقيلة على حياة الناس، تتجسس عليهم، وتصفي حساباتها معهم، وصولا إلى القتل، مع كل من لا يعجبها سلوكه، أو بالأحرى مع كل من يغرد خارج السرب، ويسعى لمعرفة الحقيقة.
وكان وكيل النيابة الشريف- عزت العلايلي- يسعى بكل ما يمكنه من جهد، للوصول إلى الحقيقة وراء مقتل الصحفية، رافضا الانصياع للضغوط التي تمارس عليه من أعلى الجهات لإغلاق التحقيق، تماما مثل المحقق (فرانكو نيرو) في الفيلم الإيطالي “انتهى التحقيق المبدئي.. إنس الموضوع” لداميانو دامياني.
كانت أحداث الفيلم تدور في مجتمع ما بعد الهزيمة مباشرة، أي في العهد الناصري، وكان الفيلم يدعو بوضوح إلى التغيير، ويتساءل حول مسؤولية ما وقع من هزائم ونكسات، ويربط بين الهزيمة العسكرية في سيناء، والقمع وغياب الديمقراطية في الداخل، بل ويبدي تعاطفا واضحا مع القوى الثائرة التي تحمل الهم الوطني على عاتقها. وفي الفيلم يقوم شكري سرحان بدور لا يمكن نسيانه أبدا، هو دور المناضل الوطني الذي يعيد إحياء خلية نضالية مع رفاق الماضي من أجل استئناف النضال بعد أن أدرك أن منطق “تفويض الزعيم” نيابة عن الشعب قد فشل ولم يؤد سوى إلى الكارثة التي وقعت.
ولاشك أن الفيلم في بنائه الذي يعتمد على اعادة رواية ما وقع من وجهات نظر متعددة، كان متأثرا على نحو كبير، ببناء فيلم “زد” Zلكوستا جافراس، الذي كان قد ظهر قبل ذلك بفترة قصيرة وحقق أًصداء هائلة ومنعته الرقابة من العرض في مصر تخوفا من تأثيره الكبير على طلاب الجامعة الثائرين.
ولاشك أيضا أن الأصل في هذاالبناء المركب، الذي اقتبسه كاتب سيناريو الفيلم، الدكتور رفيق الصبان، وفكرة استعادة الأحداث من وجهات نظر عدة، تأتي منفيلم “راشومون” Rashmonالعظيم للمخرج الياباني أكيرا كيروساوا.
وقد منع فيلم “زائر الفجر” من العرض العام بعد أيام من عرضه بسبب قوة تأثيره وحساسية الفترة واهتزاز الوضع السياسي.
ولاشك أن منع عرضه ثم تشويهه، كان ضربة شديدة الوطأة لمنتجته ماجدة الخطيب. وقد تعرض ممثلوه أيضا لنوع من “التحذير” من جانب الأجهزة الأمنية، لأن الفيلم في مضمونه كان “ساخنا” بالفعل، وكانت تتردد فيه عبارات تقول على سبيل المثال: البلد دي ريحتها فاحت.. عفنت.. بقت عاملة زي صفيحة الزبالة.. لازم تتحرق”!
وكان الفيلم ينتهي على طريقة الأفلام السياسية الايطالية بصدور أوامر عليا، بنقل وكيل النيابة وإغلاق الملف، والافراج عن المشتبه فيهم، دلالة على أن النظام أقوى من الأفراد مهما كانوا، وأن محاولة الإصلاح من داخل النظام نفسه لا تجدي.
كان “زائر الفجر” هو الفيلم الثاني لمخرجه ممدوح شكري بعد فيلمه الأول “أوهام الحب” (1970)، وبعد اشتراكه في اخراج فيلم مكون من ثلاث قصص. وكان “زائر الفجر” قفزة نوعية كبيرة في الأسلوب واللغة والبراعة الحرفية في تنفيذ المشاهد والسيطرة على أداء مجموعة كبيرة من الممثلين شاركت في الفيلم منهم سعيد صالح ورجاء الجدواي وتحية كاريوكا ويوسف شعبان وعايدة رياض ومديحة كامل وزيزي مصطفى وجلال عيسى بالاضافة بالطبع إلى شكري سرحان وماجدة الخطيب وعزت العلايلي.
وكان الفيلم أخيرا، أحد الأفلام “الثورية” السياسية النادرة في تاريخ السينما المصرية، وكان منطقه من القوة بحيث جعل السلطات تخشى من تأثيره الكبيرالمحتمل على الجماهير.
وقد أدى منع عرض الفيلم إلى إصابة مخرجه ممدوح شكري بالاكتئاب لفترة، مما جعله يهمل في صحته فأصيب بمرض حاد نقل على أثره إلى مستشفى الحميات حيث صعدت روحه إلى بارئها قبل أن يشهد التصريح بعرض فيلمه ولو مبتورا.
* جزء من الفصل الثالث من كتاب “عصر السينما”