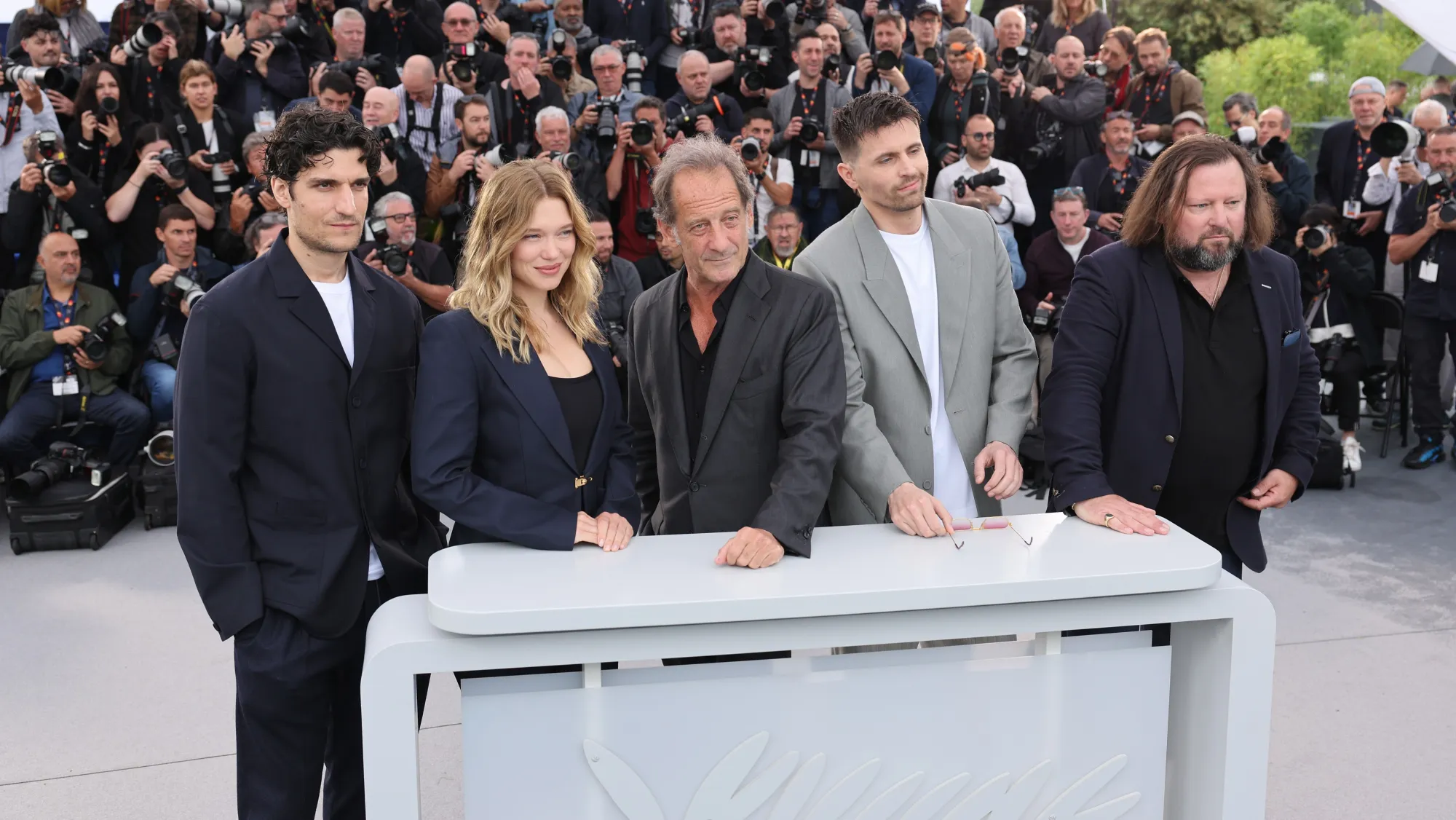“ثلاث قصص” سينما القصص المُتعدَّدة
 من قصة "إفلاس خاطبة"
من قصة "إفلاس خاطبة"
أوَّل ما سيقابلنا في تجربة “ثلاث قصص” اللطيفة البارعة هو شارة البداية التي صنعتها “نوال” والتي تستطيع أنْ ترغمك على متابعتها، بمصاحبة موسيقى “فؤاد الظواهري”. ثم سيبقى أمامنا جسد هذه التجربة التي تقوم على تقديم ثلاثة أفلام قصيرة في شريط سينمائيّ واحد قُدِّم عام 1968. كلُّ منها له شارة بداية تحمل اسم كاتب القصَّة -وكلُّها أفلام مُحوَّلة عن قصص قصيرة-، واسم مؤلِّفها الفيلميّ ومُخرجها ومُمثِّليها. ثلاثة أفلام لا يربط بينها أيّ شيء؛ فكلٌّ له تصنيف مختلف. وقبل تناول التجربة سنلقي معًا ضوءًا على مزايا هذا النوع.
مثل هذه التجربة قليلة في السينما المصريَّة والعربيَّة لكنَّنا إذا فكرنا فيها بهدوء سنجد أنَّها تجارب ينبغي على صُنَّاعنا أنْ يُكرِّروها لا أنْ يهملوها. ففيها بعض المميزات مثل كونها تجربةً مختلفةً وهذا الاختلاف بحد ذاته يصنع آفاقًا جديدةً للصانع والرَّآئي في الوقت نفسه، ويعطي الفُرصة لفتح زاوية نظر جديدة في العمل السينمائيّ. بل إنَّ الإكمال في هذا النمط سيتيح وجهات نظر مختلفة عن وجهات النظر وزوايا الرؤية التي يتيحها الفيلم الاعتياديّ.
وفيها أيضًا تنويع مفيد لإمتاع المُشاهد؛ فإذا فقد شغفه بأحدها فهناك غيره مِمَّا قد ينتظره، وكذلك فهناك ابتداءً تصنيفات مختلفة في شريط واحد -كما سنرى بعد- هذا بالقطع إنْ اختار الصانعون أنْ ينوِّعوا من تصنيفات الأفلام، فقد تكون جميعها تحت مظلَّة واحدة بل تتناول موضوعًا واحدًا. ومن ناحية الصانعين فهذه النوعيَّة -متعدِّدة الصُّنَّاع- تعطي فرصة لعدد أكبر من صنَّاع الفيلم، وكذلك تعطي أملاً في تحويل رغبة الكثير من الصنَّاع المغمورين إلى حقيقة بتلافي خسائر أكبر قد تقع عند تنفيذ العمل بخُطَّة الفيلم الاعتياديّ. ويكفي أنْ نعلم أنَّ هذا الفيلم أعطى فُرصًا لكثير من شباب المُمثلين -أقصد وقتها- مثل الفنان الكبير “محمود ياسين”، والفنان الكبير “رشوان توفيق”، وغيرهما.
الفيلم الأوَّل: “دُنيا الله”
الفيلم في الأصل قصَّة شهيرة للأستاذ “نجيب محفوظ” واسمها قد أُطلق على إحدى مجموعاته القصصيَّة. حوَّلها إلى الفيلميَّة عبد الرحمن فهمي، وأخرجها إبراهيم الصَّحن. وكانت من بطولة: صلاح منصور، ناهد شريف، ملك الجمل. وتمحور حول تصنيفَيْ دراما، جريمة.
القصَّة تدور حول فرَّاش يقترب من المعاش في إحدى هيئات الحكومة. يضغط على أعصابه فكرة اضطهاده من الدنيا نفسها، وقلَّة حظِّه منها وأنَّه يحسُّ باقتراب أجله ولمْ يهنأ في دنياه أبدًا. وكلُّ أمله في الحياة أنْ يتمتع بملذَّات الدنيا كما ينعم البقيَّة شهرين أو ثلاثة. يعيش هذا الفراش تحت ثلاث من جهات الضغط؛ الأولى هي أسرته فيها امرأته التي كبرت في السنّ مع بعض رغباته المكبوتة وابنَيْه اللذين لا يُعيران والدَيْهما اهتمامًا، والثانية هي الوظيفة التي يرى فيها كثيرًا ممَن لا يستحقون العمل فأحدهم لا همَّ له إلا التنزُّه مع أهله، وآخر مُهتمٌّ بابنة الجيران التي تظهر من شباك الوزارة، وآخر كلُّ همِّه الحصول على أموال من زوجته الغنيَّة. وجميعهم لا يهتمون أصلاً لأمر العمل وهو الكادح الذي لا يجد وقتًا من كثرة أعباء العمل.
وثالث جهات الضغط هي بائعة يانصيب -في القصَّة ابنة سبعة عشر عامًا- تثير فيه كلَّ همومه، وتتمثَّل فيها كلّ رغباته. هذه الفتاة تمثُّل نقطة التمحور المشاعريّ والفكريّ عند الفرَّاش. وهذه العمليَّة تحدث كثيرًا خاصَّةً في الوسط الذي لا فكر له ولا تأمُّل. فيمحور رغباته حول شيء، ويدعِّمه بتمثيل مشاعره وأفكاره كلَّها حول هذا الشيء. وهو في الحقيقة ليس كذلك. لكنَّ الذهن الخالي من سلوك التأمُّل ينحو نحو “تجسيد” الأمل ليراه مُتحقِّقًا أمام عينيه، وليستطيع أنْ يجد ما يريد الوصول إليه. هذه العمليَّة من تجسيد وحشد كلّ نواحي روح الفرَّاش تمثَّلت في تلك البائعة. ويعرض الفيلم فيما بعد ماذا سيفعل الفرَّاش في سبيل تحقيق لذَّة الدنيا ولو قليلاً.

وقد أخلص السيناريو والحوار للقصَّة الأصيلة، وقد صنع فيلمًا ناجحًا وحوارًا فعَّالاً حقيقةً. لكنَّ المؤلف الفيلميّ لمْ يستطع الوصول إلى المعنى الذي أودعه “نجيب محفوظ” في قصَّته. فالقصَّة مليئة بأمور بثَّها نجيب من طرفٍ خفيٍّ، وحملت الكثير من عالمه ومن فكره الذي يريد إظهاره -أو فلنَقُلْ الذي يريد إضماره في الحقيقة-. ويكفي أنْ نقرأ المقطع الأخير من القصَّة لنعرف الفارق الكبير بين أغراض الكاتب وغرض السيناريست. ولا يعني هذا أبدًا نقصًا في تأليف الفيلم؛ فالمؤلِّف نجح في اختيار وجهة من وجهات نظر القصَّة -وهي الوجهة الظاهرة المُتمثِّلة في المادة وتوزيعها الطبقيّ، فضلاً عن جانب الحوار الذاتي للفرَّاش-، وركَّز عليها ونجح في تقديمها للمُشاهد بسهولة بل بألمعيَّة.
أمَّا نجاح الفيلم الظاهر فأتى من عمل المُخرج “إبراهيم الصحن” الذي نلخِّص عمله في إخراج واقعيّ مستوٍ، وتوجيه وانضباط وسيطرة على وجهات التمثيل، ومغايرة نمط الإخراج في تمثيل الخوالِج الداخليَّة لشخصيَّة البطل من خلال صُنع مشاهد سيطرت عليها الموسيقى وحدها، ومشاهد اكتف فيها بتبادُل الحوار الخارجيّ الظاهر مع حوار داخليّ للفرَّاش في نفسه، ومشهد استخدم فيه تقنيات مونتاجيَّة على خلفيَّة سوداء ليصوِّر مصير حياة الشخصيَّة في نهاية الفيلم. وبالعموم هو أفضل الأفلام الثلاثة.
ولا يمكن إغفال جهة التمثيل وتأثيرها البالغ في نجاح الفيلم كوحدة فنيَّة. ولعلَّ أبرع الأداء أتى من الممثل البارع صلاح منصور، ومدى قُدرته على تجسيد خوالج شخصيَّة الفراش، ونوازع نفسه. ويتجلَّى هذا التمثيل البارع في نجاح أدائه للكبت النفسيّ الجامح وفي الانفراج النفسيّ الجامح أيضًا، وكذا في رحلة النهاية التي مثَّل فيها تعقيد المعاني. وكذلك براعة أداء مَلَك الجمل في دور زوجة الفرَّاش رغم قلَّة مشاهدها.
الفيلم الثاني: “خمس ساعات”
الفيلم في الأصل قصَّة “يوسف إدريس”، من مجموعة “أرخص ليالي”، سيناريو وحوار بكر الشرقاوي، إخراج حسن رضا. بطولة: رشوان توفيق، نادية لطفي، محمود المليجي، محمد الدفراوي، حمدي أحمد. وتمحور حول تصنيفَيْ إثارة، تشويق.
الفيلم يتناول قصَّة خمسٍ من الساعات مضت في مشفى “القصر العينيّ”. أجريت فيها عمليَّة لأحد الضبَّاط في الجيش الذي تعرَّض لإطلاق نار عليه من البوليس السياسيّ. وواضح من الفيلم أنَّ الأحداث سبقت أحداث عام 1952؛ حيث يحاول البوليس السياسيّ الموالي لمَلِك البلاد تحجيم ضبَّاط الجيش وحركتهم قبل حدوثها. والقصَّة في الأصل كُتبتْ عام 1952 في حادثة حقيقيَّة حدثت لـ”يوسف إدريس” نفسه.
ولعلَّنا نرى من القصَّة الحماس الشديد للحركة الجديدة. والحماس الشديد إنَّما أتى من كاتب القصَّة الرئيس. فإدريس كاتب حماسيّ تحرِّكه عواطفه بشدَّة، ولعلَّنا نرى هذا من انقلاب التأييد البالغ لحُكم الحقبة تلك إلى سخط بالغ وحنق لا يوصف بعد الهزيمة الساحقة التي تلقَّاها عام 1967. وهذا يبدو من قراءة إنتاجه القصصيّ بعده وغالبها قصص رمزيَّة جيِّدة. وعلى العكس نجد هذه القصَّة تمثِّل تصفيقًا لا أكثر للحركة الجديدة.
تبدأ الاحداث بإطلاق نار من ضابط شرطة على ضابط جيش، ثمَّ ينقل جسد الرجل مُصابًا إلى المشفى حيث يتصدَّى للعلاج الطبيب الشاب ومُساعدته. وسرعان ما يجد رجُلَيْن يبدو على أحدهما البهاء والسطوة يطلبان منه الحديث على انفراد ويكتشف أنَّه يطلب منه ترك الضابط ليموت دون علاج، أو علاجه بشكل وهميّ حتى يموت. وهنا يقع الطبيب الشاب في حيرة شديدة بين تنفيذ رغبة مَن هم الأقوى في البلاد أو تنفيذ عمله ذي الطبيعة الإنسانيَّة التي تأبى مثل تلك الرغبة. ونكتشف في بقيَّة الفيلم قرار الطبيب وما سيأتي من أحداث.

وقد قام بكر الشرقاوي بتعديلات على جسد القصَّة وإدخال عدد من الشخصيَّات، وتوضيح زمن القصَّة ووجهتها -والتي لمْ يكُنْ مُصرَّحًا بها في القصة إلا من إشارة- وأكمل جسد الفيلم ليصير عملاً يقبل مبدأ الحَكْي السينمائيّ. وقد قام المخرج بأداء طبيعيّ ليس فيه تميُّز إلا من آخر لقطة في الفيلم حيث يبدو انتصار البوليس السياسيّ واضحًا لكنَّه يقوم بقلب الكاميرا رأسًا على عقب ليُوضِّح العكس. وبالعموم هو أقلّ الأفلام قيمةً فنيَّةً وقدرًا.
الفيلم في الأصل قصَّة “يحيى حقِّي”، من مجموعة “أمّ العواجر”، سيناريو وحوار إسماعيل القاضي ومحمد نبيه، والأخير هو المُخرج. بطولة: عبد المنعم إبراهيم، عبد المنعم مدبولي، أبو بكر عزت، سميحة أيوب، نبيلة السيد، ليلى طاهر. وتمحور حول تصنيفَيْ كوميديا، دراما.
يدور الفيلم في إطار اجتماعيّ غاية في اللُّطف حول “فوَّاز عبد العزيز” الذي يبحث عن عروس بعد سنوات قضاها في عمله في السودان جمع فيها الأموال، وتجهَّز بالمنزل المناسب المُرتَّب. ولا ينقصه إلا العروس التي نرى طوال دقائق الفيلم محاولات إيجاده إيَّاها مع الخاطبة التي أتى بها صديقه للمساعدة في إيجاد خيار مناسب.
الفيلم الثالث: “إفلاس خاطبة”
أحدث المُؤلِّفان الكثير من التعديلات والزيادات على قصَّة “يحيى حقِّي”. فمثلاً بدأ الفيلم مع “فواز” والقصة مع صديقه -يحيى حقِّي-، ولعلَّهما غيَّرا اسمه من “عبد العزيز فوَّاز” إلى مقلوبه للسهولة. وأضافا قصص العروسات اللاتي قابلهنّ البطل، وأضافوا بُعدًا معنويًّا في قصَّة “ليلى طاهر” لمْ يكنْ موجودًا في القصة أصلاً بل يكاد يخالفها. كما غيَّروا من أوصاف الخاطبة وقصَّتها ومكانها.

كلُّ هذه التغييرات صاحبها إخراج كوميديّ بامتياز استطاع الاستفادة من كلّ معطيات مُكوِّنات الصورة. وقد استطاع إدخال الرسم الكرتونيّ الثابت مع الصورة الحقيقيَّة. واعتمد على مهارة كلّ الممثلين في توليد كوميديا صافية رائقة تستحق المتابعة. ولنا في مشهد “أبو بكر عزَّت” وهو يصف لـ”عبد المنعم إبراهيم” مضارَّ الزواج مثال واضح لهذه الكوميديا. وهنا أيضًا قد يسترعي انتباه المُشاهد جمال الشارة وبراعتها في توصيل الفكرة مع الإضحاك واللُّطف، كما يُحسب للمُخرج توقيت إدخاله للشارة عند أوَّل لقطة لسميحة أيوب في دور الخاطبة.
كانت هذه إحدى التجارب التي تستحق الاهتمام وتسليط الضوء عليها؛ لعلَّها تكون دافعًا لصُنع أعمال جيدة أخرى مثلها وأفضل منها.