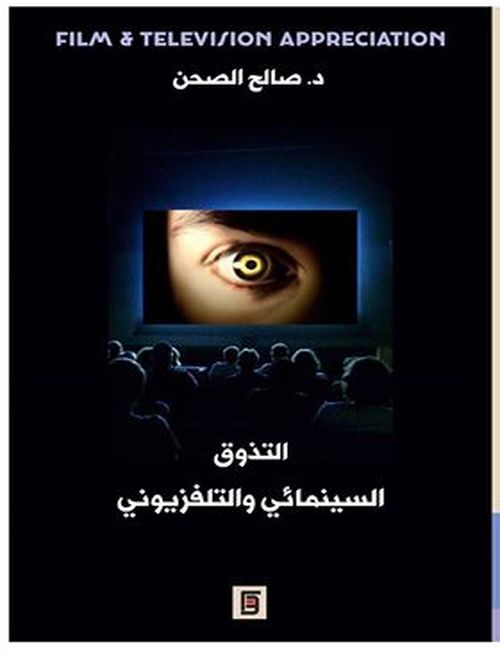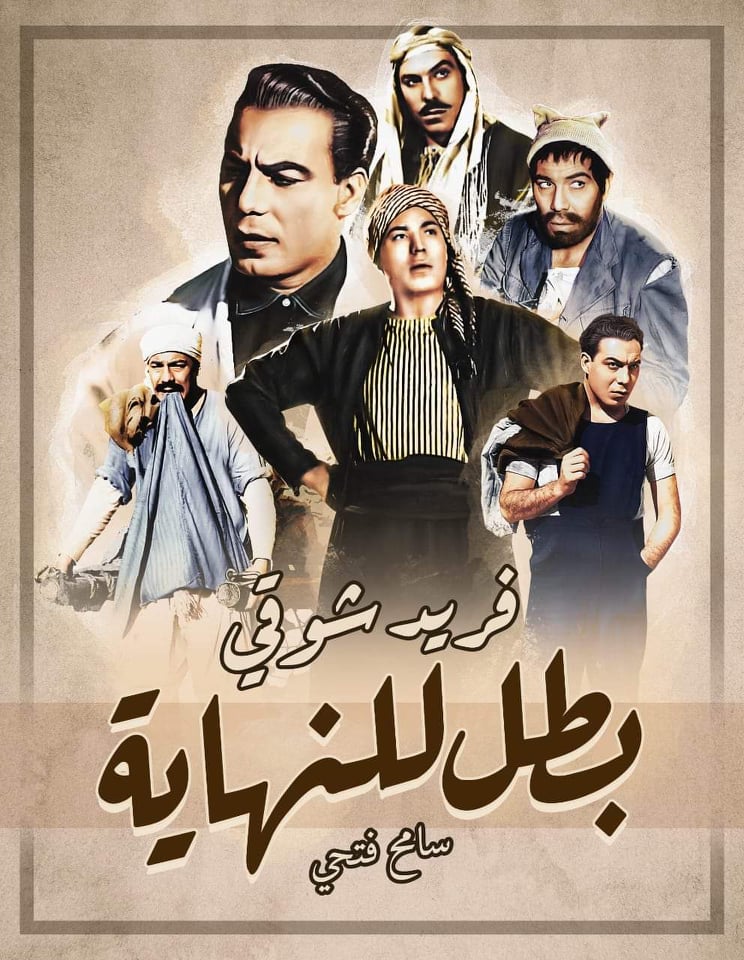واقعية بلا ضفاف: قراءة في كتاب قيس الزبيدي

عن وزارة الثقافة الفلسطينية لسنة 2017 صدر كتاب “الفيلم التسجيلي.. واقعية بلا ضفاف” للكاتب والمخرج السينمائي قيس الزبيدي، والذي أطلق فيه بعضا من تصوراته وأفكاره الفلسفية عن الفيلم التسجيلي وتجاوزه لحدود الضفاف التي تحيطه وتحدده، باعتباره الجنس السينمائي الإبداعي، الذي امتد لحدود أوسع من الآفاق والتداعيات الأكثر تعاملا مع الواقع وعالم الحقيقة والتي قد تلامس الخيال أحيانا.
بعد رحلة من الخبرة والمعرفة والبحث والتقصي عن أصول المفاهيم والأفكار الواردة من كبار الباحثين والمفكرين وتجارب المخرجين العالمية، يطل علينا ا الزبيدي بمنجزه المعرفي الجديد الغني بالأفكار الصادرة عن خبرة واسعة. كتاب في ثمانية فصول، ذهب فيه إلى التعريف الدقيق الإجرائي لمعنى (تسجيلي) والى أي مدى يتصل بالوثيقة كوثائقي، وما هي مثابات الفصل بين الفن والواقع، وبين الحقيقة والخيال؟ وناقش المشهد في الواقع وجدلية العين والإذن وفيلم العلوم والمعارف والايدولوجيا والفيلم، وكانت تحليلات الكاتب وتوصيفاته المعرفية دقيقة وعميقة لبيان مدى علاقة (المصطلح) بالحرفة والميدان كوسيط يراد له أن يكون تعبيريا في حقل السينما.
وقد تناول كذلك في فصله الثامن الأسئلة التاسعة التي تطرقت إلى قضايا فلسفية في أصول الفيلم التسجيلي وجنسه السينمائي والخاصية التي يتمتع بها، وما يحمل من إعادة بناء بين الواقعي والخيالي ومستوى الحساسية الفنية التي يتوجس البعض منها في أسبقية التصوير أم المونتاج، بالإشارة إلى الأساليب الإخراجية التي اعتمدها كبار المخرجين العاملين وعدد من المدارس والاتجاهات الفنية في السينما.
يبدأ الكاتب من الأخوين لوميير (أوغست ولويس) وكيف انبثق الفيلم التسجيلي/ الوثائقي من رحم تجاربهما الأولى بعد أن ذهب إلى القواميس الفرنسية لضبط أصول المصطلح وجذوره اللغوية والمعرفية والمنحدرة من 1214documentum اللاتينية بعد أن اكتسب مصطلحه الدقيق، الذي تخلى عن سمة الخيال عام 1915؟
عمد الكاتب الزبيدي إلى إضفاء التجربة الغنية المتميزة للمخرج جون جريريسون الذي أسس المكتب القومي الكندي لإنتاج الأفلام التسجيلية والذي أطلق فيه المصطلح بشكل صريح على فيلم “موانا” للمخرج فلاهرتي.
ومنذ ذلك الوقت 1926 عرف الفيلم التسجيلي الوثائقي بأنه “معالجة خلاقة للواقع”. كما ذهب الزبيدي أيضا إلى زوايا من المعرفة والتصورات الذهنية العميقة وتساءل كثيرا عن التيار الفني والمدارس والاتجاهات وهل يمكن أن يستقل الفيلم التسجيلي بجنسه وتسميته وشكله المختلف عن بقية الأفلام؟ والى أي مدى يستطيع أن يحتفظ بجماليته ومدى عمق صلته بالواقعية دون الافتراضية؟ وكيف يستطيع التعامل مع المادة الخام وتحويلها إلى فن؟ وشخص بعضا من هذه الاتجاهات محددا الفرق بين واقعية لوميير وخيالية ميليس بعد أن بين كيف إن الحكايات تختلف فخيالية تعتمدين التسجيلي اللاخيالي والجنس الروائي الخيالي: الأول – حسب كراكاور – يبحث عن حكايات واقعية لا يجوز لأحد اختلاق حبكتها بل تكتشف من الواقع نفسه. والثاني يبحث عن حكايات خيالية تعتمد على حبكة مختلقة.
وقد جرت نقاشات معقدة حول أين يمكن للحدود أن تتقاطع بين الخيال واللا خيال والى أي حد يجوز للفيلم الروائي/ الخيالي أن يكون تسجيليا والى أي حد يكون للفيلم اللا خيالي أن يكون تمثيليا؟

من فيلم “موانا” لفلاهيرتي
ولكنه لم ينس أن بعض الأفلام الروائية الخيالية تحتوي أيضا على جوانب تسجيلية مستعينا بمنظر الفيلم التسجيلي بيل نيكولز، ويصف الزبيدي المخرج الرائد فلاهرتي بأنه جان جاك روسو أي الفيلسوف الذي أعاد كتابة العقد الاجتماعي في السينما وهو عراي السينما التسجيلية ونموذجا في صناعة السينما المستقلة.
أما جون جريريسون فيعد الأب الروحي للسينما التسجيلية وان اوغوست لوميير هو المخترع الوحيد للسينماتوغرافية الذي اعتمد على اللقطة والمشهد والتأطير الفني لأفلامه وإعادة تجسيد الحياة. ويعد ميليس ساحر السينما، عندما حظر العرض السينمائي الأول يوم 28 ديسمبر 1895 فأنه اكتشف حينها قدرة السينما على سرد قصص خيالية كأول فنان خيالي يعيد بناء قصصه الخيالية في مناظر مسرحية مُمثلة وقد نعته شابلن وسماه كيميائي الضوء واعترف غرفث بدوره قائلا: أنا أدين له بكل شيء. وقال غودار أنا أرى إن لوميير، التسجيلي الواقعي، قدم اللامعقول في المعقول وميبليس، الروائي الخيالي، قدم المعقول في اللامعقول.
ونرصد نافذة الزبيدي التي يرى بها الأشياء بوصفه مخرجا محترفا وذا تجربة غنية وله الخبرة في معرفة فلسفة الصورة واللقطة والمشهد والى أي مدى يمكن الفصل بين الفن والواقع وما يتمتع به الفيلم من حركة وخلق عالم مرئي يبوح بما يحاكي مجسات الواقع ويذهب في الخيال بعيدا عن المحتمل والمتوقع والافتراضي، باحث ذو خزين من المعرفة والخبرة ويجيد فن صناعة استمرارية التركيب لفهمه الواسع بنظرية الدراما وأسس البناء الفيلمي.
في فصل افتراضي عن ندوة متخيلة يطلعنا الزبيدي على آراء وأفكار قيلت في أوقات سابقة مختلفة زمنيا في مهرجان لايبزغ للأفلام التسجيلية عبر عنها كبار منظري الفن التسجيلي أمثال البرنو كالفالكانتي وجون جريريسون وبول روثا ويوري ايفينز أما دزيغا فيرتوف فقد أشير لأفكاره وطروحاته في الندوة بإدارة الكاتب ذاته.
تميز كافالكانتي ببحثه عن الشعر في عالم الكاميرا وشعر الواقع إذ يقول (إن أفلامي التسجيلية كانت تنحاز دائما إلى جمالية الفيلم الروائي) بينما نقب جريريسون في جذور حركة الفيلم التسجيلي ووجدها في طبيعة الكاميرا وإمكاناتها من عام 1898 رغم اختلاف الأساليب والطرق التي سلكها العديد من المخرجين.
وهناك دزيغا فيرتوف الذي قدم طرق تصوير معينة مكنت تصوير الشيء من موقع الطائر أو من موقع الضفدعة ومن زوايا نظر مختلفة ومتنوعة فيما أخذت الكاميرا دور المراقب بنبض جديد في المانيا من خلال (مورناو) وأمريكا عن طريق (فلاهرتي) الذي قال يوما ما (في البداية كنت مستكشفا) بوصفه من وضع المبادئ الأولى للسينما التسجيلية.
ويصعب على بول روثا أن يضع فارقا بين الفيلم التسجيلي وبين الفيلم الروائي. فقد انصب على الموضوع وطريقة تصويره وأسلوب إخراجه وان كل فيلم تسجيلي يجب أن يمتلك تصورا دراماتورجيا فيما يدعو (يوري ايفنز) في الفن إلى عدم الفصل بين السياسي والجمالي ويسمح بالعلاقة بين ما هو مادي وجمالي. ذلك ان العمل هو حصيلة تركيب مما هو شعري وعاطفي والتزام اجتماعي.
ايفنز الذي قال عنه ارنست همنغواي (ايفنز ليس مخرجا موهوبا فقط بل انه شاعر أيضا) فهو صاحب فيلم الأرض الاسبانية الذي برهن فيه على إن الفن يمكن أن يكون فيلما وبنفس الوقت يمكن ان يكون حقيقيا. ونكتشف في حروف الكاتب الزبيدي نكهة من خلاصة تجربته المرموقة في صنع الأفلام التسجيلية معززة بالمزيد من التصورات والرؤى الفكرية والجمالية في لغة السينما وعالمها الفلسفي، إذ يقترب إلى حد قريب من نظرته وعقيدته المرئية من قول المفكر جيل ديلوز (مع السينما يغدو العالم صورته الخاصة، وليس صورة تغدو هي العالم) ذلك إن الزبيدي بمنهج يسعى لبلوغ الجمال والفكر والمعرفة، ويبحث عن امثل السبل للوصول إلى هدفه ومسعاه، مسترشدا بديكارت وإطار فلسفته التي تقول (لا يكفي أن يكون الفكر جيدا، المهم أن يطبق تطبيقا حسنا) وإزاء هذا الاعتقاد، يقرب الكاتب من الاتجاه الشكلي ودوره الفاعل في تعظيم المضمون.

أندريه بازان
ويشير صاحب الواقعية بلا ضفاف في الفيلم التسجيلي إلى أن رولان بارت في نظرته إلى الفوتوغرافيا والسينماتوغرافيا، يراهما نتاج ثورة صناعية ولا ينتميان إلى أي ارث أو أية تقاليد ،وعلى المرء أن يبتكر علم جمال يهتم بالفيلم والصورة الفوتوغرافية ويميز بينهما ويعمل في الواقع بقيم أسلوبية ذات نمط واقع مرئي وليس أدبي،وهو ذات الحال الذي وجده الزبيدي عند هنري اجيل بان السينما هي فن الواقع وهي نقل الحقيقة الظاهرة بأمانة وحقيقة وعلى مرمى آخر من الرؤية الخاصة بارنهايم التي رفضت استنساخ الواقع بصورة قسرية وان ما يتوفر من إمكانات تعبير إنما تنشا من وفرة التحويرات القائمة، فيما ربط الزبيدي أصل الفكرة بأسئلة اندريه بازان التي رفض فيها إقامة المعادلة البسيطة بين الفيلم والواقع، كما فعل كراكاور الذي دعا إلى إقامة العلاقة الدقيقة بينهما، بحيث يكون فيها الفيلم هو الخط المقارب للواقع، الخط الوهمي الذي يقترب منه المنحنى الهندسي دون أن يلامسه أبدا.
وفي قوله المعروف (انطولوجيا الصور الفوتوغرافية، يمكن التوقف باهتمام كبير عند الأسئلة التسعة التي أطلقها الزبيدي في الفصل الثامن من الكتاب والتي كانت ظلالا لأجوبة الفيلسوف فرانسوا نيني وهو المخرج والناقد والمحاضر في المعهد العالي والكاتب في مجلة دفاتر السينما وعلم الجمال في كتابه (الفيلم التسجيلي وحججه) الذي تناول إطلاق خمسين سؤالا عن النظرية والممارسة التسجيلية، فقد حلل معنى الصورة ومعنى اللقطة والفرق بينهما، فالصورة هي علامة، نسخة مطبوعة، رسم، ايقونة، لوحة، رسم بياني، مخطط بياني ،شكل هندسي، تصميم مخطط، فانوس سحري، رسم متحرك، فوتوغراف فيلم فيديو شريحة، صورة كومبيوتر، وتختلس الصورة النظر بين العين والعدسة عنها وتسجل اشياء واحداثاً بمادة بصرية تسمى اللقطة السينمائية التي يقول عنها كريس ماركر (بدلا من إنسان ميت، تجعله الكاميرا خالدا لا يموت)، وجان ميتري الذي يصف (جوهر اللقطة بأنه حيازة للحياة)، أما الفيلم فهو العالم الذي تعرضه الحكاية، وان السمة التسجيلية في الفيلم هي ذاتها درامية الطبيعة والحياة بحسب اندريه بازان.
ويستمر الكاتب في رحلته المعرفية التحليلية مقارنة في معطيات إعادة البناء في التسجيلي الذي حدده بستة إشكال وهي المقابلات، المسرحة الدرامية للشهود العيان، التعليق، إعادة السرد من خلال الوثائق، الخيال الموثق من خلال المحاكاة، الأزياء والإكسسوارات، حيث أثار إشكالية وضع الأسبقية التي ربما يختلف عليها المنظرون والمحترفون بما يتعلق بالمونتاج والميزانسين في ضوء الاعتقادين وهما:
1ـ اعتقاد (أعداء السيناريو) بان خطيئة الفيلم كما يرى فيرناند ليجر وقد تطورت عن هذا العداء والخصومة، مثلا حركة السينما المباشرة وحركة الدوغما التي أعادت الحيوية لطهر حركة التصوير والارتجال ضد ماكنة السيناريو.
2ـ اعتقاد (أعداء المونتاج ) الذي عبر عنهم اندريه بازان، إن هناك واقعا واحدا فقط لا يمكن تجاهله في السينما هو واقع المكان الذي يتمُّ عبره تقديم الواقع على سجيته وفقا للمعنى الذي أطلقه بازان وهو إن الميزانسين يبدو أكثر أمانة للواقع وأكثر صدقا من المونتاج ، ويثير الكاتب الزبيدي المعنى الوارد برؤية إيزنشتين المتحيزة للواقع ومدى قربه الأكثر من المونتاج الذي يهدف إلى إعادة بنائه لتتجانس فيه العلاقة العضوية للعناصر المكونة له ،وهنا يتقصد الكاتب بكشف مستويات الاختلاف والخصومات الحرفية لدى المنظرين.

دريغا فيرتوف
ويطرح اعتقاد فيرتوف المختلف عن إيزنشتاين، الذي أعتقد إن المونتاج له أسبقية ووظيفة قبل التصوير لأنه ثمة تصميم وتخطيط و حساب دقيق للزمن والحركة والشكل قبل بدء التصوير، فيما يعتقد غودار بالتركيبة الثنائية الجدلية ، حيث رأى المونتاج والميزانسين معا كوجهتين مختلفتين للنشاط السينمائي وأعاد تعريف المونتاج كجزء من الميزانسين، وان من يعمل المونتاج يعني انه يتعامل الميزانسين لهذا التوافق المتداخل وحالهما حال (اللحن مع الإيقاع)، وعن ضرورة المونتاج في الفيلم يؤكد الزبيدي إن على السينما كفن أن تسعى بفضل المونتاج إلى تنفيذ التناوب بين هاتين المقولتين، فمن جهة ينفذ التناوب الراهن عبر توثيق الصورة الفيلمية.
ومن جهة أخرى ينفذ التناوب بين ما هو خيالي متصور بين تناوب علاقة المكان والزمان عبر تدخل مخرج الفيلم الذاتي في تنفيذ اللقطة حتى في الفيلم التسجيلي.
ويقف الزبيدي مع بازوليني في مقولته التي تؤكد على (إن كل لقطة هي وصلة سمعية بصرية زمكانية ، وكل وصلة مونتاج هي مجرد وصلة ويصل المرء من كيناتموغراف إلى سينماتوغراف من خلال ربط المونتاج وبدد الزبيدي مخاوف البعض من (لعبة) المونتاج على أنها انتهاك لمصداقية الصورة ،وبسببها يصبح المونتاج لغة خداع وتلاعب في إنتاج المعاني والدلالات، فقد أشار إلى أن المونتاج هو لغة تعبير وتجاور وتجانس وربط محكم بين اللقطات في التقديم والتأخير لملاحقة فهم المعنى المختبئ في الصور، ففيه تتفجر سمة الإيجاز والتركيز والإيحاء والإشارة وفيه تتحرك العلامات للبحث عن حركة الأحداث ودورانها، الأمر الذي يحرك دائرة التأويل والتفسير وتداخل المعاني، فهو وسيط تعبيري لا يحتمل الخداع والكذب والتزييف، انه كما يطلق عليه الزبيدي (المونتاج العادل)، وقد توصل الكاتب في فصوله الأخيرة إلى أن (أية دراسة توثيقية، هي أداة مرجعية توثق لكتابة تاريخية، فالصفة (توثيقي) تحيل إلى أن كل شيء يتعلق بفكرة وموضوع الفيلم، يجب أن يكون مدعوما بالوثائق وبمعنى الاشتقاق الاصطلاحي، فان (التوثيق) يعني ضبط نوع محدد من الوثيقة أو عملية توثيقها وتسجيلها صوريا وصوتيا، وعليه فان الفيلم التسجيلي هو فيلم أو (فديو) يميز نفسه عن الفيلم الروائي/ الخيالي، كما تميز الرواية نفسها عن المقالة الأدبية، أي بمعنى أن الفيلم التسجيلي هو جنس سينمائي وليس خاصية سينمائية، لأنه يحيلنا إلى الواقع بشكل خلاق ولا يحمل خيالية الروائي التي تعيش في فضاء المختلق والمتصور والمستنبط والوهم والخيال والحلم والتنبؤ وغيرها، ويختتم الزبيدي قوله الذي أردت أن يكون ختام المقال وهو (فلا يوجد أي فيلم دون صنعة أو دون تدخلات فنية، لأن التصوير بوساطة الكاميرا يستوجب دائما ملكة الحرفة ويستوجب بشكل أمثال ـ فطنة تامة) ذلك لان الفيلم التسجيلي يقوم وفقا لأحكام ومزايا جمالية معدة مسبقا إضافة إلى الق الواقع وتوهجه الذي يصرح ويبوح بالمعنى الفيلمي من رسالة وأفكار.
*الكاتب: درس في كلية الفنون الجميلة، حصل على دكتوراه في فلسفة الإخراج- سينما وتلفزيون 2010 . مخرج تلفزيوني، أستاذ جامعي دكتوراه في فلسفة الفنون السينمائية والتلفزيونية عن موضوع “المعالجات الجمالية والفلسفية لحكايات ألف ليلة وليلة في الخطاب السمعي البصري العالمي”.
يعمل حاليا أستاذاً لمادة الإخراج التلفزيوني ومادة التذوق السينمائي والتلفزيوني في جامعة بغداد كلية الفنون الجميلة قسم السينما والتلفزيون.