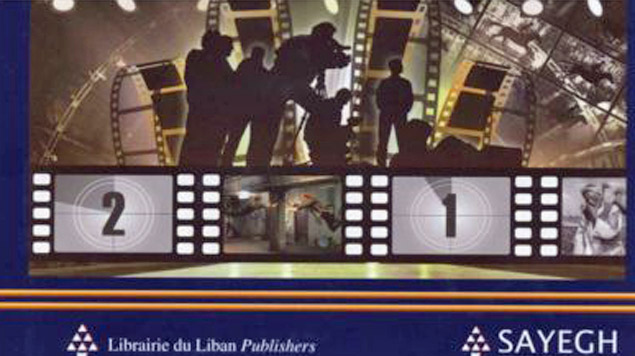ميكايل هانيكه: “الشريط الأبيض”..مكان لا حب فيه!

ميكايل هانيكه Michael Haneke واحد من أهم مخرجي السينما الأوروبية، والأعلى مكانةً وتقديراً. عبر أفلامه الهامة، سلّط هانيكه ضوءاً ساطعاً على أجواء النزوع إلى الشك والإرتياب، النابع من الشعور الحاد بالذنب، والذي يتصل بسلوكيات ومواقف العائلة المنتسبة إلى الطبقة المتوسطة. كما أظهر براعة في تحري القضايا الإجتماعية من خلال كاميرا حساسة وواعية، وعين قادرة على سبر مختلف المشاعر والانفعالات في فيلمه “الشريط الأبيض” The White Ribbon(2009) يركز بؤرته، على نحو مكثف، على الطفولة، العائلة، العلاقات الطبقية في مجتمع قمعي وكابح. كاشفاً عن الطبيعة السامة، الهدامة، للتشدّد الديني. مقدماً تأملاً قاتماً فيه يستكشف تأثيرات العنف البدني والنفسي. ومحققاً وثيقة رائعة عن الكبح الديني والإفلاس الأخلاقي والظلم الاجتماعي وتفشي الشر الذي ينخر أساس مجتمع يتجه حثيثاً نحو تدمير نفسه والآخر عبر حروب طاحنة تلوح في الأفق.الشريط الأبيض: شارة عار يضطر الأطفال إلى إبرازها لأسابيع بسبب مخالفة قانونٍ ما، مثل: التأخر في العودة إلى المنزل، ممارسة ما تفرضه امارات البلوغ واليقظة الجنسية، وغير ذلك. الشريط، كما يعرّفه القس، هو رمز للنقاء والطهارة والبراءة، تذكير بالمُثل العليا التي ينبغي بلوغها. الغاية منه هو حثّ الصغار على تجنب الوقوع في الخطيئة، الأنانية، الحسد، البذاءة، الكذب، الكسل. الشريط مستخدم كأسلوب تربوي تعليمي، لكنه في حقيقته عقاب ووسيلة قمع شنيعة.في هكذا مجتمع يعجز عن رؤية طبيعته الحقيقية، وبرفض أي تغيير جذري في أسسه الاجتماعية والأخلاقية. ثمة تدمير منهجي للحب والبراءة، وهيمنة للشر، ونفي لأي بارقة أمل.الأطفال هم ضحايا للعنف ومرتكبين للعنف في الوقت نفسه. أبرياء وآثمون في آن. إنه مؤشر للفساد المتأصل في هذا المجتمع. الرعب لا ينشأ من الصور المعروضة على الشاشة، بل هناك انبثاق لإحساس مروّع بوجود عنف سريّ يكمن أسفل سطح المجتمعات والعائلات المتحضرة. الفيلم من الإنجازات السينمائية الرائعة، على مستوى الموضوع والأفكار، وعلى المستوى البصري.. وقد حاز بجدارة على الجائزة الكبرى، إضافة إلى جائزة النقاد الدوليين، في مهرجان كان 2009. وجوائز الفيلم الأوروبي كأفضل فيلم، أفضل إخراج، أفضل سيناريو.وجائزة جولدن جلوب كأفضل فيلم أجنبي. وحصل على عشرة جوائز من مسابقة الفيلم الألماني من بينها أفضل فيلم ومخرج. وجائزة نقاد شيكاغو كأفضل فيلم أجنبي.*******هنا يتحدث ميكايل هانيكه عن فيلمه “الشريط الأبيض”..* كتبت سيناريو الفيلم قبل عشر سنوات، وقبلها بعشر سنوات أخرى، كانت الأفكار والصور تترشّح في ذهني. لم يكن سهلاً الحصول على مبلغ يغطي الميزانية المقترحة، لذلك تأجل مشروع تصوير العمل كل هذه السنوات.* نقطة الإنطلاق للفيلم، الفكرة الأصلية التي خطرت ببالي، كانت قصة جوقة من المنشدين الأطفال في الكنيسة، في منطقة بروتستانتية تقع في شمالي ألمانيا، قبل الحرب العالمية الأولى.أظن أنه دائماً في الأماكن “الصغيرة” تقع الأحداث الكبيرة أو التطورات الهامة، في ما يتصل بالمناخ الروحي والأخلاقي.* في تلك المرحلة، كان 85 أو 90 في المئة من سكان ألمانيا يعيشون في القرى. لذلك فإن رؤية المجتمع الذي أصوره هي مرآة لمجتمع إقطاعي فيه يكون البارون في قمته، والمزارعين في أسفله، بينهما المدرسون والحرفيون والقسيس. الفيلم هو إعادة إنتاج للطبقات التي كانت حاضرة في المجتمع في ذلك الوقت. لو كان عليّ أن أصور في المدينة، كموقع للفيلم، لأصبحت العلاقات الإجتماعية أكثر تعقيداً، وليس من السهل تبيّنها وتمييزها.* مع نشوب الحرب العالمية الأولى شهدت المجتمعات التغيّر المفاجئ والحاد، والأشياء بدأت تتغيّر وتتحول في مختلف مناطق العالم. المجتمع الإقطاعي، الذي كان موجوداً منذ آلاف السنين، بلغ نهايته المفاجئة، غير المتوقعة. لكن الفيلم ليس بالضرورة عن تلك المرحلة من الزمن، إذ يمكن أن يدور في زمن مختلف وعن وضع مختلف، بل يمكن أن يدور في قطر عربي. إنه عن منبت الشر، أصل التطرف والإرهاب. الفيلم يوظف هذه الفترة لتصوير الآليات التي لا تحدث فقط مع المجتمعات الإقطاعية.* في العام 1914 حدث التغيّر الثقافي الحقيقي. في ألمانيا والنمسا، وحدة الله والإمبراطور والوطن تفككت مع نشوب الحرب العالمية الأولى. ومن نواح عديدة، الحرب العالمية الثانية وتطورات ما بعد الحرب يمكن ربطها بذلك. في أوج الاشتراكية القومية، الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 إلى 15 سنة، في “الشريط الأبيض”، سوف يبلغون عمراً يؤهلهم لتحمّل المسؤولية.* من المهم رؤية الفيلم بوصفه سرمدياً، أي لا ينتمي إلى زمن معين، وليس مقيداً إلى المرحلة والمكان اللذين تدور فيهما الأحداث. لسوء الحظ، أنت تشعر بالعجز عندما يؤول الآخرون فيلمك على نحو خاطئ. هنالك أشخاص لا يستطيعون أو لا يريدون أن يفهموا أو يتقبلوا ما تحاول أن تفعله. حين تجازف بالتعبير عن نفسك علانيةً، يتعيّن عليك أن تفتح نفسك لذلك الاحتمال. * لا أظن أنها مصادفة أن يدور الفيلم في ألمانيا في هذه الفترة الزمنية المحددة، مع ذلك، سيكون تأويلاً خاطئاً إذا اعتقد المرء بأن الفيلم لا يصور إلا تلك الفترة. أظن أن الآليات الإجتماعية والنفسية والسياسية الحاضرة في الفيلم هي حاضرة في كل عصر، مع إنها تأخذ أشكالاً مختلفة. الآليات ذاتها تعمل حتى في يومنا. إني أميل إلى القول بأن على الألمان أن يشاهدوا هذا الفيلم باعتباره فيلماً عن ألمانيا، لكن في بلدان أخرى، يتعيّن عليهم أن يشاهدوا الفيلم باعتباره فيلماً عن بلدانهم. سيكون أمراً مبسطاً جداً اختزال الفيلم إلى ظاهرة معينة أو إلى بُعد واحد. نماذج السلوك التي تراها في هذا الفيلم تنطبق على أي قطر آخر وأي عصر. من الخطأ الاعتقاد بأن الفيلم يتحدث فقط عن ألمانيا وعن الإشتراكية القومية الألمانية. * كنت دائماً أجد صعوبة في تقبّل الفيلم التاريخي الذي يزعم أنه يصوّر أو يمثّل الواقع بينما لا أحد منا يستطيع أن يعرف ذلك الواقع. نحن في الحقيقة لا نعرف أبداً ما حدث آنذاك.* بالطبع أنت تتفاعل مع ما تراه وما تسمعه كل يوم، وأي مخرج يحقق فيلماً جاداً لابد وأن يتعامل مع واقع اليوم. هذا الفيلم يتحدث عنا في الوقت الحاضر، وليس في فترة ماضية. *فكرتي الأساسية كانت أن أروي قصة مجموعة من الأطفال الذين انغرست في أذهانهم قيم ومبادئ تحولت إلى حقائق مطلقة انصهرت مع ذواتهم وآمنوا بها. إنهم يجعلون من المُثُل العليا شيئاً مطلقاً، المثُل التي غرسها فيهم آباؤهم ومعلموهم.أحببت فكرة تناول الأطفال الذين يضفون على القواعد الأخلاقية، التي تعلموها من ذويهم، صفة ذاتية ومادية، فيحاكمون ذويهم وفقاً لتلك القواعد والمواعظ، ويعاقبونهم لأنهم لا يعملون وفقاً لها.حالما يتحول المبدأ أو المثل الأعلى إلى أيديولوجيا، يصير شيئاً خطيراً. الأطفال يميلون إلى أخذ كل ما يقال لهم على محمل الجد.. تلك كانت نقطة الإنطلاق للفيلم.إذا نحن رفعنا المبدأ أو المثل الأعلى، سواء أكان سياسياً أو دينياً، إلى مرتبة المطلق، أو الحقيقة المطلقة، فسوف يصبح هذا المبدأ أو المثل الأعلى وحشياً وغير إنساني، وسوف يؤدي إلى الإرهاب.إنهم يتحولون إلى مخلوقات غير إنسانية، وحشية، بتعيين أنفسهم قضاة يحاكمون أولئك الذين لا يعيشون وفق ما يبشّرون به. إذا كانت التعاليم التي تتعرّض لها صارمة حقاً فإنها تصبح أرضية مثالية لتفريخ كل أنواع الإرهاب. إنك تحوّل المثل الأعلى إلى أيديولوجيا، وكل أولئك الذين يعارضونها، أو يتخذون موقف الحياد منها، يمكن تصويرهم كأعداء. براءة الأطفالذات مرّة فكرت في عنوان آخر للفيلم هو “الساعد الأيمن للرب”، ذلك لأن هؤلاء الأطفال يحسبون أنفسهم يد الله لأنهم يعرفون الفرق بين الخير والشر ولهم الحق في محاكمة الآخرين وتطبيق تلك المثل العليا حرفياً، ومعاقبة الذين لا يشاطروهم الرأي ولا يتفقون معهم.. وهذا هو بداية الإرهاب.* لا أعتقد أن الأطفال أبرياء. الأطفال ليسوا أكثر براءة من الكبار. قد يكونون سذّجاً ويصدقون كل ما يقال لهم، قد تكون معرفتهم بالأشياء أقل من الكبار، لكنني لست واثقاً من أنهم أكثر براءة. منذ فرويد، لا أحد يعتقد ببراءة الأطفال. هذا ينطبق على الرجال والنساء. كل شخص قادر أن يمارس القسوة ضد الآخر. لا علاقة بالذكورة والأنوثة في هذا الأمر.عندما تأخذ الشيء حرفياً، من المحتمل أن يشكّل خطورة. العالم ليس منقسماً إلى أخيار وأشرار، كما يحب السياسيون والمؤلفون السيئون تذكيرنا به. من هذا تقتات الأفلام ذات النوعية المحددة، مؤكدين لنا بأنه لن يصيبنا سوء في النهاية. لكن الأمور تبدو مختلفة في الواقع، وأنا أبذل كل ما بوسعي لأستجوب الواقع المتناقض. الأطفال ليسوا أبرياء على نحو صرف، ولا وحوشاً على نحو صرف، إنهم في مكان ما في الوسط.. مثلنا جميعاً. الأطفال أناس مثلي ومثلك، لا أفضل ولا أسوأ. لا أظن أن الفيلم يُظهرهم كمخلوقات سيئة. لكن إذا أردت أن تقترب من واقع الحياة وتعقيداتها فعليك أن تحفر عميقاً.* أخشى أنني لا أرى نهاية لدائرة العنف، حيث يمارس الآباء إيذاء أطفالهم، والأطفال بدورهم يوجهون عنفهم نحو الآخرين. إني أرى الأطفال كحقل طري فيه يسير الناس بأحذيتهم المطاطية الصلبة. وكلما طال سير الناس على التربة الطرية، صارت التربة أكثر صلابةً. في آخر الأمر، الأطفال أنفسهم يبدأون في السير بأحذيتهم الصلبة على التربة الناعمة. إنها دائرة حتمية. نحن ننسى بسرعة الألم البدني، لكن لاوعينا لا ينسى الإذلال الذي عانيناه والألم النفسي الذي كابدناه.* كل الأعمال الدرامية تتناول حالة انعدام الحب بين البشر. تشيخوف مثلاً، الذي هو أعظم كاتب مسرحي بعد شكسبير. كم هو فاجع في “الخال فانيا”، الطريقة التي بها يعرض حالة الإهمال واللامبالاة والتوق اليائس إلى الحب، الذي في النهاية، المرء يكون عاجزاً عن حشده. وهذه الحالة أيضاً متفشية في الحياة اليومية، الشعور بالافتقار إلى الحب، والذي يبتلي به كل شخص.أنا بالتأكيد جزء من الثقافة البورجوازية، وأنا أنظر إلى المجتمع الذي أعيش فيه كمكان لا حب فيه. هذه الثيمة في “الشريط الأبيض” تقدّم نفسها على نحو حاد وبارز أكثر، في شكلٍ نموذجي تقريباً، بسبب المسافة التاريخية بين القصة وبيننا. لكنها ليست مقتصرة على الأعمال القديمة. أعتقد أن الأعمال الفنية القديمة زمنياً تدخل ضمن بنية الحاضر. العمل الثقافي الذي ينتمي إلى القرن السابع عشر قد ينسجم مع وضعك الحالي، وإلا لما حرّكت مشاعرنا تلك الإبداعات الكثيرة من الماضي البعيد. هناك استمرارية لثيمات معينة لا يمكن صرف النظر عنها، حتى لو كانت أشكال الحياة الاجتماعية والتعبير الفني تخضع لتغييرات هائلة.* بقدر ما يوجد خير في دواخلنا، يوجد شر.* أعتقد أن كل شخص قابل لأن يفعل أي شيء، أن يمارس كل ضروب الشر والقسوة، وأن يمارس النقيض أيضاً. هذا يشبه ما قاله غوته: “لم أسمع قط عن أي جريمة ليس بإمكاني ارتكابها”. التوازن بين الخير والشر موجود دائماً، السؤال هو كيف تجعله الظروف والخيارات الفردية يميل إلى هذا الجانب أو ذاك. ثمة ظلم لا يوصف في العالم، لأن ليس كل وضع اجتماعي أو عائلي يوفّر الفرص ذاتها لكي يكون الفرد خيّراً، ولا القدرة ذاتها لأن يشين سلوك وخيارات المرء. لكن بالنسبة لأولئك الذين يحصلون على تلك الفرص والقدرات، فإن مسألة الخير والشر هي حاضرة في الحال، وكذلك مسألة كيفية التعايش مع شيء أنت فعلته، وكيف تتحمّل المسؤولية. أما في ما يتعلق بالاستشهاد من الكتاب المقدس في الفيلم: “أنا إله غيور، أعاقب الأطفال حتى الجيل الثالث والرابع على خطايا ارتكبها الآباء”.. فقد استخدمت ذلك لأنه مرعب حقاً، والصغار أخذوا الكلام بجديّة، فهذا ما علّمهم القس. بالنسبة لهم، هذا يضفي شرعية على تعذيب الشخص الأضعف في البلدة. هذا ما يفعله المتعصبون.* ليس هناك شخصيات إيجابية أو سلبية، على نحو مطلق، في الفيلم. المدرّس، الذي يروي الأحداث، هو المثالي الذي لديه شكوكه ومن جانب آخر، يكون انتهازياً أحياناً. والقس ليس شريراً ولا سادياً بل هو يحب أطفاله حقاً، ومقتنع بأن ما يفعله هو الصواب وبأن الطريقة التي يتبعها في تربية الأطفال هي الملائمة، ذلك لأنه لا يعرف أي منهج آخر. وهذا ما يبثّ الرعب هنا. أمر سائد أن نرى أباً يضرب أولاده. حين يقول لهم “سوف لن أنام الليلة، لأنني مضطر أن أعاقبكم وأسبّب لكم الأذى في الغد” فإننا قد نتلمس سخريةً في كلامه ونشكّ في مشاعره، لكنني أظن أن من الأفضل تصديقه. ليس من المشوّق رؤيته في صورة شخص سادي أو كحالة ذهنية غريبة.القس في البداية لا يقبل اتهام المدرّس لأبنائه، لأنه لو فعل ذلك فسوف ينهار عالمه بأسره. فقط عندما يرى الطائر مقتولا على مقعده، يشعر بالصدمة ويدرك أن الاتهامات حقيقية.لو كان هؤلاء الأفراد مجرد أشخاص منحرفين وضالين، لما كان لهذا النوع من السلوك مثل ذاك التأثير الواسع. وشخصياً لست واثقاً من أن أي نظام تعليمي آخر هو، على نحو فطري أو متأصل، أفضل من هذا النظام. المسألة دائماً تتصل بالباعث البيداغوجي (أصول التدريس) الفرداني. النظام التعليمي قائم على الحافز الذي يدفع الفرد للتدريس: هل يقوم بالتدريس لمجرد أن يمارس سلطةً ما، أم ليساعد الآخرين على إيجاد طريقهم في المجتمع؟* النظام التعليمي كان بالتأكيد قمعياً. كان قائماً على العقاب، العقاب البدني، لكنه كان أيضاً النظام الوحيد المعروف والمتبع. حتى ضمن جيلي، كان الكثيرون يتعرضون للضرب من قِبل ذويهم، وهذا لا يعني كراهية الآباء لهم. ذلك كان الشكل الوحيد للتربية والتعليم الذي عرفوه واعتادوا عليه وتربوا عليه، والذي مارسوه بدورهم.أظن أن مسائل التربية والتعليم، كيف نربّي أطفالنا، هي مشكلة أساسية تتصل بالجنس البشري منذ بدايات الخليقة. لقد قرأت العشرات من الكتب عن نظم التعليم، ووسائل التربية والتعليم، منذ العصور الوسطى، مع كل القصص المرعبة التي رافقت تلك المناهج.* لشخصية الراوي احتجت إلى شخص لا ينتسب إلى القرية بل يأتي من خارجها، ليروي القصة لنا، بحيث يوفّر الطباق الدرامي. كان مهماً وجود شخص في القصة والذي سيكون قادراً في ما بعد على التفكير ملياً في ما حدث، وتقديم الشكوك المختلفة. صحيح أن المدرّس شخص غير قياسي للمرحلة لأن المدرسين آنذاك كانوا يلجأون إلى العقاب البدني، والذي كان يعتبر طبيعياً. مثل هذا العقاب لم يكن يُنظر إليه بوصفه فعلاً شريراً أو دنيئاً أو يعبّر عن كراهية للأطفال. كان ببساطة شكلاً قياسياً من أشكال التربية والتعليم.الموت والدين* ثمانون بالمئة مما نحمله معنا هو مبني على آثار مميزة لا سبيل إلى محوها من طفولتنا، من زمن فيه كنا غير قادرين بعد على تنمية آليات دفاعية. لذا إن أردت أن تصور دراما إنسانية، فبوسع الطفولة أن تخدم كما لو كانت أشبه بالعقل قبل تلقيه أي انطباعات خارجية. إذا أردت أن تصف نزاعات مجتمع ما، أو علاقات السلطة، فإن الطفولة عنصر هام، لأن عند ممارسة السلطة، الطفل عادةً يكون في الترتيب الأدنى، وأي طفل سوف ينقل هذه التجارب بطرائق مثيرة للاهتمام.* في الفيلم جعلنا طفلاً صغيراً يطرح أسئلته القلقة في مسألة الموت. إني أتذكر تلك اللحظة على المستوى الشخصي، عندما اختبرت للمرة الأولى فكرة الموت. الطفل، في سن الرابعة أو الخامسة، يتوصل إلى حقائق أساسية معينة بشأن الوجود الإنساني، ويدرك أن الحياة ليست أبدية وأن الإنسان ليس خالداً. إنها لحظة مهمة، مثيرة للمشاعر وصادمة، لجميع الأطفال.أعتقد أننا، في مرحلة الطفولة، نطرح على أنفسنا تلك الأسئلة الصعبة، ونفكر فيها بجدية أكثر مما نفعل ونحن كبار، حيث تعلمنا أن نكبت خوفنا من الموت وإزاحته جانباً. إنك لا تفكر في الموت إلا عندما يحتضر أو يموت شخص تعرفه أو يقيم في محيطك المباشر. المجتمع صار يكبح الخوف من الموت. في الماضي، كان المرء يموت في منزله بينما اليوم يموت وحيداً في وحدة العناية المركزة حيث لا أحد يستطيع أن يراه. * كنت مهتماً بالتعامل مع البروتستانتية بسبب صرامة وتزمت وشدّة هذا المذهب.* اهتمامي بالبروتستانتية بشكل خاص نابع من تربيتي ونشأتي كبروتستانتي، وهذا نسبياً غير مألوف في النمسا. أبي كان بروتستانتياً ألمانياً، وأمي كانت كاثوليكية نمساوية. البروتستانتية أثّرت فيّ بشكل كبير في مرحلة الطفولة.إذن ثمة خلفية شخصية في جعل القصة تدور في بلدة صغيرة بألمانيا البروتستانتية قبيل نشوب الحرب العالمية الأولى، لكن السبب الرئيسي هو أن ذلك أتاح للفيلم أن يشير ضمنياً إلى الأمور التي استمرت في ما بعد في القرن العشرين، أو حتى في يومنا. المظهر الشخصي يكمن في أنني كنت حالة نادرة لطفل بروتستانتي في النمسا الكاثوليكية. والصرامة التي صادفتها في البروتستانتية، في طفولتي، كانت محكمة تماماً. إنها أكثر نخبويةً وغطرسةً من الكاثوليكية، حيث يكون لديك وسيط بينك وبين الله، إذ بوسع القسيس الكاثوليكي أن يغفر لك ويزيل ذنوبك، بينما في البروتستانتية أنت مسؤول، وعرضة للمحاسبة، بشكل مباشر أمام الله.* هذا الفيلم يتعامل مع سطح الدين، جانبه السياسي السلبي، وهو لا يثير قضايا دينية. ليس هناك دين ينتج الإرهاب على نحو آلي، بل دوماً نجد أن الكنيسة والناس هم الذين يستغلون الحاجات الدينية الأساسية عند الآخرين من أجل غاياتهم الأيديولوجية الخاصة، في تواطؤ مع التربية والتعليم والسياسة. الإيمان، في ذاته، شيء إيجابي.. إنه يولّد المعنى. أنا عن نفسي لم يعد لدي إيمان ديني. هذا يصعّب الأمور، لأن المؤمن يمتلك رؤية للحياة مختلفة، أكثر اطمئناناً وراحة بال.* الدين، في هذا الفيلم، من الثيمات المركّبة جداً. لكن يخطئ من يرى في فيلمي نقداً لاذعاً للمعتقد الديني. نحن في الواقع نتحدث عن الكنيسة وما تكونه الكنيسة. أعتقد أن الدين هو جزء متمم للحاجات الإنسانية، لكن السؤال هو أيضاً: كيف تفهم الدين. أظن أننا نحتاج إلى أهداف ومُثل عليا لكي نعيش. من المستحيل التفكير في العيش بلا أهداف ومثُل عليا. مع ذلك، الشئ الخطر جداً يحدث عندما تقود الأفكار إلى الأيديولوجيا. عندئذ الأيديولوجيا تؤدي إلى خلق صورة لعدوّ ما، بالتالي تفضي إلى الجريمة، إلى المجازر التي شهدها العالم منذ بداية التاريخ. إذا تأملنا حجم الدم المسفوك، نتيجة بطش الإنسان بالإنسان طوال مسار التاريخ البشري، فسوف تكون المعتقدات المتهم الرئيسي. المشكلة تنشأ عندما تُخلق الكنيسة، المؤسسة، العقيدة. عندما تنتقل الفكرة إلى حقل الأيديولوجيا تصبح خطيرة. الشيوعية أيضاً فكرة جميلة، لكن الملايين من البشر هلكوا حين أصبحت الشيوعية أيديولوجيا. لقد قادت الكثيرين إلى حتفهم. الأناجيل كذلك رسالة فاتنة ومحببة إلى النفس، لكن أيضاً الحملات الصليبية قادت الملايين إلى الموت.*لكنني أيضاً كنت أفكر في تاريخ الإرهاب اليساري، عصبة الجيش الأحمر. بعض القيادات الراديكالية كانت تنتمي إلى عائلات بروتستانتية. جودرون إنسلين كانت الرابعة بين سبع بنات من أب هو قس بروتستانتي، و أولريكه ماينهوف جاءت كذلك من خلفية متدينة جداً. كلتاهما كانتا تحملان هذه الصرامة الأخلاقية التي وجدتها مثيرة للاهتمام جداً. كنت أعرف ماينهوف إلى حد ما في أواخر الستينيات، حين كانت تعد عملها التلفزيوني لصالح التلفزيون الألماني، وكنت أعمل وقتها محرراً إذاعياً. لم تكن تبدو متعصبة. في الواقع، كانت جذابة، رفيعة الثقافة، ومرحة جداً.

ميكايل هانيكهلكنني لا أريد أن يُفهم من كلامي بأن الفيلم معادٍ للبروتستانتية بأي حال من الأحوال، أو أن البروتستانتية تتجه نحو التطرف السياسي. العديد من المثقفين والمفكرين الألمان انبثقوا من بيوت متزمتة دينياً. فقط أردت أن أبيّن بأن البروتستانتية تتسم بصرامة في التفكير والقواعد الأخلاقية أكثر من الكاثوليكية، صرامة معينة قريبة جداً من التعصب.الشيء نفسه نجده في بيئة مختلفة، بجذور مختلفة، لكن ببنية أخلاقية مماثلة، عند المتزمتين دينياً والإرهابيين في العالم الإسلامي. هناك أيضاً نجد استبدادية فكرة معينة ورؤية محددة للدين، والتي لا علاقة لها بجوهر الدين الحقيقي. ما تتقاسمه كل هذه الجماعات والأفراد هو إيمانهم بمُثُل عليا تتحوّل إلى أيديولوجيات، وهذه بدورها تصبح مهدّدة ليس لحياة الآخرين فحسب بل لحياتهم أيضاً، لأنهم عندئذ يكونون راغبين في الموت في سبيل قناعاتهم.الشمولية والاستبداد* الفيلم هو عن جذور الشمولية والاستبدادية. إنه عن كل شكل من أشكال الإرهاب. إذا حوّل شخص فكرةً ما إلى أيديولوجيا، واعتقد أنه منبع كل حكمة، فسوف يشعر بضرورة تحويل أو تنوير كل الذين يشاطرونه معتقداته. هذا ينطبق على كل ضروب الإرهاب، بصرف النظر عما إذا هو إرهاب يميني أو يساري أو فاشي أو ديني.. وهذا ما رأيناه في مواضع عديدة عبر التاريخ.* لم يحدث قط أن حققت أفلاماً لها علاقة بسيرتي الذاتية أو بعائلتي، إلا في حدود ضيقة.السؤال الذي أحاول أن أطرحه هنا: ما هي الشروط الضرورية التي تجعل الناس سريعي التأثر بالأيديولوجيا؟الفيلم يحاول أن يعرض هذه الشروط التي ضمنها يبدي الناس استعدادهم لاتباع أيديولوجيةٍ ما، سواء أكانت دينية أو سياسية.الفيلم هو عن كيفية التلاعب بالأفراد وجعلهم يؤمنون بفكرةٍ ما، وكيف أن النفس البشرية يمكن إجبارها على الطاعة وقيادتها نحو اتجاه معيّن.أردت أن أُظهر أن كل ضروب القمع يمكن أن تجعل المرء منفتحاً وسريع التقبّل لفكرة الخلاص، ما إن يأتي شخص ما ويقول له: “بوسعي أن أنقذك”.. ولا يهم من يكون، قد يكون فاشياً ألمانياً أو ستالينياً أو متعصباً دينياً، الأمر سيان.ذلك هو لبّ الفيلم. في الأماكن التي يعاني فيها الناس، ويشعرون بالقلق العميق، بالعجز والضعف، بالإذلال، فإنهم يصبحون أكثر تقبلاً للأيديولوجيا، لأنهم يبحثون عن الخلاص، عن شيء يتشبثون به، عن قشّة قد تنتشلهم من مستنقع البؤس والتعاسة والشقاء، وتحرّرهم من المأزق. والقشة هي الفكرة، المثل الأعلى، الأيديولوجيا. قد يكون الدين أو شيئاً آخر. الشروط هي دوماً متطابقة بصرف النظر عن المكان والزمن.في أنحاء العالم، في كل بلاد، في كل عصر، هناك دائماً الشيء ذاته: حين يعاني الناس، حين يتعرضون للإذلال، حين يشعرون باليأس، فإنهم سوف يصغون إلى أول شخص يتقدم ويقول: “أنا أعرف الحل لمشاكلكم”. في الواقع، هم يكونون مستعدين وراغبين وتواقين للذهاب خلف ذلك الشخص والإنصياع له.

الحرب التي تنشب بين الناس، الحرب الأهلية التي تقع بين جماعات من الناس، هي التي تجعلهم يتقبلون بلا تردد ولا تفكير عميق مثل تلك الأيديولوجيات.تلك كانت الفكرة وراء الفيلم، ولهذا السبب اخترت أكثر الأمثلة بروزاً وشهرة للأيديولوجيا التي نعرفها.. أي الفاشية الألمانية. لكن أعتقد أن من الخطأ تقييد الفيلم ورؤيته باعتباره فيلماً عن نهوض الفاشية فقط. * الفيلم ليس فقط عن الفاشية الألمانية لمجرد أن القصة تدور في ألمانيا. هذا سيكون تأويلاً تبسيطياً. الفيلم بالأحرى عن نمط محدد، والمعضلة الكونية للمُثل العليا المحرّفة. إنه يتعامل عموماً مع جذور كل أنواع الإرهاب، سواء اليمين السياسي أو اليسار السياسي أو الديني.* هناك عملياً فيض من الأفلام عن ألمانيا النازية والفاشية الألمانية، لكن ولا فيلم واحد يتعامل مع جذور الفاشية، مع خلفيتها، مع ما سبقها. أظن أن من المثير للإهتمام تناول كيفية حدوث أو بروز ذلك. بالطبع، فيلمي ليس تحليلاً شاملاً عن كيفية ولادة الفاشية، ولا يقصد أن يكون كذلك. إنه ينظر إلى الجذور.* أميل دائماً إلى تغذية ارتياب المتفرج في ما يعرضون عليه في الأفلام. هذا معبّر عنه في “الشريط الأبيض” عندما يقول الراوي مع افتتاحية الفيلم بأنه ليس على يقين من أن كل تفاصيل القصة التي سيرويها هي صحيحة وأمينة للحقيقة، فقد نسي الكثير مما حدث، والكثير مما سيرويه يعتمد على الإشاعة.إذن منذ البداية يخلق الراوي لدينا الإرتياب في صحة وموثوقية ما سوف نراه، والقصة تكون مروية بطريقة متناقضة.. إن ما نشاهده ليس فقط ما يكون الراوي قادراً حقاً على رؤيته، بل أن هناك مشاهد لا يظهر فيها ولا يشهدها. كان هذا ما أهدف إليه في البداية، أن أوضح بأننا لا نتعامل هنا مع قصة حقيقية. والفيلم لا يزعم أنه يصور أحداثاً واقعية. *إن طريقتي في التعامل مع الراوي كانت أن أستجوب الحدث، أن أتركه مفتوحاً، أن أؤكد على حقيقة أن ما نراه عرضة للشك. بصورة عامة، في كل أفلامي، أميل إلى إحداث ارتياب معيّن بدلاً من الإدعاء بأن ما أعرضه على الشاشة هو نسخ صحيح ودقيق للواقع. أريد من الجمهور أن يستجوب ما يراه على الشاشة.بالطريقة ذاتها التي استخدمت فيها الراوي، كذلك استخدمت الأسود والأبيض، لأنها تخلق مسافة تجاه ما هو مرئي. إني أرى الفيلم كنتاج اصطناعي أكثر مما هو إعادة بناء موثوقة للواقع الذي لا نستطيع أن نعرفه.* دوماً أجاهد أن أكون دقيقاً وشديد العناية بالتفاصيل قدر الإمكان. في حالة هذا الفيلم، قمت بالكثير من البحوث، رغم إدراكي بأن الفيلم سيظل نتاجاً اصطناعياً. إنه ليس وثيقة معاصرة. وأنت تبذل كل ما بوسعك للإقتراب قدر الإمكان من الواقع. مع ذلك، دائماً أدرك أنه ليس الواقع نفسه وإنما مجرد طريقة لفهم الموضوع. لقد قرأت الكثير عن طرائق الدراسة، وأصول التدريس، والمناهج التعليمية في تلك المرحلة، وكيف كانت الحياة في القرى آنذاك. ومن أجل إعادة خلق الأزياء والمواقع، طالعنا الكثير من الصور الفوتوغرافية عن تلك الفترة. تحديداً تلك الصور التي التقطها المصور الفوتوغرافي الألماني الشهير في تلك الفترة أوغست ساندر، الذي كان حقاً مصور تلك المرحلة في ألمانيا. هناك مجموعة كبيرة من أعماله التي تشمل العديد من الأجزاء. والصور كلها دقيقة جداً وشديدة الوضوح.* في ما يتصل بالصيغة الشكلية، قررت في وقت مبكر أن يكون الفيلم بالأسود والأبيض، وأن يكون هناك راوٍ. كلاهما وسائل لخلق مسافة بين المتفرج والفيلم، ولتجنب أي طبيعية زائفة. إنها وسائل تفضي بالمتفرج إلى رؤية الفيلم كنتاج اصطناعي، وليس كشيء يدّعي أنه تصوير صحيح ودقيق للواقع. إنها ذاكرة شخص ينتمي إلى تلك الفترة الزمنية، لذا أردت العثور على لغة ملائمة لتلك المرحلة. أردت أن أكتب من الإحساس بكيفية اختباري لتلك المرحلة من خلال الأدب.. خصوصاً من خلال أعمال الروائي ثيودور فونتين. كتاباته تبدو ممثلة لتلك الفترة. أحب لغته المدروسة، إنها تمنح الموضوع والقارئ معاً نوعاً من الوقار والسمو.صوت الراوي هو صوت رجل عجوز والذي، من وجهة نظره في الماضي، هو قادر على التفكير ملياً في الأحداث. من صوته يمكن القول أنه عاصر الفاشية وجماعة بادر ماينهوف الراديكالية أيضاً.إن استخدامي للراوي مشروع في هذا الفيلم. إنها محاولة لإثارة اليقظة أو حسن الانتباه عند المتفرج، هذه الحالة التي لم تعد نماذج السرد الراهنة في الأفلام قادرة على إثارته أو إحداثه، حتى لو كانت مصقولة ومركّبة جداً. هناك أيضاً أناس في الوسط الموسيقي والأدبي، يخلقون أعمالاً متقدمة جداً وفي مرحلة معينة يعودون إلى الأسلوب أو الشكل “الكلاسيكي”.* هناك أيضاً سبب عملي هام جداً في استخدامي للأسود والأبيض. أنت تلجأ إلى الخداع عندما تحقق فيلماً تاريخياً، لأنك ببساطة لن تجد أبداً المواقع الأصلية التي ظلت من دون تغيير. يتعيّن عليك دوماً أن تضيف إلى المواقع والمبانى التي تجدها، والتي ستكون أيسر بكثير لو أن النتيجة النهائية بالأسود والأبيض وليس بالألوان. لو تجولت بسيارتك في مناطق ألمانيا الشرقية سابقاً، على سبيل المثال، فسوف ترى أن المنازل مصبوغة بألوان تختلف كثيراً عن ألوان منازلنا، وهي نتاج صناعة مختلفة أنتجت مواداً كيميائية مختلفة. إن كل مرحلة وكل منطقة لها ألوانها الخاصة التي تزول مع الشركات التي أنتجتها.أنا قلّما أشاهد أفلاماً تاريخية تكون مقنعة في اختيار الألوان الملائمة، باستثناء أفلام قليلة رائعة مثل “الملكة مارجو” لباتريس شيرو الذي نجح في خلق المناخ التاريخي القابل للتصديق رغم عدم توفر مصادر تصويرية. وفي الوقت نفسه، يصبح أوبرالياً. فيسكونتي أيضاً نجح في فعل ذلك، ربما على نحو أفضل.عن الأبيض والأسود* لأن الفيلم يدور في مرحلة تاريخية معينة فقد لجأنا إلى صور تلك الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى للتعرّف على تلك الأزياء والمواقع وحتى قص الشعر. أردت أن أصف أجواء الفترة التي سبقت مباشرة الحرب العالمية. هناك أفلام لا تُحصى تناولت المرحلة النازية، لكن ليس ما قبلها.* في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20، كل الصور المألوفة والمتوفرة لدينا هي بالأسود والأبيض، وذلك بسبب وجود وسائل الإعلام من جرائد وتصوير فوتوغرافي. أحد المراجع التي كانت متوفرة لدينا أثناء التحضير للفيلم تلك الصور الفوتوغرافية بالأسود والأبيض المأخوذة في تلك الفترة، والتي من خلالها نتعرف على مرحلة بداية القرن العشرين.. تحديداً تلك الصور التي التقطها أوغست ساندر، المصور الفوتوغرافي الألماني العظيم.

في حين أننا لا نعرف القرن 18 إلا من خلال اللوحات، التي هي بالألوان. أغلب الأفلام عن القرون 16 و17 و18 هي ملونة.ولأنني أحب الأسود والأبيض فقد تشبثت بهذه الفرصة لتحقيق فيلم غير ملوّن. في الواقع حققت من قبل فيلمين للتلفزيون، من النوع التاريخي، وقد صورت معظم مشاهدهما بالأسود والأبيض، مع بعض المشاهد الملونة.. أحدهما كان مبنياً على رواية جوزيف روث “التمرد”، والآخر دراما بعنوان “مربية خصوصية”. إن سبب اختياري هذا النوع هو أنه يسهّل على الجمهور إيجاد طريقهم حول هذا العالم. السبب الآخر هو أن الأسود والأبيض يخلق تأثيراً مضاداً للطبيعية. إنه ليس مثل الفيلم الملون الذي يجعلك تظن أن ما تراه واقعي. إنه يدفع الأحداث إلى مدى بعيد عن المتفرج مانحاً منظوراً بعيداً وموضوعياً. وهو، مثل استخدام الراوي، ساعدني على خلق مسافة بيننا وبين القصة المرويّة، والطبيعية الزائفة التي توحي بأننا نعرف بالضبط ما حدث وأننا سوف نعرضه عليكم.ما يهم هنا هو إيجاد الوسط الملائم لتصوير الموضوع.* بالنسبة لنا جميعاً، نحن العاملون في الفيلم، كانت التجربة جديدة لأننا جميعنا تقريباً لم نجرب تصوير العمل بالأسود والأبيض. لقد قمنا بإجراء الكثير من الاختبارات لرؤية كيف سيبدو الفيلم قبل أن نبدأ التصوير، وكيف نضيء المواقع الداخلية لأننا أردنا استخدام مصادر الضوء الطبيعية. إذا استخدمت الشموع والمصابيح الزيتية كثيراً فإنك تحتاج إلى مادة حساسة جداً للضوء. كان علينا أن نستخدم مادة فيلمية ملونة لأن الأسود والأبيض غير حساس للضوء. بعد تصوير الفيلم، في مرحلة ما بعد الإنتاج، قمنا بتحويله رقمياً إلى الأسود والأبيض. حتى في الموقع، بينما نتابع تصوير اللقطات عبر المونيتور، كان هذا الجهاز (المونيتور) موجهاً لإظهار الأسود والأبيض لأنه كان علينا أن نرى كيفية نقل الألوان إلى الأسود والأبيض.كان عليّ أن أبدّد الكثير من الوقت في إقناع المنتجين بأن الأسود والأبيض خيار مناسب لموضوع العمل.. درامياً وجمالياً. لقد أرادوا نسخة ملونة، ولم يتراجعوا عن مطلبهم إلا بعد حصول الفيلم على جائزة مهرجان كان.الأبيض والأسود أيضاً ساعد كثيراً في طمس الفوارق الدقيقة والتي غالباً ما تفضح حقيقة أن الديكورات هي اصطناعية. الكثير مما يبدو الآن مثالياً ما كان ممكناً أن يكون كذلك قبل 10 أو 15 سنة من دون التصحيح الرقمي (الديجيتال). لقد قضينا وقتاً طويلاً ونحن نقوم بعملية الصقل والتحسين في مرحلة ما بعد الإنتاج. هناك أكثر من ستين خداعاً بصرياً في الفيلم عن طريق الديجيتال.. على سبيل المثال، قمنا – إطاراً إطاراً – بوضع القرميد، رقمياً، على أسطح مباني القرية، وهذا وفّر علينا مبالغ طائلة كنا سننفقها لو لجأنا إلى بناء الأسطح. * بالنسبة لي، مظهر الفيلم كان دائماً مهماً. لكن كلما تعمقت تجربتك، تشعر بضرورة أن تتابع عن كثب ما يفعله المصور. على سبيل المثال، عندما نصور أسعى دوماً للحصول على إضاءة أقل. إني أعمل مع فريق فني رائع: كريستوف كانتر، مصمم المناظر الذي عملت معه منذ سنوات طويلة. مويديل بيكل، مصممة الملابس المبدعة، التي استعنت بها لأنها صممت ملابس فيلم “الملكة مارجو” Queen Margot.. أروع ملابس شاهدتها في السينما.لا أظن أن المخرج يحتاج أن يكون خبيراً أو ضليعاً في كل هذه المهن، لكن يحتاج إلى امتلاك القدرة على أن يلاحظ بسرعة كل التفاصيل والأحجام والنسب، ويرى إن كان هناك خطأ ينبغي إصلاحه.العمل مع الأطفال* من الممتع العمل مع الأطفال في الموقع، مع أن ذلك يستغرق وقتاً أطول من المعتاد. في ما يتصل بالتمثيل، هم لا يستطيعون أن يكذبوا، هم ليسوا محترفين، لذلك يتعيّن عليك أن تعمل معهم على نحو مختلف. عليك كذلك أن تعوّل أكثر على موهبتهم، بالتالي فإن حسن اختيار الممثلين الصغار أمر هام جداً. إن كانت الموهبة حاضرة والدور مناسباً، فسوف تحصل على شيء خاص جداً، أكثر مما تحصل عليه من ممثل محترف.* كنت أخشى أن لا نحصل على ممثلين صغار مناسبين للأدوار المكتوبة. لهذا السبب بدأنا في البحث عنهم قبل فترة طويلة من شروعنا في التصوير. لم أرد أن أكون في وضع حرج عندما يحين وقت التصوير وأنا لم أحصل بعد على ممثلين مناسبين فأضطر أن أستخدم أي طفل. لحسن الحظ كان اختيارنا للصغار موفقاً. الأطفال أشبه باليانصيب، للحظ دور كبير. ولأن أغلب قصصي تدور في المحيط العائلي، فإنني لا أستطيع تجنب العمل مع الأطفال. * ستكون محظوظاً إن عثرت على أطفال موهوبين، والا فستواجه صعوبة في تنفيذ فيلمك. ليست المسألة في أنهم يعملون بطريقة مختلفة عن الممثلين المحترفين. الفيلم يقتضي مشاركة العديد من الممثلين الصغار المختلفين لتأدية الأدوار الصعبة العديدة. ذلك كان خوفي الأعظم قبل البدء في تنفيذ المشروع، أن نجد صعوبة في إيجادهم. ولهذا السبب بدأنا في البحث قبل ستة شهور من المباشرة في عملية الإنتاج والتقينا بأكثر من سبعة آلاف طفل لكي ننتقي منهم 15 طفلاً.المهمة كانت شاقة جداً لأننا لم نكن نسعى وراء المظهر الجسماني فحسب، بل نحاول اكتشاف الموهوبين منهم. أما في ما يتعلق بالكبار، فقد اخترت الممثلين الذين سبق أن عملت معهم، وأولئك الذين تعرفت على أداءاتهم من خلال أفلامهم، والذين يبدون ملائمين للأدوار. أما بالنسبة للمجاميع فقد أردت وجوهاً تشبه تلك الوجوه التي نراها في الصور الفوتوغرافية لتلك الفترة، والتي تبدو مقنعة عندما تنغرس في المحيط التاريخي والإجتماعي آنذاك.الغريب أننا لم نجد هذه الوجوه بين المزارعين الألمان المعاصرين، الوجوه المسفوعة التي لها رائحة القِدم، التي وسمتها الرياح وعوامل الطقس كما في الماضي. كان علينا أن نذهب إلى قرى رومانيا للعثور على المجاميع الذين سوف يؤدون أدوار الفلاحين في الكنيسة وفي الاحتفال بالحصاد. جلبناهم بالحافلة، حوالى 100 شخص، عبر مسافة تبلغ 2000 كيلومتراً، لتصوير مشاهدهم مع 100 آخرين وجدناهم بعد تمشيط مناطق الشمال الألماني.* في ما يتصل بإدارة الممثلين، فإنني ألفت نظرهم فحسب عندما أرى خللاً ما في أدائهم. عندما يكون اختيارك للممثلين سليماً، وأداؤهم جيداً، ستكون الشخصيات مقنعة ومتفاعلة بشكل جيد.* أنا لا أجري بروفات لأي مشهد. أشعر بأن البروفة تحد من تلقائية الممثلين.* العمل مع الأطفال لم يكن يسيراً بل سبّب لنا عدداً من المشاكل. في ألمانيا ثمة قوانين ولوائح تنظم تشغيل الأطفال في الأعمال الفنية وتفرض واجبات لابد من الإلتزام بها. أنت لا تستطيع أن تصور الأطفال إلا خلال ساعات محدودة في اليوم، وإذا لم تلتزم بالقوانين فسوف تعرّض نفسك للمساءلة والتحقيق وربما السجن.* الشكل الكلاسيكي بدا لي الإختيار الأنسب لهذه القصة، لهذا الشكل الروائي الذي يأتي إلينا من القرن التاسع عشر. الكلاسيكية تصبح طليعية عندما يبذل كل شخص أقصى جهده لتطوير أشكال أسلوبية جديدة. أظن أنه أمر صحي العودة إلى الأشكال الكلاسيكية.* إذا صرّح مخرج ما قائلاً بأنه لا يهتم على الإطلاق بعدد الأشخاص الذين يشاهدون أفلامه، فإنني ببساطة لا أصدقه. وإلا فلماذا يرهق نفسه في صنع الفيلم؟أظن أن كل فنان يبحث عن متلقي. يبحث عن جمهور. هناك طرفان من المعادلة: الخالق وبالضرورة متلقي العمل.. تماماً مثل الرسام الذي يريد للوحاته أن تكون مرئية. لكن إذا خنت مبادئك أثناء محاولتك الوصول إلى جمهور أوسع فإن ذلك أشبه بخيانة إيمانك. حتى إذا زعم مخرج أو مؤلف نخبوي أنه لا يهتم إن كانت أعماله مرئية أم لا، فإنني سوف أضطر إلى النظر إليه كشخص كاذب أو منافق.* أنا دائماً أسعى إلى تحريك ذهن المتفرج، إلى إستدعاء مخيلته. من المعلوم أن الصور التي تخلقها مخيلة المرء هي أقوى من أية صورة يمكن أن أعرضها. في الواقع، من الخطأ – وهو خطأ واسع الإنتشار في السينما السائدة – أن ترغب دائماً في عرض الأشياء وفي تصوير الأشياء. نحن مغمورون بالصور.. ثمة الكثير من هذه الصور، ومن فرط الإستعمال نصبح متعودين عليها. هذا يبدو سخيفاً. بالنسبة لي، أجد تحريك المخيلة عملية فعالة اكثر. كذلك هو سماعك الخطى التي لها صرير، على سبيل المثال.. إنه فعال أكثر من رؤية وجه الوحش، الذي يبدو عادةً سخيفاً ومضحكاً، وحيث تعرف أن الدم مجرد صلصة طماطم.* أردت أن أستفز المتفرجين. لو أجبت على الأسئلة التي طرحتها فإن المتفرجين سوف لن يفكروا في الفيلم بعد الانتهاء من مشاهدته. بتركي الأسئلة دونما إجابات، سوف يستغرق المتفرجون بالتفكير في الفيلم من أجل إبعاد الفيلم عن أذهانهم.* لا أستطيع أن أحاكم الجمهور. حتى وقتنا الحاضر، كل أفلامي لقيت نجاحاً جماهيرياً. أشعر أن الأفلام المفتوحة هي مثمرة أكثر للجمهور. شخصياً، تضجرني الأفلام التي تجيب على كل الأسئلة التي تطرحها. وبالمثل، عندما أقرأ روايةً لا تترك لي أسئلة، أسئلة محركّة ومثيرة، تجابهني وتناوشني، عندئذ تكون القراءة مضيعة للوقت.* إنها المرة الأولى، بعد عشر سنوات، التي أصور فيها فيلماً في ألمانيا. وفي الحقيقة كنت أكثر استرخاء في الموقع هناك من أي مكان آخر. متعة خالصة. من الأيسر كثيراً التحكم في الوضع إذا كنت تعمل بلغتك الخاصة. لغتي الإنجليزية ليست ممتازة. وبوصفي شخصاً ممسوساً بالسيطرة والتحكم، فإنني أحتاج أن أكون مدركاً تماماً لما يجري من حولي في الموقع، وأن أعرف ماذا يقال وما يتم فعله في حضوري، وأن أكون متحكماً في الوضع. إنها ليست مسألة أن تكون قادراً على التعبير عن نفسك وشرح ما تريد فحسب، بل أيضاً أن تشعر بالراحة والإطمئنان وأنت تعرف ما يحدث حواليك. لذلك، رغم أن الفيلم هو الأكثر تعقيداً وتكلفةً واستغراقاً للوقت، من بين كل أفلامي الأخرى، إلا أن العمل كان يسيراً جداً وطبيعياً من وجهة نظري.من جهة أخرى، في فرنسا، إمكانيات صنع الفيلم أسهل وأكثر تنظيماً. إنه امتياز عظيم لي أن أكون قادراً على العمل في أكثر من بيئة واحدة. وهذا أتاح لي أن أصور فيلماً تلو الآخر.. الشيء الذي لا يستطيع فعله الكثيرون من زملائي، الذين تقتصر أنشطتهم على محيط ثقافي واحد، إذ عليهم الإنتظار فترة أطول حتى ينجزوا الفيلم التالي. المصدر: أحاديث هانيكه مأخوذة من لقاءات عديدة أجريت معه خلال العامين 2009 و2010