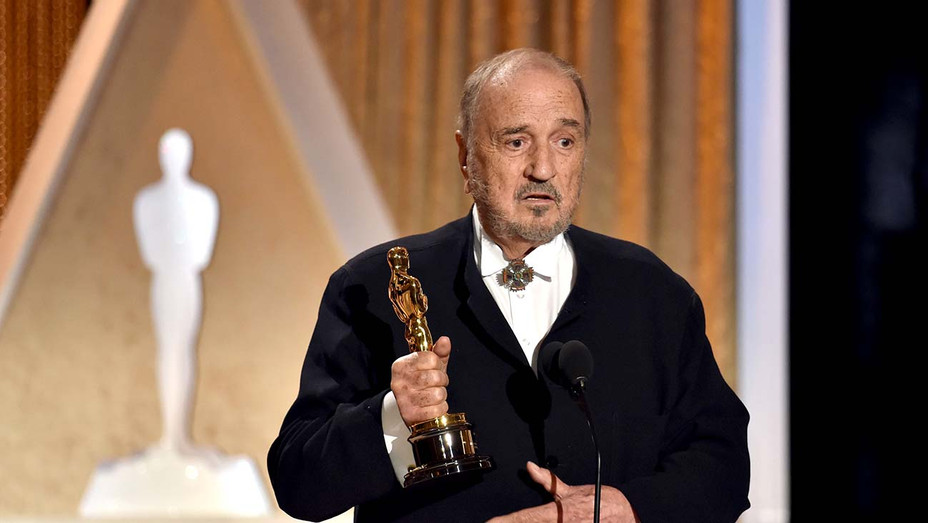مروان حامد: من العنف إلى التلصص

أمير العمري
ظهرت موهبة مروان حامد منذ فيلمه الأول القصير “لي لي” (40 دقيقة) عن قصة قصيرة ليوسف إدريس. وهو يدور حول فكرة الاشتهاء الجنسي في مجتمع مغلق، مجسدة من عيني إمام جامع شاب يشعر بالانجذاب نحو فتاة شديدة الفتنة والاغراء تسير في الباطنية أحد أحياء القاهرة القديمة حيث تنتشر تجارة المخدرات وعصابات المجرمين. هذه الفتاة التي تهبط يوميا تتهادى أمام عيون الطامعين فيها وهم كثر، تبدو كما لو كانت قادمة من عالم آخر لتدمير ثقة الرجال في أنفسهم. ينجذب لها إمام المسجد ويتخيلها في أحلامه معه في الفراش، فتزداد معاناته ويتمزق بين تدينه الشديد، وبين ورغبته.
“لي لي” رمز الثمرة المحرمة في غابة أرضية جهنمية تعيش في الجريمة وتتستر بالإيمان، وهو التناقض الكامن الذي يتعايش معه الجميع في الأحياء الشعبية، ويجعل شخصيات تلك الأحياء تحمل من الشر بقدر ما تحمل من الطيبة والخير، أي أنها مزيج مركب، لا يمكنك أن تكرهها أو تنبذها، بل تتعاطف معها وتتفهمها وتفهم دوافعها وترثي لها أيضا. هذا الجو الشعبي الغارق في المحلية الذي يذكرنا بأجواء بعض روايات نجيب محفوظ، سيعود إليه مروان حامد في فيلمه الروائي الطويل الثاني “ابراهيم الأبيض”.
أما فيلم “لي لي” فكان يتميز بالجرأة دون شك، وجاء تجسيد الفكرة على الشاشة في شكل شديد القوة والإقناع والتأثير، وقد كشف الفيلم عن الموهبة التي يتمتع بها مروان في اهتمامه بالجماليات والتدقيق في اختيار الأماكن الحقيقية الصعبة التي أدار فيها التصوير، واستخدامه الممثلين المحترفين ومزجهم بأهل الحي، والاهتمام الكبير بكل عناصر الصورة: الإضاءة وحركة الكاميرا والتكوين والألوان، إلى جانب نجاحه بالتعاون مع المونتير في اختيار اللقطات والتحكم في إيقاع كل مشهد على حدة، والإيقاع العام للفيلم، دون وجود لقطات زائدة. فالفيلم عمل متكامل كاللوحة البصرية، مع موسيقى خالد حماد البديعة وشريط صوت شديد الثراء.
هذا الاهتمام بالجوانب البصرية في الفيلم عموما وبشريط الصوت الذي يصنع خلفية مثيرة مؤثرة للصورة، سيبرز أكثر في الأفلام التالية التي يخرجها مروان حامد. وهو يختار أن يبدأ أفلامه الروائية الطويلة بعمل يستند مثل “لي لي” على أصل أدبي ذائع الصيت هو رواية “عمارة يعقوبيان” لعلاء الأسواني، وعلى سيناريو كتبه الكاتب المتمرس وحيد حامد (والد مروان).
وقد بدا من الوهلة الأولى أن السيناريو اقتبس من هذه الرواية أفضل ما فيها من مشاهد وشخصيات جسدتها ببراعة مجموعة من كبار الممثلين في السينما المصرية: عادل إمام، نور الشريف، خالد الصاوي، يسرا، هند صبري، خالد صالح، أحمد بدير، أحمد راتب، محمد الدفراوي، وغيرهم.
الفيلم مثل الرواية، يعتبر تلخيصا مكثفا لعصر كامل، شهد تدهورا كبيرا على المستوى الاجتماعي مع سقوط الطبقة الوسطى القديمة وظهور طبقة جديدة حلت محلها تفتقد للتقاليد والقيم القديمة وتخلق قيما أخرى تتماثل مع ما وقع من تدهور على جميع المستويات، والفيلم يرصد هذه المتغيرات كما يرصد ظهور حركات التطرف السياسي التي تتسربل بالدين، في شكل أقرب إلى النبوءة حيث يرسم صورة الصدام الذي وقع بعد ذلك بين السلطة القديمة، وجماعة الاخوان المسلمين. وقد بلغ الفيلم درجة كبيرة من الجرأة في التعبير عن مساوئ عصر الرئيس مبارك، لكن المفارقة أن نظام مبارك سمح بعرضه رغم تشابه الكثير من شخصياته مع شخصيات حقيقية كانت تتحرك على الساحة السياسية والثقافية، كان بوسع الجمهور التعرف عليها بوضوح.
أثبت مروان حامد بفيلم “عمارة يعقوبيان” (2006) أنه قبل أن يكون قد بلغ الثلاثين من عمره، يمكنه السيطرة والتحكم في أداء عدد كبير من نجوم التمثيل في مصر، وإحكام قبضته على الفيلم عموما، والانتقال السلس بين مشاهده وتحقيق تأثير مدهش من بين ما يصدر عن الشخصيات من تعبير عن القلق والغضب والرفض والتمرد والعنف. فلم يكن أساس هذا الفيلم الحبكة الدرامية بقدر ما كان استعراضا (أفقيا) لواقع مصر في الألفية الجديدة، من خلال شخصيات تتجاور وتتعايش وتتناقض وتتصارع معا، وتعيش التطورات وتنعكس عليها المتغيرات بكل قوة وقسوة.
إبراهيم الأبيض
من النقد السياسي- الاجتماعي ينتقل مروان حامد إلى نوع آخر من السينما، سينما الإثارة و”الأكشن” والعنف، ولكن في محيط الأحياء الشعبية القاهرية ربما كما لم يرها أو يعرفها أحد من قبل في السينما. وفيلم “إبراهيم الأبيض” (2009) المبني على سيناريو عباس أبو الحسن، مقتبس عن حكاية وأحداث حقيقية وقعت في ظروف مختلفة، بطلها هو إبراهيم الأبيض، الذي كان طفلا شهد بعينيه كيف قُتل والده بقسوة على أيدي البلطجية وتجار المخدرات، فشب وهو يحمل في صدره ضغينة ضد تلك العصابات التي تعيث فسادا في الحي الشعبي الذي تركته أمه فيه مع الرجل الذي تبناه وهو تحديدا أحد أولئك الذين قتلوا أباه أو حرضوا على ضربه وإيذائه حتى أسلم الروح.
إلا أن الفتى لكي يتمكن من تحقيق انتقامه الخاص يجب أن يتسلح بالقوة والمهارة في استخدام عضلاته وترويع ضحاياه.. بالجملة، وهو يجد نفسه أيضا مضطرا لأن يحمل الإرث نفسه، إرث القوة والعنف وتجارة المخدرات. إنه نموذج للبطل الشعبي “الأسطوري” الذي يمكنه أن يهزم عشرين وثلاثين رجلا يتكالبون عليه، يصيب من يصيبه ويقضي على كل من يتمكن منهم، بيده أو بسلاحه البدائي (السيف والسكين والمطواة)، ويدفع الباقين الى الفرار بعد أن يبث في قلوبهم الرعب.
“إبراهيم الأبيض” فيلم عن عنفوان الفتوة الذي يتبنى منطق القوة، يستعين بها في مواجهة الأشرار. وكما أنه فيلم عن الانتقام، فهو أيضا عن الصداقة والخيانة، وعن الحب وكيف يمكن أن ينقلب الى كراهية، وعن الشر الذي يتغلغل ويجعل الانسان الذي يصبح مفتونا بقوته وقوة أنصاره الذين يحيطون به، يصبح كالشيطان السادي المجنون (نموذج المعلم زرزور)، يتلذذ بالقتل والتعذيب والعنف والترويع.
لا شك أن من أهم ما يميز الفيلم شخصياته المرسومة جيدا، والتي تحصل على مساحة جيدة من الحضور على الشاشة: إبراهيم (أحمد السقا) وصديقه عشري (عمرو واكد) وحبيبة إبراهيم “حورية” (هند صبري) التي سنكتشف أنها ابنة الرجل الذي تبناه بعد أن أشرف على قتل والده وأن إبراهيم قتله انتقاما منه، والمعلم زرزور (محمود عبد العزيز)، زعيم عصابة المخدرات في الحي الذي تتخذ شخصيته أبعادا رمزية أكبر من حدود الشخصية في الواقع.
إلى جانب الشخصيات يمكن القول إن أهم عناصر الفيلم تتمثل في الأماكن التي تدور فيها الأحداث. إن مروان حامد المغرم بحواري القاهرة القديمة يجعل منها بالتعاون مع مدير التصوير الموهوب سامح سليم، عالما قائما بذاته، عالما أرضيا، ربما يكون موجودا في الواقع، لكنه يبدو من خلال العين الفنية السينمائية كما لو كان خارج الواقع، يتجاوزه، أو يقع في مساحة ما بين الواقع والكابوس. هذه الأماكن يشيع فيها الفقر والبؤس ورغم ذلك، يوجد في قلبها من يعيش داخل قلعة أو قصر كبير، ينهش لحم الفقراء ويستغلهم ويوظفهم في الشر. وتبدو دائرة الشر في الفيلم كما لو كانت موروثة أو وكأنها قدر هؤلاء الناس، كالموت تماما، وهو أكثر ما نراه هنا.
في أحد أفضل مشاهد الفيلم يعبر إبراهيم داخل أقبية وممرات وردهات وغرف وزنازين قسم الشرطة الذي يبدو أقرب إلى عالم آخر مسكون بالرعب.. حيث يعلقون بعض الأشخاص ويضربونهم ويمارسون عليهم أبشع أنوع التعذيب. وعندما ينهار أحدهم ويموت تحت وطأة التعذيب، تنفجر الفوضى تعم المكان.. ويملأ الرعب الضابط الذي يريد التخلص من أي أثر لجريمته، وينتهز إبراهيم الفرصة ليهرب، يقفز فوق أسطح البيوت، ويخترق الحارات الضيقة، ينفذ الى الطريق ثم يقفز الحواجز وينتقل بين الأماكن المدهشة ويتخلص من كل ما يعيق طريقه إلى أن يسقط في النهاية في قبضتهم مرة أخرى.

مروان حامد مغرم بفكرة الملحمة الشعبية التي تقوم على العنف إلا أنه يشعر بالتعاطف مع تلك الشخصيات الضعيفة المهزومة سلفا، مع بطله المظلوم “إبراهيم”، ضحية العنف والثأر والجريمة المورثة. هذا البطل الذي يبحث عن الحب الذي فقده منذ الطفولة، وشخصيات أخرى مثل عشري وحورية، تبحث عن لحظة تواجه فيها ذاتها دون أن تشعر بالخجل والعار، لكنها تنتهي عادة إلى الهزيمة تحت وطأة القوة والقسوة مهما بلغت شجاعتها الفردية. يخلق مروان حامد واقعا موازيا للواقع الحقيقي يصبح هو واقع الفيلم، متخذا من حالة بطله العنيد الشجاع المنتقم، الذي يشعر أيضا بالحب وبعذاب فقدانه حبيبته بسبب التباس الظروف واجتماع قوى الشر على تحطيمه، دليلا إضافيا على قسوة الواقع الاجتماعي وغياب أي دور حقيقي للدولة.
ثلاثية حامد- مراد
في روايات الكاتب أحمد مراد، سيعثر مروان حامد على عالمه الذي كان يبحث عنه، عالم بين الخيال والواقع، وشخصيات تنتقل بين العالمين. وهو ما يجسده في أفلامه الثلاثة التي أخرجها عن روايات أحمد مراد.
أولها هو “الفيل الأزرق” (2014). هنا ينتقل مروان من عالم الضائعين والضالعين في الاجرام نتيجة بؤس الواقع، إلى عالم الشريحة العليا من الطبقة الوسطى حيث ينتمي بطله الطبيب النفسي “يحيى” (كريم عبد العزيز) الذي يعيش فيما يشبه قصرا يوحي بالثراء والغرابة في آن، فرغم المنظر البديع الذي يطل عليه والحديقة الملحقة به إلا أنه يسدل الستائر معظم الوقت على قاعة الجلوس الفسيحة التي يمضي فيها وقته، يشرب الخمر الى أن يسقط في غيبوبة بعيدا عن الواقع.
يحيى يعود بعد خمس سنوات من الغياب الى عمله كطبيب في مستشفى الأمراض العقلية، لكي يلتقي وجها لوجه في قسم السجناء والمجرمين الخطرين، بزميله السابق الدكتور شريف” (خالد الصاوي) الموشوم رأسه الأصلع وجسده، بوشم غريب، والذي يتصور وجود كائن آخر غيره هو المسؤول عن تصرفاته وأخطرها بالطبع جريمة قتل زوجته. وهو موجود الآن في قسم المجرمين الخطرين الذين يعانون من اضطراب عقلية. لكن شريف أيضا هو شقيق “لبنى” (نيللي كريم) حبيبة يحيى السابقة التي رفض شريف أن يزوجها له فتزوجت من رجل يكبرها في العمر دون حب. وتزوج هو من زوجته التي ماتت مع ابنته في حادث سيارة بينما نجا هو. لذلك وبتأثير الحادث المروع انعزل عن العالم لخمس سنوات.
هل شريف مصاب بحالة فصام في الشخصية، تجعله يتخيل أشياء لا وجود لها؟ أم أن يحيى نفسه هو المريض الذي يتخيل أشياء لا يمكن أن تحدث في الواقع، كأن يتخيل مثلا أن شريف يتصل به تليفونيا عن طريق التليفون المحمول بينما شريف معزول داخل عنبر السجناء لا يملك وسيلة اتصال حديثة من هذا النوع؟
الالتواء الأول في الحبكة يجعل شريف (المجرم القاتل المضطرب الموشوم) هو الذي يقبض على المقود وهو الذي يحاسب يحيى ويحلل شخصيته ويرده الى مواجهة نفسه والحقائق الموجودة في حياته التي ينكرها مثل حبه المستمر حتى الآن للبنى، لكن الالتواء الثاني سيأتي عندما يكتشف يحيى أن هناك مصدرا “حقيقيا” لا علاقة له بالطب النفسي وتحليلاته هو الذي يعلب دورا فيما يشعر به شريف، وما يراه يحيى نفسه في أحلامه على مستويين: مستوى الحاضر ومستوى التاريخ.
هذا أكثر أفلام مروان حامد طموحا في الشكل، في استخدام حيل السينما البصرية والصوتية، وتنفيذ الكثير من المشاهد التي اقتضت وجود الخبراء في التنفيذ والحيل والمؤثرات الخاصة، لكي يحقق التأثير الخاص الذي يتميز به فيلم الدراما النفسية التي ستلد لنا من داخلها فيلما من أفلام الرعب والسحر الأسود!
كان من المثير بالطبع أن تكون تلك الرواية أكثر روايات مؤلفها نجاحا، كما أصبح الفيلم أيضا الأكثر تحقيقا للإيرادات في تلك السنة. فقد لاقت فكرة مغادرة الواقع إلى الخيال دون القطع تماما مع الواقع، ولمس ما هو مستقر داخل نفوس وعقول الكثير من المشاهدين من جمهور الطبقة الوسطى، صدى كبيرا، فهي تخاطب مشاعرهم، وتقدم لهم تفسيرا، لاضطراباتهم النفسية والعاطفية ودوافعهم السلوكية التي لا يفهمونها، حتى لو كان هذا التفسير يقوم على الخرافة.
أهم ما حققه هذا الفيلم لمروان حامد إلى جانب أن جعله يصبح من المخرجين القادرين على تحقيق الرواج التجاري الكبير، أنه أصبح أكثر ثقة، قادر على أن يسيطر تماما على الحبكة وعلى الممثلين، ويطوع إمكانيات الإنتاج الكبير لحسابه بحيث يحصل على ما يريد ويخرج الفيلم بالصورة المنشودة. قد يكون هناك بعض الاستطرادات، والتكرار، والاطالة في بعض المشاهد. وربما كان يمكن التحكم أكثر في الإيقاع العام للفيلم وجعله أسرع بعد أن يتم التخلص من 20 دقيقة على الأقل من زمنه دون أن تتأثر الحبكة، كما كان يمكن أيضا التحكم أكثر في استخدام الموسيقى وعدم فرضها فرضا على خلفية الكثير من المشاهد الطويلة، بحيث أصبحت مرهقة للأذن، وطغت أحيانا على الحوار نفسه، إلا أن هذه الملاحظات لا تقلل من براعة الإخراج بشكل عام، وقدرة الفيلم على شد المشاهدين لموضوعه، والتلاعب بمشاعرهم عن طريق تلك الالتواءات المقصودة في الحبكة.
ينتمي فيلم “الأصليين” (2017)، وهو الفيلم الثاني لمروان حامد عن رواية وسيناريو أحمد مراد، إلى سينما تعتمد على الإشارات الرمزية الكامنة تحت جلد الصورة، وعلى النص الذي يخفي أكثر ممّا يظهر، ويقوم الفيلم أساسا على لعبة القط والفأر: أي الصياد والفريسة، فمن هو الفريسة، ومن هو الصياد؟
إنه يقدّم بطله اللا- بطل (أو نقيض البطل(anti-hero “سمير عليوة” (ماجد الكدواني) كفريسة، وسمير موظف في أحد المصارف، حالته المادية ميسورة، يقيم في أحد الأحياء المغلقة الجديدة مع زوجته، وهي سيدة سطحية لا يشغلها سوى التملك والاستهلاك السلعي والمظاهر الخارجية للأشياء، وابنيه المراهقين المشغولين بأنفسهما، ينتظران منه أن يلبي مطالبهما التي لا تنتهي.
لكن سمير يعاني من عدم التحقّق، ومن أزمة انصياع لما كانت تمليه عليه أسرته، تلاحقه في الطفولة، وهو يهرب كثيرا إلى الخيال، بحثا عن تفوّق زائف لا يملك تحقيقه حتى في خياله.
سمير نموذج للمصري المتوسط، ابن الطبقة الوسطى الذي لا يملك قدرة التمرّد على واقعه أو السعي لتغييره بأي شكل من الأشكال، بل فقط مواصلة الهروب في خياله، وعندما يفقد وظيفته في البنك تنقلب حياته رأسا على عقب، فهو إنسان ميت خارج الوظيفة التي لا يعرف غيرها، ولكي يهرب من مواجهة الحقيقة يكذب على أسرته ويوهمها بأنه ما زال مستمرا في العمل، يرتدي ملابسه ويغادر منزله صباح كل يوم ويعود مع نهاية يوم العمل، لكنه لن يتمكّن من الاستمرار في خداع الأسرة طويلا.
يفشل سمير في العثور على عمل بديل، لكن الحظ يطرق بابه ذات يوم عندما يتلقى طردا داخله تليفون محمول ورسالة، وسرعان ما يتلقى اتصالا من رجل يطلق على نفسه اسم الممثل الراحل رشدي أباظة (خالد الصاوي)، ثم يقابله الرجل ليخبره بأنه عضو في منظمة تدعى “الأصليين” ويغريه بالعمل لحساب المنظمة التي يوضّح له أنها تضم الملايين من المصريين الذين يراقبون باقي المصريين، وأنهم (روح الوطن) الذين يظهرون عندما تواجه الدولة خطر السقوط في الفوضى.

ويكلفه بمراقبة أكاديمية شابة متخصّصة في علم الحضارات، هي ثريا جلال (منة شلبي) التي عادت مؤخرا من الخارج بعد حصولها على الدكتوراه في “رصد منحنى الحضارات الإنسانية”، وأصبحت -كما نرى- تدعو في محاضراتها إلى ضرورة ردم الهوة بين الماضي والحاضر، واستعادة قوة الدفع التي ميّزت الحضارة المصرية القديمة، واستلهام “الموروث” الفرعوني المقدّس الذي يتمثل في زهرة اللوتس رمز الخلق والبعث الجديد، والعين (عين حورس) التي ترمز للقدرة على إعادة الحياة إلى طريق الخير والعدل (الذي كان يمثله أوزوريس).
تردّد ثريا جلال كثيرا في محاضراتها أن “اللوتس هي التي ساعدت المصري على التخلّص من قيوده وخلق الخيال الخاص به الذي ساعده على إكمال حضارته”، ولكننا سنتغاضى هنا عن غموض هذه الأفكار والتباسها وخروجها عن مسار القصة أو عدم قدرة السيناريو على صياغتها وغرسها بشكل مقنع في إطار الحبكة التي تدور حول الفكرة الأساسية أي لعبة القط والفأر. كما سنتغاضى أيضا عن هشاشة فكرة رعب السلطة من هذه الأفكار بحيث يوحي بأنها تكره العلم والثقافة وتخشى كثيرا تأثيرهما، وهي مسألة خلافية (فهل السلطة تخشى الثقافة في المطلق، أم تهتم بما يمكن توظيفه منها لخدمة أيديولوجيتها، سواء من التراث الفرعوني أو غيره؟)، ونتوقّف أمام بعض التساؤلات (النظرية الافتراضية) من داخل الفيلم نفسه، أو ممّا يمكن استنباطه من داخل نسيج الفيلم.
أولا: لماذا يلجأ “رشدي أباظة” إلى نمط تقليدي مثل “سمير عليوة” الذي تجاوز منتصف العمر، ويميل بوضوح إلى الكسل والخضوع، ولا يمتلك طموحا، ولا طاقة له على التعامل مع لغة الميديا الحديثة ووسائل الاتصال الرقمية التي سيضطر لاستخدامها من دون أن يكون قد تدرّب عليها، هل يرجع السبب إلى أن “الأصليين” يستغلّون ظروف سمير الشاقة بعد أن فقد وظيفته مثلا؟ ولكن لماذا سمير وما هي مميزاته؟
إن نموذج سمير، هو ما يريد الفيلم تقريبه إلى أذهان المشاهدين باعتباره نموذجا شائعا للإنسان المتوسط، الخاضع، المستسلم، الجبان بحكم تركيبته الذي لا يميل إلى التمرّد، محدود الطموحات، وبالتالي يسهل تطويعه وترغيبه بإسناد ذلك العمل الجديد إليه، ضمن جهاز هائل للتجسّس على المواطنين، وإغرائه بالمال الذي سيجنيه من هذا العمل، وهو في أمسّ الحاجة إليه بعد أن تراكمت الديون عليه.
وبعد أن يبدأ سمير العمل، يتلصّص على حياة وتصرّفات ثريا جلال، يتوقّف فقط أمام كون حبيبها يخونها مع امرأة أخرى، هذه المعلومة يعتبرها رشدي أباظة الأهم على الإطلاق، لأن الفشل في الحب قد يؤدي بصاحبه إلى الشعور بالإحباط ثم اللجوء لأعمال معادية للمجتمع، غبر أن ما تتمتع به ثريا من رؤية جديدة وشخصية قوية وجاذبية أنثوية، تجذب سمير إليها، وتدفعه لمخالفة تعليمات رشدي وحضور إحدى محاضراتها، لا لكي يناقشها في أفكارها، بل ليبلّغها عبر رسالة مكتوبة بأن حبيبها يخونها.
لكن ما مغزى ولع سمير، حدّ الإدمان، بشراء الصحف القديمة وترتيبها في أكوام كبيرة داخل غرفة صغيرة خاصة في شقته على نحو يذكرنا ببطل الفيلم التركي “من 10 إلى 11” (2009) للمخرجة بيلين أسمر؟ هل يعكس هذا مجرد حنين لدى سمير لتكديس وتخزين أوراق تنتمي إلى الماضي، خاصة وأنه لا يقرأها أبدا، بل يكتفي بمطالعة عناوين بعضها بين وقت وآخر؟
هل هي رغبة في تجميد الزمن هربا من الحاضر الخانق داخل هذه الغرفة الخانقة التي تحتوي على الصحف القديمة، وتحريم دخولها على أفراد أسرته وانزعاجه إذا ما فاجأته زوجته بداخلها وكأنه يقوم بفعل “سرّي” مثلا؟ ليس هناك تفسير محدّد، فالأمر متروك لكي يفسّره كل منا طبقا لاستقباله له.
سمة الغموض والإخفاء والتلويح بالإشارات، تبرز في الفيلم كثيرا، وربما كانت تضفي عليه جمالا خاصا، لكن الجمهور الذي اعتاد الشرح وتفسير الدوافع يجد بالطبع صعوبة في التفاعل مع هذا النوع من السينما المختلفة.
رشدي أباظة اسم وهمي دون شك، وهو يوحي بالرغبة في المداعبة والسخرية أيضا التي تميّز أسلوب الشخصية، وميلها للشعبويّة، إنه يترك نفسه يتطوّح مع الصوفيين الذين يتطوّحون وهم ينشدون الأذكار، ويساهم في أعياد الأقباط ويندمج في احتفالاتهم، ثم يصل إلى قمة العبث عندما يجذب سمير معه في رحلة ليلية وسط الأشجار الكثيفة، ليسمعه صوت امرأة “نداهة”، غالبا ساحرة أو بالأحرى محتالة، ثم يعترف له بأنه نجح أيضا في “تجنيدها” لحساب الأصليين.
هذه الشخصية التي يتقمصها خالد الصاوي ببراعة كبيرة، تستدعي إلى الأذهان صورة ضابط الأمن (أو المخابرات) الذي يكون عادة ناعما، رقيقا، استدراجيا، إغوائيا عند تعامله مع “عميل مفترض” يقوم بتجنيده، لكن هذا لا يمنع من أنه عند الضرورة، أو عندما يقتضي الأمر، يكشف عن وجهه القبيح مهدّدا ومنذرا بالتهام ذلك “الفأر” الذي وقع في المصيدة، فالقط رشدي يتسلّى بفريسته قبل أن يقبض عليه بأسنانه إذا ما حاول التملص.
يكتشف سمير أنه يمارس عملا في التجسّس لا يتلاءم مع شخصيته وتركيبته النفسية الانعزالية، خاصة بعد أن يجد نفسه منجذبا إلى شخصية ثريا التي هي نقيض شخصية رشدي، فهي التي تنتمي حقا إلى “الأصليين”، أي المصريين الباحثين عن “الأصالة”، أما جماعة “روح الوطن” التي تنسب لنفسها الأصالة في مقابل وصم غيرها بالشك والاشتباه، فهي أساسا منظومة السلطة الشمولية الاستبدادية.
وفي الحوار بين سمير ورشدي يكرّر رشدي في أكثر من مشهد “ليس هناك أحد لا تتم مراقبته”، وأن كل الناس مشبوهون “إلى أن يثبت العكس”، وعندما يتساءل سمير بدهشة “هل تراقبون التسعين مليون”؟ يجيبه رشدي “يهمنا منهم 54 مليون”، أما كون “الأصليين” بالملايين وقد يكونون أيضا “أقرب الناس إليك فهي عبارة بليغة تتأّكّد ببراعة عندما تكشف الأم لسمير عن أشياء خاصة كان يمارسها في مراهقته لا يعرفها غيره، ليستنتج بالتالي أنها من “الأصليين”!
وعندما يخالف سمير التعليمات ويسعى للاقتراب من ثريا، يكون كل عقابه مجرّد وشم على ذراعه لتذكيره بضرورة الانصياع، ولكن إذا كان سمير قد تمرّد على الأصليين في النهاية، فما الذي ترتّب على هذا؟
الإجابة لا شيء، فهو لم يدفع الثمن، فلا هو منع من مغادرة البلاد، ولا ألقي القبض عليه، ولا انتهى -كما كان متوقعا مثلا- نهاية شبيهة بنهاية “هاري كول” بطل فيلم “المحادثة” (1974) لفرنسيس كوبولا، حينما أخذ يبحث في أرجاء منزله عن أجهزة التصنّت محطما كل محتويات المنزل، ثم جلس بين الحطام بعد أن يأس من الوصول للحقيقة.
وسمير -كما نعلم في المشاهد النهائية- يتمكّن من الفرار من القاهرة إلى الواحات لكي يُحوّل قطعة الأرض التي ورثها عن أبيه، إلى منتجع سياحي، ثم يسافر إلى ألمانيا للاتفاق على جلب مجموعة سياحية، من دون أن يتعرّض له أحد أو يعاقبه على مخالفته شروط “العقد” الذي وقعه مع “الأصليين”، وإن كنّا نشاهد في اللقطة النهائية رشدي وهو يتأهّب لركوب الطائرة مع سمير، فهو ما زال يتتبّعه ويراقبه، وتعليقه من خارج الكادر على شريط الصوت يؤكّد أن لا أحد يمكنه الخروج من مزرعة الدواجن، فهل سينزل العقاب بسمير؟ ربما لكن ألم يتأخر العقاب طويلا؟
ما الذي يترتّب أيضا على عمليات المراقبة المعقدّة التي تشمل الملايين من المصريين؟ لا يوجد نموذج واحد في الفيلم يشي بوقوع أي نوع من “العقاب”، وحتى عندما يقول رشدي أباظة لسمير إنهم يراقبون شخصا يشكّل خطرا ما، ويسأله سمير لماذا لا يقبضون عليه؟ يستنكر رشدي الاقتراح، ويقول إنهم لا يقبضون على أحد.
إنهم أقرب إذن إلى شرطة الفكر، لديهم نهم خاص لجمع المعلومات، كل المعلومات، حتى عمّا يتناوله المرء من طعام وشراب، والواضح أن منظومة القهر عند “الأصليين” أكبر من مجرد منظومة وظيفية، بل “منظومة وقائية”، فهل هي مرتبطة بمنظومة أخرى عالمية أكبر وأشمل؟
هذا التساؤل وغيره يظل من دون إجابة، لكن ميزة الفيلم، الذي لا شك أنه منسوج ببراعة كبيرة، تكمن في قدرته على إثارة الكثير من الأفكار والتساؤلات، وفي الوقت نفسه، من الواضح أن صنّاع الفيلم حرصوا على ألاّ يتسبّب الفيلم في اعتراضات من جانب الرقابة، فاللجوء إلى الرمز والإشارة لا يكون دائما اختيارا فنيا، بقدر ما يلجأ إليه الفنانون الذين يعملون في مجتمعات استبدادية.

ويتمتع فيلم “الأصليين” بأداء تمثيلي ممتاز من البطلين الرئيسيين بوجه خاص، وبصورة ممتازة، وموسيقى ملائمة لطبيعة الموضوع وغموضه، مع قدرة على ابتكار تكوينات مدهشة. ويعتبر الحوار من المعالم المتميزة في الفيلم، بإيحاءاته ومراوغاته وإسقاطاته القوية، ومع ذلك يعاني الفيلم من بعض الاستطرادات الزائدة في مشاهد محاضرات ثريا وما يكتنفها و”مونولوجاتها” الطويلة المفتعلة من حيث الكلمات، وخروج المشاهد التسجيلية المصنوعة لأسطورة ياسين وبهية عن السياق، بينما كان الأفضل استبعادها تماما من الفيلم لتجنّب الدخول في متاهات فكرية جديدة، مثل نسبية الحقيقة والتشكيك في الروايات الشائعة لأحداث التاريخ. عندها كان يمكن أن يصبح الفيلم أكثر قوة وإحكاما، خاصة لو اختار صانعوه تصوير نهاية رمزية تتناغم مع موضوع الفيلم وأسلوبه، فالتمرّد الفردي على “النظام” عادة ما ينتهي بهزيمة قاسية.
أخرج مروان حامد “تراب الماس” في عام 2018. ولا شك في الطموح الفني الكبير الذي يتبدى في الفيلم، أولا على أيدي مروان حامد مع شريكه أحمد مراد الذي كتب السيناريو عن روايته، من ناحية طرقهما موضوعا يبدو للوهلة الأولى قاسيا قاتما، ثم في استخدام التعليق السياسي النقدي الرصين بشكل غير مباشر، أي عكس المألوف في أفلام النقد السياسي في السينما المصرية.
ويبدو الطموح ثانيا في تلاعب السيناريو بالسرد، الذي يتخذ نسقا متعرجا، يروح ويجئ، ينتقل حينا بين الماضي والحاضر، ويعتمد حينا آخر، على استدعاء الأحداث التي عاشتها الشخصية الرئيسية في الفيلم، وهي كما أرى، ليست شخصية الصيدلي الشاب “طه”، بل شخصية والده “حسين الزهار” التي يقوم بأدائها باقتدار وتفوق وسيطرة مدهشة، الممثل أحمد كمال. وفي ظني أن من أكثر عناصر الفيلم بروزا وقوة بدا في اختيار الممثلين، باستثناء الممثل اللبناني عادل كرم الذي قام بدور رجل الأعمال الملياردير المثلي الجنس “هاني برجاس” الذي لا يتورع عن اللجوء للقتل تجنبا للفضيحة، فقد بدا تائها غريبا على الدور، عاجزا عن التكيف مع الشخصية، خاصة وأنه غير مدرب بدرجة كافية على الأداء باللهجة المصرية.

وعلى نحو ما، يذكرنا “تراب الماس” بفيلم “سائق التاكسي” (1974) لسكورسيزي، فهو ليس فقط عن الانتقام الفردي، بل – أساسا- عن “تطهير” المجتمع بالمعنى الأخلاقي، فكما كان ترافيس بيكل بطل “سائق التاكسي” العائد من فيتنام يستخدم العنف لتطهير المجتمع من الفساد الأخلاقي، يدبر “حسين الزهار” عمليات متعددة لتطهير البلد ممن يعتبرهم مسؤولين عن الفساد الذي يتمثل في استغلال النفوذ (عقيد الشرطة وليد سلطان)، تجارة المخدرات (الضابط مع سليمان اللورد)، الشذوذ الجنسي (هاني برجاس)، وتجارة الجنس لحساب الطبقة الراقية (القوادة بشرى)، مع لمسة جريئة دون شك، من نقد الفساد السياسي كما تشير شخصية عضو البرلمان “محروس برجاس” الذي تخصص في “تفصيل القوانين” لإرضاء السلطة في كل العصور.
شخصية “محروس برجاس” التي يؤديها عزت العلايلي، ليس من الممكن أن تظل فاعلة في الواقع وفي خدمة السلطة كما نرى، حتى 2018 إلا أن يكون الرجل قد تجاوز الثامنة والتسعين من عمره مثلا، فنحن نشاهد صورا له مع الملك فاروق ثم محمد نجيب وعبد الناصر.. وغيره، لكن ربما كان وجوده رمزيا. أما موقف الفيلم من الصراع السياسي بين نجيب وعبد الناصر فيتضح منذ المشاهد الأولى في الفيلم التي يسترجع خلالها الزهار وقائع ما جرى في مصر بعد يوليو 1952، والصراع بين نجيب وناصر، الذي ينتهي بعزل نجيب والاتجاه إلى “الدولة الشمولية”.
يتحسر الفيلم أيضا على مجتمع التعدد العرقي والثقافي في مصر قبل 1952 ووجود الأقليات كالأقلية اليهودية التي يمثلها في الفيلم تاجر المجوهرات “ليتو” (بيومي فؤاد)، وكان يرتبط بصداقة وطيدة مع “حنفي الزهار” (سامي مغاوري)، جد طه ووالد حسين، وهو “اليهودي الطيب” الذي يقف إلى جانب حسين بعد وفاة والده، يتولاه بالرعاية ويسند إليه عملا في دكانه، بل وينفق على استكمال تعليمه.
ورغم تعاطف الفيلم الواضح مع اليهود المصريين إلا أنه يدينهم ويصمهم بالخيانة الوطنية عندما يكتشف حسين (الطفل) أن “ليتو” جاسوسا يعمل لحساب إسرائيل في 1956، فيقتله باستخدام “تراب الماس” السام بعد خلطه بالشاي، وهي الطريقة التي تعلمها من ليتو نفسه عندما تخلص من قط ابنته الجميلة “تونا” (تارا عماد) بعدما أصيب بالسعار. ومع ذلك يستمر حسين في حبه لـ “تونا” حتى بعد أن تتطوع في جيش الاحتلال الصهيوني ثم تأتي لزيارة مصر وتلتقي به بعد معاهدة السلام في أواخر السبعينات.
دوافع شخصية
تبدو دوافع حسين الزهار للتخلص من الفاسدين في نطاق الدائرة التي يراقبها من نافذة غرفته من فوق مقعده المتحرك، دوافع شخصية، نتجت عن شعوره بالغضب والإحباط، فقد فشل في الالتحاق بالكلية الحربية (لغياب الوساطة)، وعندما تطوع في الجيش شارك في حرب 1967 وعاش الهزيمة المريرة وعاد الى حارة اليهود سيرا على قدميه (خذله القادة). وهو يتجه لدراسة التاريخ ويصبح نموذجا للمثقف الذي يتطلع الى أن تصبح مصر دولة ديمقراطية الحديثة، لكنه يصاب بالشلل بسبب اهمال طبي دون الحصول على أي تعويض، فيفقد وظيفته، وتهجره زوجته وتترك له ابنهما طه الذي يتعلم ويصبح صيدليا، لكن حسين يشاهد ذات ليلة، ما لم يكن مسموحا له بمشاهدته. وسوف نبقى حتى النهاية، قبل أن نعرف الحقيقة، وهنا يستخدم الفيلم ببراعة التواء الحبكة ليوحي لنا بالحقيقة دون أن تكون هي الحقيقة. ولكن عندما تتبين الحقيقة تأتي أقل من توقعاتنا. فرؤية ضابط شرطة فاسد يمارس فساده ليس بالأمر الجلل الذي يستوجب قتل حسين.
الضابط الفاسد
من أكثر شخصيات الفيلم قوة وانسجاما مع أحداثه، شخصية الضابط المنحرف “وليد سلطان” (ماجد الكدواني) فهو يبدو في البداية طيب القلب، لطيف، مجامل، ثم يكشف تدريجيا عن وجهه القبيح كشخص يتصف بالجشع والخبث والقسوة، وحتى بعد أن يتم وقفه عن العمل بعد أن ثبت أنه كان يراود سيدة على نفسها مقابل نقل زوجها الضابط من مكان عمله الى القاهرة، يحاول “وليد” أن يستخدم “طه” ويوظفه من أجل تحقيق أطماعه عن طريق الوعيد والتهديد وهو ما يفعله أيضا مع القوادة “بشرى” (شيرين رضا).. لكنه لا يمارس التعذيب والقهر وخطف المعارضين السياسيين أو قتلهم واخفاء جثثهم أو تلفيق التهم لهم وتقديم شهادات مزورة أمام القضاء. لذلك ينحصر الفساد في الفيلم في الانحرافات الفردية لا في النظام السياسي عموما. ومع ذلك يقول الفيلم إن الحالات الفردية لم تعد فردية بل شملت قطاعات واسعة في المجتمع، من النخبة ومن القاع.

لا يبدو أن ثمة أهمية لوجود شخصية المذيع التليفزيوني الانتهازي شريف مراد (أياد نصار) الذي يغتصب بالقوة والعنف زميلته “ساره” (منة شلبي) بعد أن تكتشف خيانته لها، رغم أنه سبق أن مارس معها الجنس كما صورها على أحد شرائطه مثل غيرها، ويبدو من العسير أن نصدق ما يحاول الفيلم اقناعنا به فيما بعد، أن “ساره” أقنعت شريف بأنها غفرت له اعتداءه الوحشي عليها وعادت إلى حبه، فقط لكي تنتقم منه بالطريقة التي علمها إياها طه، أي بوضع حفنة من تراب الماس في كأس الشاي!
مادة “تراب الماس” اختلسها حسين الزهار من اليهودي ليتو، وطعمها لا يمكن الإحساس به في الشاي، وهي تسبب الأعراض الرهيبة التي نراها في الفيلم ثم الموت حلال أسابيع معدودة، مع ملاحظة أن اليهودي “ليتو” هو أول من استخدمها في الفيلم ومنه تعلم حسين الزهار. أما طه فيستعين بمنشار كهربائي لتقطيع جثة “السيرفيس” (محمد ممدوح) أو “البلطجي” القاتل الشرير الذي كان يستخدمه الضابط في تصفية وترويع الآخرين، لكنه يضع الجثة في حامض الكبريتيك داخل البانيو، قبل أن يقوم بتقطيعها، ثم ينقلها بعد ذلك في حقيبة كبيرة إلى المقابر، فإن كان قد تم تذويبها في الحامض فلماذا ينقلها!
تتردد في الفيلم أكثر من مرة، فكرة تطهير المجتمع من الأشرار (بعيدا عن القانون)، أي بالطريق الفردي كما يفعل حسين الزهار، أو حتى على لسان الضابط وهو يقول لطه ذات مرة، مبررا تجاوزاته للقانون “إلى حين أن يصبح هناك قانون”. ويتكرر ظهور الغراب الأسود كرمز للموت القادم، ويتكرر الحلم الذي يتنبأ بالموت ويرويه الزهار لترويع ضحاياه قبل أن يتركهم بعد وضع السم لهم.
لكن إذا كان حسين الزهار قد فعل ما فعله مؤمنا بأنه “صاحب رسالة”، فابنه طه يستكمل دور والده فقط بدافع الانتقام الشخصي ممن تسببوا في قتله. فهو يقتل البلطجي “السرفيس” ثم الضابط، ويدخر حياة هاني برجاس الذي يعيش ليستمر في الفساد. ولا يدين الفيلم الحل الفردي، بل يتوقف عند مقولة تتردد أيضا أكثر من مرة وهي أنه “أحيانا يمكن معالجة خطأ كبير بخطأ صغير” وإن كان ينتهي بفكرة “ضرورة أن يراقب الصغار الكبار”، إضافة الى القصة التي ترويها العمة “فايقة” (صابرين) لطه عن “القاتل العادل” الذي ينتهي بالموت على أيدي من كان يقتل لأجلهم.
أسلوب الإخراج
هناك اهتمام واضح في الفيلم بالتكوين والإضاءة وحركة الكاميرا، وعناصر الصورة عموما، على نحو يضفي جمالا خاصا وغموضا ساحرا على الفيلم خاصة في نصفه الأول، وتٌظهر مواقع التصوير التي اختيرت بعناية فاقة، التناقضات الطبقية بين مجتمعات النخبة التي تحتكر الثروة والنفوذ، وبين الفئات المحرومة، كما يعكس ديكور وإضاءة شقة الزهار، جوا كابوسيا خانقا، فالمكان ينضح برائحة القدم وعلامات تعاقب الزمن بما في ذلك واجهة العمارة التي يقيم فيها، وفي الداخل تنتشر الكتب القديمة والصحف، وتشي الإضاءة الخافتة التي تصطبغ باللون الأصفر والبني، بقتامة الشخصية وسريتها، وتدعم موسيقى هشام نزيه هذا الاحساس كما تعكس في باقي أجزاء الفيلم، أجواء القلق والتوتر والصراع الذي يدور داخل شخصية “طه”. ويستخدم مروان حامد زوايا التصوير الغريبة كما في اللقطة المصورة من أعلى للحمام من زاوية قائمة تقريبا بعد وضع جثة “السرفيس” في الحامض. ويأتي بعد ذلك مباشرة الانتقال المنطقي من تلك اللقطة الخانقة مع تصاعد الأبخرة الخانقة داخل الحمام، إلى لقطة عامة من بعيد لطه وهو يقف في نافذة الغرفة يتطلع إلى الخارج وهو يستنشق الهواء النقي بينما تتقدم العدسة نحوه تدريجيا.
السرد المتعرج الذي ينتقل بين الأزمنة يبرز حضور شخصية “حسين الزهار” وسيطرته على مجمل أحداث الفيلم رغم موته في نهاية المشهد الأول. وينجح مروان حامد في التغلب على الطابع الأدبي للسرد الذي نسمعه بصوت الزهار تارة، وبصوت الضابط تارة أخرى، في استعادة الأحداث من وجهة نظر كل منهما، أولا عن طريق مذكرات الزهار المكتوبة التي تمر على أبرز الأحداث السياسية التي شهدتها مصر، وثانيا من خلال ما يرويه الضابط لطه، فقد استخدم مروان بالتعاون مع المونتير، تداعي الصور واللقطات بطريقة شبه تسجيلية، مع تعدد زوايا التصوير (تصوير مشاهد تدور في المقابر له طابع خاص يكتسي بالرهبة). كما ينجح مع المونتير (أحمد حافظ)، في خلق إيقاع متزن، متدفق، متوازن، وبفضل مدير التصوير محمد المرسي، يأتي الفيلم في صورة شديدة الجمال والصدق معا سواء في التكوين أو حركة الكاميرا (الحركة البطيئة من اليسار لليمين أو حركة المتابعة أو الكاميرا المهتزة، التي توحي بالدوار والترنح) مع دقة شديدة في اختيار العناصر التكميلية للصورة (الصور التي تمر عليها الكاميرا على الجدران والاكسسوارات سواء داخل شقة ليتو اليهودي وشقة الزهار ومكتب محروس برجاس). وينجح مدير التصوير في خلق علاقة بصرية جيدة بين الشخصيات والأماكن.
يتميز التصوير الخارجي سواء في المشاهد المصورة بالأبيض والأسود والتي تستدعي الماضي، في الخمسينات، خاصة مشاهد حارة اليهود، والبيوت والأزقة الضيقة وأجواء الفجر.. وغيره ذلك، أو في المشاهد التي تعكس الزحام والضجيج في الأحياء العشوائية عندما ذهب طه ليختفي بعد أن تمكن من وضع السم للضابط. وبين الحدثين نرى في مشهد “فوتومونتاج” بديع صامت يوجز الكثير من الأحداث، فنرى الضابط مع أتباعه من “البلطجية”، يقومون بتفتيش شقة طه ويبحثون عنه دون جدوى، ثم نرصد تدهور الحالة الصحية للضابط إلى أن نقرأ خبر وفاته منشورا في الصحف، ثم العزاء الذي يحضره طه.
كان يمكن اختصار بعض المشاهد لكي يصبح إيقاع الفيلم أكثر دقة، مثل مشهد قتل الصبي الشاذ “كريم” في السجن، واستبعاد مشهد إصابة طه بنوبة صرع خاصة أنه لا يضيف شيئا من الناحية الدرامية، واختصار رد فعل طه بعد أن يعلم بموت والده فيغادر الفراش ويسير في ردهة المستشفى وهو يجر خلفه جهاز نقل المحلول، ينادي على أبيه وهو يتطلع يمينا ويسارا، ويبحث عنه، ثم يصرخ وينهار. وكان يمكن الاكتفاء بتصوير رد فعل طه في لقطة واحدة. لكن هذه المغالاة في تصوير المشاعر من العلامات الراسخة في الفيلم المصري.
ورغم أي ملاحظات سلبية على الفيلم، يبقى أحد الأعمال المهمة في مسيرة مخرجه ومحاولة لاختراق الطابع التقليدي العتيق في السينما المصرية، وتجربة تجمع بين العمق والغموض والقابلية الجماهيرية.
فصل من كتاب: السينما المصرية خارج الصندوق””