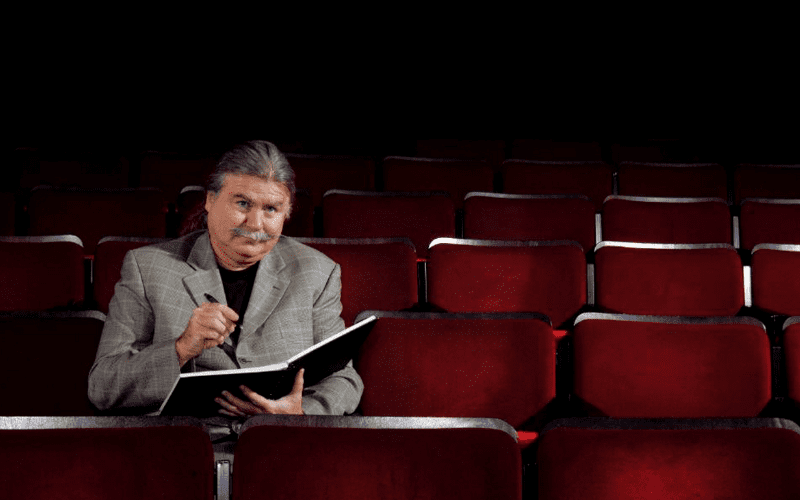متى سنخرج من عباءة السينما الأمريكيَّة؟
يلاحظ المُشاهد لما يُعرَض في عالَمنا العربيّ من أفلام هذه الغلبة والتسيُّد لأفلام سينما واحدة فقط هي السينما الأمريكيَّة. فهي مسيطرة وذات انتشار طاغٍ على جميع وسائط النشر الفيلميّ. نذهب إلى دار السينما (وهي الوسيط الأصيل والأعظم) فنجد إمَّا أفلامًا عربيَّة وإمَّا أفلامًا أمريكيَّة، وقلَّما نرى أفلامًا لسينمات أخرى. وقديمًا كان المُشاهد يشتري -أو يستأجر- شريط فيديو (وهي الوسيط التالي) به أفلام أمريكيَّة، ثُمَّ حلَّتْ السيطرة نفسها عندما استُبدل الشريط بأقراص دائريَّة. وعندما نفتح القنوات المُتخصِّصة في عرض الأفلام (وهي الوسيط المنزليّ الأكثر انتشارًا) نجدها مليئة بالأفلام الأمريكيَّة.
ولا ينجو من هذه السيطرة على سلوك المُشاهدة العامّ إلا فئة النُّقَّاد -التي تهتمّ بغيرها من الأفلام قصدًا إليها-، أو محبُّو السينمات الأخرى -وهؤلاء قليلون- فيبحثون عنها رأسًا، وكذلك تقديم بعض الأسابيع الأوربيَّة أو غيره هنا وهناك. أمَّا فئات المشاهدة العامَّة وهي السواد الأعظم من مُشاهدِيْ الأفلام ومُتلقِّي السينما فهم محصورون بين ثنائيَّة الفيلم العربيّ أو الأمريكيّ. كانت برامج التلفاز المصريّ قديمًا تقدِّم أفلامًا من سينمات أخرى في برامج مخصَّصة لها. والآن ينفكّ هذا الحصر بين هذيْن الخياريْن عن طريق وسيطَيْن: منصَّات البثّ المُباشر، خاصةً منصة “نتفلكس” التي تنتج أو تشتري أفلامًا من بلدان مختلفة وتسعى إلى توسيع هذه الرقعة، ومنصَّات قرصنة المحتوى السينمائيّ التي تعرض أفلامًا من هنا وهناك.
نطرح هذه القضيَّة “سيطرة السينما الأمريكيَّة وضرورة الخروج منها” لأهميَّتها الشديدة، ولكونها دراسة للتلقِّي الفنيّ. فالفنّ مُرسِل ومستقبل؛ وهذا السلوك “الاستقبال” أو التلقِّي في الفنّ السينمائيّ هو فعل المُشاهدة. فموضوعنا هذا يتعلَّق بالتلقِّي الفنيّ من جهة، وبالوعي العامّ من جهة أخرى كما سيتضح. وفي القادم سنطلع سويًّا -وفي اختصار بالغ- على بعض من أسباب هذه القضيَّة، وعلى أخطارها علينا كمُشاهدين.
أسباب سيطرة السينما الأمريكيَّة:
جودة المنتج السينمائيّ الأمريكيّ. فرواج أيّ منتج -فنيّ أو غير فنيّ- يتوقف على مدى جودة هذا المنتج -إذا تساوى السعر-. ولا شكّ أنَّ السينما الأمريكيَّة سينما جيدة وذات إتقان؛ خاصَّةً في صناعة التغليف أو الإبهار البصريّ. وهذا العنصر له تأثير ضخم في رواج هذه السينما ومدى الإعجاب بها على نطاقات واسعة. وكذلك في صنعها لأنواع معيَّنة تناسب الذائقة الشعبيَّة -في الغالب- مثل أفلام الرُّعب، والجريمة، والإثارة (هذا لا يعني إطلاقًا أنَّ هذه الأفلام بها عوار في فكرة “الفنّ”، ولا يعني الانتقاص منها).
الإعجاب بالنموذج الأمريكيّ والاعتقاد بسيادته وبأنَّه أفضل نماذج الحياة بين الدول (وسنرى أنَّ السينما الأمريكيَّة هي التي ابتدعتْ هذا الإعجاب أصلاً). وهذا السبب قديم سيطر على القرن الماضي كلَّه؛ خاصَّةً بعد تخلُّص الولايات المتحدة من العدوّ السُّوفيتيّ وتقرير مركزيَّة ما يُسمَّى بـ”الحُلم الأمريكيّ”. هذا الحُلم الذي استولى على مُخيِّلة الشعوب -خاصةً الأفقر منها والمملوءة قهرًا- بأنَّ أمريكا هي جنَّة الله الجديدة على الأرض، كما كانت روما القديمة وبيزنطة وبغداد وقرطبة.
الإقبال على اللغة الإنجليزيَّة لأنَّها صارتْ اللغة العالميَّة، وأيضًا تدريسها في المدارس منذ القديم. وهنا نجد علاقة الارتباط بين المُختَزَن في العقل وفي النَّفس وبين الذي نسمعه ونراه؛ -ولذلك نرى الاستهجان السمعيّ و بعض المزاح عندما يُعرض فيلم من كوريا مثلاً- لأنَّ النَّفس تعتاد وتألف. ولهذا التقارب اللُّغويّ نرى أنَّ الجُزء الغربيّ من العالم العربيّ -الذي كان مُحتلاً من فرنسا، ونشرتْ فيه الفرنسيَّة- له تداخل مع السينما الفرنسيَّة أكثر من الجزء الشرقيّ.
ظهور وطغيان ما يُسمَّى بـ”العَولَمَة” وهي في نهاية الأمر تسيُّد النموذج الأمريكيّ على العالَم أجمع. لكنْ يُعرِّفها الباحث الفلسفيّ الكبير د/ مصطفى النشَّار في كتابه “في فلسفة الثقافة” بأنَّها “التقارُب الذي يحدث بين شعوب العالَم المختلفة لدرجة ذوبان الفوارق الحضاريَّة بينها، وصهرها جميعًا في بوتقة ثقافيَّة واحدة ذات خصائص مشتركة واحدة”. ولمَنْ لمْ يشهد هذه المعركة المُزيَّفة في نهاية التسعينيَّات وبداية الألفيَّة الجديدة فهي حركة اكتشف العالَم كلّه بعدها أنَّها هيمنة أمريكيَّة محضة، وأنَّ أمريكا قد أرادتْ للعالَم بعد أن أصبح قرية صغيرة أنْ ترفع علمها عليه وحيدًا خفَّاقًا، ويصير الكلّ أمريكيّ الثقافة والاتجاه لكنْ دون أيّ حقوق أو مُقابل، في حركة تُسمَّى “الأمْرَكَة”.
الدعم الهائل لمنظومة السينما الأمريكيَّة من الدولة الأمريكيَّة وأطرافها السياسيَّة، ومن منظومات عالميَّة يهوديَّة -بل صهيونيَّة- وذلك لمدى الاستفادة التي تحققها لهم هذه السينما -سنتناول هذا في الأخطار-، وبالقطع بسبب الأرباح التجاريَّة الضخمة التي تعود عليهم من ورائها.
هذه وغيرها هي الأسباب التي أدَّتْ إلى هذا التسيُّد للسينما الأمريكيَّة. ولنا هنا أن نعرف أنَّ العالَم العربيّ ليس المكان الوحيد الذي تهيمن عليه، بل يعاني من هذه الهيمنة كلّ العالم لأنَّ هيمنة أمريكا السينمائيَّة لا تنفكّ أبدًا عن الهيمنة الكُليَّة، بل هي أكبر وسائلها في هذا. والآن ننتقل لأهمّ الأخطار لهذه السيطرة.
أخطار هذه السيطرة الأمريكيَّة علينا:
يتمثَّل الخطر الأكبر في توحيد الذائقة الجماليَّة عند المُتلقِّين. وهنا يجب أنْ نشرح أشياء ضروريّة؛ فإنَّ لكُلِّ ثقافة طابعًا يطبعها ويشيع فيها هو الذي يُكوِّن خصوصيَّة هذه الثقافة، ويرسم ملامحها كملامح الإنسان، حتى إذا رأيتها عرفتها من تلك الملامح. وكمثال يقرِّب الفكرة قارنوا بين إخراج “كريستوفر نولان” وبين إخراج “تارنتينو” فمَن يعرف كلاً منهما إذا عُرض عليه فيلم دون ذكر اسم المخرج فسيعرف إلى أيّ فيلم ينتمي هذا الذي يراه. عرفه بملامح الإخراج وطابعه وهذا السمت الذي يميِّز شخصًا عن شخص وإبداعًا عن إبداع. وكمثال آخر أقرب لقضيَّة الحضاريَّة إذا عرضنا على المُهتمّ شِعرًا مترجَمًا للشاعر الهنديّ الكبير “طاغور” وآخر للشاعر الفلسطينيّ الكبير “محمود درويش”، وكلاهما سطور شعريَّة -أيْ ليس شعرًا عموديًّا- فسيعرف هذا المهتمّ شعر كلٍّ وسينسبه إليه.
عرف هذا وهذا، وميَّز بين ذاك وذلك من هذا الطابع الخاصّ لأسلوب الفنّ، ولإبداع التشخُّص، ولخصوصيَّة الحضارة في النصّ أو العرض، ولتأثير الثقافة فيه. فالمخلوق الذي يُسمَّى فنًّا يُركَّب من هذه العوامل، ولا يمكن فصلها عنه لا أصلاً ولا فرعًا -أرجو أنْ أكون واضحًا كفايةً-. فلنتخيَّلْ نحن المُشاهدين -في ظلّ هذا الذي عرفناه- أنَّنا نشاهد طابعًا واحدًا، ونمطًا متميِّزًا، من الفنّ السينمائيّ كلّ هذه السنوات. هذه المُشاهدة تؤثِّر فينا تأثيرًا مباشرًا -سيأتي الحديث عنه- وتأثيرًا أعمق ينصبّ على جهازنا التذوقيّ -أيْ قدرات الإنسان التي تتذوَّق الأفكار والجمال وهي مُوازية لأجهزته الحيويَّة مثل الجهاز الهضميّ مثلاً.
هذه الذائقة قد أصيبتْ بفعل هذا التوحُّد في التلقِّي، فلمْ تعد قادرةً على تذوق الجمال؛ لسبب بسيط هو أنَّ قدرة الإنسان على التذوق واكتشاف الجمال رهينة بمدى اتساع أفقه في فعل التذوق؛ فمثلاً لا يمكن أن أستشير إنسانًا في ملابسي وهو لا يعرف شيئًا في تذوق الجمال في هذا المجال، وكذلك مَنْ لمْ يأكلْ إلا صنفًا واحدًا من الصعب جدًّا أنْ يكون ذوَّاقًا أو متذوِّقًا سليمًا أصلاً لأنَّه لا يعرف غير هذا الصنف الذي أدمنه.

يتصل بهذا خطر آخر هو “تنميط النموذج الجماليّ” السينمائيّ، وحصره في النموذج الأمريكيّ. وعليه تكون هذه السينما الأمريكيَّة -في نظر هذا الذي تنمَّطَ لديه الجمالُ- معيارًا للجمال والفنّ، ويقيس بها مقدار الفنّ والجمال في أيّ عمل آخر. وهذا أدَّى بنا إلى سلوك إبداعيّ بالغ السوء؛ أنَّ سينمانا العربيَّة صارت رهينة هي الأخرى بالسينما الأمريكيَّة ناقلة مباشِرة منها، مقتبسة منها كلّ شيء. وذلك -من بين أسباب أخرى- أنَّها رأتْ أنَّ المُشاهد يُعجَب أيَّما إعجاب بالنموذج الأمريكيّ، ويُقبل عليه كلَّ الإقبال. وبما أنَّها راغبة في مُجاراة ما يحدث، وأنَّها تسترضي دومًا ذائقة المُشاهدين -أيْ تقدِّم لهم ما يريدون أنْ يروه- فها هي تتبع سيدها كلّ الاتباع -لا أقصد إلا الأفلام التي تقلِّد الأفلام الأمريكيَّة فقط ولا إساءة لبقيَّة الأفلام في تاريخنا أو واقعنا الراهن بالقطع-. بل إنَّنا نرى وبعد سنوات طويلة من هذا الارتباط بين السينما المصريَّة ونموذجها الأمريكيّ تلك الأسواق السينمائيَّة العربيَّة الأحدث كالسينما في الخليج تقلِّد الأفلام الأمريكيَّة تقليدًا أعمى، وتتبعها في كلّ شيء -وأيضًا لا أقصد الجميع.
ومن الأخطار الناجمة عن هذا السلوك بالتبعيَّة حرمان الذائقة العربيَّة من غير الطعام السينمائيّ الأمريكيّ. وفيه ما فيه من جيِّد ومن سيِّء، ومِمَّا يُناسبنا ومِمَّا لا يناسبنا. لكنَّنا -قاعدة المشاهدة العريضة- حُرمتْ أو حرمتْ نفسها ابتداءً من رفاهية الاختيار بالإقبال على سينما واحدة. وهنا يأتي سؤال أعرف أنَّه سيُطرح عن أنَّ السينما الأمريكيَّة ليست واحدة بل متنوعة فلماذا لا نقتصر على تنوُّعها؟ والجواب واضح فالسينما الأمريكيَّة كالأدب الأمريكيّ أو الروسيّ أو أو… هو بالقطع متنوِّع فليس كلّ مَن ينتج فيلمًا سيكون من التصنيف نفسه أو في الموضوع عينه، وليس هذا أصلاً المقصود بالتنوُّع. فالتنوُّع المقصود هو التنوُّع الكُلِّي لا التنوُّع في داخل الإطار الواحد. ولعلَّ الكلام يكون أوضح إذا رأينا حقًّا أفلامًا أصيلة من ثقافات أخرى فسنرى مفهوم التنوع في التجربة البصريَّة والإنسانيَّة والإبداعيَّة. وأقول أفلامًا أصيلة لأنَّ كثيرًا من سينمات العالَم تفعل الفعل نفسه الذي تفعله السينما العربيَّة فتقلد السينما الأمريكيَّة وتحاكيها باعتبارها نموذجًا جماليًّا.
وهناك خطر يقع أيضًا بسبب هذه السيطرة هو وقوعنا تحت هذه الهيمنة التي قصدتها أمريكا من دعم أفلامها ونشرها في العالَم أجمع. فها نحن نشاهد الأفلام الأمريكيَّة فنرى هذا الأمريكيّ الذي لا يُقهر والذي ينقذ العالَم بينما بقيَّة أهل الأرض يقفون فاغِرِيْ الأفواهَ لا يعرفون كيف يستطيع الساحر الجبَّار فعل هذا بعبقريَّته التي لا تُبارى. وهذا السلوك لمْ ينتهِ لا من الأفلام الرفيعة ولا الهابطة ومثال على ذلك الفيلم الرفيع ” Tenet ” الذي صدر منذ أيام. وها نحن نجد اليهوديّ الذي يعرف كلّ شيء، والذي يسامح الجميع، والذي يضحك ويستبشر دومًا في وجه كلّ إنسان، وفي النهاية ينقذ الموقف ويفعل الصواب مثال على ذلك الفيلم الشهير ” Independence Day “، وغيره من أفلام لا نهاية لها تسبِّب لنا هذه الأوهام الاستعماريَّة الفكريَّة، وتغزونا ثقافيًّا وروحيًّا.
زرع ما يُسمَّى بـ”أسلوب الحياة أو المعيشة” ( Lifestyle ) الأمريكيّ ومساعدة هذا النموذج العَوْلَمِيّ في التسرُّب إلينا وإلى داخل ثقافتنا. وحتى لا أكرر كلامًا سأترك المجال للدكتور مصطفى النشار ليُبين لنا مساوئ النموذج الثقافيّ الأمريكيّ خاصة، يقول -بتصرُّف مِنِّي للاختصار-: “إنَّ الثقافة الغربيَّة عمومًا والثقافة الأمريكيَّة خصوصًا على حد تعبير أحد الفلاسفة ثقافة البُعد الواحد. وسلبيَّات هذه الثقافة على الصعيد الأخلاقي هي تغليب القِيَم اللَّذِّيَّة (قِيَم اللذة ويتعلَّق الأمر بمذاهب اللذة والمنفعة) على القِيَم الأخلاقيَّة، وكَمْ نادَىْ الفلاسفة والمفكرون بضرورة إعادة هذا التوازن في الثقافة الأمريكيَّة.. وتغيير المَثَل الأعلى للإنسان إلى ما يُسمَّى بالإنسان الاستهلاكيّ.. وشيوع مبدأ الغاية تبرِّر الوسيلة” (صـ66،65) من الكتاب المذكور آنفًا. وأضيف للدكتور الشيوع الأعظم لمبدأ “البرجماتيَّة” العمليّ الذي نراه في أن كلّ حياتنا الآن من كثرة استلهامه من النموذج الفلسفيّ الأمريكيّ الذي أنشأه.
والآن علينا نحن المشاهدين هذه المسئوليَّة.. لكنْ ما المطلوب؟ هل هو الاستغناء التامّ عن السينما الأمريكيَّة؟ .. بالقطع لا، بل المطلوب هو الترشُّد في كلّ شيء، والتنويع في مصادر التلقِّي والمشاهدة والتعلُّم والمعرفة. وأيضًا يظهر هنا دور آخر على النقَّاد الفنيِّين وضرورة نشر هذه القضيَّة وعيًّا، وتطبيقها في التناول الفيلميّ.
وهنا يجب أن نعلم أنَّ حياة أيَّة ثقافة في حركتها، وهذه الحركة لنْ تأتي إلا من الاطلاع أكثر والمناقشة أكثر. أمَّا دليل موت الثقافة فهو ثباتها وجُمودها عند حدّ لا تتعدَّاه. وهذا يكشف لنا ضرورة الاطلاع برؤية مُناقِشة ناقدة واعية على هذا وعلى ذاك. والمطلوب هو قارئ واعٍ ومُشاهد واعٍ ولنْ يأتي هذا الوعي من التوحيد في مصادر التلقِّي، بل من التنويع فيها، واختيار الأفضل والأحسن، ومعرفة ما المُناسب لنا نحن العرب وما هو غير المُناسب. فإذا فعلنا ذلك حقَّقنا معادلة بين أمور تؤدي إلى ما يُسمَّى بحُسن الإدراك.