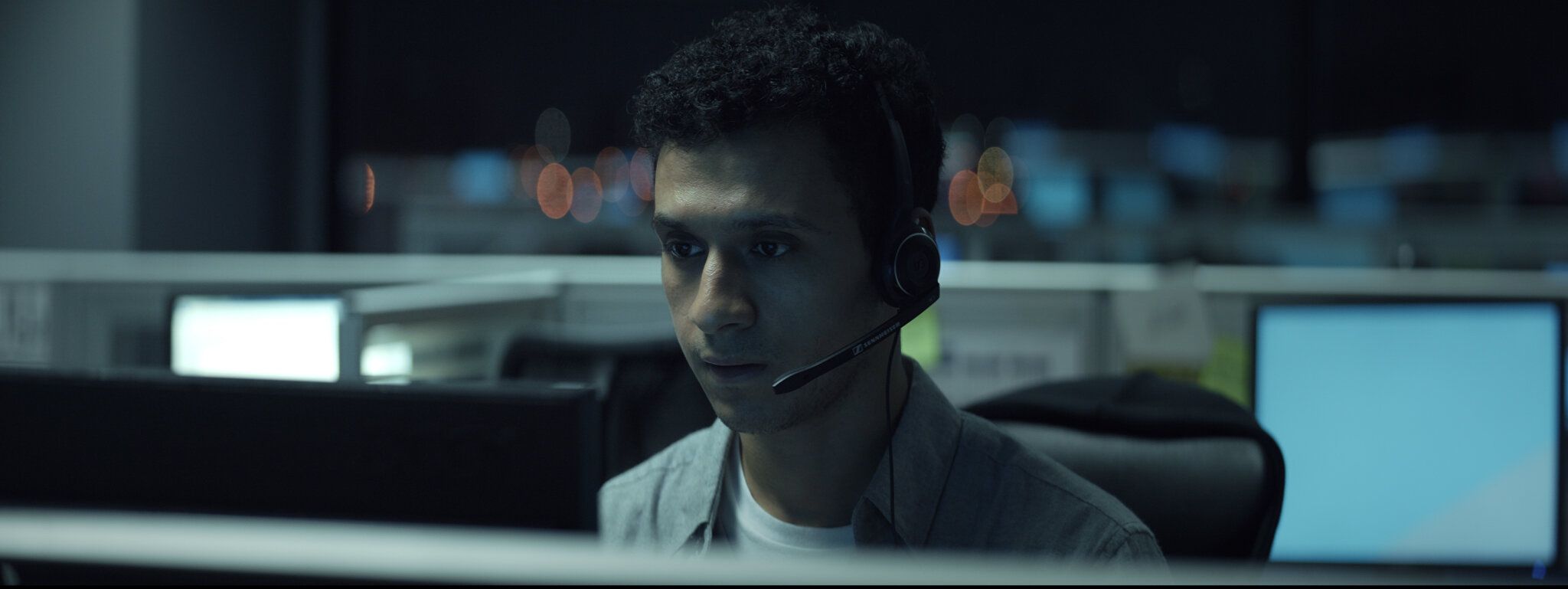قلب الأسد” وتساؤلات الراهن سينمائياً واجتماعياً وثقافياً

ما الذي يغري جماهير تعيش حالة من الانتشاء اللذيذ بعد تغيرات سياسية لا أعظم منها تمر بها بلادنا، لدفع ثمن تذكرة السينما، وهي لم تعد زهيدة، من أجل مشاهدة بطولة زائفة وزائغة في فيلم ضعيف درامياً وفكرياً كفيلم “قلب الأسد”؟
ما هي الأشياء المُفتقَدة على الأرض، وحاضرة هنا في شريط من إنتاج مجموعة من التُجار الشُطار الذين يدرون تماماً كيف تؤكل الكتف؟
في مواسم الصخب النفسي، والتحرش الجنسي الجماعي.. في الأعياد، يأتي فيلم “قلب الأسد” كخير مساير للموجة، أي موجة، وكراكب لها، مداعبا السخرية المصرية السياسية التي تسود الآن مُتبدية في استخدام ألفاظ من عينة خرفان وأسود، وما يصاحبها من دلالات فكرية تصف الإخوان الساقطين من الحكم تواً.
منذ اللحظات الأولى يعكف الفيلم على بناء أسطورة البطل الشعبي، الذي لا يُقهر، وكألعاب الفيديو جيم، لا يموت ولا يهوى، وكالأفلام الهندية القديمة يجد من كل حفرة مخرجاً، وفي كل أزمة درامية حلاً سحرياً، ساذجاً، لكنه بالأخير ينطلي، ولو أنه ربما ينطلي لأن مزاج هذا المشاهد/ الزبون يريد له الآن أن ينطلي.
لم تكن السينما التي يقدمها المنتج السينمائي محمد السبكي منذ سنوات منبوذة جماهيرياً، فأفلامه لم تزل تُنتج كي تُشتَم ثم تحقق إيرادات هائلة، وإذا كانت ثورة يناير قد قادتنا إلى تقديم مجموعة من البشارات تفيد بضرورة شرطية لتحسن الحال السينمائي، فإن الواقع جاء ليأخذ الصناعة كلها عشرات الخطوات إلى الوراء ويعرقلها اقتصادياً.

التغريدات القليلة الجميلة التي لاتزال تلتفت للسينما، وحيدة تماماً، ونتيجة مجهودات فردية مستقلة، لا يحتضنها شباك التذاكر كما يجب ولا تنصفها ثورة. وفي المقابل يحدث أن الذين كانوا يهاجمون السبكي ويشنون حملات لمقاطعة إنتاجه، صار بعضهم الآن يعامل شرائطه بالكثير من الأريحية والتبرير.
فنية أو تجارية؟
متى كانت أفلام الأعياد، معبرة عن حال السينما؟ ومتى كانت السينما المصرية سينما فنية لا تجارية؟ إن التيار العريض والعظيم لدينا تيار تجاري لا يصنع الموجة بقدر ما يجيد امتطائها، وأمام هذه الذائقة التي تفضل الآن مهرجانات أوكا وأورتيجا يصبح الغزل العفيف لها نوعا من السفه، والغباء، كما في كلمات أغنياتهم المليئة بالتحرشات اللفظية، مادام أن الرقص الشعبي قادر على اجتياح وتلوين كل شيء بما في ذلك الفن الذي يقولون له السابع.
إن الشكل الذي يسير به فارس الجن في الفيلم – تأمل اختيار الاسم- متمطياً مزهواً برجولته، وبفائض فهلوته، وبخفة ظل نابعة من طريقة نطق شائهة للكلمات، لا ترسي دعائم فكر جديد، إنما فقط تدلل على وجوده وعلى سيادته.. مسألة عبادة نموذج البطل الشعبي، والإعجاب الشديد بجسمه الذي يأسر النساء ويشعل جنون انتقامهن، وبسلوكياته كلها، ولو كانت معوجة، لأن ثمة مبررات درامية، لا يهم أن تكون ضعيفة، هذا الاستخدام المباشر والمبتور للأسد أول الفيلم، المنسي بقيته، فقط كي يكون هناك رباط مع الاسم، ولأن هذه اللقطات البهلوانية مُحببة.. ثم إن هناك كثيرا من الأحداث المثيرة ، ولو أنها قديمة، وفيها الكثير من التأثر بفيلم أُنتج قبل الآن بأعوام هو “إبراهيم الأبيض” مع الاعتراف بوجود هوة في المستوى الفني للفيلمين، لصالح الفيلم الثاني بالطبع.. كل ذلك لا يهم.
إن محمد رمضان الذي قدم قبل أعوام مع فارس حقيقي للسينما هو يسري نصر الله دورا رائعا في فيلم “احكي يا شهرزاد”، يصنع الآن مشروعه الخاص، وهو اختيار لا يُشترط أن ينجح كل الوقت- ولدينا في محمد سعد مثالاً وعبرة، صحيح أن أفلام السبكي الأخرى، ربما تكون أكثر وهناً من هذا، لكن ذلك لا يمكن احتسابه لصالح “قلب الأسد” إلا في ظروف وأوضاع مقلوبة كالتي نحياها، ليس رمضان فقط الذي سيستهويه هذا الصخب المُربح، لكن أيضاً بالإمكان رؤية مواهب كبيرة بحجم عايدة رياض سيد رجب وصبري فواز في مساحات ضئيلة لا تناسب تفردهم، مع التسليم الكامل بأحقيتهم في اختيار الأثواب التي يفضلون ارتدائها فنياً.
نحن الذين تحدثنا كفاية عن الانسحاق السياسي، كمسبب لتردي الذوق العام، وسيادة تصرفات جماعية مستهجنة، لم يعد سهلاً علينا تفسير هذا التهافت على مشاهدة أفلام لا شيء فيها أصيل، حتى العنوان توليفة من أعمال فنية عديدة سابقة، وعلى إنجاحها بهذا الشكل الذي يستحق دراسة نفسية واجتماعية مستفيضة، في ظل أيام معدودة يصبح فيها التحرش الجنسي، بدلالاته الفكرية والجنسية والحضارية، طقسا من طقوس الأعياد.
إن عملية تسليع السينما بدلاً من تثويرها تتم بإصرار شديد، كما يتم تسليع كل شيء، وكل أحد، بما في ذلك نجوم هذه السينما أصحاب الأعمار القصيرة فنياً.. التاجر هو الرابح الأوحد، ونحن كلنا خاسرون.. ولا يمكن بالضبط التنبؤ.. إلى متى؟