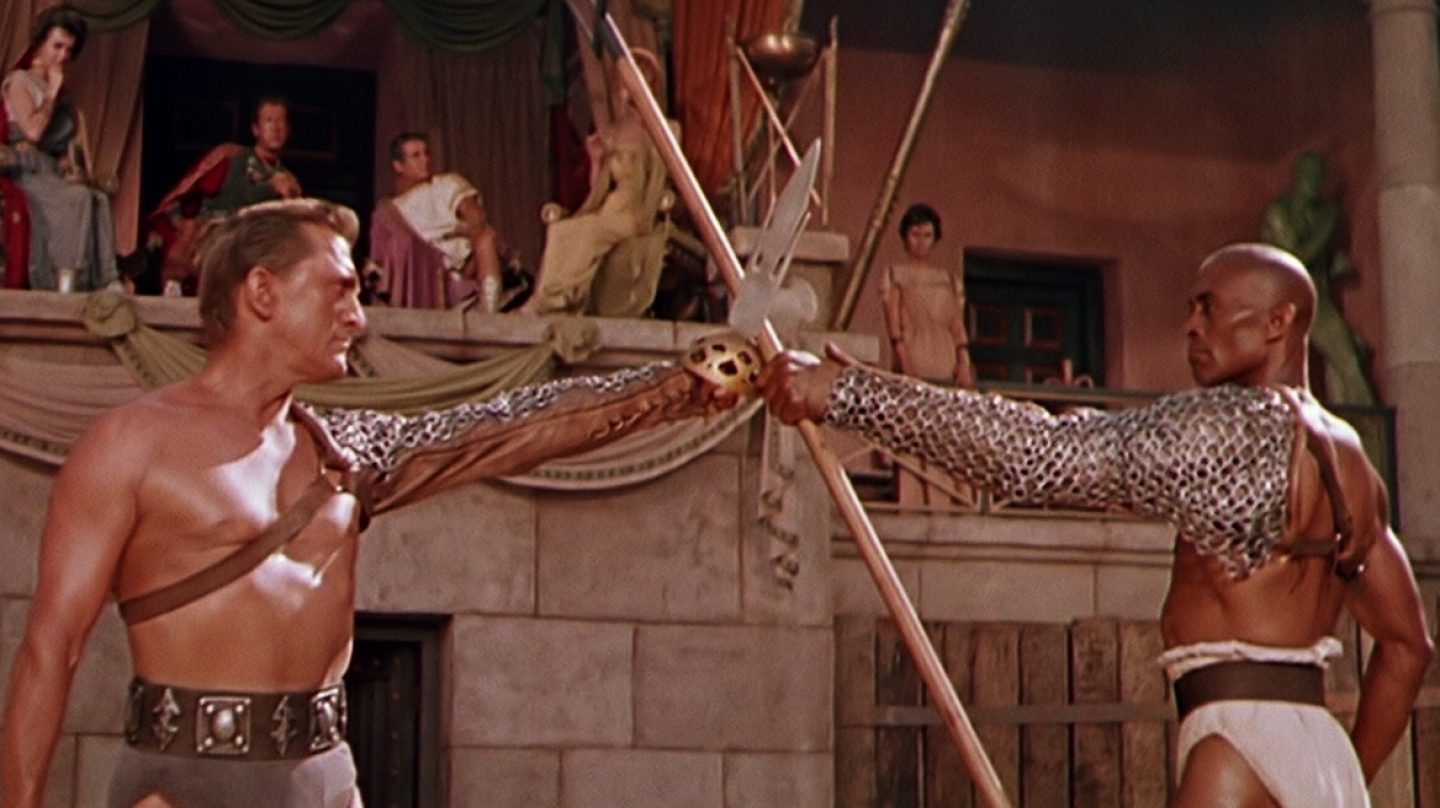“عن يهود مصر”.. حكاية وطن كان يوماً بألوان الطيف

أسوأ طريقة تُصنع بها الأفلام الوثائقية هى جمع المعلومات عن موضوع الفيلم، ثم تكديس الصور والتفاصيل، دون إعادة بناء ما تم جمعه، فى إطار رؤية خلاّقة تقدم فى النهاية رأياً ووجهة نظر حول المادة، وتعيد ترتيبها باستخدام أدوات السينما وعالمها الساحر.
ولكن مخرجاً شابًاً مثل أمير رمسيس أدرك تماماً أن الفيلم الوثائقى هو الرؤية الخلاّقة للواقع، واكتشاف الدراما وسط أكداس المعلومات والصور، ولذلك قدم لنا أحد أهم أفلام موسم 2013 السينمائى، فيلمه الوثائقى “عن يهود مصر”، الذى استقبلته ثلاثة من دور العرض التجارية المصرية، بعد أن كانت قد استقبلت، بعد الثورة، فيلما وثائقياً مصرياً طويلاً آخر هو “التحرير 2011″، أتمنى لهذا التقليد أن يستمر، مما يفتح أفاقاً أوسع لتسويق الفيلم الوثائقى المصرى.
أثار “عن يهود مصر” جدلاً ونقاشاً طويلاً عندما عُرض فى مهرجان الفيلم الأوروبى بالقاهرة، وأثار أزمة عندما تأخر عرضه رغم حصول الفيلم على تصريح الرقابة للعرض، ثم قالت الرقابة إن جهة أمنية طلبت الحصول على موافقتها عند عرض الفيلم تجارياً (مقابل تذاكر)، وأخيراً عرض الفيلم على مسؤولية رئيس الرقابة، لنكتشف أننا بالفعل أمام عمل مؤثر وهام وحافل بالأسئلة والأجوبة، فيه جهد كبيرو واضح (استغرق العمل فيه وفقاً لبعض المصادر أربع سنوات ما بين القاهرة وباريس وتكلف ما يقارب نصف المليون جنيه)، ولكن الأهم من كل ذلك أن هذا الجهد الهائل يجمعه خيط واحد هو الرؤية والمعنى الذى أراد أمير رمسيس أن يقدمهما من اختيار موضوعه (هو أيضاَ كاتب السيناريو وشارك فى جمع المادة وفى المونتاج).
يجتهد الفيلم فى تغطية موضوعه الكبير الذى قدمت فيه رسائل علمية ووضعت فيه الكتب، ولكنه لا ينسى أن يجدل فكرته عن خصوصية يهود مصر فى خيطين هامين يشكلان مغزى الحكاية كلها: الخيط الأول هو مصر الكوزموبوليتانية (التى لم تعد كذلك)، مصر التى كانت بألوان الطيف من حيث الأديان والعقائد والجنسيات، والتى صهرت الجميع فى سبيكة واحدة، فعاشت فى قلب الجميع: مقيمين ومهاجرين.
أما الخيط الثانى فهو أكثر ذكاء وعمومية لأنه يشن حرباً واضحة ضد ثلاثة أشياء هى: الجهل والتعصب والتمييز، أعداء أمير رمسيس ليس شخصاً بعينه، ولكنها هذه الأفكار الفاسدة التى تجعل الآخرين يمارسون ضد غيرهم القهر والعزل سواء بقوا فى بلادهم أو غادروها، هذا هو العنوان العريض الإنسانى الذى جعل الفيلم مؤثراً للغاية مهما تناقشنا حول معلوماته أو أفكاره.
اليهودى والصهيونى
أرجو أن تلاحظ أن بناء السيناريو، وهو متماسك الى حد كبير، ليس فى حقيقته سوى ترجمة لهذه الخيوط الثلاثة ممتزجة ومختلطة. هناك مقدمة سريعة أقرب الى الاستطلاع العشوائى، السؤال عن اليهود المصريين، أما الإجابات فهى متناقضة، البعض يعرف أن اليهودية ديانة بينما الصهيونية عقيدة سياسية، والبعض يشمئز عندما يعرف أن ليلى مراد يهودية، فوضى معرفية يتخذها الفيلم نقطة البداية، وكأن أمير يقول لنا: من أجل هذا صنعت الفيلم، تعالوا نحارب الجهل والتعصب، لنكتشف الآخر الذى لم نعرفه.
ينطلق السرد بعد ذلك الى حالة من الجدل متواصل بين مصر وفرنسا، فى باريس مجموعة من اليهود المصريين الذين هاجروا فى الخمسينيات أو الستينيات من القرن العشرين، أو أولادهم و أحفادهم، وفى مصر مجموعة من الباحثين والمؤرخين، فى باريس كلمات من القلب وحنين الذكريات وصور من ألبوم العائلة، وفى مصر رصيد هائل من المعلومات تروى حكاية يهود مصر من الإزدهار الى الشتات (وهو بالمناسبة عنوان كتاب هام للدكتور محمد أبو الغار أحد أبرز ضيوف الفيلم ومصادره).
فى باريس صوت البيانو مثل مطرقة تدق ناقوس الذكرى وتفتح أبواب الشجن، وفى مصر ضربات العود وكأنها ترانيم قديمة منسية (موسيقى تصويرية مميزة ومؤثرة ومعبّرة لهيثم الخميسى)، فى أحيان كثيرة تذوب المسافة بين باريس ومصر، وبين الماضى والحاضر، فيتعانق البيانو مع العود، ولكن الجدل بين باريس ومصر مستمر من أول الفيلم الى آخره، ومثلما يبدأ الفيلم بمصريين يحاولون الإجابة عن سؤال حول ماهية يهود مصر، ينتهى الفيلم باسرة يهودية مصرية تحاول أن تغنى أغنية مصرية مازالت فى الذاكرة، وبين المحاولتين تتبلور الرؤية من خلال المعلومات، تتزاحم مواد فيلمية قديمة (هجرة اليهود الى فلسطين، خطاب تأميم القناة)، وصور أرشيفية (مشاهير اليهود المصريين من يعقوب صنوع الى ليلى مراد)، وعلى شريط الصوت أغنيات قديمة وخطب زعماء، وفى أجزاء قليلة نستمع الى صوت المعلق (محمد سليمان)، وإن كنت أرى أن الفيلم لم يكن بحاجة إلي تعليق على الإطلاق، وخصوصاً أن صاحب الصوت انتهك فى دقائق قليلة قواعد النحو، فرفع المفعول ونصب الفاعل ودشدش العبارات والجمل.
أردتُ فقط أن أقول فى البداية إن أهمية فيلم “عن يهود مصر” ليست فقط معلوماتية، ولكنها بالأساس مرتبطة بالطريقة التى تم بها بناء الفيلم كوحدة واحدة (صوت وصورة ومونتاج وموسيقى) توظيفاً لهذه المعلومات. قد تجد المعلومات فى الكتب، ولكن الفيلم التسجيلى أكثر تعقيداً من ذلك، انه يدرس أولاً هذه المعلومات، ثم يحدد الرؤية تجاهها، ثم يوظف أدوات السينما لعرض المعلومات ممتزجة بالرؤية.
سفر الخروج
من باريس تتزاحم الأسماء والوجوه والذكريات: ألبرت أرييه، جويس بيلو، روث براوننج، جيرار دوبوتون، إيزابيل دوبوتون، إيلى حكيم، إلين كوفال، أندريه حزّان، ومن مصر تتوالى الشهادات: الدكتور محمد أبو الغار، المؤرخ الراحل أحمد حمروش، الباحث عصام فوزى، المؤرخ الدكتور رفعت السعيد، الإخوانى المخضرم على نويتو، السيدة نولة درويش ابنة الراحل يوسف درويش، هناك ربط دائم بين كلمات باريس، ومعلومات مصر، والسرد يتحرك مثل الشكل التقليدى للدراما، البداية والوسط والنهاية، الهجرة والاستقرار، ثم الأزمة وصولاً الى سفر الخروج.
ربما تلكّأ السرد طويلاً عند شخصية مصرية يهودية هامة جداً هى هنرى كورييل أحد مؤسسى الحركة الشيوعية المصرية، فأصبح لدينا فيلم قصير عنه داخل الفيلم الأصلى، هو يستحق فى الحقيقة فيلماً طويلاً كاملاً، ولكن البناء عموماً كان متوازناً سواء فى الإنتقال بين مصر وباريس، أو فى حجم كل مرحلة تاريخية وشخوصها، أو فى الإنتقال السلس من مرحلة تاريخية الى أخرى.
فى شهادات باريس لحظات مليئة بالنوستالجيا، والمشاعر الصادقة: تلك المصرية اليهودية التى انتمت الى الحركة الديمقراطية المصرية (حدتو)، والتى سجنت وطردت من مصر بعد حرب 1956، ولكنها ظلت تتواصل مع مجموعة روما التى كونها هنرى كورييل فى أوربا، ثم أخذت منه خطة حرب 1956 وسلمتها الى الراحل ثروت عكاشة، فسلمها بدوره الى عبد الناصر، ألبرت أرييه ومعاناته مرتين، مرة كشيوعى فى سجن الواحات، ومرة كيهودى يشعر بالتمييز لأنه تزوج من مصرية مسلمة، رغم أنه أعلن إسلامه، تلك الحكاية الطريفة عن المصرى اليهودى العائد، الذى أصرّ على وضع الزهور على قبر عبد الناصر، وكتب علي ورقة :”شكراً لك، فلولاك ما أصبحت مليونيراً”، قصة المصرى اليهودى الذى رفض مغادرة مصر، ورفع قضية من فرنسا لاسترداد جنسيته، حكايات كثيرة عن توقيع المغادرين بعد 1956 على إقرار بعدم العودة، والتنازل عن الجنسية.

فى الشهادات الباريسية صور ليهودى مصرى بملابس العسكرية المصرية، جيرار دوبوتون يغنى لأم كلثوم “غنى لى شوى شوى”، ويترجمها الى الفرنسية، يحكى عن رحلة عودته لزيارة منزلهم القديم فى الاسكندرية، وعن زيارته الى المستشفى الإسرائيلى الذى ولد به، والذى تحول الآن الى مستشفى الطلبة، أخته إيزابيل تحكى عن مشاركتها الطاهر ومبروكة، العاملين لدى أسرتها، طقس الصوم فى شهر رمضان، حكاية الابن غير الشرعى لهنرى كورييل، ونضاله دفاعاً عن مصر والجزائر والفلسطينيين، حكاية قصره بالقاهرة الذى منحه ليكون مقراً للسفارة الجزائرية، ولغز اغتياله فى باريس فى مايو 1978.
يتوازن هذا الجزء الباريسى العاطفى والذاتى، مع شهادات مصر التوثيقية: الدكتور محمد أبو الغار يقدم الفروق الدقيقة بين يهود مصر، ويفرق بينهم من حيث الطائفة أو مكان الهجرة (سفارديم وأشكناز) أو المستوى الإقتصادى والإجتماعى، طائفة اليهود القرّاءين مثلاً لم يكن أحد يستطيع أن يميز بينها وبين المصرى العادى، ومن هذه الطائفة مشاهير كثيرون مثل عائلة دواود حسنى وليلى مراد، مردخاى والممثلة الراحلة نجوى سالم، يتحدث أيضاً عن فشل حاييم وايزمان عند زيارته الى مصر عام 1902 فى جذب يهود مصر الى المشروع الصهيونى، ويحدد عام 1935 كنقطة تحول ضد يهود مصر بسبب تسليح المستعمرات الصهيونية على أرض فلسطين، ثم يتزايد العداء عام 1947، وتبدأ جماعة الإخوان المسلمين سلسلة من الاعتداءات على حارة اليهود، ومتاجر المصريين اليهود، ويعتذر الملك فاروق عن ذلك، ويأمر بتعويض المضارين، ولكن الكثيرين يخرجون، يتجهون الى أوربا وليس الى إسرائيل التى كانت ما زالت دولة ناشئة، البعض ذهب الى إيطاليا وفرنسا واسبانيا واستراليا، بل إن شيكوريل، صاحب المتاجر الشهيرة، نقل استثماراته الضخمة الى أفريقيا.
فى الشهادات المصرية حكايتان عن اثنين من يهود مصر الشيوعيين الرائعين اللذين رفضا مغادرة مصر: يوسف درويش محامى العمال والفقراء، وشحاتة هارون المحامى وعضو حزب التجمع، الذى رفض اتفاقية كامب ديفيد، والذى رفض فى وصيته أن يصلى عليه حاخام من إسرائيل، إبنة يوسف درويش تقول إن بعض اليهود المصرين تعرضوا للطرد من منازلهم فى شارع يوسف الجندى بعد حرب 1956، ولكن والدها قام بتأنيب ضابط بوليس مصرى حاول أن يطرده، وقال له: “أنا مصرى أكثر منك”، نسمع حكاية وعد كورييل بالحصول على الجنسية المصرية جزاء خدماته دون أن ينفذ ذلك، يتعرّض الفيلم لتفصيلات فضيحة لافون التى جعلت المصريين يشكون فى اليهود، ويعتبرونهم مشاريع جواسيس متنقلة.
حربان وملاحظات
يكاد ينعقد الإجماع بين باريس ومصر على أن ظهور اسرائيل، وتحقيق المشروع الصهيونى، كان بداية مأساة يهود مصر، لم يكن هناك فى البداية إدراك لهذا الخطر الصهيونى، لدرجة السماح بمظاهرات يهودية فى مصر تؤيد وعد بلفور، والى حد مشاركة وفد مصرى برئاسة رئيس الجامعة المصرية أحمد لطفى السيد فى حفل افتتاح الجامعة العبرية، والى حد أن اليهودى ليون كاسترو، احد أصدقاء سعد زغلول، قام بتأسيس الإتحاد الصهيونى المصرى، ولكن الخطر أصبح واضحاً بعد حرب فلسطين، وبعد صعود جماعة الإخوان وحزب مصر الفتاة، ثم جاءت حرب 1956 لتكمل الصورة، لاشك أن كل ذلك صحيح، وإن كانت هناك بعض الملاحظات على هذا الجزء، فقد كان يجب الإشارة، ولو سريعاً، الى دور الصحافة الصهيونية فى مصر، والى مصير القلة اليهودية التى هاجرت واستقرت فى اسرائيل (كان منهم مثلا ابن الموسيقار داوود حسنى)، كان ضرورياً فى رأيى ايضاً الإشارة الى ارتباط هجرة اليهود فى الستينيات بفضيحة أخرى هى تورط إسرائيل فى محاولة قتل خبراء الصواريخ الألمان.
أما ملاحظات الجزء الباريسى فهى خاصة بالطريقة التقليدية التى سجلت بها شهادات الشخصيات فى معظم الأحيان، حيث الكاميرا الثابتة مع تغيير قليل فى حجم اللقطات، وباستثناء مشاهد عشيقة كورييل العجوز، واستعراض بعض صور إيلى حزان فى منزله، ولقطات من الشارع الذى قتل فيه كورييل، وجلسة لأسرة دوبوتون وهى تغنى، لم نشعر بحضور المكان، ولا بحيوية اللحظة، ولا بحساسية الكاميرا عند لحظات التأثر، ورغم كل ذلك، فقد كان واضحاً أن أمير رمسيس واع تماماً الى أن تعاطفه منحصر فى دائرة اليهود المصريين الذى خرجوا خوفاً أو طرداً دون جريرة، والذين وقعوا ما بين سندان همجية وعنصرية وعدوانية وتعصب إسرائيل، ومطرقة النظام الأمنى البوليسى فى عهد عبد الناصر، والذى طال المصريين مسلمين ومسيحيين أيضاً وليس اليهود فقط .
الفيلم متعاطف فقط مع هؤلاء، إنه بالتحديد عن الذين لم يهاجروا الى إسرائيل، والذين يقولون حتى اليوم أنه لولا الظروف السياسية لما تركوا مصر ابداً. التعاطف هنا لايمكن أبداً تجاهله، لأنه يتعلق بحق الإنسان فى ألا يترك بلده، وحقه فى الحفاظ على جنسيته، وحقه ايضاً فى أن يحاكم أو يدان بطريقة عادلة، وليس بطريقة عشوائية تجمع فى قيد واحد بين مصرى يهودى متورط، ومصرى يهودى معاد للصهيونية!
يمس فيلمنا قلب متفرجه بهذه الرؤية الإنسانية الواسعة، ينطلق من خصوصية اليهود المصريين الى إنسانية القضية والمعنى، لا يدافع الفيلم عمن اختاروا وطناً آخر، أو من ذهبوا ليقتلوا الفلسطينيين، أو من انضموا الى الحركة الصهيونية من الشباب المتعصب (وهم قلة)، ولكنه يدافع عن المناضل العجوز الذى يقول أنا مصرى يهودى ولست يهودياً مصرياً، والذى قام بتدريب المسجونين فى سجن الواحات على السلاح لمقاومة العدوان الثلاثى، يدافع عن إسهام اليهود المصريين فى الإقتصاد المصرى وفى النضال الوطنى (مع الأسف لم يتوقف الفيلم عند دور يوسف قطاوى باشا وأسرته فى مقاومة الحركة الصهيونية).
لا أعتقد أيضاً أن الفيلم كان متجنياً على التجربة الناصرية، فقد أسس عبد الناصر بالفعل نظاماً أمنياً صارماً لا يمكن إنكار تجاوزاته، ولكن الفيلم يذكر بموضوعية أن عبد الناصر ألقى خطاباً بعد فضيحة لافون أوضح فيه الفارق بين اليهودى المصرى الوطنى والصهيونى المخرب والجاسوس، يُذكر للفيلم أيضاً إشادته بتسامح محمد نجيب، وزيارته الشهيرة للمعبد اليهودى، وإصراره على استيراد الدقيق من الخارج ليصنع منه اليهود المصريون طعامهم الشرعى (الكوشير)، وإجباره الشيخ حسن الباقورى على الإعتذار لليهود عن أحاديثه الإذاعية المسيئة لهم ولعقيدتهم، وبالمناسبة، فإن محمد نجيب كان من أبطال حرب فلسطين، وأصيب فى معاركها إصابات بالغة، وحصل فيها على أعلى الأوسمة، ولكنه كان يستطيع التفرقة، رغم ذلك، بين اليهود الذين حاربهم فى فلسطين، واليهود الذين يعيشون فى وطنهم مصر.
ربما افتقدتُ فى الفيلم الهام مشاهد عن تغيّر صورة اليهودى فى السينما الروائية المصرية مما كان سيوضح بذكاء ما فعلته التحولات السياسية، ولكنك تستطيع أن تتحدث، رغم الملاحظات، عن عمل ناضج متماسك، له رؤية ووجهة نظر، يمزج ببراعة بين الخاص والإنسانى والعام، أحسست أن أمير رمسيس يتجاوز الطائفة والدين رغم أنه ينطلق منهما، لكى يتحدث عن معنى أن يكون التسامح وطناً، وأن تكون المواطنة ديناً، إدانته واضحة لا لبس فيها لمشروع صهيونى يحول أرض الغير الى مستعمرة عنصرية، ورفضه واضح لا لبس فيه لأى نظام بوليسى يسلب حقوق مواطنيه تحت لافتات سياسية أو قومية أو حتى أمنية، وانحيازه الرائع لاشك فيه للإنسان، وأحلامه المشروعة بألا يتعرض للظلم أو التمييز بسبب الجهل أو التعصب أو حماية الأنظمة الحاكمة.
يقول فيلم “عن يهود مصر” إن أحداً لا يستطيع أن يقتل وطناً يعيش داخل الإنسان، ولا يستطيع أن ينسيه ظلماً وقع عليه، إنه ليس فيلماً عن طائفة، ولكنه فيلم عن وطن كان يوماً بألوان الطيف، فلما خسر ألوانه، أصبح يعانى اليوم من كآبة الأبيض والأسود.