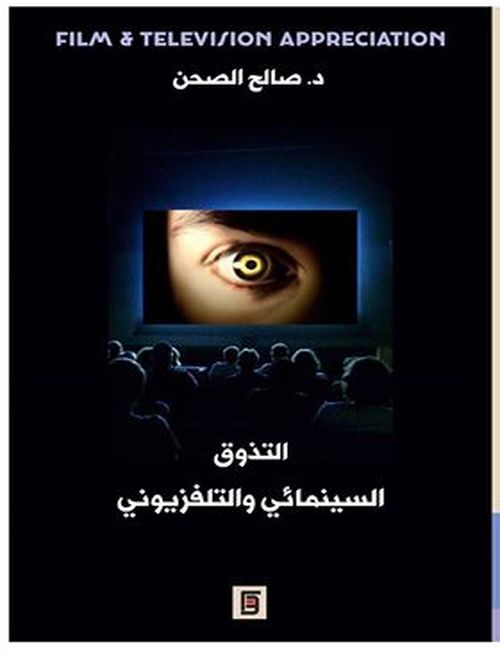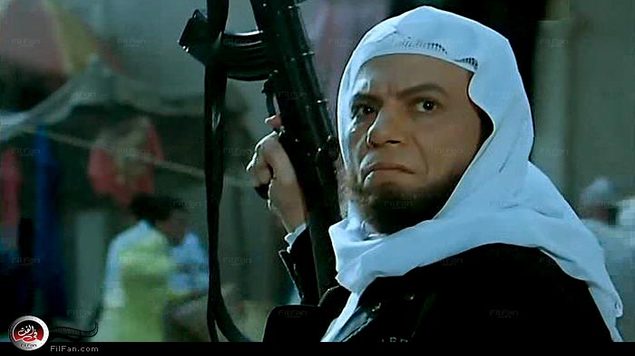عن السينما والعنف.. تسـاؤلات في الإعلام المغربي

كثيرا ما تساءلت عندما تتبعت الحلقات الاولى لبرنامج “مختفون” أو حتى الظهور الأول لبرنامج “مداولة” في القناتين المغربيتين، عن ما توفره هذه البرامج كقيمة، من تقريب بعض الحالات والمعاناة الى المجتمع المغربي؟
ومما لاشك فيه، أن أغلب المتتبعين تساءل وتعاطف وقتها مع مشاهد ما عانته بعض الأسر، إما بحالة اختفاء أو عنف أو حتى سرقة واغتصاب. كما استفاد من ذلك، علماء الاجتماع والمتخصصون في علم النفس وفي القضاء وحتى الإعلاميون (شكلا ومضمونا) وحتى المواطن البسيط، تتبع هموم غيره.
لكن ما الذي تشكله هذه البرامج ومثلها إعلاميا وسينمائيا؟ هل يستفيد “المخرج المغربي”، إما بقصة او بفكرة، بما تطرحه هذه القضايا؟ وهل تنقل تجربة رصد المشاكل وإعادة تمثيلها المشاهد الى عالم الاحتمالات أم الى واقع الحقيقة؟ وما الذي يمكن أن تضيفه إلى الشأن الثقافي؟
عرفت جدلية الثقافة والاتصال جهودا ونقاشات كلما اكتشف الإنسان وسيلة اتصال تمكنه من معرفة ما حوله. وظهرت في فترات موازية أفكار عن سلطة وهيمنة وسائل الاتصال، لما تحمله من ازدواجية التحرك؛ الاستهلاك والربح. أي مدى التجاوب معها والإعجاب بالمنتـج (في الراديو، التلفزيون، السينما،…). لكن ألا يُعـرِّض منطق البحث عن طرق التجاوب الثقافة إلى الخطر، كما تساءل “بيير بورديو”؟ لتجعل قوانين السوق كل الامور تتساوى… وأن لا شيء له قيم.
بعد عرض فيلم “قتلة بالفطرة“، للمخرج الأمريكي اوليفر ستون سنة 1994، تم منع الفيلم في أيرلندا، ومنعت إعلاناته في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لكثرة مشاهد العنف الدموية التي توحي مع الوقت أنه أمر عادي، فالقتلة في بعض المشاهد احتفل بهم على أغلفة المجلات ونالوا شهرة إعلامية، بالإضافة إلى المشاهد العنيفة والدموية. مما أوحى للكثير من الناس بفكرة ارتكاب جرائم من أجل الاحتفاء بهم والظهور في التلفزيون مستخدمين نفس حوار الفيلـم. وهو الشيء الذي جعل من رسالة الفيلم، حسب النقاد، غير أخلاقية.
وقد ارتكبت بعد عرض الفيلم، أكثر من 12 جريمة في أمريكا وخارجها. والأمثلة كثيرة على أفلام منعت لنفس السبب ولأسباب اخرى؛ لكثرة مشاهد العنف وتجسيدها لطرق التعذيب والايحاءات الدموية. على سبيل المثال لا الحصر؛ فيلم “المحاربون” 1979، وفيلم “مايكي” 1992، وفيلم “الرجل ذو الأربعة والأربعين قدما” 2009.
الاحتفاء بالعنف اعلاميا، هو ما يجعلنا نراجع ما بثته القنوات المغربية وما تعرضه من برامج لحد الآن، لنجد نسبة كبيرة منها تطغى على الاعلام، من الإجرام إلى تمثيل للعنف إلى للصراعات بين الإنسان والإنسان (من قريب أو بعيد). وفي السنوات الأخيرة لوحظ هذا الأمر في القنوات مثل: “أخطر المجرمين”، “مسرح الجريمة”، “المحققون”، “مختفون”، “الخيط الأبيض”، “ملفات بوليسية” (بالإذاعة)، “مداولة”… والقائمة قد تحتمل المزيد عند أصحاب القرار. وكأن حـالنا لا يدل إلا على الصراعات!
وتدخلنا هذه الأمثلة في الحيرة ما بين أن لا نعرض هذا الشكل من البرامج والأفلام عن الجريمة والعنف، ونستفيد من تحويلها سينمائيا وثقافيا؟ أو أننا نعرضها كواقع وتجارب منقولة ويتم معالجتها سينمائيا بكل مشاهدها؟ قد تتقاطر الأسئلة عن المجتمع المغربي، لكن وصولنا الى البحث عن الأجوبة سينمائيا قد يفكك بعضا منها؛ انطلاقا من طريقة الإخراج أو فكرة الفيلم أو واقع الفيلم !ويحق لنا إثـارة ما يثير المشاهد المغربي، للأفلام أو البرامج الاعلامية، الاحتفاء بالعنف وبالجرائم والرعب النفسي؟ وكيف يمكن تجنب العنف في الإعلام دون إغفال النظر عن الواقع المليء بمشاهد العنف اليومية؟ وهل للسينما دور في ذلك إذا ارتبطت إبداعاتها بالراديو والتلفزة والانترنت..؟ ما دور الاعلام في الجرائم أو الثقافة؟
كثيرة هي الاسئلة التي تدخل المتتبع، للإعلام المغربي عموما، إلى عالم النظريات والواقع التواصلي والثقافي لهذا المنتوج، صوتا كان او صورة.
ولهذا قد نجد السينما، وحسب الناقد السينمائي أمير العمري كونها “فن تعرية، تعري القشرة الخارجية الزائفة حول الواقع وحول الإنسان في الواقع… ومهما بلغ الفيلم في تصوير الحياة إلا أنه ليس بديلا عن الحياة، فالسينما ليست هي الواقع، وليست محاكاة للواقع، بلرؤية للواقع، حالة فلسفية لمعنى أن نحيا وأن نشاهد وأن نتأمل“. ولعلنا بعد ذلك، نخرج إلى الحياة ونحن أكثر قدرة على الفهم والمعرفة، وعلى الاستمتاع.
لم يخل أي فيلم عن الجريمة أو القتل… وحتى الانتحار، محكم الشكل والمضمون، من مشاهد وإيحاءات (نفسية أو جسدية)، أثرت، من خلال تصويرها لأحد تجليات العنف أو الإجرام، على شريحة واسعة من المشاهدين، ولاسيما فئة الأطفال والشباب، كما تنقله قنوات العالم (اليابان، امريكا، المانيا،..) لحالات من شدة التأثر.
وفي المغرب سمعنا أو لم نسمع عن حالات تأثرت بمشاهد من افلام او برامج، فإننا نجد البرامج مأخوذ مضمونها من الواقع المعيشي، أي أن صناعته الإعلامية (أغلبها برامج وليست أفلام سينمائية) هي؛ من ناحية الشكل تعـد أمرا مقبولا ولائقا، لكن اذا وقفنا معها من ناحية المضمون، نجد أن الأمر يوحي بواقع اجتماعي أو نفسي مضطرب. ولا يتطلب الأمر قلب الصورة أو المضمون، بل توظيف “التوليفة البصرية- السمعية” لتخدم الجانب الثقافي للمجتمع، وقد لا يتـم ذلك إذا لم نهتم بالسينما باعتبارها “توجد في قلب الحياة، لكنها ليست بديلا عنها، والحياة بدون السينما تجربة ينقصها الكثير من الحياة”، ولكي لا يغدو طابع الجرائم كواقع وليس استثناء يقع على شكل حالات.
أصبحنا نعيش نقـصا في المعطى الإعلامي، أولا بما يفرضه أصحاب القرار، أو بما ينقصنا من ناحية الإبداع الذي يخدم المجتمع والقضية الثقافية، فالمسئول في المغرب تنقـصه المادة المنتـَجة، والسينمائي يشكو ضعف الطاقة الأولية للإبداع. وبذلك يغدو تضادا بين الطرفين، فتقف عجلة الإنتاج الإبداعية في نفس المكان على أنها الصورة النهائية (الأفلام الرديئة نموذجا). وثانيا بما توفره المواد والبرامج حين تجاري هيمنة الخيال “العنفي” الذي تمنحه وسائل الإعلام المغربية، مجانا، للمتلقي.
ولهذا قبل أن نعتمد على الثقافة والسينما للخروج من هيمنة “واقع الصراع” يجب ترسيخ ثقافة السينما، الكتاب، المسرح، الفن، وليس “مَهرَجنتها” والاكتفاء بأشكال فعالياتها.
وصدق الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي حين قال: “إذا سمعت بمهرجان الشعر، ومهرجان السينما في العالم العربي.. فاعلم أنه يحضر المهرجان ويغيب الشعر والسينما، لأن المسئول العربي لاتهمه الثقافة”.